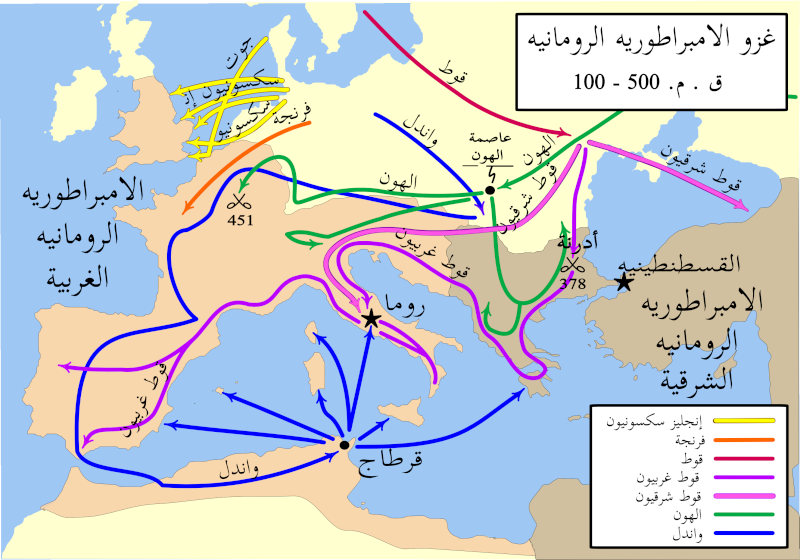محمد شعبان صوان
ساد الحديث زمناً عن "الاحتلال العثماني" وبعضهم زايد بصفة "الاستعمار التركي" للبلاد العربية، ونال القطر المصري نصيباً موفوراً من التهم التي صبت على الدولة العثمانية ووصفتها بالاستغلال استناداً إلى ما سطره المستشرقون، وراج الحديث عن استغلال تركي بالتبعية والجزية والتجنيد، وطال زمن الاتهامات إلى وقت قريب، ولكن بعد التحري وفتح السجلات تبين أمر آخر مغاير تماماً لما ساد الاعتقاد به دهراً طويلاً، فماذا قال المؤرخون المحدثون؟ وما هي أحكامهم المستجدة والموثقة؟ نبدأ بالتسلسل:
* السلطان والمستشرق
وسم العداء علاقة الغرب بالدولة العثمانية طالما كانت الدولة قائمة سواء في وضع يهدد أوروبا كما كان الحال عندما كان العثمانيون في طور قوتهم، أو في وضع التراجع والضعف كما كان حالهم في القرن الأخير من عمر دولتهم، واستمر هذا العداء حتى لحظاتها الأخيرة عندما اشتبكت في الحرب الكبرى ضد الحلفاء وانتهى الأمر بإصرارهم على القضاء على الخلافة الإسلامية كما سبق شرح ذلك في دراسة: علاقة الغرب بإلغاء الخلافة الإسلامية.
كانت الدراسات الاستشراقية في ذلك الزمن تمارس دورها في تسويغ الهيمنة الغربية على الشرق المكون أساساً من الدولة العثمانية، وكان هذا التبرير يتم بتحريف صورة الآخر بما يناسب عملية مواجهته أو السيطرة عليه بآليات سبق شرحها في دراسة: أدوات الاستئصال المعرفي: كيف يؤدي الاستشراق وظيفته التحريفية؟ .
وكما هي عادة الغرب الذي يصحو ضميره بعد فوات الأوان ويكتشف حقيقة ضحاياه بعدما يفرغ من عملية القضاء عليهم، حدث للدولة العثمانية كما حدث للهنود الحمر، إذ اكتشفت الدراسات الأكاديمية الأوروبية كثيراً من الجوانب الإيجابية فيها بعد انقضاء عهدها وزوال عمرها، وبدأ المستشرقون بفتح السجلات والوثائق في أرشيف الرجل المريض الذي توفي ليكتشفوا أنه لم يكن وحشاً كما تصوروه أو بشعاً كما ظنوه، وفي ذلك يقول المؤرخ العربي زين نور الدين زين: "إن معظم الذين ألفوا في التاريخ التركي لم يكونوا يجهلون وفرة الوثائق التاريخية التي يجب أن يطلع عليها الباحث في هذا الحقل وحسب وإنما كانوا، بصورة عامة، على كثير من التحيز والتعصب. فقد كتب هارولد بوون (Harold Bowen) يقول [1945]: "... فيما يتعلق بالتعاميم الجارفة التي كانت تصدر عن بعض الكتاب الذين عالجوا القضية فإننا نلاحظ أن معظمهم كانوا يخبطون خبط عشواء أو أن التعصب كان يخفي الحقيقة عن أبصارهم،[1] ويقول الأستاذان هرولد جب (Harold Gibb) وهارولد بوون (Harold Bowen) في مقدمة كتاب "المجتمع الإسلامي والغرب" (Islamic Society and the West) [1969] "إن كثيراً من الآراء الشائعة فيما يتعلق بتاريخ تركيا ومصر في القرن الثامن عشر هي آراء خاطئة، آراء كنا نحن أيضاً نأخذ بها عندما أقدمنا على كتابة هذا البحث. ولذا نرى واجبنا الأول هو عرض الوثائق والمعطيات التي جعلتنا نبدل رأينا في هذا الأمر تبديلاً تاماً".[2]
ويقول المؤرخ الفرنسي روبير مانتران [1969]: "ظلت الفترة العثمانية من تاريخ مصر، تعامل كما لو كانت أحد الأقارب الفقراء لهذا التاريخ. وحين نتصفح المؤلفات التي تناولت هذه الحقبة، فإننا نلاحظ أن تناول حقبة كهذه بلغت ثلاثة قرون من تاريخ مصر، قد اقتصر - حتى عهد قريب- على عدة فصول هزيلة، كما أنه كان يتم من زاوية لا تقدم إلا كل ما يثبط الهمم، ويعود هذا إلى حقيقة أننا ظللنا نعتمد أساساً ولفترة طويلة على يوميات أو حوليات لم تكن تقدم عن التاريخ الحقيقي لمصر إلا بعضاً من الأخبار البالغة السطحية كما يعود بالمثل إلى أن مؤرخي الإمبراطورية العثمانية في القرن التاسع عشر - وخاصة ابتداء من جوزيف فون هامر (Joseph Von Hammer)- قد اقتصر تناولهم لتلك الحقبة على أحداثها العارضة فكانوا يلحون بشدة في بعض الأحيان على الاضطرابات والاغتيالات وحوادث العصيان والتمرد.. إلخ الأمر الذي جعل العثمانيين يبدون في أسوأ مظاهرهم مما ساهم في اتهامهم بأنهم قد أغرقوا مصر في فوضى سياسية واضطراب مالي، وبأنهم جروا إليها الخراب الاقتصادي منذ مجيئهم وحتى قدوم حملة بونابرت".
ثم يتحدث عن الذين يجعلون من الحملة الفرنسية بداية لتجديد مصري لأنه لم يكن هناك شيء في مصر قبل هذا التاريخ "لكن الواقع يثبت عكس ذلك"، لقد ظهر إلى النور قبل تاريخ الحملة الفرنسية تيارات تجديد دينية وثقافية عديدة، ونحن مدينون لمؤلفات حديثة عن مصر العثمانية أعطتنا معرفة أقرب "نتيجة لاكتشاف ودراسة وثائق الأرشيف" مثل مؤلفات جان ديني قبل أربعين عاماً من كتابة هذا الكلام [أي منذ نهاية العشرينيات] الذي كان "أول من أرسى دعائم تاريخ بالغ الجدة والعمق بدراسته: موجز الأرشيف التركي بالقاهرة" ثم أكمل مسيرته "وبأستاذية فذة" المؤرخ ستانفورد شو بدراسته عن النظام المالي والإداري في مصر العثمانية [1958].[3]
وجاء في التعريف بكتاب "المدن العربية الكبرى في العصر العثماني" للمؤرخ الفرنسي أندريه ريمون [1985]: "أندريه ريمون، مؤلف هذا الكتاب، يعد مرجعاً أساسياً لكل الدارسين والباحثين في التاريخ الاجتماعي- الاقتصادي والعمراني للعالم العربي بفضل معرفته الوثيقة به وبفضل عديد من الدراسات الميدانية الجادة التي أنجزها.
"وفي دراسته هذه، الأولى من نوعها، ينطلق المؤلف من نقطة بدء جديدة كل الجدة: فالمدن العربية الكبيرة: القاهرة وحلب ودمشق وبغداد والموصل والقدس وتونس والجزائر، شهدت أثناء العصر العثماني ذروة تطورها حيث تأصلت العمارة العربية وأثْرت، وتعزز الاستقلال الذاتي للجماعات المختلفة نتيجة لتنظيمها على أسس مهنية وعرقية ودينية، في ظل تجارة مزدهرة، وطوائف مهنية قوية" (الناشر).[4]
وكتب الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم وهو يؤرخ للاهتمام بالتاريخ العثماني في مصر أنه بدأ في نهاية القرن التاسع عشر لتوضيح الدور الذي قامت به الدولة العثمانية الإسلامية في تاريخ الكثير من البلاد العربية، ولكن هذه الكتابات الأولى اعتمدت على الكتابات الأوروبية السابقة عليها دون الاعتماد على كتابات العصر ووثائقه، وكانت تلك الكتابات الأوروبية التي اعتمدوا عليها من كتابات بداية العصر الاستعماري وهدفها أن تثبت للعرب أن الدولة العثمانية سبب تخلفهم، وذلك لتمهيد الطريق للاستعمار الذي كان يتطلع إلى بلادهم، إلى أن بدأ حال الدراسات العثمانية بالتغير مع الأستاذ محمد شفيق غربال في منتصف ثلاثينيات القرن العشرين والذي دعا إلى الاهتمام بتاريخ مصر العثماني وتنقيته مما شابه من افتراءات.[5]
وفي هذا الموضوع أيضاً يقول الدكتور رءوف عباس إن العصر العثماني في مصر عانى من الإهمال وقلة اهتمام المؤرخين العرب والمصريين لأسباب منها انبهارهم بالتغيرات التي حدثت في زمن محمد علي باشا وميلهم إلى تفسيرها بالمؤثرات الحضارية التي جلبتها الحملة الفرنسية التي حركت "الركود" الذي عانت منه مصر في العصر العثماني، وهو اتجاه روجه المستشرقون ومن تأثر بهم من مؤرخين صاحبوا نشأة الجامعة المصرية، فتأثرت الكتابات المحدودة عن العصر العثماني بما أشاعته المدرسة الاستشراقية من صفات الجمود والركود والاضمحلال والتخلف التي لصقت بالمجتمع العربي على تبايناته والمجتمع المصري خاصة نتيجة إهمال المصادر الأولية والركون إلى التعميمات الاستشراقية حتى نشأت أجيال صاعدة فتحت الوثائق والسجلات ونقدت المفاهيم الاستشراقية ودحضتها وبينت فساد استنتاجاتها عن العصر العثماني، وهو ما جعلنا نشعر بالحاجة إلى إعادة اكتشافه بل إعادة النظر في فكرة الحداثة نفسها والبحث عن عوامل التطور الذاتي في مجتمعنا والتي لم يكن الغرب باعثاً إياها بل معرقلاً لها.[6]
وسأورد فيما يلي من صفحات مقتطفات من الآراء الجديدة التي توصلت إليها المدارس الحديثة لاسيما الآراء العربية، والمصرية خاصة، التي بنيت على دراسة الوثائق فيما يتعلق بموضوع البحث الحالي دون الادعاء أنني سأتمكن من حصرها فالمهم هو الإشارة إليها لبيان عمق الهوة التي تفصل العلم الحديث عن مدعي تقليد الغرب في بلادنا والذين ما زالوا يرددون أقوال الاستشراق القديم لأنها تلبي حاجات برنامجهم التغريبي الذي لا يرون له استقراراً إلا بشيطنة تاريخ الإسلام ولو بطريقة تخالف الأعراف العلمية المعمول بها لدى سادة الغرب أنفسهم.
* مكانة مصر العثمانية
يقول المؤرخ ستانفورد شو إن مصر كانت منذ دخول السلطان سليم الأول واحدة من أهم الوحدات داخل المنظومة العثمانية، فقد كانت ترسل الضرائب بشكل مباشر إلى مركز الدولة دون وساطة ملاك الأراضي العسكريين (التيمار) الذين طبق نظامهم في الموانئ المصرية وحدها، وكانت محاصيل مصر تطعم المدن الكبرى في الدولة كما كانت تفعل من قبل للدول التي حكمت المنطقة، كان السكر والرز والعدس وغيرها من البضائع المصرية تصل من مصر بالبر والبحر لكفاية حاجات إسطنبول ومدن الأناضول، وكثير من الذهب الذي استخدمته الدولة لسك عملتها جاء من السودان وإفريقيا الوسطى خلال مصر، كما كانت مصر تزود الجيش العثماني بعشرة آلاف جندي جيد التدريب سنوياً، وقد فتح هؤلاء باسم الدولة العثمانية جنوب الجزيرة العربية وسواحل الحبشة ودافعوا عنها في مجمل المشرق من اليمن إلى شمال إفريقيا، وكانت المدن المقدسة في الحجاز تأكل وتلبس وتحمى من الخزينة المصرية، ومن الموانئ المصرية انطلقت الأساطيل العثمانية للدفاع عن المحيط الهندي وخليج البصرة والبحر المتوسط.[7]
* تهمة "الاحتلال العثماني" قومية قبل زمنها بشهادة انتفاء تهمة "الاحتلال" المصري
ولكن هل كان هذا استعماراً أو احتلالاً كما حلا لمدرسة التغريب الزعم رغم أنها بررت الاحتلال الأوروبي؟ ولماذا أثير هذا السؤال على الفترة العثمانية وحدها مع أنها مجرد امتداد للتاريخ الإسلامي الذي شهد كثيراً من التمازج القومي وحكم سلالات تركية وفارسية وكردية وشركسية في بلاد عربية لم تنظر إلى هؤلاء الحكام المسلمين بأي استهجان قومي؟ ولعل مثال محمد علي باشا يوضح المقصود فقد تولى حكم مصر وهو ليس مصرياً ولا عربياً بل أوروبي مسلم ومع ذلك فرضته الجماهير المصرية على السلطة المركزية في إسطنبول، وما زال الفكر القومي العربي يحتفي بمشروعه إلى اليوم بمفارقة عجيبة إذ لم يكن الباشا يتكلم اللغة العربية، ولما بدأ مشروع التوسع وغزو الشام والأناضول رحبت به الجماهير في تلك الولايات بصفته منقذاً ولم يقل أحد إنه احتلال أو استعمار مصري بمفهوم الوصف الحديث، وكانت الثورات عليه بعد ذلك وعملية تحجيمه في إطار سياسي لا علاقة له بهذه المفاهيم القومية، فلماذا لا يذكر من يتحدثون عن "الاحتلال العثماني" أن مواطني الدولة العثمانية في الأناضول نفسه رحبوا بالجيوش المصرية بصفتها منقذة لهم وللأمة الإسلامية؟ بل إن الأسطول العثماني رحل إلى الإسكندرية وأعلن مبايعته لمحمد علي باشا بعد هزيمة الجيش العثماني في نصيبين ووفاة السلطان محمود الثاني 1839،(*) أليس هذا دليلاً على غياب التقسيمات القومية التي يحاول البعض دسها في أزمنة مغايرة؟ وهل يمكن أن يستوعب التاريخ إسقاط مشاعر وأفكار لاحقة على فترات سابقة لم تسد فيها هذه المقولات؟
بداية يجب الإشارة إلى أن قرون التاريخ الإسلامي لا تصلح لإسقاط أفكار التمايز القومي أو حتى الحدود الوطنية والقطرية كما يحلو للبعض أن يفعلوا، فهناك من يذهب إلى رفض أن تخرج من مصر ضريبة لمركز إسلامي حاكم يقع في خارج الحدود المصرية الحالية، ويذهب التعصب للحدود إلى مدى القبول بالسرقة الداخلية وتفضيلها على أي كيان وحدوي كبير لمجرد امتداداته خارج الحدود التي رسمها المستعمر الأجنبي، أي أن منطق "الاستقلالية" نفسه قائم على الاستسلام للأجنبي وهو ما يدعي الهروب منه ورفضه، وفي الوقت الذي يرفض صاحب هذا الزعم دفع ضريبة خارج الحدود تراه يلهث خلف الحياة بجنسية أجنبية قد تكلفه دفع ثلث أو نصف دخله ضريبة لحكومة أجنبية معادية ولا يقدم هنا أي اعتراض على أن يدفع الساكن في كاليفورنيا في أقصى الغرب الأمريكي ضريبة لحكومة تقع في واشنطن في أقصى الساحل الشرقي، هذا كله مقبول ومستحسن، أما دفع ضريبة لحكومة إسلامية مركزية تقدم الكثير من الحماية والخدمات للجميع مما سنراه لاحقاً وتنفق معظم الضريبة محلياً فهذا ما ترفضه شياطين الكرامة المزعومة!
وأقول إن التاريخ الإسلامي بقرونه الطويلة لا يصلح للإسقاطات القومية والوطنية كون هذه الأفكار لم تكن قد نشأت بعد في الأصل،[8] وحتى لو كانت إيجابية فلا نستطيع البحث عن اختراع لم يحن وقته في زمن مبكر كمن يروم رؤية التلفاز في العصر العثماني، هذه كلها إسقاطات مبكرة، فلا يمكن وصف دولة المماليك "بالسلطنة العربية" كما ذهبت بعيداً بعض الكتابات القومية الحماسية،[9] كما لا يمكن وصف الدولة العثمانية بالدولة التركية وفقاً للتقسيمات القومية الحديثة، إذ أن العثمانيين أنفسهم لم يعرّفوا انتماءهم بالتركي وكانوا يرون أنفسهم دائماً مختلفين عن الأتراك،[10] دولتهم ذات طابع إسلامي استمد رموزه من اللغة العربية[11] وإدارتها متنوعة الأعراق وليس فيها ما هو تركي خالص إلا في أواخر عهدها، وقد تمكنت من الازدهار مختلف الشعوب داخلها،[12] ولم يكن هذا هو الحال في أي امبراطورية استعمارية ولم تكن تلك هي صفاتها، ولهذا فإن كل النقد الذي بني على الالتزام بالقوميات والحدود الوطنية لا يصلح تطبيقه على التاريخ العثماني.
والدليل على غياب التقسيمات القومية والصفات الاستعمارية في عالم التاريخ الإسلامي زيادة على ما سبق الاستشهاد به من تنوع السلالات الحاكمة في العالم العربي، أنه في مصر نفسها كان الحكم العثماني استمراراً إدارياً وعرقياً للحكم المملوكي الذي لم يصفه أحد بالاحتلال بل لقد وصف بالعروبة كما سبق رغم أن حكامه كانوا من الأتراك والشركس ثم جاء العثمانيون وتركوا النخبة المملوكية الحاكمة على وضعها بالإضافة إلى أسلوبها الإداري العام مع بعض الإضافات العثمانية،[13] ولهذا لا يمكن الحديث عن تغير بنيوي في الجهاز الحاكم يبرر وصف الوضع الجديد بالاحتلال، بل إن الحوادث تؤكد أن الوضع الجديد منح مصر الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي والاستتباب الأمني والرواج التجاري والإنتاج الزراعي والهدوء الصحي ومن ثم النمو السكاني في القرن الأول بسبب حضور الدولة وتدخلها في كافة شئون الولاية، ولم يتغير الحال إلا بعد ضعف الدولة وما ترتب عليه من مظاهر أدت إلى فرض القوى المحلية نفوذها واستغلالها لكافة الموارد الاقتصادية لحسابها الخاص مما أدى إلى عودة دورة الغلاء والمجاعات والأوبئة على فترات متقطعة، ومع ذلك ستتعامل معها الدولة بكفاءة أكثر من الماضي كما سيأتي، ويجب أن نتذكر أن هذا هو الحال الذي ساد قبل دخول العثمانيين وأن اقتصار فلسفة الحكم على المهام الدفاعية والأمنية للدولة ليس خاصية عثمانية بل نمط مستمر قبل العصر العثماني،[14] كما أن التشريعات والتنظيمات الإدارية التي وضعها العثمانيون كانت تهدف إلى إنصاف الفئات الاجتماعية الريفية وأن عدم الاكتراث بها جاء من قبل رجال الإدارة المحلية في الريف من الملتزمين ومشايخ النواحي،[15] وبهذا يتبين أولاً أن حضور الدولة لم يكن حضوراً استعمارياً استغلالياً وثانياً أن المشاكل نتجت عن عدم حضور الدولة لا عن سطوتها،[16] وثالثاً أن العيوب كانت في الجهاز المحلي وليس في المركز كما يفترض في الاحتلال الأجنبي، وإذا كان هذا من ثغرات الحكم العثماني فإن النقطة التي تتعلق بموضوعنا هنا هي نفي البعد الاستعماري الاستغلالي الذي حاولت الكتابات المتأثرة بالاستشراق، التابع للاستعمار الحقيقي، إلصاقه بالعثمانيين.
كما أن هذا العالم العثماني شهد موجات من الهجرات عابرة الحدود بين ما أصبح أقطاراً مختلفة، ولم تكن هذه الهجرات لتثير أي اعتراضات قومية أو قطرية في زمنها، لم تكن هذه الاختراعات موجودة أصلاً، ومن الأمثلة البينة على ذلك هجرات المغاربة إلى مصر والتي سبقت زمن الدولة العثمانية ولكنها ازدادت فيه إلى المشرق العربي عموماً وإلى مصر خاصة وقام المغاربة بأدوار سياسية واقتصادية بارزة، فقد عملوا بالتجارة في مصر وكونوا ثروات كبيرة واحتكروا بعض أصناف السلع وتغلغلوا في الحياة الاقتصادية المصرية وصار لهم نفوذ سياسي إلى حد التمكن من عزل والي القاهرة الذي كان يهدد مصالحهم فطلبوا إلى الباشا العثماني عزله وإلا لجئوا إلى السلطان نفسه فلم يسعه سوى تلبية طلبهم.
ولم يؤد الدور السلبي الذي قام به بعض العربان المغاربة في صعيد مصر إلى أي حزازات قومية أو قطرية، كان التعامل يتم مع مصدر الخطر بصفته الفردية دون تعميم الاستياء على الشريحة كلها كما يحدث في يومنا هذا مع شديد الأسف، لقد كانت الأمور تجري بسلاسة أكثر من زمننا، ولما تعرضت مصر لخطر الحملة الفرنسية هب المغاربة للدفاع عنها من مصر بل ومن الحجاز أيضاً، وهنا بدأ نابليون العزف على نغمة الحدود وتهديد "الأغراب" المغاربة بوجوب السفر إلى "بلادهم"، أما قبل ذلك فلم يكن أي دور سلبي تقوم به أي شريحة مغربية داخل المجتمع المصري العثماني مؤدياً إلى التأثير سلباً على الأدوار الإيجابية الكبيرة في الحقول السياسية والاقتصادية والعلمية والاجتماعية حيث احتل المغاربة إضافة لما سبق ذكره مكانة هامة في أروقة العلماء واندمجوا وتزاوجوا مع المجتمع المصري وأثّروا فيه تأثيرات ما زال بعضها ظاهراً إلى اليوم، كلهجة أهل الإسكندرية،[17] دون حواجز الحدود التي نشأت بعد ذلك.
ومن مظاهر التمازج التي لا تقبل إسقاط واقعنا على الماضي مظهر مصر المؤثرة هذه المرة وليست المتأثرة، فالحجاز في العصر العثماني "كان ميداناً مصرياً خالصاً، حيث قامت الإدارة المصرية برعاية كافة شؤونه"، سواء السياسية حيث لم يكن يعين الأشراف ولا الولاة في الحجاز وجدة والمدينة إلا بموافقة الإدارة المصرية إلا ما ندر، ومن الناحية الاقتصادية كانت مصر أهم الأقاليم التي تقدم المساعدات للحجاز بسبب شح موارده "وقامت بأعباء الحجاز فيما يحتاج إليه من رعاية كافة شؤونه"، وفي الجانب الاجتماعي قامت علاقات مصاهرة بين الطرفين وقدمت مصر رواتب خاصة للضعفاء والأيتام والأرامل وذوي الحاجات الخاصة، كما تولى مصريون وظائف علمية وإدارية عديدة، وقدموا دعماً كبيراً للحياة العلمية في الحجاز على شكل أوقاف ورواتب للعلماء بالإضافة إلى أموال الصرة والجوالي وبعض الضرائب المفروضة على المقاطعات والناس في مصر، ويلاحظ أن معظم مدرسي المدارس المصرية في الحجاز كانوا من غير المصريين وهو ما جعل هذا الإقليم جاذباً لعلماء العالم الإسلامي مثل مصر نفسها في تلك الفترة، وقام الكثير من المصريين بإنشاء مختلف المؤسسات العلمية في الحجاز كالمدارس والمكتبات والزوايا، وقدم المصريون مساهمات علمية كبيرة في حلقات العلم بالحرمين في شتى فروع العلوم الإسلامية واللغة العربية وحافظوا على روايات أمهات الصحاح ومسانيد الأئمة كما ساهموا في العلوم العقلية والطبيعية والاجتماعية، وكانت الإجازة العلمية المصرية "أشهر الإجازات، يبذل الطالب في الحجاز كل غال وثمين من أجل الحصول عليها من علماء مصر حتى إنهم كانوا يحضرون إلى مصر للحصول عليها وكانت الإجازة المصرية أشهر إجازة في ذلك العصر يأخذها طلاب الحجاز"،[18] كل ذلك في جو من التمازج والاختلاط البعيد عن التعصب القومي والوطني أو المحاصصة الطائفية التي ابتكرها الغرب في بلادنا بزعم توزيع الحقوق على أصحابها فأدت إلى مزيد من النفور، ولم يتحدث أحد آنذاك عن احتلال مصري ولا هيمنة مصرية على الحجاز، فكيف يمكن الحديث عن احتلال عثماني يوفر "لضحاياه" المصريين فرصة هذا التمدد والانتشار؟ وهو ما يفيد موضوعنا بعدم صواب إسقاط الواقع المعاصر على ماض يخلو من الظواهر الحالية فلا مكان لوصف المسلم أيا كان أصله "بالأجنبي" أو حكمه "بالاحتلال".
ومن الملاحظ أن اللغة العربية ظلت سليمة ودارجة لمدة أربعة قرون من الحكم العثماني لم تتغير لغتنا، ويقوم الأزهر على حمايتها في ظل رعاية الدولة العثمانية له وعدم تدخلها في شئونه الداخلية أو محاولة فرض تعيينات أو أنظمة عليه من خارج محيطه وبروز عدة أعلام كبار من شيوخه وطلابه وفقاً لتوثيق حتى من يتحامل عليها كما يسرد ذلك الدكتور عبد العزيز الشناوي،[19] كل ذلك مقارنة بما صنعه الاستعمار لاسيما الفرنسي الذي محا العربية وأحل الفرنسية محلها ثم جاءت دولة التجزئة لتقوم مقام الاستعمار بعد رحيل جيوشه فتضمحل اللغة العربية في ظلها اضمحلالاً شديداً ولما يمر على حكم التجزئة قرن واحد صارت فيه العربية غريبة في أوطانها ثم لا يستحي أنصار التجزئة من الحديث عن أسطورة التتريك العثماني ولو كان هناك تتريك مدة هذه القرون الطويلة لما بقي للعربية أثر كما تؤكد هذا التجربة الفرنسية.
* رمتني بدائها وانسلت: أين هو الاحتلال الفعلي وأين تمت الوحدة الحقيقية؟
هذا من جهة، ومن جهة أخرى أعجب كثيراً من وصم التجربة العثمانية الوحدوية التي استقرت في العالم العربي بين ثلاثة وأربعة قرون بالاحتلال من جانب أنصار الاستقلال والدولة الوطنية التي كانت كل تجاربها الوحدوية احتلالية حتى تجاه أشقائها العرب إذ وجدنا كل هذه التجارب تنتهي بالفشل الذريع بعد مدد وجيزة جداً بعدما فشل الأخ العربي في معاملة أخيه على قدم المساواة مما أدى إلى الانفصال أو النزوع إلى الانفصال في جميع تلك التجارب بلا استثناء حيث اشتكى الإخوة بمرارة من احتلال أخيهم وجارهم ولم تستمر تجربة وحدوية عربية واحدة في ظل الدولة الوطنية والمشاعر القومية، ولو درسنا فشل التجارب الوحدوية العربية على تعددها سنجد الرابط بينها تسلط الأخ على أخيه والجار على جاره، هذا إذا لم تنزع الدول الواحدة إلى التفتت والانقسام في ظل التسلط الداخلي بين الفئات المتناحرة، وبينما كان العرب ينزعون للانضمام للدولة العثمانية والاستنجاد بها ضد الأخطار الخارجية، نزعوا للاستنجاد بالخارج ضد الأخطار الداخلية في زمن التجزئة العربية، ونجد النزعات الانفصالية تستشري في هذا العالم العربي داخل الدول الموحدة نتيجة المشاعر الساخطة من تسلط الإخوة والأشقاء فضلاً عن الجيران، وبدلاً من الوحدة نتجه لتقسيم المقسم وتجزئة المجزأ، ولا أتحدث هنا عن مؤامرات الأعداء التي هي بالتأكيد حاضرة دائماً وأبداً بل حديثي عن الظلم والإساءة التي يرتكبها الأخ في حق أخيه باسم شعارات براقة فيدفعه للاستجابة لمؤامرات الأعداء بعدما يكون في البداية مقبلاً على أخيه ومرحباً به ومصدقاً لدعاواه، ولهذا يحسن بأنصار الدولة الوطنية ألا يقذفوا تجارب غيرهم بالحجارة فيما تجاربهم هم من زجاج.
* الحكم العثماني في مصر في تقويم المؤرخين المحدثين
تجيب المؤرخة المصرية نيللي حنا على سؤال: هل كان العثمانيون محتلين؟
بالقول في مقابلة موجزة هذا نصها: "إذا أردت أن تضع الدولة العثمانية في مقارنة، فيجب مقارنتها بنظيراتها من الإمبراطوريات، مثل الإمبراطورية النمساوية التي سيطرت على شرق أوروبا، ومثل هذه الإمبراطوريات لم تكن احتلالاً، فالاحتلال له خصائص لم تتوفر في الإمبراطوريات، ومنها الإمبراطورية العثمانية.
وما هي خصائص الاحتلال؟
تاريخ الاحتلال الإنجليزي لمصر (1882- 1923) والفرنسي للجزائر (1830- 1962) يعطى فكرة عن أهم خصائص الاحتلال، والتي لم تتوفر في الدولة العثمانية، فالاحتلال يسعى لتغيير النمط الزراعي للدولة التي يحتلها بما يخدم أهدافه، فمصر مثلا في فترة الاحتلال الإنجليزي كانت تكثر من زراعة القطن، وذلك لخدمة المصانع الإنجليزية.
كذلك حاول الاستعمار الإنجليزي لمصر فرض لغته، وتغيير النمط الاقتصادي للدولة، وهو ما لم يحدث في الحقبة العثمانية.. لذلك فإن استخدام كلمة "محتل" هو وصف غير دقيق.
هل نستطيع أن نأخذ من فترة الدولة العثمانية وما شهدته من تعايش بين الأديان دروسًا لعلاج قضايا الحاضر؟
نعم.. ومن هذه الدروس أنه إذا أردت أن تقيم التعايش بين الطوائف، فيجب أن يشمل ذلك مستوى الحوادث الفردية، والحوادث التي تتسبب فيها الدولة وقوانينها.
فعلى مستوى الدولة وقوانينها، تستطيع أن تقول إنه كان هناك تسامح، لكن على مستوى الأفراد كانت هناك حوادث فردية أشبه بما يحدث في الوقت الحالي، ولكن هذه الحوادث عموما كانت أقل من فترة المماليك (1250- 1517).
وكيف كانت قوانين الدولة تشجّع على التسامح؟
القوانين لم تكن بالمعنى المفهوم لكلمة قانون الآن.. يعني مواد تعرض على برلمان يقرها ويصدر بها قانون، لكنها كانت عبارة عن "فرمان" يصدر من السلطان، مثل الفرمان الصادر لإدارة إقليم مصر، وهذا الفرمان لم يشر إلى غير المسلمين، ومن ثم فإن أية قضية تعرض على القاضي يحكم وفق الشرع بصرف النظر عن الديانة.
عند التطرق لتاريخ الدولة العثمانية توجه الكثير من الاتهامات ويقال إن مصر لم تشهد أي تطور؟
الأوروبيون حاولوا أن يظهروا الفترات التي احتلوا فيها الشعوب بأنها كانت فترات ازدهار، فقيل عن الهند إنها كانت متأخرة قبل الاحتلال الإنجليزي، وقيل نفس الشيء عن مصر وقت الدولة العثمانية، لإظهار أن الفترة اللاحقة، وهي الاحتلال الإنجليزي كانت أكثر ازدهارًا.
وما هي أبرز جوانب هذه الازدهار؟
الدولة العثمانية التي امتدت لأكثر من 600 عام (1299 حتى 1923) كانت إمبراطورية ممتدة من شمال إفريقيا حتى يوغسلافيا والمجر، وكانت تشهد تعايشًا بين أكثر من 20 ديانة، ولكن عامة يصعب أن تطلق وصفًا دقيقًا لتقول إنها كانت فترة ازدهار أو انحسار.
يعني في فترات عديدة شهد الاقتصاد تطورًا، وشهدت صناعة النسيج ازدهارًا، ولكن في فترات أخرى كانت هناك أزمة مالية بسبب نقص المعادن أثرت على اقتصاديات البلد.. فالخلاصة أنه يصعب إطلاق وصف دقيق يلخص الحالة، سواء بالازدهار أو الانحسار.
وماذا عن العلاقة بين مصر وتركيا وقت الإمبراطورية العثمانية؟
كانت هناك علاقة تجارية مهمة وحركة تبادل تجاري بين الموانئ المصرية والعثمانية، وكان يوجد تجار أتراك في (مدينة) رشيد (بمحافظة البحيرة بدلتا النيل).. وساعدت هذه الحركة التجارية مصر كثيرًا".[20]
وفي تقديمه لكتاب المؤرخة نيللي حنا عن تجار القاهرة في العصر العثماني يقول الدكتور رءوف عباس إن هذا الكتاب "يدحض الآراء التي ذهبت إلى أن مصر وبلاد الدولة العثمانية عانت من الركود الاقتصادي والجمود الحضاري والاضمحلال الثقافي من خلال تقديم صورة حية للواقع الاقتصادي في أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر أعادت المؤلفة تكوينها من شتات المعلومات التي جمعتها من سجلات المحكمة الشرعية، بينت فيها عدم صحة المقولات التي أشاعها المستشرقون حول أثر تحول التجارة إلى طريق رأس الرجاء الصالح على الركود الاقتصادي وكساد أسواق الشرق الأوسط".
ويشكك في مقولات الركود والتراجع عندما يؤكد أن نهضة محمد علي باشا لم تنشأ من فراغ، لا سيما أنها اعتمدت على موارد مصر بصورة أساسية، فمن أين وفر الاقتصاد المصري كل هذه الموارد لو كان اقتصاداً راكداً؟ وكيف تجاوب المجتمع مع هذه الإصلاحات لو كان مجتمعاً متخلفاً؟ وكيف استطاع العمال المصريون استيعاب الأساليب الفنية الحديثة لو كانوا جهلة؟ وكيف تجاوب الطلبة في مصر مع التعليم الحديث إذا كان نظامهم التعليمي الأصلي متخلفاً وعاجزاً؟ وكيف تمكن الفلاح المصري من استيعاب فنون القتال إذا لم يكن يملك القدرات اللازمة لذلك؟
إن محمد علي باشا لم يقم إلا بإعادة ترتيب الأوراق التي كانت متوفرة في الأصل بين يديه، واتخذت إصلاحاته الطابع المصري العثماني رغم وجود المساعدة التقنية الأجنبية ولكن نسق الإصلاح لم يكن غربياً، ولو كان المجتمع المصري متخلفاً لما تمكن محمد علي من صنع المعجزات "ويعني ذلك أن واقع مصر في العصر العثماني كان له شأن آخر، غير ذلك الذي شاع في كتابات مدرسة الحداثة".[21]
وكما هزت اكتشافات الدكتورة فكرة الركود الاقتصادي وبينت أن الرأسمالية التجارية قد استردت عافيتها وأعادت بناء شبكة تجارتها العالمية الممتدة من الهند إلى غرب إفريقيا ومن إيطاليا إلى السودان، أتبعت ذلك في كتابها عن ثقافة الطبقة الوسطى في مصر العثمانية بتحدي نظريات: التطور والتخلف، والمجتمع التقليدي والتحديث، والمركز والأطراف، والاستبداد الشرقي، بتبيان أن الرخاء الاقتصادي أنتج طبقة اجتماعية وسطى كانت لها ثقافتها التي استجابت للتحولات وتوافقت مع حاجات المجتمع في إطارها الديني والأخلاقي بعيداً عن الجمود الذي وصفت به في المدارس الاستشراقية، ولم يكن هذا التطور خاصاً بالقاهرة وحدها بل وجد أيضاً في بقية المدن العثمانية، ولم تكن الفجوة واسعة بين بلادنا وجنوب أوروبا حيث مدن النهضة حتى أواخر القرن السابع عشر على الأقل.[22]
ويعترف الدكتور رءوف عباس بكونه أحد المتأثرين بل من المروجين زمناً لنظريات الاستشراق عن ركود وتخلف وجمود البلاد العربية في العصر العثماني وبأنه انبهر بنظرية التحديث التي جاءت مع الغزو الغربي وبما أشاعته المدرسة الماركسية عن مجتمع ما قبل الرأسمالية أو الاستبداد الشرقي ومفهوم المجتمع الخراجي المعدلة له، وغاب عن جيل الستينيات والسبعينيات كما يقول الدكتور النظر للنصف المليء من الكوب بما فيه من عناصر إيجابية "كانت لصالح بلادنا" كعدم التدخل في حياة الناس الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتركهم يديرون شئونهم وفق ما اعتادوه، وتحقيق الأمن والاستقرار زمناً طويلاً مع تأمين البحر المتوسط والبحر الحمر وصارت مصر تتعامل مع سوق واسعة شملت حدود الدولة العثمانية في ثلاث قارات وكانت مصر هي المركز فيها وهي تجارة لم يعرقلها الوجود البرتغالي في المحيط الهندي وبحر العرب إلا برهة من الزمن أعاد بعدها التجار العرب بناء شبكتهم التجارية، دون أن يعني هذا خلو القرون العثمانية من السلبيات حيث رفعت الدولة يدها عن تقديم الخدمات وما تبع ذلك من أوبئة ومجاعات وآثار سلبية نتجت عن صراع العسكر على السلطة وتراجع قوة الدولة.
المهم أن الرؤية الاستشراقية لم تلحظ إلا ما يؤيد أفكار الجمود والتخلف والركود ولم تر العناصر الهامة ولكن الحقيقة أننا أمام مجتمع متحرك ومتغير يصعد ويهبط كبقية المجتمعات البشرية وليس كائناً راكداً.[23]
ويقول المؤرخ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم في مقدمة كتابه النفيس "فصول من تاريخ مصر الاقتصادي والاجتماعي في العصر العثماني" وهو يرد على الطرح الاستشراقي: "نقدم للقارئ تلك الدراسات التي ترصد بعضاً من الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع المصري، خلال الفترة التي تعرف في التاريخ المصري باسم "العصر العثماني 1517- 1798 م"، التي وصفت بأنها فترة التخلف والركود والجمود، وظللنا نحن نكرر تلك الأوصاف التي رسمها لنا الأوروبيون الذين أرادوا أن يرسموا لنا صورة قاتمة للدولة العثمانية، وأنها وراء ما أصابنا من هذا التخلف والركود والجمود، وصدقنا ما وضعوه لنا، دون أن نقترب من تاريخ هذه الفترة وندرسه من وثائق وكتابات العصر لنقف على حقيقة دور الدولة العثمانية في تاريخنا.
"وعندما اتجه البعض إلى دراسة تاريخ هذه الفترة بان لهم أن الدولة العثمانية لم تكن بالصورة التي رسمها لها الأوروبيون، فدراسة وثائق العصر تثبت أن الدولة العثمانية لم تضع قيوداً على حراك السكان، وانتقالهم من بلد إلى آخر، ولا على ممارستهم للأنشطة الاقتصادية والمهنية، مما جعل الاستقرار الاقتصادي، يعود إلى السوق المصرية، بعد أن كان هذا الاقتصاد قد ضُرب ضربة شديدة على إثر اكتشاف رأس الرجاء الصالح (1498م)، وساد السوق المصرية الكساد الاقتصادي، وعدم الاستقرار، مما أثر بالتالي على البنيان السياسي والاقتصادي للدولة المملوكية.
"وتبدأ هذه الدراسات بإلقاء الضوء على وثائق العصر، التي لا تزال تعيش في دور وثائقنا، وترسم لنا صورة واضحة المعالم للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمجتمع المصري، خلال هذه الفترة التي امتدت ثلاثة قرون من تاريخنا، كما تلقي الضوء على بعض من المصادر الأصلية والمعاصرة، لتؤكد الصورة التي رسمتها لنا الوثائق، وكيف أن هذه المصادر، التي ألفت في تلك الفترة التي وُصفت بالتخلف، ظلت تعيش في عالم النسيان، حبيسة خزائن الكتب العالمية حتى شاء الله لبعضها أن يرى النور في السنوات الأخيرة".
"ثم نقدم بعد ذلك فصولاً من التاريخ الاقتصادي والاجتماعي، للمجتمع المصري، خلال تلك الفترة، فمنذ منتصف القرن السادس عشر، وبعد أن استقرت الأمور للحكم العثماني في مصر بدأت السوق المصرية تشهد نشاطاً تجارياً متزايداً، وبدأت تعود للسوق المصرية عمليات التبادل التجار بينها وبين أسواق بلاد الشام والحجاز واليمن، وبلدان المغرب العربي، والغرب الإفريقي، وبعض البلدان الأوروبية والهند، وبلدان جنوب آسيا، وبدأ النشاط التجاري في البحرين المتوسط والأحمر يشهد رواجاً كبيراً، وترتب على النشاط التجاري ازدهار الموانئ المصرية الواقعة على البحرين مثل: الإسكندرية، ورشيد، ودمياط، والسويس، والقصير، كما نشطت الموانئ الداخلية الواقعة على النيل مثل: بولاق ومصر القديمة. وبدأت فئة التجار تحوز على أرباح باهظة، وأصبح للكثير من أبناء هذه الفئة وكلاء في موانئ البحر الأحمر في مخا، والحديدة، وجدة، يقومون بأعمالهم في تلك الموانئ، كما كان لهم وكلاء في بعض موانئ البحر المتوسط، ولعب هؤلاء التجار دوراً فعالاً في المجتمع المصري".[24]
ويذكر رحمه الله بقية الظواهر سلبية كانت أم إيجابية ليخرج المراقب بنتيجة أن الصورة القاتمة لا أساس لها وأنه مجتمع بشري كبقية المجتمعات وكانت فيه من الإيجابيات ما أغفله الأوروبيون طويلاً.
وقد سبق الحديث في دراسات سابقة عن كون القاهرة المدينة التي تلت العاصمة العثمانية إسطنبول مباشرة في الأهمية داخل الدولة العثمانية، وهو ما لم يحدث في أي امبراطورية استعمارية حكمت مصر من أوروبا سواء فرنسا أو بريطانيا، وأنها تمتعت بزمن من التوسع والازدهار، وفي مؤلفها الخاص بالقاهرة في القرن السادس عشر تقول الدكتورة هدى جابر إن التحول الذي شهدته المدينة سنة 1517 بالتحول من قاعدة لإمبراطورية المماليك إلى مدينة عثمانية لا يعني أن القاهرة فقدت أهميتها، لأنها أصبحت المدينة الثانية بعد إسطنبول، وظلت تحتفظ بأهميتها التجارية، وشهدت عمراناً كان أساساً لتطورها العمراني اللاحق وهذا عكس ما قيل عن انكماشها واضمحلالها في العصر العثماني، وقد حظيت الخدمات العامة والصحية باهتمام السكان خلافاً لما أشيع عن جهلهم بهذه الأمور، واهتمت الإدارة بالأمن العام والأمن الاقتصادي، وشهدت المدينة ظهور طوائف اجتماعية وتطور الطوائف الحرفية خلافاً لما أشيع عن جمودها، ولم تكن الجاليات الأوروبية تعيش في عزلة وانغلاق على عكس المشهور عنها، وترى الدكتورة هدى أن بحثها خطوة في مسيرة تصحيح الأفكار والمفاهيم السائدة عن العصر العثماني.[25]
ويفصل المؤرخ روبير مانتران الحديث عن وضع الحكم العثماني في مصر وطبيعة العلاقة بينها وبين مركز الدولة العثمانية بالقول بعد ذكر الأفكار السلبية التي أشيعت عن الحكم العثماني سابقاً إن العثمانيين عاملوا الجامع الأزهر باحترام شديد وحافظوا له على كل نفوذه، وإن الحجاج الأتراك كانوا يمرون بمصر ويقيمون في القاهرة مما أدى إلى علاقات ثقافية ودينية بين تركيا ومصر، وقد ظلت اللغة العربية هي لغة الدواوين ولا يمكن الحديث عن "عثمنة" في هذا المجال، فلم يأت انتصار العثمانيين في البلاد العربية "بعثمنة" لهذه البلاد وفقا لجب وبوون، وكانت ظاهرة الأرستقراطية العسكرية التركية ليست جديدة لأن البلد اعتادت عليها منذ زمن المماليك، أما البيروقراطية القاهرية فلم تكن تركية خالصة، والحاميات التركية اندمجت بالشعب إلى درجة نسيان لغتها التركية الأصلية، واستمرت ظاهرة "اللاعثمنة" إلى نهاية القرن الثامن عشر، وظلت مصر تؤلف إقليماً واحداً مركزه القاهرة على عكس الولايات الآسيوية الأخرى مما أعطاها خصوصية وضحت أن لها ميزة لدى السلطان وأنه ينوي المحافظة على أهميتها.
ولم تكن الأموال الذاهبة إلى الخزانة السلطانية تثقل كاهل الإقليم، فقد كان النظام المالي المطبق في مصر هو نفسه المطبق في العاصمة وسائر الولايات، وكانت سيطرة حكومة إسطنبول على مصر ليست شديدة الوطأة ولم تكن بالغة التعسف والجور، أما الاضطرابات فلم تكن حركات عصيان شعبية بل اضطرابات قام بها الانكشارية وبقية الفرق العسكرية لعدم حصولهم على رواتبهم وصدامهم مع المماليك أي مجرد مشاجرات شوارع، وكان سبب التوترات التي ظهرت في القرن الثامن عشر محاولة الدولة إحلال نظام جديد للجيش يتألف من متطوعين محل النظام القديم وقد تسببت نفقاتها في حوادث التوتر ولم يكن سبب ذلك بذخ الباشوات أو مطالب الباب العالي، ولم يواجه العثمانيون حالة قطع الروابط مع رعاياهم في مصر رغم بعد القاهرة عن إسطنبول ورغم أن حكام الإقليم كانوا يتمتعون باستقلال واسع حتى النصف الثاني من القرن الثامن عشر، ولم يكن السلاطين العثمانيون يولون اهتماماً كبيراً للاحترام والطاعة من جانب الحكام وكبار الموظفين، وكان ما يهمهم هو مظاهر السيادة الشكلية للسلطان واحترام الالتزامات المالية.
وعن حكومة الإقليم المصري يقول مانتران إن مركز والي القاهرة كان من أعلى المراكز في السلم الإداري العثماني، فكثيراً ما تولاه كبار الوزراء في الحكومة المركزية بعد عملهم فيها ولم يكن ذلك إنقاصاً من شأنهم، أو صار الولاة أنفسهم في مناصب عالية كالوزارة بعد عملهم في مصر، ولم تكن الصراعات داخل الإدارة المحلية تصل إلى حد الصراع مع الباب العالي، إذ لم تكن سيادته محل مناقشة، ولم تكن اضطرابات القاهرة تتجاوز نطاق الإقليم إلا جزئياً في القرن الثامن عشر، ورغم هذه الاضطرابات فقد استطاعت الإدارة المحلية أن "تقوم بعملها وأن تصل بهمة ولدرجة ملموسة إلى تحقيق أقصى الفوائد للإقليم وللخزانة السلطانية معاً"، وقد تمكن مشايخ البلد في القرن الثامن عشر من انتزاع السلطة الضئيلة التي كانت بحوزة الباشوات ولم يكن خلافهم معهم يصيب الحياة في القاهرة بالارتباك إلا قليلاً.
وفيما يتعلق بالحياة الحرفية وتنظيماتها التي كانت موجودة قبل دخول العثمانيين فإنهم "قلما حاولوا التدخل لتوجيه هذه التنظيمات القاهرية كي تتخذ نمطاً تركياً"، وكان رؤساء الطوائف الحرفية يتمتعون بسلطة كبيرة وكان من حقهم الدخول على الباشا ولم يكونوا يترددون في فعل ذلك وأخذ نفوذهم يقوى في الإدارة والحكم منذ القرن السابع عشر بسبب دخول الإنكشارية والعسكريين في الطوائف الحرفية.
وكانت مصر تحتل مكانة سامية في ميزانية الخزانة السلطانية لكونها بلداً غنياً وكانت مبالغ الخراج تتفاوت حسب الظروف وقد فرضت على كبار موظفي الديوان ضرائب نظير امتيازاتهم والدخول التي يحصلون عليها وحتى عام 1761 كانت مقاطعات الجمارك تدار بواسطة أمناء من الأقباط أو اليهود، وفيما يتعلق بالضرائب "من الواضح أنه وإن كانت الضرائب المختلفة تزيد في مصر بنسب لافتة للنظر في بعض الأحيان فيما بين 1517 و 1798 إلا أن التدهور شبه المستمر للنقد العثماني كان بمثابة تعويض عن الزيادة أما من الناحية الفعلية فيمكن القول بأن هذه الضرائب لم ترتفع".
وعن الحياة التجارية وصف الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم مصر العثمانية بأنها كانت "محور العلاقات الاقتصادية بين المشرق والمغرب... وهي مركز لعمليات التصدير والاستيراد مع كل من البلدان الأوروبية والإفريقية والآسيوية".[26]
وفي دراسته الشاملة عن الموانئ المصرية في العصر العثماني يقول الدكتور عبد الحميد حامد سليمان إن الفترة العثمانية من تاريخ مصر اتسمت بالغموض الكثيف والنقص الكبير في المعلومات حتى أماط اللثام عنها باحثون قديرون كالأساتذة ستانفورد شو وعبد الرحيم عبد الرحمن، وقال أيضاً إن الموانئ المصرية أمنت طوال العصر العثماني غائلة الحملات المعادية والهجمات المتتابعة التي كثيراً ما نكبت بها من قبل وشهدت فترة طويلة من الأمن لم تعرفها فيما سبق ودعم ذلك دخول رودس وقبرص تحت السيطرة العثمانية (بعدما كانتا من مصادر الأخطار الفرنجية على مصر) واستمر ذلك الأمن إلى أواخر القرن الثامن عشر حينما بدأت مظاهر الضعف العثماني، ويتحدث عن الاضطرابات التي أثارتها الصراعات بين الأمراء المماليك في أواخر القرن السابع عشر والقرن الذي تلاه وقال إن الموانئ المصرية باستثناء السويس كانت بمنأى عن هذه الصراعات إلى أن تغير الحال في النصف الثاني من القرن الثامن عشر باختفاء منصب القبودان.
وقد خضعت الأجهزة الإدارية في هذه الموانئ للرقابة المزدوجة من الحكم المركزي في العاصمة إسطنبول وفي القاهرة مع وعي سكان الموانئ بحقوقهم وواجباتهم ما أدى إلى تصديهم لانحرافات الإداريين والملتزمين وشيوخ الحرف وكثيراً ما نتج عن هذا التصدي إقالة المنحرفين حتى لو كانوا على رأس الجهاز الإداري، كما تمكن الأهالي من الوقوف على تطبيق القانون العثماني والتصدي لمحاولات تهريب الحبوب إلى الإفرنج وهو ما كانت الدولة العثمانية تحظره، وتؤكد الوثائق كثرة الأمثلة التي توضح فعالية الرقابة الشعبية وسرعة استجابة الديوان العالي في القاهرة لشكايات الأهالي دون الالتفات إلى مكانة المنحرفين ولم تحل وظائفهم دون عزلهم وسجنهم ومصادرة أموالهم.
وشرح نظام الالتزام الذي أديرت به الموانئ المصرية فوضح أنه لم يكن مجرد نظام مالي بل فلسفة إدارية شاملة لمعظم أوجه النشاط الإنساني حيث أديرت الأنشطة الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بتخويل سلطات معينة للملتزمين مقابل حصولهم على ضرائب محددة لا يتعدونها ويدفعون حصصاً مقررة منها للسلطات المعنية، وكان هذا النظام ناجحاً للدولة والرعية باستثناء بعض فترات الاضطراب بسبب ضعف قبضة السلطة التي تمكنت بشكل عام من التصدي لجشع الملتزمين.
وفي دراسة موسعة عن نظام الالتزام بعنوان "الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثماني" يتجاوز الدكتور جمال كمال محمود التعميمات الأيديولوجية التي وصمت العصر العثماني ويقول إنه بعد تحول مصر من قاعدة لسلطنة المماليك إلى ولاية عثمانية أصبح نظام الالتزام هو أساس النظام الاقتصادي فيها، ولكن تطبيقه تم بصورة تدريجية ليحل محل نظام الأمانات في الربع الثاني من القرن السادس عشر، وإنه لم يكن نظاماً غريباً لأنه يشبه أنظمة سبق تطبيقها في العصور الإسلامية السابقة، وأوضح أن ضريبة الميري المفروضة على الأراضي الزراعية لم تتغير طوال العصر العثماني ولكن ظهور المضاف هو الذي زاد أعباء الفلاح المصري، ورغم تعدد الضرائب في ظل الالتزام فإن الخطأ لم يكن في صلب النظام بقدر ما كان في القائمين عليه من ملتزمين ومساعدين وعسكر، وأوضح أيضاً آثار الصراعات العسكرية بين الكتل المملوكية، ويخلص إلى أن نظام الالتزام لم يكن كله مساوئ، ولولا جشع وعسف القائمين عليه لكان من الصعب وصفه وصفاً سلبياً، ويصعب كذلك إلصاق الضعف والركود بالعصر العثماني اعتماداً على بعض الدراسات القديمة، لأن التاريخ هو الوثائق، والوثائق تؤكد غير ذلك، وهذا لا يعني وصفه بعصر النهضة، المهم أنه فترة تاريخية لها محاسنها ومساوئها أيضاً.[27]
وكانت الأحوال الاقتصادية في الموانئ المصرية أسعد حالاً من بقية نواحي مصر وكفلت الأنشطة الاقتصادية الداخلية والخارجية لسكانها حظاً من الثروة والرفاهية، ورغم ارتفاع الأسعار وتذبذب قيم العملات في بعض الأحيان فإن التكامل الاقتصادي بين أجزاء الدولة العثمانية مكن الإدارة المركزية في إسطنبول من التصدي لخطر المجاعات في مختلف الولايات، وفي سنوات قصور النيل قدمت السفن العثمانية بالحبوب من الشام والأناضول إلى مصر الأمر الذي جعلها بمنجاة من المجاعات التي عانت منها كثيراً في السابق وكانت تودي بحياة الكثيرين وتدفع الناجين إلى الهجرة.
وشهدت الموانئ المصرية أنشطة اقتصادية مزدهرة دفعت كثيراً من التجار المصريين والأتراك والشوام والمغاربة والهنود والعرب والأوروبيين إلى امتلاك وكالات فيها، ويرى الباحث الدكتور عبد الحميد سليمان أن نظام الطوائف الحرفية أدى إلى جمود وتراجع الدور الصناعي لهذه الموانئ.
ويختم الدكتور عبد الحميد سليمان حديثه بالقول "إن الموانئ المصرية قد شكلت شريحة بالغة الأهمية من مصر في العصر العثماني حيث أسهمت بدور بارز بالغ الأهمية في تشكيل الصورة العامة لها كما أسهمت إلى حد كبير في تمويل الدولة العثمانية بالمال والحرفيين الذين أسهموا كثيراً في بناء الأساطيل العثمانية وتمويلها وإصلاحها وكانت بمثابة قواعد عسكرية للأساطيل العثمانية ومراكز إمداد للجيوش العثمانية ساهمت في القدرات العسكرية العثمانية التي من خلالها خاضت هذه الدولة حروباً طويلة كما كانت الصادرات عبر هذه الموانئ من التجارة الواردة إليها ومنتجاتها ذات أهمية بالغة في إدارة النشاط الاقتصادي داخل الدولة العثمانية كلها والنشاط الاقتصادي العالمي..." وهو ما قاد فيما بعد إلى التنافس الاستعماري على التعامل مع هذه الموانئ ثم احتلالها بعدما ضعفت الدولة العثمانية،[28] وخلاصة الصورة التي يقدمها هذا الكتاب هي صورة التكامل وليس الاستغلال الذي ينطبق على الاستعمار.
وعن العلاقات الدينية والثقافية يقول مانتران إن العثمانيين لم يمارسوا ضغطاً محسوساً يتصل بالقضاء الشرعي، فقد احتفظ علماء مصر والبلاد العربية إلى حد ما بالمرونة التقليدية لنظامهم وبنفورهم من الأنظمة الأجنبية ولدينا القليل من آثار العثمنة، وكان التدخل المباشر مقصوراً على النظام القضائي، أما النواحي الأخرى كالتعليم وهيئاته "فإنه لا استانبول ولا الموظفين المحليين كانوا يتدخلون مطلقاً في نظمها التقليدية ولا في أشخاص القائمين عليها ولا في المناهج التي يتبعونها... ولم تكن ثمة ضرائب تحصل من العلماء" رغم كون السلطان حنفياً "فإنه لم يحدث مرة واحدة أن ولي مشيخة الأزهر شيخ حنفي، وظل هذا المنصب - طيلة القرن الثامن عشر- وقفاً على الشافعية".
ورغم حضور التزمت فإن هذا لم يمنع تيار التجديد الفكري في النصف الثاني من القرن الثامن عشر حين ظهر علماء حاولوا التجديد في مجالات الثقافة المختلفة ولعل أشهرهم مرتضى الزبيدي صاحب قاموس تاج العروس الذي فتح الطريق لتجديد اللغة العربية ووصلت شهرته إلى إسطنبول حيث دعاه السلطان عبد الحميد الأول لمواصلة النشاط في العاصمة ولكنه رفض، وكان عبد الرحمن الجبرتي صاحب محاولة تجديد في التاريخ قبل الحملة الفرنسية، وقد خضع الفن المصري لبعض التأثيرات العثمانية دون أن يفقد أصالته أو خصوصياته.
ولطالما صورت مصر تحت الحكم العثماني لمدة ثلاثة قرون تقريباً قبل الحملة الفرنسية (1517- 1798) بصورة قاتمة تسودها الفوضى والركود والجهل والتخلف في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى أن بزغ "نور أوروبا" ومهد للحداثة التي شهدتها مصر في زمن محمد علي باشا، وهذا ما زعمته المدرسة الاستعمارية زمناً طويلاً لتأكيد اعتقادها أن الأخذ بالنموذج الأوروبي هو السبيل الوحيد للتقدم، ليتكشف الأمر بعد بحوث عديدة على أن الرأي السابق بني دون بحث أو تمحيص وأن قيام بحوث رائدة في هذا المجال أخضع النظرة السابقة للنقد والمراجعة وأدى إلى اهتزاز الصورة الراكدة التي كونتها وكشف عن "قصور مصادرها، وفساد تعميماتها، وخضوعها لسيطرة فكرة المركزية الأوروبية، فجاءت تلك الدراسات الجديدة بمعلومات وفيرة وآراء جديدة، أكثر دقة وموضوعية، نبهتنا إلى ضرورة إعادة اكتشاف وجه مصر خلال هذه القرون الثلاثة".[29]
ومن هذه الدراسات دراسة الأستاذ ناصر عبد الله عثمان عن الحركة العلمية في مصر في أكثر حقب التاريخ المصري غموضاً وهو القرن السابع عشر لترد على "المزاعم التي تدعي بأن شعلة العلم قد انطفأت تماماً في مصر والدول العربية تحت ظل الدولة العثمانية"، لتكشف أولاً أن "تقلص الينابيع الفكرية لم يكن وليد العصر العثماني أو شيء انفرد به دون غيره، فقد أشارت الدراسة إلى أن هذا الأمر ظهر منذ بدايات القرن السابع الهجري، الثالث عشر الميلادي"، وأهم ما خرجت به الدراسة أن الجوانب الفكرية في كثير من العلوم قد شهدت تطوراً كبيراً في القرن الحادي عشر الهجري، السابع عشر الميلادي، كالحديث والفقه واللغة والتاريخ بفروعه، بالإضافة إلى الأدب الذي لم يكن أسلوبه منحطاً أو ركيكاً كما وصفه المتحاملون على العصر العثماني، والعلوم العقلية التي لم تكن محرمة كما ادعى البعض بل وجدنا عكس ذلك تماماً من الاعتناء والتدريس للمنطق والحساب والطب، كما وجدنا الكتابات الموسوعية غير المقتصرة على تخصص واحد، وكل ذلك طبعاً يجب أن يقاس بمقاييس ذلك العصر لا بمقاييسنا المعاصرة.[30]
وعن الفكر المصري في القرن الثامن عشر بين الجمود والتجديد يقول الدكتور عبد الله العزباوي في كتابه الذي يحمل نفس العنوان والذي وصفه الدكتور يونان لبيب رزق بعدم الانحياز، إن هذا الفكر كان يغلب عليه الجمود والتقليد في النصف الأول من القرن، ولكن لم يكن العثمانيون هم السبب في هذا الضعف الذي بدأ منذ القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي)، وإن التعليم لم يكن متدهوراً كما ظن بعض الباحثين بل إنه كان متقدماً وإن شابه التركيز على العلوم النقلية، ومع ذلك لم تختف العلوم العقلية كالطب والرياضيات والفلك، وإن الحركة الفكرية في مصر أخذت منذ أواخر القرن الثامن عشر تحرز درجة كبيرة من التقدم والتطور على أيدي علماء موسوعيين وآخرين خرجوا عن طريقة الحواشي والشروح ونادوا بالتجديد، فلم تكن الحملة الفرنسية هي التي أدت إلى تطور الفكر المصري لأن نهضته بدأت منذ أوائل القرن ونمت في أواخره قبل مجيء الفرنسيين، وكانت هذه النهضة مختلفة عن النهضة الغربية.[31]
وخلاصة ما يقوله الدكتور أحمد زكريا الشلق إن مصر لم تكن نائمة قبل أن يأتي الغرب، وأن حركتها كانت مستمرة نحو حداثة من صنع تطورها ضمن المجتمع العثماني الأكبر، وأن تاريخ الحداثة فيها سبق الحملة الفرنسية، وإذا لم تأخذ تلك الحداثة الشكل التقني فقد أخذت الشكل الثقافي والاقتصادي الذي يدحض إمكان سحب صفات سلبية موحدة على القرون العثمانية الثلاثة، فقد مرت بمراحل من الازدهار والتطور ومراحل من التدهور، وإذا كنا نقرأ عن عبقريات كالزبيدي مؤلف تاج العروس والجبرتي صاحب التاريخ فإن هذه العبقريات لم تكن مقطوعة الأصول بمجتمعاتها، وأثبتت الحداثة التي شهدتها مصر أنه يمكن أن يكون لكل مجتمع طريقه الخاص في التطور الذي يأخذ دائماً شكل التغيرات الاجتماعية الهادئة، ويتراوح كثير من المؤرخين في الحديث عن آثار الحملة الفرنسية بين القول إنها إذا لم تتعمد الإفساد فإنها لم تشجع بشكل جاد على النهوض بمصر والمصريين إلى مرحلة أعلى من التمدن، والقول إن حتمية التاريخ كانت ستفضي بمصر إلى الانفتاح على الحداثة دون غزو فرنسي، وإن مصر كان مآلها إلى التغيير سواء ظهر بونابرت أم لا، والقول إن الاحتلال الفرنسي قطع سياق التطور الطبيعي لمصر كما قطع سياق علاقتها بالدولة العثمانية، وخصوصيتها سياسياً وحضارياً.[32]
وفيما يتعلق بوضع المرأة الذي كثيراً ما اتخذ مؤشراً لمدى التحضر ومبرراً للتطفل الأجنبي، يقول الدكتور عبد الرزاق عيسى في كتابه الوثائقي عن المرأة المصرية في العصر العثماني إن هذا العصر ظُلم كثيراً وما زلنا بحاجة ماسة لمزيد من البحث لاستخراج الكنوز المعرفية المدفونة مع الوثائق لتنير لنا السبل المظلمة من تاريخنا، وإن موضوع المرأة العثمانية من المواضيع التي تحتاج للتصحيح وإعادة النظر لأن معظم إن لم يكن كل الآراء التي تحدثت في هذا الموضوع أكدت على سوء أوضاع النساء وانتهاك حقوقهن في ذلك العصر، وأن المرأة كانت حبيسة الجدران لا تخرج من منزل أبيها إلا إلى منزل زوجها أو القبر، ولم تتنبه لحقوقها إلا مع فجر الحملة الفرنسية وما تبعها من نهضة تمثلت في قاسم أمين أو رفاعة الطهطاوي، وهذه النظرة غربية وتريد وصم تاريخنا بما لم يكن فيه وللأسف فقد روجها كثير من الباحثين والمفكرين منذ لويس عوض ومن تبعه عن جهل أو تجاهل أو إسقاط أيديولوجي أو تقليد استشراقي، هذا في الوقت الذي تؤكد فيه الوثائق عكس تلك الدعاوى وتوضح بما لا يدع مجالاً للشك أن المرأة حصلت على كافة حقوقها سواء المتعلقة بإقرارها عقد الزواج وقدرتها على وضع ما يحلو لها من شروط عليه واللجوء إلى القاضي في حالة الإخلال بها وطلب الخلع، أو المتعلقة باستقلال ذمتها المالية وما يتبعه من بيع وشراء وتعامل مع من تشاء دون قيد ولا شرط، أو قدرتها على وقف الأوقاف بل تولي نظارتها حيث تكون "الأرشد والأعقل والأقدر على إدارة الوقف" حسب قول القاضي، وتبين أن الحديث عن الحرملك شابه الخيال والأساطير سيراً خلف دعايات الأوروبيين وتبين بعد الدراسات المدققة بأن الكثير مما كتب لا يمت إلى الحقيقة بصلة وهو محل شك كبير في وجوده أصلاً.
وجاءت دراسات الدكتورة نيللي حنا المعتمدة على وثائق المحكمة الشرعية لتؤكد أنه في القرن السابع عشر كان وضع النساء في مصر يفضل وضع نظيراتهن في فرنسا وإنجلترا من عدة وجوه، وبعد دراستها بيوت القاهرة تبين عدم وجود العزلة التي تخيلتها فكرة الحرملك بمعنى حبس المرأة وانتهاك حقوقها، ويرى الدكتور عيسى وجوب اضطلاع الباحث بنشر الوعي الصحيح بعيداً عن الآراء المتحجرة والقوالب الجامدة والنظرة الغربية لتاريخنا الذي يجب أن نفهمه من مصادره الأصلية حسب ظروفنا ومراحل تطورنا بعيداً عن القوالب المستوردة التي توضع الحوادث فيها قسراً فينتج عن ذلك التاريخ المشوه.[33]
أما وضع غير المسلمين الذي طالما كان ذريعة للتدخل الأجنبي والتدمير فيلخصه الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن استنادا إلى دراسة الدكتور محمد عفيفي الشاملة بالقول إن هذه الدراسة وضعت وصفاً دقيقاً لوضع الأقباط ودورهم في الإدارة المالية العثمانية "وكيف أنهم عاشوا كجزء من المجتمع المصري، دون أدنى شعور بالتفرقة أو التمايز، إنما كجزء من المجتمع يتوافق كل التوافق مع بقية الأجزاء".[34]
ويدون المؤرخ مانتران خلاصة دراسته كما يلي: "نستطيع إذن أن نقول في النهاية إن السيادة العثمانية على مصر قد وجدت قبولاً سريعاً وأنها - بعكس ما حدث في البلدان الأخرى- لم تكن شديدة الوطأة بصفة عامة. كان ثمة قدر ضئيل من القمع العسكري- إذا نحن نحينا جانباً حملة 85- 1786، إلا أن حوادث العصيان والتمرد لم تكن من صنع المصريين في غالب الأحيان، كما أنها لم تكن موجهة ضد العثمانيين إلا في نهاية القرن الثامن عشر. وفي مقابل ذلك كان العثمانيون يكنون بالغ الاحترام للقاهرة التي ظلت تحتفظ في نظرهم بكامل هيبتها.
"إن الأفكار التي تروج عن ظلم الأتراك لم تظهر إلا في وقت متأخر من القرن التاسع عشر، بالإضافة إلى أنها من صنع الغرب وترتبط "بالمسألة الشرقية" وكان يلجأ إليها في شعارات الحركات الاستقلالية التي تظهر في قلب الإمبراطورية العثمانية وكذلك أثناء التأييد الفرنسي لمصر بعد 1830 وفي التصورات التي أشاعتها حملة بونابرت على سبيل المثال، وكذلك في الاستراتيجية السياسية للقوى الغربية التي كانت ترمي لإحداث شقاق بين القاهرة واستانبول بقصد إحكام السيطرة على دولة بدأ يرتفع شأن وضعها الاقتصادي والاستراتيجي مع إنشاء قناة السويس.
"إن الأمر لم يكن علاقة تبعية سياسية في أية لحظة، ومنذ بداية القرن السادس عشر وحتى بداية القرن التاسع عشر، وبرغم أن القاهرة لم تكن عاصمة لدولة مستقلة فإنها لم تكن بأية حال أقل من عاصمة، فقد ظلت واحدة من أوليات المدن في امبراطورية إسلامية مترامية الأطراف، يولي حكامها - أي حكام الإمبراطورية- القاهرة قدراً لا يمكن تجاهله من رعايتهم واحترامهم".[35]
هذه هي شذرات عامة عن وضع مصر أثناء فترة الحكم العثماني آثرت الاستشهاد بأقوال المؤرخين المتعددة عنها، وبالنص نفسه أحياناً كثيرة لنقل انطباعاتهم الصادقة كما سطروها، بعدما قاموا بدراسات وثائقية وافية استغرقت أعماراً وأزاحت الآراء الاستشراقية المسبقة والتعميمات الاختزالية التي قادت إلى أفكار مشوهة طمست الحقائق زمناً طويلاً وادعت دعاوى غير مؤسسة من باب الاحتلال العثماني بل الاستعمار التركي، ويلاحظ من توجه الأبحاث التاريخية الجديدة أنه كلما قام باحث جاد بدراسة أحد الجوانب من التاريخ العثماني تكون النتيجة خروجه "بتصور جديد" يلغي الانطباعات السلبية الشاملة التي وصمت الدولة العثمانية زمناً طويلاً، وهذا يقودنا إلى تصور مدى التشويه الذي ساد نظرتنا إلى هذه الدولة عقوداً طويلة بطريقة أعمتنا عن رؤية الحقيقة وشوهت نظرتنا إليها فانتظرت المؤرخين المنصفين ليجلوا شيئاً فشيئاً ركام السنين الذي راكمته عداوة الغرب للعثمانيين الذين عرقلوا مشاريعه الاستعمارية دهراً طويلاً، فنظر إليها بعداء وحاول ناجحاً أن يقنعنا أن خلاصنا في التحالف معه فوقعنا في الفخ فعلاً لمدة طويلة، ولهذا وجب علينا التريث قبل تبني المقولات الشائعة عن الخلافة العثمانية والإنصات جيداً إلى الباحثين الجادين الذين ما عادت الآراء الاستشراقية المسبقة تسيطر على توجهاتهم.
* مصر العثمانية في قراءة الدكتور حسن الضيقة: دحض المقولات الأيديولوجية الجاهزة
ويرى الدكتور حسن الضيقة في دراسته الشاملة والمميزة التي تفند القراءات الأيديولوجية المسبقة وتستحق منا اهتماماً بنقل رءوس أقلامها وفق لغته ما أمكن أن دخول مصر في منظومة الدولة العثمانية كان مخرجاً لها من المآزق السياسية والاقتصادية التي عاشتها عند منقلب القرن السادس عشر إذ كان وصول البرتغاليين إلى المحيط الهندي والإسبان إلى البحر المتوسط ذا آثار مدمرة بالنسبة لمصر في ظل حالة التفسخ التي وصلت إليها الدولة المملوكية، واستطاعت الدولة العثمانية أن تدفع الخطر عن شمال إفريقيا وأن تضع يدها على رودس وأن تطرد الخطر البرتغالي من البحر الأحمر فحققت بذلك عدة أهداف استراتيجية حكمت وضعها داخل المجال العربي لمدة ثلاثة قرون وهي كسر السيطرة الأوروبية وتوحيد البلاد العربية وإحداث تجديدات في البنى السياسية والاقتصادية والثقافية أدت دوراً فاعلاً في مقاومة التحديات الداخلية والخارجية التي شهدتها الدولة.
وبهذا لم يكن دخول مصر في الدائرة العثمانية مجرد تغيير نظام حكم بل كان تحولاً نوعياً، وقد أعادت الدولة العثمانية تشكيل النظم السياسية فوفرت نوعاً من المشاركة السياسية الكابحة للاستئثار بالسلطة وألغت الضرائب غير الشرعية واستكملت التجديدات على المستوى القضائي مما وفر الأمن وأزاح القوى المعيقة للوحدة ومنح شروط قيام سوق داخلية موسعة تربط أقاليم الدولة بشكل تكاملي.
احتلت مصر مكانة خاصة في إطار الدولة العثمانية مكنتها من النهوض بدور مركزي داخل الولايات العثمانية، فقد كانت مصر هي المركز الذي تمر منه سياسة المواجهة العثمانية ضد القوى الأوروبية الطامعة بالسيطرة على المنطقة، كما نهضت مصر بتأمين احتياجات مكة المكرمة والمدينة المنورة في الحجاز، وقد حررتها السيادة العثمانية من الآثار السلبية لتحول طرق التجارة نحو المحيطات وأعادت انتعاش الطرق المارة بمصر، فكان هناك علاقة وثيقة بين قدرات الدولة وما قامت به مصر من أدوار، فلم يكن المجال العثماني مجرد متلق سلبي لسياسات أوروبا، ولهذا فإن الحديث عن دخول مصر والبلاد العربية طور الركود والانحلال في ظل السيادة العثمانية لا يمتلك أي مسوغ تاريخي من حقائق الصراع مع الغرب.
وكان هدف تحطيم السيادة العثمانية في جزيرة العرب والبحر الأحمر سياسة ثابتة للقوى الأوروبية المتعاقبة في المحيط الهندي، وتمكن العثمانيون من مواجهة هذه السياسة بدعم من الطبقة التجارية في مصر والحجاز واليمن، وقد تمكنت مصر من مواجهة الاختراقات الأوروبية سواء التي نتجت عن التحولات الخارجية في موازين القوى أو عن التنازلات التي قدمتها الطبقة المملوكية الحاكمة، ووجدت مصر سندها في الموقع المركزي الذي احتلته داخل السوق العثمانية الواسعة مما أعطاها مكانة اقتصادية تنقض المقولة الشائعة عن دور مصر كمجرد وسيط تجاري دولي.
وتمثل دورها المركزي في احتكار تجارة البن العدني داخل السوق العثمانية مما منحها مورداً اقتصادياً رئيساً كما كانت المصدر الرئيس للسكر داخل الدولة وهو ما وسع عمليات الاستثمار الزراعي والصناعي في حواضر مصر وأريافها، بالإضافة إلى صادرات الحبوب وعلى رأسها الأرز، وهناك أيضاً السلع المصنعة كمنسوجات القطن والكتان، وفي إطار هذا التكامل تم تحفيز الإنتاج والتبادل التجاري مع العاصمة والقسم الأوروبي من الدولة وجزر البحر المتوسط وولايات الشام وشمال إفريقيا والسودان خارج إطار وساطة السلطة المركزية، وفي الظروف الحرجة كنقص المحاصيل وكوارث الزلازل والأوبئة كانت السلطة المركزية تتولى تغطية النقص في السلع الرئيسة في مصر من بقية ولايات الدولة.
وأكملت النظم التشريعية المحفزة لانتقال الأموال والأفراد دعم هذه الشبكة من العلاقات الاقتصادية بالشروط القانونية وهو ما جعل القاهرة مركز استقطاب للتجار والحرفيين من الشام والمغرب وإسطنبول فشهدت المدينة نمواً سكانياً ملحوظاً رغم كوارث الأوبئة التي وقعت بها.
ونلاحظ نمو الشريحة التجارية العليا واستثماراتها حتى بلغت الذروة في القرنين السادس عشر والسابع عشر وكان ذلك نتيجة ما وفره المجال العثماني من ظروف مواتية للنمو والازدهار التجاري، وكان ضعف السلطة المركزية ذا أثر سلبي بسبب التناقض بين النزعات المملوكية الانفصالية عن المركز وميولها لنهب واستنزاف قوى السوق وتنازلاتها للقوى الأوروبية ولهذه الأسباب لا يمكن وصف اتجاهات السياسة المملوكية بأنها استجابة سياسية لصعود طبقة تجارية رأسمالية ويستحيل الحديث في هذه المرحلة من تاريخ مصر عن نواة رأسمالية مبكرة حيث كانت التوجهات السياسية الانفصالية معاكسة لمتطلبات ازدهار السوق ولهذا عانت الشريحة التجارية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر من الانكماش وليس النمو.
وبناء على ما وفره المجال العثماني الموحد وما نتج عن النزعات الانفصالية من آثار سلبية يتبين لنا خطأ القراءات الأيديولوجية الماركسية التي اختزلت الدولة العثمانية بصفات النهب والاحتلال وجعلت من صعود القوى المملوكية انتقالاً لحقبة تاريخية ذات طابع رأسمالي تقدمي بما فيها من انسجام مع السياسات الأوروبية لمغادرة مجال "الاستبداد الشرقي"، وهي قراءة أيديولوجية لا تتفق مع حقائق وأرقام التاريخ حيث يتبين أن التنازلات التي منحت لبريطانيا وفرنسا كانت تستهدف تأمين الدعم السياسي للطبقة الحاكمة على حساب قوى السوق المحلية وهو ما جعل هذه الإجراءات آلية انحلال سياسي واقتصادي عملت القوى الأوروبية على استغلالها وتوظيفها لتوسع سيطرتها على المنطقة، وإن تلك القراءة الأيديولوجية تحجب حقيقة الصراع بين دورة السوق الداخلية والسياسات الأوروبية المعتدية لصالح وجهة نظر موهومة تتخيل الصراع بين مصالح السوق المصرية ومجال السوق العثماني الموحد، وهو ما يضفي في النهاية الطابع التقدمي على سياسات الخضوع لأوروبا.
وفيما يتعلق بالريف المصري ينقل الدكتور الضيقة عن المؤرخ الاقتصادي شارل عيساوي أن الريف المصري شهد منذ بداية الفتح العثماني إلى منتصف القرن السابع عشر فترة ازدهار متميزة مقارنة بما سبقها وما لحقها وكان سببها السياسة العثمانية التي اعتنت بالإنتاج الزراعي من نواحي التشريعية والقضائية والضريبية، وكان نظام الأمانات يعطي القاضي صلاحية الإشراف الإداري الذي يمنع الإدارة المالية من ظلم الفلاحين.
وإضافة إلى اعتدال النظام الضريبي فقد كانت معظم مال الخزانة يصرف داخل الولاية ولا يصل منه إلى العاصمة العثمانية سوى الربع، وتشير الحقائق السابقة إلى المرتكزات التي أمنت التوازن لوضع الفلاحين:
1- تحرير الإنتاج الزراعي من الأعباء الضريبية التي وضعها الجهاز السياسي العسكري دون مبررات تشريعية.
2- كان الحضور الفاعل للسلطة المركزية عامل توازن في توزيع الضرائب وهو ما ينفي مقولة الاستبداد الشرقي أو نمط الإنتاج الآسيوي التي تؤكد على الطبيعة الاستئثارية للفائض الإنتاجي، حيث نجد العلاقة عكسية بين تركيز السلطة واحتكار الثروة.
3- وجود جملة من التقنيات التي تتحكم في توزيع الضريبة بين احتياجات السلطة المحلية واحتياجات الأهالي المتنوعة.
ورغم أهمية الإنتاج الزراعي وموقعه المركزي في الحياة الريفية، فقد وجد إلى جانبه نشاطات حرفية ثابتة من صناعات الفخار والأنسجة الصوفية والقطنية والحصر التي كانت تكفي الريف وتغطي جانباً من احتياجات السوق العثمانية، وإلى جانبها كان هناك صناعات الزيوت وتقطير ماء الورد وملح النشادر الذي يصل جزء منها إلى أوروبا، والبارود والسكر والبيض.
وظل هذا التوازن مستمراً إلى منتصف القرن السابع عشر إلى أن أدى ضعف السلطة المركزية إلى الصعود السياسي للقوى المملوكية ذات النزعات الاستقلالية ولكنها لم تكن ذات طابع تجديدي بل تعبير عن عملية تفسخ القوة المركزية وامتداد لذلك، وكان استئثارها بالقوة والثروة على حساب السلطة المركزية والمجتمع الأهلي المنتج أيضاً، وجاء استغلالها مضاعفاً باستجابتها لسياسات الاقتحام الغربية على حساب المجتمع، وتحول نظام الالتزام الذي خلف "التيمار" و"الأمانات" نتيجة سوء التطبيق إلى مدخل لصعود القوى العسكرية وطبقة الأعيان وقيامها بانتزاع قدر من الاستقلالية السياسية على حساب الحكم المركزي ما منحها فرصة انتزاع فائض مالي لا تقره التشريعات القانونية بالاشتراك مع شريحة قبطية عليا على حساب حصة الدولة والفلاح المسلم والقبطي معاً، وفقاً لدراسة الدكتور محمد عفيفي عن الأقباط في العصر العثماني، وذلك لتلبية حاجات السلطة المحلية الاستهلاكية ومتطلباتها السياسية والعسكرية بصفتها الخارجة عن السلطة المركزية وهو ما جعل الوضع في هذه الفترة شبيها بوضع الدولة المملوكية قبل الدخول العثماني وأصبح اتجاه عملية الإنتاج الزراعي نحو الركود والانهيار وهروب الفلاح من أرضه.
تؤدي هذه المعطيات إلى دحض القراءة الماركسية الرائجة التي تحمل صعود المماليك فيضاً من الدلالات الإيجابية التي تتعارض مع الواقع كتصويرها بأنها ظاهرة رأسمالية واعدة تشبه المركنتيلية الأوروبية (المرحلة التجارية من الرأسمالية التي مهدت الطريق لنهضة أوروبا وثورتها الصناعية) في زمنها وهي قراءة تسقط أحكامها الأيديولوجية والنظرية بشكل متناقض فترى نشوء رأسمالية داخل حركة المجتمع في ولاية مصر على غرار الرأسمالية الأوروبية وفي نفس الوقت ترى النزعة المملوكية للاستئثار بالسلطة أحد شروط نشوء هذه الرأسمالية، وعلى كل حال فهذه القراءة تضفي على التحول المملوكي مغالطات تتعارض مع واقعه الطفيلي والانفصالي والانعزالي والذي لا يشير إلى أي ظاهرة تجديدية والادعاء بتعايش الطبقة المملوكية مع التجار والصناع يكذبه واقع أن ازدهارهم ارتبط عضوياً بوحدة السوق العثمانية وتصدي العثمانيين لسياسات التطويق الأوروبي ومحافظتهم على أحد مرتكزات الازدهار التجاري المصري وهو طريق البحر الأحمر الواصل بين مصر والجزيرة العربية ومن هنا كان الاتجاه المملوكي الانفصالي ضربة مميتة لدور التجاري المصري ولا مكان للحديث عن تعايش أو دعم متبادل بين المماليك والتجار والصناع كما لا نلحظ أي تطور في الصناعات اليدوية التي تخيلتها القراءة الماركسية إرهاصاً رأسمالياً، ذلك أن التوسع الحرفي الحقيقي حدث في الماضي استجابة لاحتياجات السوق العثمانية ولم يعرف القرن الثامن عشر أية عملية تجديد في بنى الإنتاج في أوجهها التقنية أو التنظيمية سواء بسبب الاضطرابات الناجمة عن تفكك السلطة المركزية أو بسبب عزوف أصحاب رءوس الأموال عن الاستثمار في النشاط الحرفي، كل ذلك يؤكد التناقض بين سياسات السلطة المملوكية ومتطلبات السوق التجارية والحرفية، وما زاد تفاقم الأمر علاقة المماليك بالغرب واستقواؤهم بالدعم الروسي والبندقي والأوروبي الذي سعى للولوج إلى البحر الأحمر ومن ثم تفكيك إحدى مرتكزات الدورة الاقتصادية المصرية التي مكنها العثمانيون منذ الفتح من السيطرة على تجارة التوابل ثم البن ومنع الأوروبيين من ذلك ومن إقامة علاقة مباشرة بين أوروبا والهند عن طريق السويس ما أعطى ضمانة ثابتة للسوق المصرية والحجازية، ولهذا لقي فتح المدن المصرية أمام السفن البريطانية معارضة السلطة العثمانية والتجار في مصر والحجاز معاً، وأدت سياسة الارتهان الخارجية للسلطة المملوكية إلى استنجاد قوى المجتمع المصري بالسلطة العثمانية للتخلص من المماليك إلى حد تصور حسن باشا الذي أوكلت إليه مهمة القضاء على المماليك وكأنه "مهدي العصر" كما يقول الجبرتي، ولكن فشل إزاحة المماليك أدخل مصر في أسوأ مراحل تاريخها في ظل الدولة العثمانية وهو العقد الأخير من القرن الثامن عشر.
"بالمحصلة بقيت ولاية مصر حتى الحملة الفرنسية تستمد نقاط توازنها وقوتها من ارتباطها بحقل سياسي واقتصادي أمّن لها دوراً مميزاً، كما سمح بنشوء تراتبية اقتصادية واجتماعية شديدة التباين داخل فئات وشرائح المجتمع المصري. أما فيما يتعلق بدرجة التغلغل الاقتصادي والسياسي الأوروبي، وسيطرته المتصاعدة على تجارة المتوسط واختراقه للبحر الأحمر، فإنها لم تستطع أن تحدث اختلالاً أساسياً في توازنات السوق الداخلية...".
ولهذا كان على أوروبا أن تكثف جهودها لإحداث الاختراقات المطلوبة في الداخل العثماني، وهو ما بدأ بالحملة الفرنسية على مصر التي قلبت وضع الطرف العثماني من الهجوم إلى الدفاع، والطرف الأوروبي من الدفاع إلى الهجوم واتحدت مواقف شرائح شعب مصر في مقاومتها منذ لحظة دخول الفرنسيين الإسكندرية إذ سارع جميع الأئمة إلى قراءة فرمانات السلطان سليم الثالث وفتحت أبواب المواجهة الشاملة مع كافة قوى المجتمع المصري، وإذا كان البعض قد اختار التعاون مع المحتلين سواء من المشايخ أو الأقباط فإن مواقفهم كانت معزولة في محيطهم، إذ كان العلماء هم مركز الثقل في المقاومة، وحتى من لم ينخرط فيها كان موقفه سلبياً من الاحتلال الذي لم يلق أي تجاوب في المجتمع الذي قاوم كل بما يتفق مع موقعه مع التأكيد العام على أن مصر ولاية عثمانية، ومن هنا كانت القراءات التي جعلت الدولة العثمانية ضمن القوى الاستعمارية المتنافسة على مصر أو التي قسمت المواقف المقاومة والمتعاونة والحيادية إلى أقسام متساوية قراءة مضللة تستهدف قسر الحوادث وصبها في قالبها الأيديولوجي دون سند من الواقع، فإسقاط الصفة الاستعمارية على الدولة العثمانية التي أنقذت كافة الولايات العربية من الاحتلال الغربي لمدة قرون لا يتفق مع الحقيقة بالإضافة إلى أن مشكلتها زمن الحملة الفرنسية لم تكن في منافسة بريطانيا وفرنسا بل في عجزها الآن عن حماية مجالها وبهذا أصبحت صفتها لا في سعيها لامتلاك مصر بل في عجزها عن مواجهة المستعمرين، أما قراءة المواقف المصرية بصورة محرفة تجعل المقاومة فعلاً تابعاً "للاستعمار التركي" على نفس مستوى التعاون مع "الاستعمار الفرنسي" فهي قراءة لا تراعي الوزن الحقيقي لهذه "التيارات" وهامشية المتعاونين مع الفرنسيين حتى في الوسط القبطي كما تغفل مواقف المقاومين الذين لم يكونوا تابعين للسلطة بأي حال، ويفند الدكتور الضيقة هذه القراءة العائدة للويس عوض وقراءة الأستاذ أنور عبد الملك التي عجزت عن التمييز بين الولاء للدولة العثمانية وهو الموقف الجامع لكافة قوى المجتمع المصري وبين الخضوع لسياسات السلطة وهو موقف اختلفت بشأنه الآراء ووصل الخلاف حد الخروج عليها دون أن يعني ذلك خروجاً عن الدولة نفسها، ومن هنا الاستنتاج بقصور القراءات التي اعتمدت مقولة الاستبداد الشرقي أو نمط الإنتاج الآسيوي والتي تجعل السلطة هي المهيمن الشامل الذي يحدد وظائف كل تكوينات المجتمع، أما في الحقيقة فمن الخطأ معادلة السلطة بالدولة حيث أن السلطة هي إحدى حلقات الحقل السياسي العام وفي ضوء ذلك تكون الصفة الجامعة للعلماء على اختلاف توجهاتهم هي العمل على تأمين وحدة الدولة اقتصادياً وسياسياً بصفتها الممثل المعبر عن الشريعة- الأمة.
بادرت الدولة العثمانية إلى مقاومة الغزو الفرنسي بكل ما تملك من قدرات، ولكن موقع ضعفها جعلها مهزومة دائماً إلا حين انتصر والي عكا على الحصار الفرنسي، فلجئت إلى طلب الدعم الخارجي لتعديل ميزان القوى، وعملت السياسة البريطانية على دعم القوة المملوكية لقطع الطريق على فرنسا ومنع العثمانيين من تثبيت سلطتهم على مصر، وكانت شريحة المماليك في حاجة للدعم الخارجي لأن الشرعية تعوزها في مواجهة السلطة المركزية والأهالي أيضاً بعد استئثارها بالسلطة والثروة ثم هزيمتها أمام الغزو الاستعماري، فوجد الإنجليز والفرنسيون ضالتهم فيها وصارت مرتكز السياسات الأوروبية بهدف تفكيك الدولة العثمانية والسيطرة عليها، فاستجابت للدور الذي رسم لها بما يتعارض مع المصالح الرئيسة لدورة المجتمع العثماني سواء في السلطة المركزية أو المجتمع الأهلي الذي دافع عن انتمائه العثماني وعد دفاعه عن الدولة دفاعاً عن النفس وقام بالتصدي للاستعمار والمماليك دون أن يكون ذلك رضوخاً بلا مغالبة لسلطة الباب العالي.
والغريب بعد كل هذا قيام مدارس التغريب الليبرالية والماركسية والقومية بالنظر إلى الكتلة المملوكية متخشبة البنيان والعاجزة عن أي تجديد والمستقوية بسياسات الاستعمار على أنها قوة استقلالية نهضوية تنتقل بالمجتمع مما قبل الرأسمالية إلى الرأسمالية وأنها قوة تؤسس لدخول المجتمع العربي عهد التحديث والتنوير وهي مقولة لا سند لها في الواقع عندما نرصد مسار التحولات التاريخية وهي مجرد موقف أيديولوجي متمم للغة التنوير الاستعمارية، ويلاحظ أن الدكتورة نللي حنا توصلت إلى نفس هذه النتيجة أيضاً عن النتائج السلبية لسياسات المماليك ودورهم في إجهاض حركة الرأسمالية التجارية بالضرائب الثقيلة التي فرضوها على المجتمع وبتحالفهم مع التجار الأجانب الذين غزت بضائعهم السوق المصرية مما تسبب في إفقار الطبقة الوسطى،[36] وقد أظهرت المواجهة ضد الحملة الفرنسية تفكك وتآكل شرعية القوة المملوكية في نظر الأهالي الذين غدوا بعد الاحتلال أكثر تمسكاً بالانتماء العثماني،[37] وبهذا تنتهي قراءة الدكتور حسن الضيقة.
* الصراع الداخلي والنزعات الاستقلالية كانت بوابة الاحتلال الأجنبي
دخلت مصر في زمن محمد علي باشا وخلفائه طوراً من الاستقلال الفعلي لا يميل مؤيدوه لنسبة مزاياه إلى الحكم العثماني كما لا يحب معارضوه نسبة عيوبه إلى العثمانيين، لاسيما أن الوالي دخل في مواجهة عسكرية ضد الحكم المركزي في إسطنبول إلى أن حصل على حكم مصر له ولورثته، وظلت دائرة الاستقلال تتسع وكان من المفارقة أنها أصبحت بوابة للاحتلال الأجنبي الذي بدأ تسلله بمهادنة الخديو إسماعيل لأوروبا والتقرب إليها للحصول على تأييدها للاستقلال عن الدولة العثمانية في الوقت الذي كان الخطر متأتياً من الاحتلال الأوروبي الأجنبي وليس من تركيا الضعيفة كما يشير لذلك المؤرخ المصري المعروف عبد الرحمن الرافعي.[38]
* احتلال بريطانيا لمصر كان بداية العداوة العميقة بين الدولة العثمانية والإنجليز
رغم الخيط الضعيف الذي ظل يربط الولاية المصرية بالحكم المركزي فإن المراجع التاريخية تجمع على أن احتلال بريطانيا لمصر 1882 كان الحد الفاصل بين زمنين في العلاقات العثمانية البريطانية التي كانت فيما سبق تقوم على الانسجام الظاهري لمدة طويلة نتيجة التزام بريطانيا بالدفاع عن فكرة وحدة الأراضي العثمانية منذ معاهدة باريس بعد حرب القرم 1856 ثم تغيرت الأمور بعد تخلي بريطانيا عن هذا المبدأ بعد الحرب العثمانية الروسية ومؤتمر برلين 1878 واتجاهها إلى احتلال أراض عثمانية كانت قبرص هي بوابتها 1878 ثم لما وقع احتلال مصر أصبحت بريطانيا في موقع العدو الكريه بالنسبة للسلطان العثماني الذي "كان عنيفاً في كرهه للإنجليز" وأصبح ينتهج سياسة معادية لهم ويجمع المؤرخون (ومنهم الدكتور عبد العزيز الشناوي والدكتور جوني منصور والدكتور وليد الخالدي والمؤرخ شوكت باموك والمؤرخ موريس جاسترو) على أن احتلال مصر قد غيّر مكانة بريطانيا في الدولة العثمانية عامة وعند السلطان عبد الحميد خاصة والذي أصابه هذا الاحتلال بألم حز في نفسه مدى الحياة وبات معادياً لبريطانيا وكارهاً للإنجليز بعنف كما يقول المؤرخ إرنست رامزور ومتوجساً منهم أكثر من توجسه من الروس أعدائه التقليديين[39] وأصبحت سياسته توصف بكونها Anti- British أي معادية لبريطانيا التي عزى إليها مشاكله السياسية مع الأقليات،[40] ولم يكن يفوت فرصة للعمل مادياً ومعنوياً ضد الاحتلال البريطاني في مصر والسودان كما يذكر الدكتور محمد حرب[41] أو ضد مصالح بريطانيا كما يذكر ذلك المؤرخ جون هاسلب،[42] وذلك خلافاً للأفكار الأيديولوجية التي حاولت بشكل مناف للطبيعة أن تصور تواطؤاً عثمانياً بريطانياً لتسهيل احتلال بريطانيا مصر، وكل ما في الأمر أن ضعف الدولة العثمانية شل يدها عن الدفاع العسكري المفترض عن ولايتها الأثيرة ولهذا اتسمت سياسة السلطان بالحيرة والتخبط إذ منح قائد الثورة المصرية دعماً واضحاً برتبة الباشوية ثم عاد وأعلن عصيانه، وفي الحالين كان الهدف هو درء الاحتلال واتباع التجارب المتناقضة لتحقيق هذا الهدف ولكن الإصرار البريطاني على اقتحام مصر أبطل مفعول كل المحاولات العثمانية التي يتبين مغزاها فيما بعد من السياسة الواضحة التي اتبعها السلطان عبد الحميد تجاه الحركة الوطنية المصرية ودعمه غير المحدود لزعيمها مصطفى كامل باشا مما بيّن أنه ليس هناك أي تنسيق مزعوم مع الاحتلال والأمر لا يتعدى سنّة الضعف الطبيعية، والعجيب أن تتوجه الاتهامات للسلطان عبد الحميد نتيجة موقفه من عرابي باشا ولا توجه نفس هذه الاتهامات لوجوه نهضوية وتغريبية بارزة اتخذت مواقف سلبية من عرابي نفسه كالشيخ محمد عبده وأحمد فارس الشدياق وأستاذ الجيل أحمد لطفي السيد ولكن مواقفهم كانت نتيجة انسجام أصحابها مع السياسة البريطانية وليس مناوأتها، ومع ذلك لم يوجه أحد إليهم تهمة ولا اعتراضاً وهو أمر مثير للشبهة.
* تمسك شعب مصر بالجامعة الإسلامية ينفي تهمة الاحتلال عن الدولة العثمانية حتى آخر لحظاتها
ظلت السيادة الاسمية على مصر للدولة العثمانية منذ وقوع الاحتلال إلى اندلاع الحرب الكبرى الأولى 1914 حين ألغت بريطانيا هذه التبعية وأعلنت سلطاناً في مصر لمناوأة منصب السلطان العثماني ولكن من الطريف أن السلطان حسين كامل كان يتمتع بصلاحيات أقل من سلفه الخديو عباس وكل ما في الأمر هو زيادة الألقاب والنياشين الرمزية التي اتسمت بها دولة التجزئة دون مضمون حقيقي، وقد رفض شعب مصر السلطان الذي عينته بريطانيا وحاول اغتياله أكثر من مرة بالإضافة إلى محاولة اغتيال وزرائه، وكان ذلك بسبب رفض المصريين تبعية السلطان الألعوبة لبريطانيا واستمداده الشرعية من الاحتلال بعدما كان الخديو يستمد شرعيته من خليفة المسلمين، وتشير المراجع التاريخية إلى أن الشعب المصري في زمن الاحتلال التف حول القيادة الوطنية المتمسكة بفكرة الجامعة الإسلامية التي دعا إليها السلطان عبد الحميد، وفي ذلك يقول الدكتور رءوف عباس إن مصر في مطلع القرن العشرين كانت تتبنى فكرة الجامعة الإسلامية التي كانت بنداً رئيساً في طرح الحزب الوطني، ومضمونها هو الحفاظ على سلامة الأراضي العثمانية ووحدتها وانتماء مصر إلى دولة الخلافة الإسلامية، ذلك أن الحزب الوطني بنى نضاله على أساس عدم شرعية الوجود البريطاني في مصر الخاضعة للسيادة العثمانية، وكان التمسك بالتبعية العثمانية هو طوق النجاة من الاحتلال البريطاني، كما كان التحزب للجامعة الإسلامية التي دعا إليها السلطان عبد الحميد مواكباً للتمسك بالتبعية العثمانية وغالباً على فكرة القومية المصرية التي دعا إليها أحمد لطفي السيد بخجل قبل الحرب الكبرى الأولى، كما كان التحزب للجامعة الإسلامية رفضاً لفكرة القومية العربية بصفتها دعوة إلى تمزيق أوصال الدولة العثمانية إلى كيانات قومية، ووصل التمسك بالجامعة الإسلامية درجة عالية إلى حد أن موقف غالبية المصريين كان مؤيداً للدولة العثمانية في صراعها مع بريطانيا على حدود مصر الشرقية رغم أن بريطانيا زعمت الحفاظ على حقوق مصر 1906،[43] وفي هذا الموقف يتبين إدراك شعب مصر لحقيقة الصراع بين دولته الإسلامية والغرب ويحدد من الذي كان حامياً ومن الذي كان مستعمِراً، ولا يمكن بعد ذلك أن نتهم الدولة العثمانية بالاحتلال أو نصم شعباً كاملاً بالغفلة وعدم إدراك الواقع ثم نسقط صفات من زمن لاحق على ماض لم يكن يشعر بذلك مع أن هذا كان دأب التغريب المتعالي والمرتبط بالاستعمار الحقيقي.
* الدولة العثمانية لم تسلم أراضيها لقمة سائغة وهُزمت بعدما بذلت جهداً جاهداً
دخلت الدولة العثمانية في الحرب الكبرى الأولى (1914- 1918) بهدف كسر القيود الأوروبية التي كبلت قرارها السياسي ونهبت مواردها الاقتصادية واحتلت بلادها عسكرياً، وكان الهدف الواضح هو استعادة ما احتله الحلفاء وعلى رأس ذلك مصر، فقام جمال باشا بحملة ضخمة لعبور قناة السويس واسترجاع مصر 1915 ولكن الحملة فشلت ومنيت بالهزيمة، ومن دلائل تمسك المصريين بالدولة العثمانية حتى النهاية أن كثيراً منهم أطلقوا على مواليدهم زمن الحرب أسماء القادة الاتحاديين وهم جمال وأنور وطلعت وكان من بين هؤلاء المواليد قادة مصر فيما بعد، وعلى كل حال فإن مجهود الدولة العثمانية في الحرب الكبرى يدحض تهمة أنها سلمت بلادها لقمة سائغة لأوروبا، وتبقى بعد ذلك موازين القوى خاضعة لعدة عوامل ولكن لا يمكننا بكل الأحوال لوم كبير السن بسبب عجزه إذ كانت الدولة العثمانية في تلك الفترة تصارع سكرات الموت بعدما عاشت عمراً من أطول أعمار الدول في التاريخ وصمدت صموداً رائعاً في جبهات الحرب الكبرى سواء في القوقاز أو البلقان أو إسطنبول أو العراق أو فلسطين أو الجزيرة العربية وحققت انتصارات مذهلة أدهشت أعداءها وأصدقاءها على السواء ولكن لكل أجل كتاب (وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرينا) ولا يمكن أن نتوقع من دولة بلغت هذا الهرم أن تنتصر على قوانين الطبيعة أو أن تخلد إلى الأبد ولا يمكن أن نلومها بسبب اتفاق زمن نهايتها مع زمن مطالع الدول الغربية وعنفوان قوتها كما ذهبت لهذا المضمون بعض الاتهامات والمطالبات غير الواقعية بانتصار دولة بلغت من الكبر عتياً على الدول الحديثة في أوروبا (وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقاً وجاهد مسلماً).
* النموذج المصري بين فاعلية التكامل والوحدة وعجز الاستقلال والتجزئة
يؤكد الدكتور عبد الوهاب المسيري مقولة الدكتور جمال حمدان بعد دراسته المستفيضة لتاريخ مصر: "إنه لا نهضة لمصر دون أن تكون جزءاً من كيان سياسي أكبر"،[44] إن سجل الوحدة زاخر بالنجاح الفعلي والإنجاز العملي في زمن الخلافة، الضعف والتراجع طارئ عليه، أما سجل التجزئة والاستقلال فليس فيه سوى أحلام وأماني خيالية لم يتحقق منها غير الهزيمة والفشل والتراجع، والنجاح الفعلي هو الطارئ والمؤقت وظروفه خاصة، وعند المقارنة التاريخية بين ريادة مصر ودورها الفاعل عندما كانت "تابعة" لدولة الخلافة حين أنقذت المسلمين من المجاعة في عام الرمادة ثم أصبحت مركزاً للخلافة (ومن المفارقات أن ليبرالية التغريب ترفض حتى هذه المركزية لمصر باسم الهوية المستقلة) ثم هزمت حملات الفرنجة الصليبية وصدت الغزو المغولي لتعود مركزاً للخلافة ثانية ثم أصبحت الولاية الأولى في دولة الخلافة العثمانية مقدمة على الأناضول وأوروبا العثمانية، وبين فشلها وتراجعها زمن "الاستقلال" الذي صنعته بريطانيا حين سقط حكام مصر ضحية مشاريعهم لاستقلالها فدخل المسلمون في صراع داخلي أذكته أوروبا بين مصر والدولة العثمانية فتحطم الاثنان، ثم وقعت مصر تحت براثن الإفلاس ثم الهيمنة الأوروبية ثم الاحتلال البريطاني ولم تحقق نجاحاً مؤقتاً إلا اعتماداً على اختلاف الدول العظمى التي لم تلبث أن تكالبت عليها (1967) لتلحقها بمصالحها ثانية وتتخذ منها أداة للسيطرة على المنطقة العربية وتمرير السياسات الأمريكية وقيادة التطبيع مع الصهاينة وتدمير دولة عربية (1990- 2003)، ومع ذلك لم تمكنها كل هذه الخدمات من تحقيق مصالحها الوطنية الضيقة فكبل اقتصادها بالقروض والمساعدات والإصلاح الاقتصادي على حساب الاكتفاء الذاتي والمصالح المصرية وذلك لخدمة السياسة الأمريكية، ولعل المثل الأبرز في هذا المجال بيع النفط والغاز المصريين للكيان الصهيوني بخسارة لمصر بلغت ملايين الدولارات يومياً في حالة الغاز، وهو عبء كبير على الاقتصاد المصري المنهك أصلاً ومع ذلك فقد ضحت الدولة "المستقلة" بمصالحها الوطنية المباشرة لأجل مصالح الأقوياء، وقبلت كذلك بالتعاون العسكري الأمريكي الصهيوني الذي وصفه مبارك بالكارثة على الدول العربية المعتدلة وبالعقبة في طريق السلام (1983/12/6) ثم اضطر للاستسلام، والتزمت مصر بمعاهدة السلام مع الصهاينة "على الرغم من الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاقية" كما قال مبارك (1984/3/11)، ومنحت تسهيلات للقوات الأجنبية في مياهها ضد سيادتها وضد البلاد العربية الأخرى، بالإضافة إلى عجزها عن فرض رؤيتها لترتيبات أمنية عربية في الخليج بعد حرب الكويت واستسلامها للوجود الأمريكي هناك،[45] هذا إذا لم نذكر تحييد دورها وتهميشه وتأمين جانبها أثناء شن الصهاينة حروبهم ضد أشقائها العرب (1982 و2003 و2006)، هذا إذا لم تشارك في العدوان فعليا (1991 و2008)، وإذا استدعينا نموذجاً بسيطاً لا يتطلب طموحات كبرى ومع ذلك يدل على مدى عجز دولة التجزئة مهما كبر حجمها عن الخروج على إملاءات الدول الكبرى، فسنجد ذلك على الحدود بين الأراضي الفلسطينية ومصر، حيث استمرار التوتر فيها رغم تعاقب الأنظمة ذات الهويات المختلفة يؤكد أن عداوة الإخوة والجيران هو منطق دولة التجزئة المقيدة بسياسات الكبار التي تمنعها حتى من تحقيق مصالح قُطرية صغيرة كتبادل تجاري محدود، بين الأشقاء والأقارب في مدينة واحدة مقسمة بشكل هزلي بأمر الكبار، وذلك حين تقتضي المصالح الغربية ذلك المنع، ويصبح الأخ أداة لخنق أخيه الواقف خلف الحدود، إكراماً لتسلط الأجنبي وغطرسته واحتلاله، ولهذا فإن أية مراهنة على تحقيق أي نجاح نهضوي مهما صغر بواسطة الدولة القُطرية لن يكون مصيرها سوى إفساد المراهنين وجرهم إلى مستنقع المساومات فهزيمة كل مشاريعهم، إذ مهما تغيرت هويات الحكام سيجدون أنفسهم مقيدين بقلة إمكانات كيانات التجزئة التي التزموا بها ومن ثم عدم قدرتهم على تنفيذ أحلامهم وتحدي الأعداء الكبار، وسواء كانت الأحلام قومية واسعة أو إسلامية أوسع أو وطنية ضيقة لتوحيد شطري دولة أو حتى الحفاظ على وحدتها أو تحقيق مصالحها الوطنية لن يكون حاكم التجزئة في كل ذلك إلا أداة تطبق ما تقبله سياسات الكبار بغض النظر عن مشروعه وآماله.
ومما له دلالة أن دولة التجزئة الوطنية المصرية في عز سلطانها وقمة عنفوانها لم تستطع الحؤول دون فقدانها جميع مكملاتها ومقتضيات مصلحتها (السودان 1956، سوريا 1961، غزة وسيناء 1967) أمام التآمر الأجنبي وهو ما لا يضاهي في زمن الوحدة التي جسدتها الخلافة الإسلامية إلا أشد عصورها تراجعاً وهزيمة وضعفاً عندما كانت تفقد ولاياتها واحدة تلو الأخرى أمام الاحتلال الأجنبي، ومع ذلك يسجل لدولة الخلافة أنها لم تعترف بكل إجراءات الاستعمار في العالم العربي حتى وقّعت على ذلك وتنازلت عنه تركيا الكمالية (1923)، كما أن الدولة الوطنية المصرية في أبهى عصورها عندما تحدت العدوان الثلاثي في جو من التأييد العالمي لم تستطع إلا أن تطالب بالحقوق التي شرعتها اتفاقيات قناة السويس زمن الخلافة في أضعف حالاتها (اتفاقية القسطنطينية 1888)، كما جاء في تصريح الحكومة المصرية في 24 إبريل/ نيسان/ أفريل 1957،[46] ولم تقدر على ما هو أفضل من ذلك رغم كل الظروف العالمية المواتية، وإذا كانت الدولة الوطنية أكثر عزاً من زمن الخلافة حتى بأضعف حالاته، فلماذا لم تفرض شروطاً أفضل على أعدائها وعلى المجتمع الدولي؟ وكل ما سبق يحسم الخلاف والجدال عن "ضرورة" الدولة القُطرية و"أهميتها"، فوقوف المرء في صف متراص مع الإخوة لا يلغي الذات أو يمحوها بل يعزز موقفها ويقويها، والوقوف "مستقلاً" وحيداً هو الذي يمهد لافتراس المرء وزواله بجعله عرضة لهجوم أي وحش عابر في الغابة التي نعيش فيها، ولهذا نرى أن المرء عندما يريد إبراز قوته أمام الأغراب يعتز بانتمائه إلى أسرة أو قبيلة أو دولة تمنعه ولا يمكنه الاستقواء بعضلاته وحدها في مواجهة تكالب الأعداء.
* النتيجة
تؤدي محصلة دراسات المؤرخين الجديدة التي قلبت رأساً على عقب الأحكام الاستشراقية التي تحدثت عن التخلف والركود والتراجع والاحتلال الذي أصاب مصر في العصر العثماني أن الحكم العثماني جاء بمزايا لمصر صحبتها عيوب مثل كل الدول في التاريخ، ولكن المزايا كانت بارزة إلى درجة أن استمرت بها مكانة مصر التاريخية رغم تحولها من قاعدة دولة إلى ولاية في دولة أخرى لاحقة، ومع هذا استمرت مركزيتها الاقتصادية وشهدت نمواً عمرانياً ملحوظاً، وكانت مسيرة التطور الحضاري مستمرة ولا تنطبق عليها صفة الاستغلال الاستعماري من جهة الدولة العثمانية وكانت المسيرة ستأتي أكلها بعوامل النمو الذاتي لولا أن قطع الغرب طريقها وعرقل عوامل تقدمها وهي الجريمة الأبرز للاستعمار قبل وبعد سفكه الدماء ونهبه الموارد وحكمه الظالم، ثم غرس فينا أفكاراً من صناعته اختلقت في مرحلة متأخرة عن ظلم العثمانيين ليبيض صفحته ويبذر الشقاق بين أمتنا، وفي جميع الأحوال فإنه لا يجوز قراءة الوقائع العثمانية عموماً وفق أفكار لم تكن موجودة في العصر العثماني ويجب عدم الاعتراض على أي ظاهرة وتصنيفها عيباً وفق مقاييس لاحقة أو حتى وفق مقاييس لا تطبق إلا حسب الأهواء، لاسيما أن العثمانيين لم يفرضوا لغة أو نظاماً أو طابعاً اقتصادياً خاصاً بهم على ولاياتهم، وكان معظم خراج مصر ينفق فيها، وكانت العلاقة عكسية بين تركيز السلطة واحتكار الثروة، ويتبين من قراءة التاريخ العثماني في مصر بإمعان خلل القراءات الأيديولوجية سواء الليبرالية أو الماركسية أو القومية التي أرادت سكب التاريخ في قوالبها بدلاً من استنطاق حقائقه ووقائعه التي تبين بصورة جلية أن فاعلية مصر ومكانتها وقوتها كانت في زمن اندماجها بإخوتها أعلى وأكبر من زمن احتفي فيه "بالاستقلال" والشخصية الوطنية دون أرضية تبرر ذلك ودون إنجازات تدعم المكانة المتراجعة، وأن شعب مصر تمسك حتى اللحظة الأخيرة بالجامعة الإسلامية والولاء العثماني ضد الاستعمار الأوروبي لأنه لم يكن يرى في الدولة العثمانية أي نوع من أنواع الاحتلال وبهذا يتبين مدى انفصال التغريب عن قواعد الأمة حين قلب المعادلة وجعل الدولة العثمانية احتلالاً والاستعمار الغربي تنويراً رغم أن هذا الحكم يعاكس الحقائق العلمية التي تحدثت عنها الوثائق.