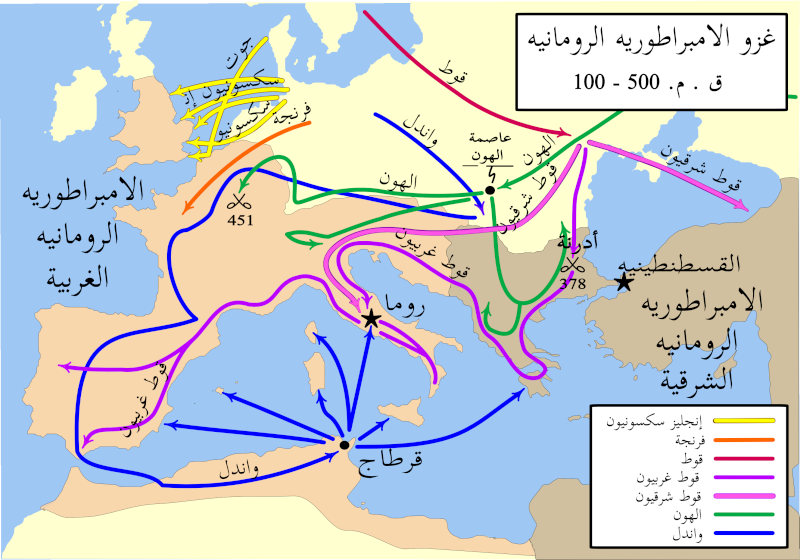محمد شعبان صوان
لا يصلح الختم الإسلامي للمصادقة على فتن الاستئصال الجارية باسم الإسلام اليوم والتي يتخذ منها الغرب المجرم ذريعة لتشويه صورة مازالت حقيقته الاستئصالية في العالم كله أقبح منها بمراحل، ذلك أن حكم الإسلام امتد في بلادنا 1300 سنة لم تسد فيها المشاهد الدموية الحالية رغم فترات التوتر والفتن التي لا ننكرها
والتي يذكرنا بعضها كالصراع العثماني- الصفوي الذي تخللته الدماء من الجانبين بكون السياسة الطارئة هي التي سفكت الدماء، وليست العقيدة الحاضرة دائماً في ظروف مختلفة عن المشهد الدامي الذي يحاول البعض استغلاله لدعايات سياسية تخفي ما تشاء وتضخم ما تشاء بعيداً عن الحقائق العلمية لخدمة هذا الطرف أو ذاك مما يؤدي في النهاية إلى حجب الأنظار عن الرؤية الحقيقية لتاريخنا الطويل وإدامة أوضاع التبعية التي لم نر منها خيراً منذ زرع الغرب دولة التجزئة في بلادنا على أنقاض الخلافة الجامعة، ذلك أنه رغم مشاهد الآلام الطارئة في تاريخنا فقد ظلت المكونات العديدة في بلادنا حية ومتجاورة حتى جاء الغرب ليعيرنا بتنوعنا ويصدّر إلينا بضاعته الانفصالية والطائفية والإبادية، وكل من يتصور أنه يطبق حكم الإسلام بهذه الممارسات ما عليه إلا إلقاء نظرة على المشرق حين كان يحكم الإسلام ويزدهر الجميع بدرجات متفاوتة في ظله، ويقارن ذلك بمشهد الغرب حيث سادت إبادة السكان الأصليين والأقليات والهويات الفرعية وشن حروب عالمية وصلت حصيلتها جميعاً مئات الملايين من الضحايا، ليعلم في النهاية أنه يستورد بضاعة الغرب ويدخلها مصنع تزوير البيانات ليكتب عليها (صناعة إسلامية) بدلاً من الختم الأصلي (صنع في الغرب) Made in the West.
* الأسباب الغربية للصراعات الطائفية والدينية والقومية الدموية في المجتمع العثماني
يقول المؤرخ الأمريكي المختص في التاريخ العثماني دونالد كواترت (1941- 2011) إن الإمبراطورية العثمانية كانت عبر تاريخها تستوعب قوميات كثيرة وطوائف دينية مختلفة، وكانت هذه الطوائف تعيش في وئام وتتعاون في شتى الأمور، وإن الصراعات التي نشأت في القرنين التاسع عشر والعشرين بين الأتراك وكل من الأرمن واليونانيين والأكراد بالإضافة إلى الصراع على فلسطين، لم تكن لتنشأ لولا ظروف تاريخية معينة جرت حديثاً ولم تكن وليدة أحقاد تاريخية قديمة متأصلة كما يفترض البعض، وبالرغم من الكثير من الأفكار المغلوطة عن طبيعة التعايش بين الطوائف المختلفة في الدولة العثمانية، لا يمكن إنكار أن العلاقات بين مختلف الأقوام والأقليات كانت علاقات جيدة نسبياً، وما من شك أن الأقليات الخاضعة للحكم العثماني كانت تتمتع بحقوق وبحماية أكثر من تلك الأقليات التي تعيش في الممالك الأخرى مثل فرنسا أو امبراطورية الهابسبورغ (النمسا- المجر)، وإن تدهور علاقات الطوائف في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر سببه تسلط الرأسمالية الغربية من جهة وتدخل الدول الكبرى في الشئون الداخلية للدولة العثمانية، ومن سخريات التاريخ أن بريطانيا وفرنسا أذكتا نار الكراهية العربية للحكم العثماني ثم اتخذتا من هذه الكراهية التي صنعتاها ذريعة أخلاقية لتفكيك الدولة العثمانية.[1]
* حوادث الشام
كانت فتنة 1840 امتداداً لثورة الشعب في سوريا بدعم عثماني وبريطاني على حكم إبراهيم باشا الذي فرض التجنيد الإجباري على الناس، ولم يكن بوسع نزع السلاح الشامل، الذي تقرر بشكل جد متأخر (1840)، أن يوقف الانتفاضة، إذ تدخل الدول العظمى اللعبة الطائفية، ويصبح قناصلها محركين حتميين للأزمة: فرنسا والنمسا في صف الكاثوليك، روسيا في صف الأرثوذكس، بريطانيا في صف الدروز، ودعاية الأب الفرنسي ريبو تشجع المسيحيين على الثورة ضد الدروز وتؤجج النار، وعندما تحاول الدولة العثمانية تجنب صدامات جديدة وتصوغ مشروعاً يفصل بين المتقاتلين ويعين قائمقامين ماروني ودرزي لهما سلطة على أتباعهما دون سلطة على الأرض، تعترض أوروبا لأن ذلك يتعارض مع مفهومها السياسي، وتوصي بتقسيم لبنان إلى وحدتين إداريتين يحكم كل منهما قائمقام له سلطة على كل سكان منطقته بغض النظر عن الدين، فكان ذلك "تنظيماً رسمياً للحرب الأهلية في البلد" وفقاً للمؤرخ اللبناني كمال الصليبي والمؤرخين فيليب فارج ويوسف كرباج.[2]
وعن فتنة 1858- 1860 التي شهدت حرباً أهلية ومذابح في الشام بين المسلمين والمسيحيين والدروز يقول المؤرخ الأمريكي زاكري كارابل إن سنة 1860 في دمشق حيث ذُبح المسيحيون كانت شذوذاً عن قاعدة التاريخ الإسلامي وسبب هذا الشذوذ هو الغرب الذي تجاوز حدوده، أكثر من كون السبب هو العلاقات الإسلامية المسيحية الداخلية، وحتى في زمن حروب الفرنجة حين سادت نظرة الشك للمسيحيين واليهود في الشام لم تحدث مجازر مشابهة لما حدث سنة 1860، وكان الذي تغير منذ تلك الفترات السحيقة وجود الغرب على الساحة وتدخله المتزايد في شئون المشرق الداخلية مما جعل أحداث الثأر حصيلة حتمية، ومع ذلك قامت الدولة العثمانية باسترداد النظام واستعادة ما يشبه الوئام القديم.[3]
* الأحداث الأرمنية
وعن القضية الأرمنية يقول المؤرخ الأمريكي جستن مكارثي إن الاستعمار الروسي والتطفل الأوروبي والعصبية الثورية الأرمنية بالإضافة إلى الضعف العثماني يشتركون في مسئولية ما حاق بالمنطقة من خراب ودمار زمن الحرب الكبرى الأولى (1914 وما بعدها) ويرى أن الحوادث الأرمنية كانت جزءاً من صراع كبير وعملية تاريخية واسعة قُتل فيها من المسلمين خمسة ملايين ونصف وهُجر خمسة ملايين من البلقان والقوقاز وجنوب روسيا في القرن الواقع بين سنتي 1821- 1922، وفي الوقت الذي عرف العالم كله معاناة الأرمن فإن معاناة المسلمين التي لا تقل عنها ظلت طي الكتمان وبحاجة إلى مراجعة تاريخية، وكما قُتل الكثير من الأرمن فقد قتل الأرمن كثيراً من المسلمين، ويوزع مسئولية الوفيات الأرمنية في قوافل الترحيل، بين العثمانيين (الاتحاديين) والروس والثوريين الأرمن وأنصارهم.[4]
أما المؤرخ جيرمي سولت فيوثق دور التبشير الأمريكي والإنسانية البريطانية في خلق المسألة الأرمنية، وينقل عن أحد المبشرين قوله إنه لو تركت أوروبا الأرمن مع الأتراك لكان أفضل من إثارتهم ثم إحباطهم، كما ينقل عن المستشرق والعميل البريطاني إيفن فامبري قوله إن دور بريطانيا في إثارة الخلافات والأحقاد بين عناصر الدولة العثمانية لا ينكره إلا الأعمى.[5]
ويقول في كتابه "تفتيت الشرق الأوسط: تاريخ الاضطرابات التي يثيرها الغرب في العالم العربي" بعد أن يورد تقديرات المؤرخين لعدد الضحايا الأرمن في الحرب الكبرى الأولى 1914- 1918 (حوالي 800 ألف على الأكثر) بعيداً عن المبالغات التي وصلت إلى مليون ونصف: "ويجب أن توضع هذه الأرقام في إطار مجموع المدنيين العثمانيين الذين قضوا، وهو من ثلاثة إلى أربعة ملايين، وعادت الجيوش العثمانية (بعد الحرب) إلى الهياكل الفارغة للمدن والبلدات والقرى المدمرة والأنقاض والجثث المبعثرة بينها، وإلى كل إشارة أو رمز للوجود المسلم العثماني فيها، كالمساجد والمدارس والمقابر وتكايا الصوفيين والأسواق وبنايات الحكومة، دُمرت كلها، وفي منطقة كانت فيها، مثلاً، غالبية السكان من المسلمين، كان ضحايا الحرب المسلمون، تبعاً لذلك، من الأكراد في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، وهذه النقطة ترسم خطاً عريضاً يبرز المظهر الكردي المهمَل بالنسبة للمسألة الأرمنية".[6]
أما المؤرخان شو فيوضحان دور الدعاية الروسية التي طورت واستعملت القضية الأرمنية "بمهارة كبيرة" في الوقت الذي لم تكن فيه روسيا سعيدة بالاستقلال الأرمني في الدولة العثمانية لأنه سيثير الأرمن وبقية القوميات عندها وكانت تفضل إثارة الاضطرابات فقط للعثمانيين، وفي هذا الصراع الطويل استغل الروس والأوروبيون الأرمن - الذين لقبهم التاريخ العثماني بالأمة الصادقة- لإثارة المشاكل للدولة العثمانية والمطالبة بوطن مستقل على رقعة واسعة لا يؤلفون فيها أغلبية، ولم تتورط الأغلبية منهم في تأييد هذا المشروع وأحجمت عن مناصرة الثوريين.[7]
وعن التقويم الشامل للوضع يقول المؤرخ دونالد كواترت إنه عندما اندلعت الحرب الكبرى الأولى سنة 1914 انضم الأرمن أو بعضهم في روسيا للهجوم الروسي على الدولة العثمانية، وشاركهم في ذلك بعض الأرمن العثمانيين مما أدى إلى ارتياب حكومة الاتحاد والترقي في ولاء الأرمن، فأصدرت أوامر سنة 1915 بترحيل جميع الأرمن في غرب الأناضول بعيداً عن ساحات القتال "وتبين الوثائق الرسمية التي لا نشك بصحتها، أن الأوامر كانت تهيب بالمسئولين تأمين الحماية اللازمة للأرمن والعناية بهم والمحافظة على ممتلكاتهم وسلامتهم أثناء نزوحهم القسري، ولكن ذلك لم يتحقق" إذ انتقل المهجرون سيراً على الأقدام في ظروف مأساوية ومات بعضهم من سوء التغذية والأمراض وقُتل آخرون بأيدي قطاع الطرق، ولا مفر من الإقرار أن الموظفين العسكريين والمدنيين كانوا مسئولين عن مقتل أعداد كبيرة من الأرمن المدنيين في الوقت الذي كان واجبهم يقضي بالمحافظة على رعايا الدولة.
وتفسير هذا التناقض كما يشرح كواترت أن هناك فئة متمكنة ضمن جمعية الاتحاد والترقي كانت تسعى سراً لاستخدام ذريعة الإجلاء وسيلة للقضاء على الأرمن خشية من نشاط المنظمات الثورية الأرمنية ومن عواقب انحياز الأرمن للعدو الروسي، وقامت هذه الفئة وهي بزعامة طلعت باشا بتكوين القوات الخاصة التي عهد إليها بالتهجير فاستباحت الدماء "وكانت تتلقى أوامرها من هذه الفئة حصراً عبر شبكة اتصالات خاصة بها وليس عبر القنوات الرسمية"، أي أن أقطاب الإتحاد والترقي ردوا على التمرد الأرمني بعصبية قومية مقابلة، وقد تكون هذه الوقائع صحيحة أو غير صحيحة ولكن أدلتها تبدو مقنعة وإن كانت غير موثقة بسبب ضياع وتلف السجلات الرسمية لجمعية الاتحاد والترقي، ولكن الأرمن لم يتعرضوا للقتل والتشريد خارج المناطق المتاخمة لمسرح الحرب، وفي اسطنبول وأزمير ظل الأرمن يعيشون بسلام في الفترة 1915- 1916 دون أن يمسهم سوء.[8]
(ملاحظة: البروفيسور الراحل دونالد كواترت لم يكن مرضياً عند الحكم في تركيا رغم خدماته المشهودة للتاريخ العثماني ودراساته العميقة في هذا المجال، واضطر في سنة 2006 لترك منصبه في رئاسة معهد الدراسات التركية في جامعة جورج تاون في واشنطن بضغط من السفير التركي آنذاك بسبب الخلاف مع وجهة النظر التركية في المسألة الأرمنية، كما تقول ذلك موسوعة ويكيبيديا:
http://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Quataert
وليس من العدل أن تتحمل الخلافة الإسلامية جريرة العصبيات القومية كالمجازر الأرمنية (1915)، بعدما كان الوئام سائداً إلى درجة أن لُقب الأرمن في التاريخ العثماني بالأمة المخلصة، أو كالطرد السكاني التركي- اليوناني المتبادل (1923) بعدما كان السلطان العثماني هو خليفة امبراطور بيزنطة لدى اليونانيين، أو كالصراع العربي- التركي (1916) بعدما كانت منزلة العرب في الدولة العثمانية هي منزلة "الأمة النجيبة"، وهي الصراعات التي اجتاحت الخلافة نفسها وعصفت بها وبالعالم الإسلامي في النهاية، وعلى جيراننا وشركائنا الأرمن إذا كانوا يريدون من الآخرين الاعتراف بمعاناتهم الأكيدة ألا يحتكروا دور الضحية وأن يعترفوا في المقابل بمعاناة الآخرين التي كان لهم دور كبير فيها بدفع من الروس والأوروبيين، وبدلاً من التراشق بالتهم الآن علينا أن نتعلم من تاريخنا الطويل الذي أطلق العثمانيون فيه على الأمة الأرمنية لقب الأمة المخلصة والصادقة وهو دليل على حسن الجوار والتعايش الذي وسم تاريخنا قبل أن يتدخل عنصر استثنائي طارئ وغريب هو الغرب وهو الذي قطع الطريق على مئات السنين من الانسجام الذي هيمن على معظم هذا التاريخ، وعلينا أن نتساءل لماذا سالت الدماء فقط في تلك الفترة المتأخرة من الزمن العثماني وليس قبل ذلك؟ ألا يدل هذا على تطفل من عنصر غريب وطارئ لم يكن له وجود قام بإثارة العداوات التي استجاب لها الأرمن ولم يقصروا في إسالة دماء جيرانهم المسلمين كما سالت دماؤهم هم أيضاً؟ وعلينا بعد ذلك أن نتعلم أن حتمية الجوار الجغرافي تتطلب منا ألا ندخل الغرباء الغربيين فيما بيننا وأن نتشارك الحياة على هذه الأرض دون استقواء ولا اضطهاد.
* فتن البلقان
وعن فتن البلقان العثماني يقول المؤرخ كارابل نفسه إن هذه المنطقة طالما اضطرب توازنها بسبب القوى الأوروبية، التي كانت تعامل تلك الشعوب كأدوات رهان جاهزة للاستخدام والتضحية،[9] ويفند كواترت وجود دافع يتعلق بتردي الأحوال الاقتصادية في الولايات البلقانية العثمانية لدى الحركات الانفصالية، والتي كانت تحركها عوامل خارجية روسية وأوروبية يهمها إثارة الاضطرابات للعثمانيين كما كان الأمر في الحالة الأرمنية، ويؤكد هذا المؤرخ أن بلاد البلقان كانت تنعم بازدهار اقتصادي عشية انفصالها عن الدولة العثمانية وما لبثت بعد استقلالها أن ساءت أوضاعها المعيشية بطريقة أصبحت معها في حالة أسوأ مما كانت عليه قبل استقلالها.[10]
* الحل العلماني زاد طينة التدخل الغربي بللاً
لم يكن الحل العلماني الذي طرحته دولة التجزئة التي قامت على أنقاض الدولة العثمانية شافياً من الأمراض التي أوجدتها التدخلات الغربية في الشئون العثمانية الداخلية، بل يمكننا ملاحظة أن الدولة القومية والوطنية كانت امتداداً سلبياً ومرَضياً لتلك التدخلات، فالقومية الطورانية والعلمانية الخجولة لجمعية الاتحاد والترقي أفضت إلى الكارثة الأرمنية (1915) والتي تبعها إخلاء الأناضول من الوجود المسيحي الأرمني واليوناني على يد الجمهورية الكمالية العلمانية المتشددة، وبهذا قضت طورانية الاتحاديين وعلمانية الكماليين في غضون عشر سنوات (1914- 1924) على نسيج فسيفسائي عاش قروناً في ظل الإسلام، ولا يجوز هنا إغفال الدور الغربي المشبوه في إثارة النعرات واستهداف المسلمين من قبل الأطراف الأخرى، ولكن ما تجب الإشارة إليه أن رد الفعل العثماني على تلك الحوادث لم يكن بفداحة ردود الفعل القومية المتعصبة والعلمانية الاستئصالية اللتين كانتا في النهاية من البذور الغربية التي شقت الصفوف ودمرت الانسجام.
* أثر الفتن الغربية على المجتمع الإسلامي العثماني
ففي القرن التاسع عشر حين كان الغرب يمر بالثورة العلمية، كانت الخلافة العثمانية في آخر أيامها، وتقوم بإصلاحات تغريبية تمهد للعلمانية التي "سوف تمحو الجماعة المسيحية نهائياً في القرن العشرين" بعدما كان صدى الحركات القومية يجتاح الطوائف المسيحية واليهودية بل وشعوب الامبراطورية، ورغم الثورة اليونانية بدعم غربي واضح يؤدي لانفصال اليونان عن الخلافة، فقد استمر صعود الأقليات داخل الدولة العثمانية، فمن 8% هي نسبة المسيحيين في الأناضول في القرن السادس عشر، تصل النسبة إلى 12% سنة 1831 عشية استقلال اليونان (1830)، ويستمر الصعود رغم ذلك لتصل الجماعة سنة 1881 إلى 21%، أي أن تزايد المسيحيين أسرع من تزايد المسلمين في دولتهم، وكانت الجزية أقل فداحة من تأثير الحروب التي تصيب المسلمين المجندين أساساً، وفرص الحراك الاجتماعي أوسع لدى المسيحيين واليهود البعيدين عن "العبوديات العسكرية".[11]
ويلاحظ المؤرخ نيكولاس دومانيس ملاحظة مهمة وهي أنه وسط الفتن التي عصفت بالمجتمع الإسلامي في القرن التاسع عشر وأدت إلى تهجير 5- 7 ملايين مسلم من روسيا واضطرابات دموية في لبنان سنة 1860 وحوادث أرمنية بلغت ذروتها في مجازر 1915 وصراعات عنيفة في جزيرة كريت بين 1841- 1908، ظلت الغالبية العظمى من العثمانيين المسلمين والمسيحيين واليهود تتعايش في سلام، بل إننا نجد أرمن اسطنبول وإزمير يعيشون في سلام في نفس الفترة التي قُتل فيها إخوانهم على يد حكومة الاتحاد والترقي في مجازر 1915- 1916 في مسرح العمليات العسكرية أثناء الحرب الكبرى الأولى،[12] وهو ما يشير إلى عدم تأصل العداوات العرقية حتى في زمن الأزمات، ولهذا نجد الدولة العثمانية وقد أصبحت ملجأ لمسيحيي البلقان وشرق أوروبا الباحثين عن ملاذ ديني أو سياسي في ظاهرة يصفها كواترت بالمدهشة كما كانت ملجأ للمسلمين المضطهدين،[13] ومن خصائص هذا العصر أيضا المدن الساحلية النابضة بالحياة في شرق المتوسط والتي احتوت عناصر من جميع أنحاء العالم ومن مختلف الأديان تفاعلت وازدهرت، كما أن معظم اليونانيين والأرمن في الأناضول كانوا في وضع سيؤدي إلى خسارة كبرى لو تدهورت العلاقات الاجتماعية بين الطوائف، ولهذا لم يكن هؤلاء مرحبين بالأفكار القومية الانفصالية،[14] وظلت غالبية الأرمن الساحقة مستمرة في رغبتها في البقاء داخل الدولة العثمانية حتى اندلاع الحرب الكبرى،[15] وقد أدى القضاء على الدولة العثمانية إلى زوال واحدة من أكثر الدول التعددية استمراراً واستقراراً في التاريخ.[16]
* وآثار الفتن نفسها على الدولة العلمانية القومية
ولكن النزعات القومية والأوهام عن أعداد الأقليات وانتشارها تؤدي إلى الشرخ القومي داخل المجتمع الإسلامي، وسوف يدفع ثلاثة ملايين مسيحي ثمن تصادم القوميات وميلاد تركيا الحديثة وتقلبات السياسات الغربية الأمريكية والفرنسية والبريطانية التي تخلت عنهم بعد القيام بإثارتهم، والروسية التي تبدل وجهها بعد الثورة البلشفية، ودفع اليونانيون على وجه الخصوص ثمن طموحات الحكومة اليونانية الزائدة عن الحد والمدعومة بقوات الحلفاء بعد الحرب الكبرى الأولى، ورغم الأفول الذي تعرض له اليونانيون لصالح الأرمن في اسطنبول والأناضول بعد استقلال اليونان (1830)، فإنهم استمروا في الدولة العثمانية لقرن بعد ذلك وفضلوا ازدهارهم فيها على حريتهم في اليونان، بل سنجد هجرة من اليونان إلى دولة الخلافة تعزز مواقعهم حيث كان القادة العثمانيون يريدون الحفاظ على البنية متعددة القوميات، أما مصطفى كمال أتاتورك فكان أقل كرماً، وفي سبيل تحقيق التجانس القومي الذي لم تستطع جمعية الاتحاد والترقي تحقيقه تم الطرد السكاني المتبادل بين اليونان وتركيا (1923)، والذي لم يكن طرد يونانيين من تركيا وأتراك من اليونان بل طرد أتراك مسيحيين من تركيا ويونانيين مسلمين من اليونان، واستمر نزيف اليونانيين وبقية الأقليات من تركيا، ومنها الجماعة العربية المسيحية بعد المنحة الفرنسية (الاسكندرونة) لتركيا عشية الحرب الكبرى الثانية، لمدة عشرات السنين بعد سنة 1923 في ظل الإجراءات الاقتصادية المتحيزة والحملات الصحفية العنصرية، "وبدلاً من تحقيق السكينة لآخر الباقين من الأقليات، التي اعتادت على مدار عدة قرون على الاستقلال الذاتي الإداري والديني في ظل نظام الملل، أدت العلمانية إلى تشديد هشاشة وضعهم"، ومع إلغاء الخلافة الإسلامية يُطرد البطريرك اليوناني الأرثوذكسي المقيم في اسطنبول، وتُغلق الجمعية الأدبية اليونانية والمدارس اليونانية، أو يعين عليها مدراء ومدرسون أتراك.[17]
"ومن بين جميع الكوارث التي ميزت تاريخ الجماعة المسيحية في بلاد الإسلام منذ الهجرة (النبوية)، فإن السنوات العشر التي اختفت خلالها الجاليتان الأرمنية واليونانية من تركيا، بين عامي 1914 و1924، كانت الأكثر جسامة، إن التكلفة البشرية، 3 مليون نسمة، والمذبحة والمفاجأة غير المتوقعة، قد قطعت بشكل حاسم مسار التاريخ الإسلامي، والمفارقة الأولى هي أن اختفاء المسيحيين يخالف التطورات التي ترتسم معالمها، فالواقع أنه قد حدث في ظل نظامين عصريين، نظام جماعة تركيا الفتاة والنظام الكمالي، اللذين كانا مفعمين بالروح العلمانية (وهناك من جادل بأن قادة الاتحاد والترقي كانوا من الملحدين وأن معركتهم مع المسيحيين كانت قومية لا إسلامية)، واللذين شكلا بديلاً راديكالياً لسلطة أضفت الشرعية على الإسلام، ولم يكن هناك ما يسمح في اتجاهات ديموغرافيا المسيحيين بالتنبؤ باختفائهم... والمفارقة الثانية هي أن الإسلام الظافر كان يتفاخر بحياة مشتركة مع المسيحيين واليهود، أما إسلام زمن الانحطاط... فإنه يكبتهم... لا مراء في أنها (الإمبراطورية) قد قدمت بنية فريدة قادرة على ضمان السلم الأهلي، وقد استفادت من ذلك ديمغرافية الطوائف المسيحية واليهودية، وقد شهدت نمواً طبيعياً أكثر ارتفاعاً بفضل نظام الملل... وكان المسيحيون ضحايا لإفقار الشعب التركي، كما كانوا، بلا مراء، ضحايا المشاعر المتناقضة التي حفزها لدى هذا الشعب النموذج الغربي".[18]
"والحال أن السلطان، الذي يخضع جماعات سكانية مسيحية متزايدة العدد بلا توقف، لا يجبرها على التحول إلى اعتناق الإسلام، بل يشركها في السلطة، وسوف يكفي عقد واحد، بين عامي 1914 و1924، حتى تتوصل الدولة العلمانية المولودة من حطام الإمبراطورية إلى تدمير هذا البنيان لحساب أمة تركية ومسلمة فقط، إن ألف سنة من التاريخ المتعدد الطوائف سوف يجري محوها في عشر سنوات"،[19] وسوف تلجأ السلطة العلمانية إلى أساطير النقاء العرقي،[20] والتي يرفضها الإسلام رفضاً قاطعاً، لتبرير مواقفها الاستئصالية على عادة الأنظمة العلمانية الشاملة كالنازية والفاشية والصهيونية.
ولم يعد في تصور الأجيال اللاحقة أن الأناضول الحالي كان لمدة قرون عثمانية مساحة متنوعة من الطوائف المتعددة ذات الأعداد الضخمة التي تتخلل المسلمين في وسطهم وليس على حدودهم، وظلت كذلك إلى زمن قريب جداً،[21] على عكس الانفراد المسلم الذي أوجدته العلمانية، وهو انفراد اتخذ الهوية التركية على حساب الوجود الكردي أيضاً والذي سحقته بدموية تلك العلمانية بحجة الانسجام القومي للمساحة التي خصصت للأتراك بعد تنازل مصطفى كمال أتاتورك عن الأملاك العثمانية للدول العظمى في اتفاقية لوزان 1923، هذا بالإضافة إلى الوجود العربي المسيحي في الاسكندرونة والذي سيرحل لصالح الانسجام الديني والقومي في تركيا العلمانية،[22] بل يطال الاضطهاد الوجود اليهودي الذي ظل معفياً من الملاحقة زمناً طويلاً.[23]
وسنجد أن الحل العلماني الاستئصالي الغربي يؤدي إلى كارثة سكانية أخرى في فلسطين حين أنشئت الدولة اليهودية على حساب أهل فلسطين من المسلمين والمسيحيين الذين رحلوا عن بلادهم إلى شتات عالمي نتيجة تفرد السيادة اليهودية بفلسطين على عكس الوضع الذي كان قائماً عندما كانت سيادة المسلمين هي المهيمنة على هذا البلد وهو حال وصفه أحد المؤرخين بالتآخي العثماني إلى مطلع القرن العشرين،[24] ومازال النزيف السكاني العربي قائماً في فلسطين في ظل صمت غربي واضح عن "حماية" المسيحيين الذين كانوا الذريعة التي تتحجج بها الدول الغربية للتدخل في شئون العثمانيين وذلك لو أحس مسيحي بمجرد صداع أو أصيب بزكام، والمسيحيون اليوم يتعرضون لكل أنواع الاضطهاد في فلسطين والغرب لا يحرك ساكناً "لحمايتهم"، وسنرى أن الحل الذي رسمته العلمانية الفرنسية للبنان الطائفي هو المفضي إلى الحروب الأهلية التي ألصقت فيما سبق بالدولة العثمانية زوراً ولكنها لم تتوقف بعد رحيل العثمانيين وفي ظل هيمنة المفاهيم الفرنسية، كما وجدنا المجازر الطائفية والقومية تجتاح دولة التجزئة في عدة أماكن من البلاد العربية العلمانية مع وجود أصابع أجنبية جلية تتلاعب بالمصائر، وليس من العجيب أن يؤدي المفهوم العلماني إلى هذه الكوارث الدموية، وهي على كل حال نماذج مصغرة للإبادات الجماعية التي اقترفتها العلمانية الغربية الشاملة في الأمريكتين وأستراليا ومواقع متفرقة أخرى من العالم.
* مصيبة العثمانيين كانت في تسامحهم لا في وحشيتهم
بل إن المؤرخ الأمريكي جستن مكارثي يعزو مصائب القتل والترحيل التي حلت بالعثمانيين في القوقاز والبلقان وأماكن أخرى في القرن التاسع عشر ونتج عنها مقتل أكثر من خمسة ملايين مسلم وتهجير خمسة ملايين أيضاً إلى تسامح العثمانيين الأوائل مع الأقليات وسكان البلاد التي فتحوها: "كانت إحدى أفضل ميزات التقليد العثماني في الحكم التسامح مع التنوع العرقي والديني، ولكن كان يمكن أمة مطبّعة بطابع تركي أن تكون أكثر أماناً وأن تعطي الأمم الأوروبية ذرائع أقل للتدخل"، "إذ لو كان الأتراك في أيام قوتهم قوميين من النوع اليوناني، لكان المسيحيون هم الذين طُردوا تاركين وراءهم أراضي كانت تركية مسلمة بكل معنى الكلمة، بدلاً من ذلك، عانى العثمانيون وبقي المسيحيون، كثيراً ما كانوا يعاملون المسيحيين معاملة حسنة، وفي أحيان كثيرة على نحو رديء، لكنهم سمحوا لهم بأن يستمروا بالبقاء وأن يحافظوا على لغاتهم وتقاليدهم ودياناتهم، كانوا على حق حين فعلوا ذلك، لكن لو أن أتراك القرن الخامس عشر لم يكونوا متسامحين، لبقي أتراك القرن التاسع عشر على قيد الحياة في بيوتهم".[25]
* المسألة اليهودية تلخص حالنا مع نكران الغرب لجميل المسلمين
لم يكن استخدام الغرب للأقليات المسيحية هو جزاء سنمار الوحيد الذي قوبل به الجميل العثماني، ولعل المسألة اليهودية مثال أوضح من الأقليات المسيحية على نكران الغرب للجميل واستخدامه أقلية طالما غمرها جميل العثمانيين، في الوقت الذي تنكرت لليهود كل أوروبا، في طعن الأمة التي آوتهم ونصرتهم بدلاً من الاعتراف بجميلها، ليصبح المسلمون في نهاية المطاف هم "الإرهابيين" و"الهمجيين" و"المتخلفين" و"الدمويين" الذين يمارس اليهود ضدهم كل الجرائم التي يعرفها الجنس البشري من إبادة وتهجير وسلب ونهب وتعذيب وحصار وتفريق واعتقال وإنكار أبسط حقوق الأحياء، جزاء لجميل الإيواء الذي قام به المسلمون في زمن الضيق اليهودي سواء بعد سقوط غرناطة أم بعد ذلك بثلاثة قرون في زمن صعود معاداة اليهود في فرنسا الجمهورية وروسيا القيصرية.[26]
يقول المؤرخ كارابل: "لقد كان اليهود في العالم العثماني على دراية كافية كم كان من الأفضل لهم العيش في سالونيكا، أو اسطنبول، أو إزمير، من العيش في أي مكان من أوروبا تقريباً"،[27] وكان كل ما قدمه الغرب واليهود في المقابل هو الشكر النظري الذي يناقض التنكر العملي، فقد قام رئيس الكيان الصهيوني سنة 1992 بزيارة إلى تركيا لحضور احتفالات الذكرى الخمسمائة لقبول الدولة العثمانية إيواء اليهود النازحين من إسبانيا بعد سقوط غرناطة، وفي هذه الزيارة عرض الرئيس الصهيوني شريط فيديو على المدعوين إلى المناسبة يتضمن خطاباً للرئيس الأمريكي جورج بوش الأب يشير فيه إلى ترحاب العثمانيين بقدوم اللاجئين اليهود من إسبانيا ومازالوا يعيشون بسلام منذ خمسة قرون في تركيا وهو مثال لحياة المسلمين واليهود، ويعقب الأستاذ وديع أبو زيدون متسائلاً: "لماذا لا يعيش المسلمون واليهود في سلام عادل في فلسطين الآن بعد أن سيطرت أمريكا على العالم وبإمكانها فعل شيء مشابه لما فعلته الدولة الإسلامية العثمانية والدولة التركية العلمانية الآن".!!؟[28]
والإجابة واضحة: الدولة العثمانية تصرفت وفق الخلق الإسلامي، والعالم الغربي يتصرف وفق الاستئصال العلماني الذي طال قبلنا الملايين من السكان الأصليين في بقاع عديدة من العالم، اليهود كانوا يعيشون بسلام في ظل سيادة المسلمين، والمسلمون يعيشون في بلاء في ظل سيادة اليهود، وهذه إجابة جلية عمن يجب أن تكون له السيادة، وما يحدث لنا نموذج مصغر لما حدث في الأمريكتين وأستراليا، وشتان بين فعلنا وأفعالهم، ولم يكن جميل العثمانيين مع أقلية يناظر جميلهم مع اليهود في ساعة المحنة، ومع ذلك لم يتنكر أحد كما تنكر الصهاينة للمسلمين الذين مثلتهم الدولة العثمانية، فأين نرجو العدل في الأحكام من الغرب بعد ذلك؟ ولهذا يحسن عدم الالتفات للتهم التي يغرقوننا بها صبح مساء، وفي نفس الوقت ملاحظة أنه في الوقت الذي تجسد الدولة العثمانية انحطاط الإسلام لدى الغربيين، فإنها تمثل لمسيحيي المشرق "زمن النهوض الذي ولّى الآن، أما اليهود فإنهم لم ينسوا حسن الضيافة الذي تكرر مرتين... وبعد ثلاثة أرباع قرن من سقوط الإمبراطورية العثمانية، تجد مدافعين عنها في الشرق العربي: إن مسيحيين ويهوداً ما زالوا يرون في الكيمياء السحرية الإمبراطورية الفرصة الوحيدة للتعددية الطائفية، فهي تفصل وضعية الأشخاص عن وضعية الأرض".[29]
* شهادة مسيحية عربية بعد سقوط الدولة العثمانية عن تبعات التدخلات الأجنبية
في دراسته عن المسيحيين في العصر العثماني الثاني (القرن السابع عشر) يقتبس الأب الإيطالي فينسنزو بودجي من كتاب حبيب أبي شهلا بمناسبة إلغاء الامتيازات الأجنبية في البلاد العربية، العثمانية سابقاً، الذي طبع سنة 1924، والذي جاء فيه العرض التاريخي المختصر الآتي: "عندما وصل الأجانب إلى المشرق حصلوا على الوضع القانوني عينه الذي كان يتمتع به المسيحيون من أبناء البلاد، ما نريد أن نلفت النظر إليه هو أن أحوال مسيحيي الشرق القانونية (في ظل الدولة الإسلامية) لم تكن أبداً ثمرة التدخل الأجنبي كما يعتقد هؤلاء المسيحيون. إذ لا يعود الفضل في تمتعهم بحرية الدين والعبادة إلى طيبة القوى العظمى ونفوذها في الشرق كما توهمنا هذه الأخيرة خلافاً للأحداث التاريخية. إذ لا يسع الأجانب وصف أنفسهم كأبطال لقضية نبيلة ما أحسنوا الدفاع عنها وحسب، لا بل استغلوها... وينبغي الاعتراف بأن الحماية الأجنبية ليست إلا كذبة، فهي لم تسفر يوماً عن نتائج حميدة، فهل استطاعت تفادي المجازر الفظيعة؟... بالعكس، حصد المسيحيون المجازر والاعتداءات والكراهية التي زرعتها وأرادتها القوى العظمى (لأن الهزائم المسيحية كانت"أداة توسع قوي" الدول العظمى)،[30] وكانت النتيجة عكس ما كنا نتوقع، فقد اتسع الشرخ بين المسلمين والمسيحيين، وكان من مصلحة هؤلاء أن يتحدوا ويتعاضدوا للدفاع عن إرثهم المشترك".[31]
* أحكام "شرعية" ضد الدولة الإسلامية
إن كل من يحاول تغيير مسار ذلك التاريخ الطويل من الانسجام أو تجاوزه يساعد في تنفيذ المخطط الغربي الذي بدأ منذ القرن الثامن عشر كما سبق ذكره، وإن زعم أنه يطبق حكم الإسلام، تماماً كما ساعد أنصار فكرة الخلافة العربية الدول الاستعمارية في تفكيك الخلافة العثمانية وقدموا بلادهم لقمة سائغة للاحتلال الأجنبي والتجزئة القُطرية، وكل ذلك كان انطلاقاً من حجة تطبيق حكم الإسلام أيضاً.
* المحاكم الإسلامية كانت ملجأ لغير المسلمين وليست مسلخاً لهم
يذكر عدة مؤرخين أن محاكم الدولة الإسلامية في صيغتها العثمانية كانت ملجأ يجد فيه غير المسلمين العدل الذي يفتقدونه في شرائعهم التي أقرهم المسلمون عليها، فيذكر المؤرخ زاكري كارابل مثلاً "وفي بعض الأحيان، كان المسيحيون أو اليهود، يحاولون حسم خلافاتهم الداخلية في محكمة عثمانية عندما كانوا يعتقدون أن الشرع الإسلامي يقدم لهم حكماً أكثر ملاءمة، ولطالما حاول المسيحيون تثبيت طلاقهم قانونياً في محكمة إسلامية؛ لأن شروط الطلاق تحت حكم الشريعة الإسلامية تبقى أقل تصلباً، إن الكاثوليك بوجه الخصوص يتميزون بتشدد موقفهم تجاه فكرة الطلاق، بينما المسلمون عموماً أكثر مرونة، فلذلك كان كل من رجال المسيحيين ونسائهم يلتمسون من المحاكم الإسلامية المعونة، وهناك بعض الحالات عندما كان الزوج أو الزوجة في حاجة ماسة للتملص من زواج فاشل، كانا يتحولان إلى الإسلام فقط من أجل التخلص من شريك حياة مزعج، وكذلك فإن الطوائف المسيحية المختلفة، التي كانت في حال نزاع بين بعضها لأكثر من ألف سنة، كانت غالباً ما تحمل نزاعاتها إلى المحاكم الإسلامية بسبب أن العداوة المتبادلة كانت تمنعهم من احترام شرائع الآخرين وعاداتهم".[32]
ويتحدث المؤرخ دونالد كواترت عن الظاهرة نفسها فيقول إن "المحاكم الإسلامية الشرعية كانت في كثير من الأحيان تمنح المسيحيين واليهود حقوقاً لا تتوافر في المحاكم المذهبية لهاتين الطائفتين، لذلك كان العثمانيون غير المسلمين يلجئون من حين لآخر إلى المحاكم الشرعية لإنصافهم علماً بأنهم لم يكونوا ملزمين بذلك، والجدير بالذكر أن المسيحيين كانوا كثيراً ما يلجئون إلى المحاكم الإسلامية في القضايا الإرثية وذلك لأن الشرع الإسلامي يضمن الحقوق لجميع أفراد الأسرة والأقارب، لذلك كان المسيحيون واليهود الذين يخشون حرمانهم من حقوقهم الإرثية يلجئون إلى الشرع الإسلامي لإنصافهم، لاسيما وأن الشرع الإسلامي كان يمنح الزوجة التي توفي زوجها نصيباً أكبر من الميراث عما يمنحه لها القانون الكنسي، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كان بمقدور الشابة الذمية التي يرغمها أهلها على الزواج من شخص لا تريده أن تلجأ إلى المحاكم الشرعية لمنع عقد مثل هذا الزواج، إذ أن الشرع الإسلامي يشترط موافقة المرأة المعنية في هذه الحال"،[33] وسنجد المؤرخ البريطاني يوجين روجان يؤكد هذا الأمر أيضاً ويقول إن اللجوء إلى المحاكم الإسلامية كان خيار الكثير من المسيحيين واليهود لإقامة الدعاوي وتسجيل الصفقات رغم تمتعهم بحق تسوية خلافاتهم في محاكمهم الخاصة.[34]
* الاستنتاج
الحديث السابق لم يستهدف توضيح أحوال غير المسلمين في المجتمع الإسلامي العثماني، بل كان عن أسباب التوترات التي عصفت بهذا المجتمع وتبين أنه تعرض مثل كثير من مجتمعات العالم غير الغربي إلى قُطاع الطرق الحضارية من الغربيين الذين استغلوا قوتهم وهيمنتهم في تمزيق هذه المجتمعات وليس في نشر نموذجهم الحضاري وضم الآخرين إليه، على العكس من النموذج الإسلامي عموماً والعثماني خصوصاً حيث قام أصحاب المشروع الحضاري باستيعاب المجتمعات التي دخلوها فاتحين، وبضم أعدائهم السابقين إلى نموذجهم لاسيما بعد زوال الخطر العسكري من قبلهم[35] وهو حال أدى في الغرب إلى تهميش السكان الأصليين بعد تحقيق الانتصار عليهم كما حدث في الأمريكتين وأستراليا وفلسطين، والجزائر وجنوب إفريقيا وكل المستعمرات قبل هزيمة الاستعمار، في الوقت الذي حرص فيه المسلمون على الاختلاط بالسكان المحليين وعدم الانعزال عنهم،[36] وكسب مشاركتهم في الفتوح[37] وفي الإدارة وعلى أعلى المستويات[38] ولكنهم لم يجبروهم على اعتناق الإسلام والذي تم بشكل تدريجي طويل وصل إلى ألف عام،[39] باستثناء بعض حوادث الإكراه المعزولة،[40] حتى اندمج الجميع وأصبحوا متشابهين مع الفاتحين القلة من العرب الأوائل والأتراك،[41] ومن رفض الاندماج بالدين الجديد لم يفته الازدهار والنمو،[42] وإن ليس بصورة متواصلة،[43] ووجدنا العصر العثماني يتقدم عما قبله من الامبراطوريات الإسلامية[44] بل يعطي فرصاً للمسيحيين لم تكن لهم في العصر البيزنطي الذي سبقه[45] والذي أحياه العثمانيون بصيغة جديدة تكفل استمرار بيزنطة ولكن بصيغة إسلامية جديدة،[46] وهي مواصفات عجز الغرب عن تحقيقها مع الغالبية العظمى ممن حكمهم حيثما اتجهت فتوحاته.
وضمن هذا العرض تعرضنا بشكل جانبي لطبيعة المجتمع العثماني ونموذجه الجامع الذي ضم فسيفساء متنوعة من الاختلافات العرقية والدينية والثقافية، خلافاً للمجتمعات الغربية التي استأصلت التنوعات داخلها، ومن يحاول تكرار تلك التجارب الاستئصالية الغربية بستار إسلامي لن ينجح في أسلمة هذه الممارسة التي سبق للغرب أن احتكرها بالإبادات الجماعية العالمية والتي تبدو الممارسات الحالية إلى جانبها نوعاً من المزاح الثقيل.
وإن حديث التاريخ يختلف عن حديث الفقه والدعوة لأنه لا يقتصر على التنظير بل يتكلم عما (كان) فعلاً وليس عما (يجب أن يكون) فقط، وعندما يتطابق ما (كان) مع ما (يجب أن يكون) فإن ذلك يتجاوز الاعتراضات التي تقال بحسن نية أو سوئها: هذا الكلام مثالي ونظري ولا يوجد إلا في الكتب، فثبوت التطبيق التاريخي يؤكد لجميع المتشككين أن الحل ممكن وليس خيالياً، وأن ما كان يقال في كتاب الفقه، وجد طريقه للتطبيق العملي في حياة الناس ولم يعد مقتصراً على النظريات وحدها، وهو تراث فقهي وتاريخي ثري يمكننا بسهولة أن نبني عليه تطوراً مستقبلياً أفضل مما نغرق فيه اليوم من نتائج الواردات الغربية.
**
الهوامش
[1] دونالد كواترت، الدولة العثمانية 1700- 1922، مكتبة العبيكان، الرياض، 2004، ترجمة: أيمن أرمنازي، ص 305- 307 و335.
[2] فيليب فارج ويوسف كرباج، المسيحيون واليهود في التاريخ الإسلامي العربي والتركي، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2011، ترجمة: بشير السباعي، ص 145.
[3] زاكري كارابل، أهل الكتاب: التاريخ المنسي لعلاقة الإسلام بالغرب، دار الكتاب العربي، بيروت، 2010، ترجمة: د. أحمد إيبش، ص267- 268.
[4] جستن مكارثي، الطرد والإبادة مصير المسلمين العثمانيين (1821- 1922)، قدمس للنشر والتوزيع، دمشق، 2005، ترجمة: فريد غزي، ص 19- 24 و191 و212 و257.
[5] Jeremy Salt, Imperialism, Evangelism, and the Ottoman Armenians 1878- 1896, Frank Cass, London, 1993, pp. 154- 155.
[6] د. جيرمي سولت، تفتيت الشرق الأوسط: تاريخ الاضطرابات التي يثيرها الغرب في العالم العربي، دار النفائس، دمشق، 2011، ترجمة: د. نبيل صبحي الطويل، ص 89.
[7] Stanford J. Shaw & Ezel Kural Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, Vol. II, Cambridge University Press, 2002, pp. 188, 200- 205.
[8] دونالد كواترت، ص 326- 328.
[9] زاكري كارابل، ص 302.
[10] دونالد كواترت، ص 142.
[11] فيليب فارج ويوسف كرباج، ص 192- 194.
[12] دونالد كواترت، ص 328.
[13] خليل إينالجيك (تحرير)، التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية، دار المدار الإسلامي، بيروت، 2007، ترجمة: د. قاسم عبده قاسم، ج 2 ص 537.
[14] Robert Aldrich (Ed), The Age of Empires, Thames & Hudson, London, 2007, pp.41- 42.
[15] دونالد كواترات، ص 333.
[16] Robert Aldrich, p. 43.
[17] فيليب فارج ويوسف كرباج، ص 196- 202.
[18] نفس المرجع، ص 202- 203 و229.
[19] نفس المرجع، ص 178.
[20] نفس المرجع، ص 179- 182 و226.
[21] نفس المرجع، ص 178.
[22] نفس المرجع، ص 229.
[23] نفس المرجع، ص 201.
[24] Michelle U. Campos, Ottoman Brothers: Muslims, Christians, and Jews in Early Twentieth- Century Palestine, Stanford University Press, Stanford- California, 2011.
[25] جستن مكارثي، ص 36- 37 و298- 299.
[26] فيليب فارج ويوسف كرباج، ص 132.
[27] زاكري كارابل، ص 221.
[28] وديع أبو زيدون، تاريخ الإمبراطورية العثمانية من التأسيس إلى السقوط، الأهلية للنشر والتوزيع، عمّان، 2003، ص 357.
[29] فيليب فارج ويوسف كرباج، ص 131- 132.
[30] نفس المرجع، ص 146.
[31] حبيب بدر وسعاد سليم وجوزيف أبو نهرا (تحرير)، المسيحية عبر تاريخها في المشرق، مجلس كنائس الشرق الأوسط، بيروت، 2002، ص 660.
[32] زاكري كارابل، ص 220- 221.
[33] دونالد كواترت، ص 312.
[34] يوجين روجان، العرب من الفتوحات العثمانية إلى الحاضر، كلمات عربية للترجمة والنشر، القاهرة، 2011، ترجمة: محمد إبراهيم الجندي، ص 42.
[35] فيليب فارج ويوسف كرباج، ص 179 و186.
[36] نفس المرجع، ص 183 و235.
[37] نفس المرجع، ص 182 و186.
[38] نفس المرجع، ص 189.
[39] نفس المرجع، ص 135.
[40] نفس المرجع، ص 135.
[41] نفس المرجع، ص 235.
[42] نفس المرجع، ص 131- 229.
[43] نفس المرجع، ص 137.
[44] نفس المرجع، ص 133 و136 و178 و187.
[45] نفس المرجع، ص 186.
[46] نفس المرجع، ص 132 و181.