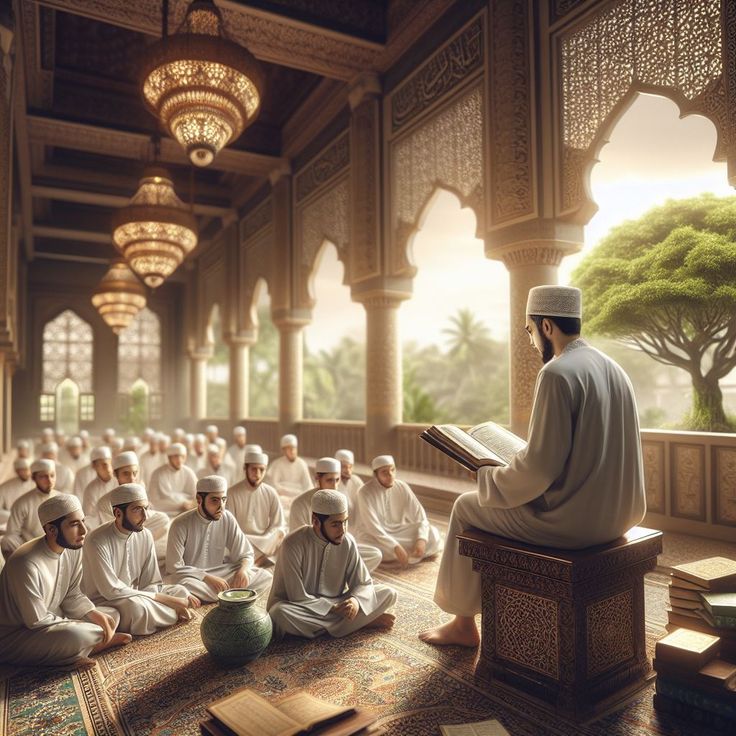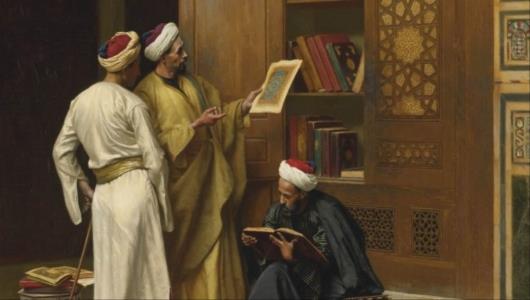3- النظرية السياسية (نظرية الإمامة):
اتسمت الزيدية الهادوية إلى جانب ما تقدم بنظريتها السياسية (نظرية الإمامة) التي تمثّل أصلاً كليّاً من أصول المذهب، شأنها في ذلك شأن كل فرق الشيعة من هذه الناحية، على خلاف النظرية السياسية عند أهل السنة التي تقوم لدى جميع مذاهبها على الشورى، أما لدى الزيدية الهادوية فترتكز على نظرية الحق الإلهي، أي النص، ومبدأ حصر الحكم في البطنين والخروج بالسيف، وذلك من أسس المذهب، وسماته الجوهرية. وإذا كان الحصر في البطنين معروفاً بداهة في المذهب؛ فإن الخروج بالسيف شرط أساس وضروري كذلك لاكتمال شرعية الإمامة، خاصة أن بعض الباحثين يذهب إلى أنه لا تقية لدى الزيدية (1)، لذلك يصرّح المرجع الزيدي مجد الدين المؤيدي أن مبدأ الزيدية إنما يقوم على أساس الخروج بالسيف، ومن لم يفعل ذلك فلا يستحق شرف الانتساب إلى الزيدية (2). ونقل عن أبي طالب يحيى بن الحسين بن هارون الحسني في كتابه (الدعامة) في سياق حديث الحسني عن فضل الإمام زيد بن علي وإجماع الأمة عليه قوله:
” إنّ الإمام منّا أهل البيت المفروض علينا وعليكم وعلى المسلمين، من شهر سيفه، ودعا إلى كتاب ربه، وسنّة نبيه، وجرى على أحكامه، وعُرف بذلك، فذلك الإمام الذي لاتسعنا وإياكم جهالته. فأمّا عبد جالس في بيته، مُرخٍ عليه ستره، مغلق عليه بابه، يجري عليه أحكام الظالمين، لا يأمر بمعروف، ولا ينهى عن منكر، فأنى يكون ذلك إماماً مفروضة طاعته؟ “(3).
ومن قبل ذلك قال الإمام يحيى بن حمزة:
” وإذا قالوا بالنص على الأئمة الثلاثة والدعوة والخروج في أولادهم، وهو طريق الإمامة خرجوا عن رأي المعتزلة…” (4). ويقصد بالأئمة الثلاثة: علياً وبنيه (الحسن والحسين).
وهنا لا مناص من الإشارة إلى أن هذا الأمر ألصق بالمذهب الهادوي، وليس له تلك الصلة العضوية بالإمام زيد ومذهبه الأصلي، على نحو ما تصوره به الهادوية عبر تاريخها، وللباحث أن يؤكّد أن الخروج على الحكّام الظلمة، وإن كان من أبرز ما اشتهر به الإمام زيد؛ فليس ذلك متلازماً مع القول بأن الخروج بالسيف شرط من شروط الخليفة أو الحاكم، لينال الشرعية السياسية. ويستنتج هذا بوضوح من خلال ذلك النقاش الذي جرى بين زيد وبعض أتباعه من أهل الكوفة، الذين اشترطوا عليه قبل القتال معه أن يتبرأ من أبي بكر وعمر – وقد تمّ النقاش حول ذلك سابقاً- وحين أبى ذلك، وذكرهما بخير، سألوه:” فلِمَ تقاتلهم إذن؟” فأجابهم ” إن هؤلاء ليسوا كأولئك. إن هؤلاء ظلموا الناس وظلموا أنفسهم…” (5). وهنا يتبين أن مفهوم الخروج عند زيد ليس على نحو شرط شرعية الخلافة، حتى من غير سبب حقيقي، كما تقول الهادوية، وذلك واضح من ردّه عليهم، إذ أقرّ بمشروعية خلافة أبي بكر وعمر لعدالتهما، وأنكر مشروعية حكم هشام بن عبد الملك ومن على شاكلته من الأمويين، لأنهم ليسوا على نهج الشيخين في العدالة، لا لسبب نسبي، ودون أن يطالب بالخروج عليهما، بل إننا نجد موقفاً إيجابياً لزيد من أمثال الخليفة عمر بن عبد العزيز بالخصوص، للسبب ذاته، دون أن يشترط فيه شرط البطنين، وأن يدعو للخروج عليه، ولذلك فشرط السيف والخروج على نحو ما يصوّره به المذهب الهادوي، غير لازم في حق الإمام زيد.
وبناء على ذلك فلا نعلم أن مجددي اليمن بدءاً من الوزير ظلوا ملتزمين بمفهوم الخروج على الحاكم بالسيف على نحو ما هو مقرّر عند الهادوية، حتى بعد تحوّلهم إلى الإطار السنّي. نعم إنهم – وبعضهم بالأخصّ- لا يجارون ما قد يقع فيه بعض آحاد علماء المذاهب السنيّة، أو (الأثرية بالخصوص) أو المنتسبين إليها في القديم أو الحديث، من حيث تبرير طغيان الحاكم، وتصوير بعضهم أن النصح العلني له، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وقول كلمة الحق في غيابه أو حضوره، كل ذلك مما يعدّ من ضروب الخروج عليه! لكن أيّاً من علماء التجديد والإصلاح اليمنيين أولئك، كما أنه لا يقول بشيء من ذلك التبرير للطغيان؛ فإنه في الوقت نفسه لا يجيز الخروج المسلّح على الحاكم، ومن ثمّ فكيف يُقال: إنهم لايزالون في الإطار الزيدي الهادوي مصنّفين، مع أنهم لا يؤمنون بالخروج بالسيف ابتداء؟!
والواقع أن مسألة الخروج بالسيف هذه غدت مسألة بدهية في التراث الهادوي (6)، ولكنها جرّت الأمة إلى صراعات ومهالك وضعف استقرار، يل إلى حروب وانتهاكات وانتقامات يرثها الخلف عن السلف، والجيل اللاحق عن السابق- وقد سبقت الإشارة إلى ذلك-.
ترجيح اتجاه التحوّل إلى الإطار السنّي العام:
بعد كل ما تقدّم من عرض ومناقشة لكل واحد من المعالم الثلاثة في المذهب الزيدي الهادوي؛ فإن من العسير – من وجهة نظر الباحث- القول بأن أولئك المجدّدين لايزال يمكن توصيفهم في إطار الانتماء إلى المذهب الزيدي أو الهادوي، هذا على الرغم من أن بعض الباحثين مثل محمد أحمد الكبسي استثنى العلّامة الحسن الجلال من هذا التصنيف، فجعل له خصوصية نِسْبِية من هذه الناحية، فربما اختلف منهجه عن منهج الوزير والمقبلي والأمير والشوكاني نِسبياً، نظراً لأن أولئك تحرّروا من ربقة المذهب كليّة، أمّا الجلال فهو- كما يذهب إلى ذلك بعض الباحثين- مع تحرّره لم يزل منتمياً بالجملة إلى المذهب الزيدي، فقد ” اختار لنفسه طريق الاجتهاد، مع انتمائه إلى المذهب الزيدي، مذهب أهل البيت”(7)، والأدق – حسب الدكتور أحمد عبد العزيز المُليكي الباحث في حياة الجلال وفكره على نحو من الشمول والاستقصاء إلى حدّ كبير – أن يُقال: إن الجلال دون الأربعة المجدّدين الآخرين (الوزير والمقبلي والأمير والشوكاني) ” في نزعته التحرّرية، فهو وإن فاق بعضهم في إنتاجه العلمي، فقد كان واقعاً – إلى حدّ ما- تحت تأثير الحياة السياسية السائدة في عصره، سياسياً واجتماعياً وثقافياً” (8)، لكن ذلك التأثير ظلّ محدوداً للغاية، قياساً بحجم تحرّره، وتصريحه بنبذ التمذهب. ووفق الدكتور المليكي فإن الجلال لم يتقيّد بالمذهب الزيدي، أصولاً وفروعاً، جلة وتفصيلاً، إذ كان حريصاً على اتباع الدليل، وفتح باب الاجتهاد، ونبذ التقليد(9)، إلى حدّ وصفه للتمذهب بصورة عامة بأنه ظلمة تعوق ذوي البصائر عن الإبداع، وسبيل التحزّب والتفرّق (10)، هذا على الرغم من أن يحيى بن الحسين بن القاسم (ت:1100ه) زعم أن الجلال كان على مذهب داوود الظاهري (ت:270هـ)، بل زاد فنسب إليه آراء بعضها جدّ غريب على مذهب الظاهري وغيره من مذاهب أهل السنة والزيدية بكل فرقها، حتى بدا ذلك مذهباً شاذاً، كإباحته جواز المتعة، ثم أشار إلى أن الجلال يتفق مع الخوارج في عدم اشتراط القرشية، وأن ذلك في جميع الناس، عربي وعجمي، على سواء، وإنما يشترط فيهم التقوى(11). وبذلك فيغدو الجلال- وفقاً لهذا الرأي- مخالفاً للزيدية الهادوية في أبرز مسألة عُرفت بها، وهي عدم اشتراط البطنين في الحكم، غير أن عدم إسناد ابن الحسين ذلك إلى مصدر بعينه للجلال، لا يبعث على الاطمئنان إلى صحّة النسبة إليه بيقين، في ضوء ما اشتهر من تراثه، في مسألة الإمامة بالذات، حيث تبدو هي الاستثناء الكليّ الوحيد، في هذا السياق، الذي جعل الجلال غير قادر على مغادرة المذهب في هذه المسألة بالخصوص(12)، وهو ما دفع الباحث المليكي ليصف ذلك الرأي من يحيى بن الحسين بأنه جَور منه، حيث حمّل كلام الجلال ما لا يحتمل، وقوّله مالم يقل، وألزمه بما لا يلزم (13).
وثمّة مفارقة هنا تتمثل في ما ذهب إليه الدكتور عبد العزيز المقالح من احتمال أن استبعاد بعض الباحثين مثل الدكتور أحمد صبحي صاحب كتاب الزيدية إدراج شخصيتي الحسن الجلال وصالح بن مهدي المقبلي ضمن الشخصيات التي وصفها صبحي بالمنفتحة على تيار أهل السنّة – وقد مرّ بنا ذلك في موضعه- ؛ يرجع إلى أن ليس من السهل “إدراجهما تحت هذا التيار السلفي، أو حشرهما مع أهل السنّة، بالسهولة التي تمكّن بها من إدراج الثلاثة الأسماء السالفة الذكر”(14). ويقصد بالثلاثة: الوزير والأمير والشوكاني. ولم يفصح المقالح عن الأسباب الحقيقية التي دفعته لذلك الاستخلاص، واعداً بأن يخصص لتعليل ذلك دراسة مستقلة عن ” الجلال”، لكن من الواضح أنها لم تتم فعلياً، أو على الأقل لم تخرج ضمن ما نُشِر! ثم إن الدكتور صبحي لم يَدَعْ لذلك الاحتمال الذي أشار إليه الدكتور المقالح أن يظل بلا جواب، إذ كشف الاول – في تعليقه على ملحوظات الأخير- أن ما احتمله المقالح من سبب لعدم إيراد صبحي شخصيتي الجلال والمقبلي ضمن قائمة المجدّدين الخمسة، لاعلاقة له بكونهما يختلفان عن الثلاثة الآخرين، من أيّ جانب، بل السبب فنّي، بكمن في تعذّر تغطية قائمة الأعلام الكبار جميعاً، في نطاق كتاب واحد، فكان أن اجتهد صبحي فاختار ثلاثة منهم ، ليس أكثر(15) .
وإذا لم يسلّم للقول بان الحسن الجلال لم يغادر المذهب الزيدي كليّة، كما ذهب إلى ذلك بعض الباحثين- حسبما تقدّم- فإن من العسير القول- من باب أولى- بأن الجلال والمقبلي لم يتحوّلا إلى الإطار السنّي العام، كما ذهب المقالح، بل هما كذلك، وفق ما يؤكّده نتاجهم الفكري والفقهي، لكن ذلك لايستلزم استنتاج أنهما- أو حتى المجدّدون الثلاثة الآخرون-؛ أصبحوا متماهين مع أيّ من المذاهب السنيّة التقليدية الأربعة، أو سواها، أمّا بروز آراء لأيّ منهم سلباً أو إيجاباً – وبالأخص للجلال والمقبلي- تبدو خارج سياق الفكر السنّي التقليدي؛ فذلك استثناء لايؤذن بإصدار حكم عام وحاسم، بأنهما لم يتحوّلا إليه بالجملة – على الأقل- بل يؤكّد أن تحوّل أيّ من المجدّدين الخمسة المشار إليهم، ليس تماهياً مع المذاهب السنية الأربعة، أو أيّ منها، بقدر ما هو تحوّل إليها، ولكن في إطار الفكر الإسلامي العام ورحابته.
ومع التأكيد على أن ذلك لايعني تنكّرهم للمذهب الزيدي وعلمائه ورموزه، أو أنّهم قد تحوّلوا بالضرورة إلى موقف المهاجم له، المحذّر من اتباعه، بل مع التأكيد على تحرّرهم من الالتزام به، أو بغيره من المذاهب السنيّة المعروفة؛ ومع تخليهم – في الجملة- عن منظومة المذهب وأصوله الفكرية، ومنهجيته في التلقي ومصادر الاستدلال بالخصوص؛ فإنهم ما برحوا يجلّون رموز المذهب الأصليين، كالإمام زيد بالخصوص، ويعلنون ولاءهم لـ”آل البيت”- بالمفهوم الخاص السائد- كما أنّ تحوّلهم من إطار المذهب الزيدي الهادوي لا يعني أنّهم تحوّلوا إلى إطار مذهب سنّي آخر بعينه- كما سبقت الإشارة- بل هم جميعاً تقريباً أقرب إلى وصف أستاذنا الدكتور عبد الغني قاسم الشرجبي في أطروحته للدكتوراة عن الشوكاني بأنه ” لا يتقيد بالمذهب الزيدي، ولا بمذاهب اهل السنة الأربعة المشهورة، ولا بالمذهب الأشعري، ولا المعتزلي، وإنما ديدنه البحث عن الدليل، بمنهج علمي خالٍ من التمذهب المُسْبَق، والتعصّب والجمود، وفي إطار الكتاب والسنّة، ونهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، في فهم نصوصها، وفي استنباط الأحكام الشرغية منهما، فاتخذ من تراث جميع المسلمين بستاناً، أخذ يستأصل منه كل عشب ضار، ويقطف منه كل ماطاب ثمره، وأينع زهره…”. (16) ، أو على حدّ وصف الأستاذ عبد الله السريحي، المحقق في التراث اليمني الشوكاني- بـ”أنّه مجتهد متحرّر، من أيّ نزعة مذهبيية، فالإسلام هو المذهب الذي ينتمي إليه، ويستقي أفكاره ومعارفه من ينايبعه الأولى (الكتب والسنّة)، بعيداً عن أيّ تعصب مسبق،لأي مذهب من المذاهب ولا ضدّه”(17)، وقل مثل ذلك عن جميعهم. وإلى ذلك بعض الباحثين الآخرين كذلك(18).
الهوامش:
- سامي الغريري الغرّاوي، الزيدية بين الإمامية وأهل السنة: دراسة تاريخية تحليلية في نشأتها وظهورها وعقائدها وفرقها، 1426هـ-2006م، د.م: مؤسسة دار الكتاب الإسلامي، ص 592.
- مجد الدين المؤيدي من تقديمه لكتاب علي شرف الدين، الزيدية: نظرية وتطبيق، مرجع سابق، ص هـ.
- مجد الدين المؤيدي، التحف شرح الزلف،1417هـ-1997م، ط الثالثة، صنعاء: مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيع، ص69.
- يحيى بن حمزة، الرسالة الوازعة، مصدر سابق، ص 52.
- محمد أبو زهرة، الإمام زيد: حياته وعصره- آراؤه وفقهه، 1425هـ-2005م، د.ط، القاهرة: دار الفكر العربي مرجع سابق، ص 62.
- مجد الدين المؤيدي من تقديمه لكتاب علي شرف الدين، الزيدية: نظرية وتطبيق، مرجع سابق، ص هـ.
- محمّد أحمد الكبسي، الفروق الواضحة البهيّة، مرجع سابق، 102.
- أحمد عبد العزيز المُليكي، الحسن بن أحمد الجلال: حياته وفكره، 2005م، د.ط، صنعاء: جامعة صنعاء، ص 13.
- المليكي، الحسن بن أحمد الجلال، المرجع السابق، ص 188، وانظر الصفحات : 192-194
- المليكي، الحسن بن أحمد الجلال، المرجع نفسه، ص 189.
- يحيى بن الحسين، بهجة الزمن في تاريخ اليمن (تحقيق: أمة الغفور عبد الرحمن الأمير) ، أطروحة دكتوراة، 2004م، جامعة صنعاء: كلية الآداب- قسم التاريخ، جـ2، ص354-355.
- انظر: المليكي، الحسن بن احمد الجلال، مرجع سابق ص 330، 340
- المليكي، الحسن بن احمد الجلال، المرجع السابق ص 167.
- المقالح، قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة، مرجع سابق، ص 54.
- انظر تعليق أحمد صبحي على ملحوظات عبد العزيز المقالح في :المقالح، قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة، المرجع السابق، ص 70.
- عبد الغني قاسم الشرجبي ، الإمام الشوكاني: حياته وفكره، د.ت، د.ط، بيروت: مؤسسة الرسالة وصنعاء: مكتبة الجيل الجديد، ص 291
- عبد الله السريحي (محقق): محمد بن علي الشوكاني، أدب الطلب ومنتهى الأرب1419- هـ- 1998م، الطبعة الأولى، بيروت: دار ابن حزم وصنعاء: مكتبة الإرشاد، ص45.
- عبد الله نومنسوك، منهج الإمام الشوكاني في العقيدة، 1414هـ- 1994م، الطبعة الأولى، الرياض : مكتبة دار القلم والكتاب،ص 854-855
الخاتمة
(النتائج والتوصيات)
في ختام البحث توصّل الباحث إلى النتائج التالية تليها التوصيات، وذلك على النحو التالي:
أولاً: النتائج:
1- تمثل سمة الانفتاح في المذهب الزيدي، وإتاحة الحرّية للمجتهد، لتحرير علاقته بالمذهب ، بقاء فيه، أم تخلياً عنه، ميزة إيجابية، أتاحت لبعض المجتهدين إمكان التحرّر من ربقة التقليد المذهبي.
2- هناك خلاف بين الباحثين حول حقيقة وضع المجدّدين من حيث بقاؤهم في إطار المذهب الزيدي رغم اجتهادهم الذي تجاوز المذهب، من حيث تحوّلهم عنه، أم بقاؤهم فيه، مع انفتاح على الإطار السنّي، ليس أكثر.
3-هناك ثلاثة معايير علمية تضبط مسألة الجدل حول بقاء المجتهد في إطار المذهب أم التحوّل عنه، وهي : مدى التزامه بالأصول الفكرية للمذهب؟ ومدى التزامه بمنهج الاستدلال ومصادر التلقّي فيه؟ ومدى إيمانه بالنظرية السياسية (نظرية الإمامة)، أو اختلافه معها؟
4- بتطبيق المعايير العلمية الثلاثة الضابطة لمسألة بقاء المجتهد في إطار المذهب أم التحوّل عنه؛ تبيّن أن أئمة الاجتهاد والتجديد في اليمن، محلّ البحث؛ تحوّلوا عن المذهب الزيدي بالكليّة، ولكن ليس إلى مذهب سنّي بعينه، بل إلى الفكر الإسلامي السنّي العام، وتأكد – من ثمّ- أن الأمر لا يقف عند حدود انفتاح على الإطار السنّي فحسب.
ثانياً: التوصيات:
يوصي الباحث بما يلي:
الإشادة بسمة التحرّر التي يمنحها المذهب الزيدي لكل مؤهل لذلك، والبناء عليها، في سياق دعوات التحرّر من التقليد، لكل مؤهّل لذلك. 2-الاحتكام إلى المعايير العلمية عند الخلاف، للخروج منه بوجهة قويمة. 3-حثّ طلبة العلم الجادّين المؤهلين، على التزام منهج التجديد والمجدّدين. 4-دعوة مؤسسات البحث العلمي والمراكز الاكاديمية لإيلاء تراث مجدّدين اليمن، ومن على شاكلتهم الاهتمام المناسب، للإفادة من جوانب الاجتهاد والتجديد، في المجالات المختلفة، فكراً تربوياً، وفقهياً، وحديثياً، وتفسيرياً، ومن النواحي الأخرى كذلك.
قائمة المراجع
- الزيدية، أحمد محمود صبحي، 1404هـ-1984م،ط الثانية، القاهرة: الزهراء للإعلام العربي.
- الزيدية باليمن، محمد بن إسماعيل العمراني، 1369هـ، د.ط، د.م:د.ن.
- الزيدية: نشأتها ومعتقداتها، إسماعيل الأكوع، ، 1413هـ-1993م، ط الأولى، بيروت: دار الفكر المعاصر.
- لزيدية في اليمن، بدر الدين الحوثي، د.ت، (طباعة استنسل)، د.م: دار الزهراء.
- الزيدية والإمامية وجهاً لوجه، محمد بن إبراهيم الحسن المرتضى، 1418هـ-1998م، ط الأولى، صعدة: مركز الهدى.
- إشكالية التعامل مع السنة النبوية، طه جابر العلواني، 1435هـ- 2014م، ط الأولى، هرندن- فرجينيا- أمريكا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي.
- الزيدية بين الإمامية وأهل السنة: دراسة تاريخية تحليلية في نشأتها وظهورها وعقائدها وفرقها، سامي الغريري الغرّاوي، 1426هـ-2006م، د.م: مؤسسة دار الكتاب الإسلامي.
- بهجة الزمن في تاريخ اليمن، يحيى بن الحسين بن القاسم، ( تحقيق: أمة الغفور عبد الرحمن الأمير)، أطروحة دكتوراة، 2004م، جامعة صنعاء: كلية الآداب- قسم التاريخ.
- التحف شرح الزلف، مجد الدِّين المؤيّدي، ،1417هـ-1997م، ط الثالثة، صنعاء: مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيع.
- الفروق الواضحة البهيّة بين الفرق الإمامية وبين الفرقة الزيدية، محمّد أحمد الكبسي، ، 1413هـ-1992م، د.ط، د.م: د.ن.
- كتاب التربية الوطنية للصف الخامس من مرحلة التعليم الأساسي، وزارة التربية والتعليم (الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء) الإدارة العامة للمناهج، طبعة 1442هـ/2021م، الدرس الأول: اليمن مقبرة الغزاة.
- كتاب الثقافة الوطنية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء)، 2020م، ،د. ط، د.م: د.ن.
- جناية أدعياء الزيدية على الزيدية، عبد الوهاب بن لطف الديلمي، 1433هـ-2012م، ط الأولى، صنعاء: دار النشر للجامعات.
- السيل الجرّار المتدفق على حدائق الأزهار(شرح متن الأزهار)، محمد بن علي الشوكاني، 1425هـ، 2004م، ط الأولى، بيروت، دار ابن حزم.
- الهادوية في اليمن: نشأتها وتطورها مع تحقيق كتاب البراهين الصريحة على العقيدة الصحيحة للإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم بن محمّد، عادل حيدان، 1431هـ2010م، رسالة ماجستير(غير منشورة)، جامعة القاهرة: كلية دار العلوم.
- المجموع المنصوري، العقد الثمين في تبيين أحكام الأئمة الهادين، عبد الله بن حمزة، (تحقيق: عبد السلام الوجيه)، (أمير المؤمنين وولديه) (الجزء الأول)، 1421هـ- 2001م، ط الأولى، صنعاء: مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية.
- لوامع الأنوار في جوامع العلوم والآثار وتراجم أولي العلم والأنظار، مجد الدين المؤيدي، 1414هـ- 1993م، ط الأولى، صعدة:
- ابن الأمير وعصره: صورة من كفاح شعب قاسم، غالب أحمد وآخرون، ،د.ت، د.ط، د:م، د.ن.
- الإمامة وخطرها على وحدة اليمن، محمد محمود الزبيري، ،1425هـ-2004م، د.ط، صنعاء: وزارة الثقافة والسياحة.
- محمد بن إسماعيل الأمير: رائد مدرسة الإنصاف في اليمن، محمد عبد الله زبارة، ،2007م، د.ط، د:م،د،ن.
- كتاب الأزهار في فقه الأئمة الأطهار، أحمد بن يحيى المرتضى، ، د.ت، د.ط، د.م. د.ن.
- المنار في المختار من جواهر البحر الزخّار، صالح بن مهدي المقبلي، 1408هـ-1988م، ط الأولى، بيروت: مؤسسة الرسالة.
- القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد (ضمن الرسائل السلفية للشوكاني)، محمّد بن علي الشوكاني، 1348هـ-1930م، د.ط، بيروت: دار الكتب العلمية.
- الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب صحابة سيّد المرسلين ، يحيى بن حمزة، ،1348هـ،د. ط ،د.م: إدارة الطباعة المنيرية.
- الإمام زيد: حياته وعصره- آراؤه وفقهه، محمّد أبو زهرة، 1425هـ-2005م، د.ط، القاهرة: دار الفكر العربي.
- اليمن الخضراء مهد الحضارة، محمد بن علي الأكوع الحوالي، 1402هـ- 1982م، ط الثانية، صنعاء: مكتبة الجيل الجديد.
- قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة، عبد العزيز المقالح، 1982م، د.ط، بيروت دار العودة.
- الزيدية: نظرية وتطبيق، علي عبد الكريم الفضيل شرف الدين،1405هـ- 1985م، ط الأولى، عمّان: جمعية عمال المطابع التعاونية.
- مجموع حميدان القاسمي( تنبيه الغافلين على مغالط المتوهمين)، حميدان القاسمي، (تنبيه الغافلين) ،د.ت، د.ط، د.م، د.ن.
- الحسن بن أحمد الجلال: حياته وفكره، أحمد عبد العزيز المُليكي، 2005م، د.ط، صنعاء: جامعة صنعاء.
- الإمام الشوكاني: حياته وفكره، عبد الغني قاسم الشرجبي ، د.ت، د.ط، بيروت: مؤسسة الرسالة وصنعاء: مكتبة الجيل الجديد.
- منهج الإمام الشوكاني في العقيدة، عبد الله نومنسوك، 1414هـ- 1994م، الطبعة الأولى، الرياض: مكتبة دار القلم والكتاب.
- العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ، صالح بن مهدي المقبلي، 1328هـ، ط الأولى، د.ن: القاهرة.
- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، محمد بن علي الشوكاني د.ت، د.ط، القاهرة: دار الكتاب الإسلامي.
- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، محمد بن علي الشوكاني (تحقيق: محمد صبحي حلّاق)، 1427هـ-2006م، الطبعة الأولى: بيروت ودمشق: مكتبة ابن كثير.