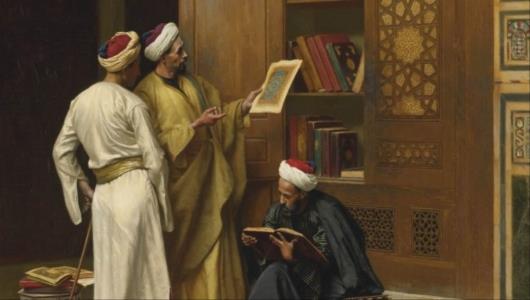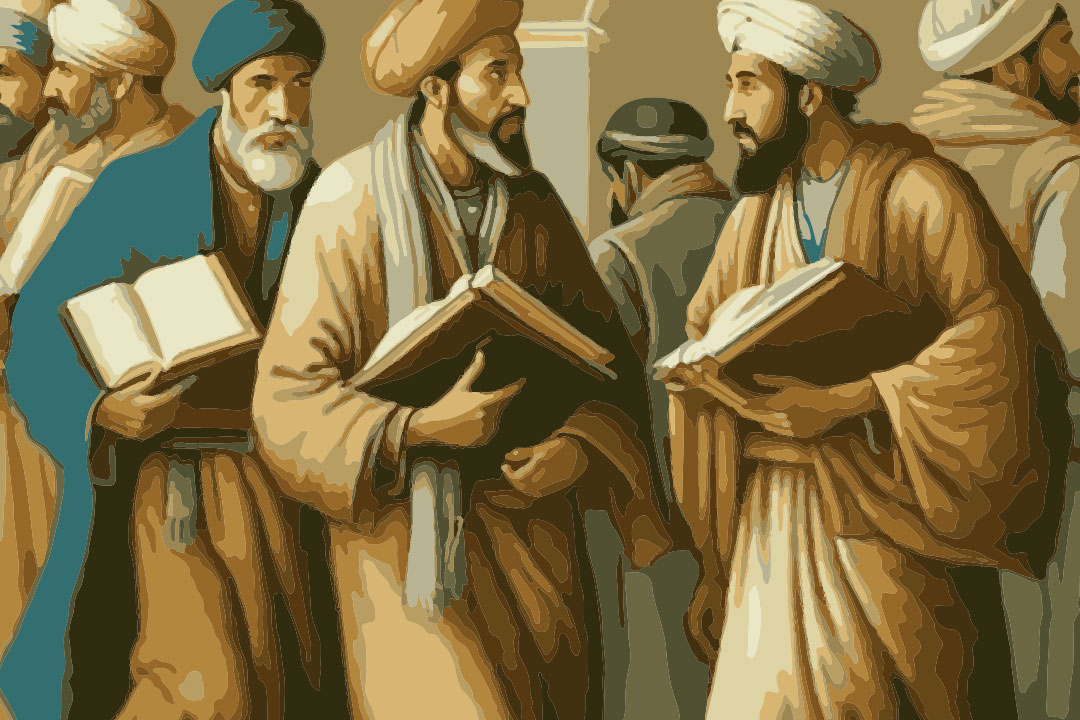هل لايزال المجدّدون زيديين هادويين؟
في ضوء ذلك التوصيف والنقاش المتقدّم هل يمكن للباحث أن يستنتج أن أمثال أولئك المجدّدين المشار إليهم آنفاً؛ لايزال من الممكن تصنيفهم على المذهب الزيدي الهادوي، بوصفهم مُخرجاً من مخرجاته على نحو أو آخر؟
الواقع أن ثمة اتجاهين في هذا، يمكن توصيفهما على النحو التالي:
الاتجاه لأول: المجدّدون: زيديون هادويون
يرى هذا الاتجاه أن أولئك المجّددين وإن تحوّلوا عن فكر المذهب الزيدي الهادوي وفقهه الخاص، إلى آفاق الفكر الإسلامي وسعته؛ فإنهم لم يخرجوا عن دائرة المذهب بقدر تمثيلهم لتيار الانفتاح على الفكر السنّي في المذهب الزيدي (الهادوي).
من اللافت– ابتداء- أن يتساوق مع هذا الاتجاه منذ وقت مبكّر؛ القاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني (ت: 1443هـ- 2021م)، الذي يلقّبه البعض بـ” الشوكاني الصغير”، نظرًا لمتابعته – في الغالب- اجتهادات الإمام الشوكاني وفقهه، ومدرسته الفكرية بصورة عامة. وقد نُشِرت رسالة صغيرة باسم العمراني، في كتيب صدر عن مكتبة دار التراث بصنعاء، عنوانها (الزيدية باليمن)، بعد أن كان قدّمها – في الأصل- عام 1369هـ -1950م (تقريباً)، لأحد مؤتمرات التقريب بين المذاهب الإسلامية، التي عقدت بالقاهرة، وحاصلها أنه يتفق وهذه الوجهة، في عدّ سلسلة مجدّدي الفكر الإسلامي باليمن؛ لايزالون في دائرة الزيدية الهادوية التقليدية، وإن انفتحوا بقوّة على الفكر السنّي(1). وهل ظل القاضي العمراني على رأيه المبكّر هذا؟ أم تراجع عنه؟ ليس لدينا جواب محدّد مقطوع به، وإن كان الغالب على الظن مراجعته لذلك، في ضوء جملة أحاديثه ذات العلاقة، وما عاناه من المقلّدة والمتعصبين المنتمين إلى المذهب الهادوي في بيئته، المعادين – علانية- لاتجاه المجدّدين وفكرهم.
أمّا ما يمثّل اتجاهًا علميًّا ورؤية تأصيلية لهذه المسألة، بحسب معرفة الباحث الحالي وترجيحه؛ فإن أول من تبنّى هذه الوجهة بقدر من الدراسة الوافية – وليس انطباعاً عابراً، أو مجرّد رأي قيل من آحاد المعاصرين- كان الأستاذ الدكتور أحمد محمود صبحي (ت:1425هـ-2004م)، أستاذ الفلسفة الإسلامية – حينذاك- بجامعة الإسكندرية، ذلك الذي عاش في البيئة الزيدية الهادوية بضع سنوات، حين أعير للعمل أستاذاً بجامعة صنعاء (1976-1980م)، وتفاعل مع البيئة العلمية فيها عن قرب، فخرج بعد ذلك بعمل فكري كبير عن الزيدية، مثّل الجزء الثالث من موسوعته في علم الكلام، وكان له صداه في إطار النخبة الفكرية المهتمة داخل اليمن وخارجها، مع أنه قد سبق هذا العمل عملان علميان سابقان لصبحي ذاته، عن المعتزلة والأشاعرة، وكان قد خصّص في عمله الأخير (عن الزيدية) باباً مستقلاً لمسألة علاقة المجدّدين بالزيدية عنوانه (الاتجاه الزيدي المنفتح على أهل السنّة)، فجعل الفصل الأول منه للوزير، والثاني خصّ به الأمير، أما الثالث فللشوكاني(2)،وكان قد ذهب إلى مثل هذا الرأي أو قريب منه من قبل صبحي باحثون ومفكّرون آخرون، مع ملاحظة أن آراء بعضهم إلى الانطباع أقرب منها إلى رؤية الباحث ومن هؤلاء: الدكتور حسن الترابي (ت: 1437هـ/2016هـ)، في إحدى محاضراته بالولايات المتحدة الأمريكية، في الثمانينات الميلادية، حين وصف الشوكاني بأنه زيدي شيعي، في معرض تقريره أن السنّة والشيعة متفقون على 95 بالمائة ومختلفون في 5 بالمائة فقط(3)،كما صنّف الدكتور طه العلواني (ت: 1437هـ/2016هـ)، النتاج العلمي الحديثي لأمثال ابن الوزير وابن الأمير ضمن التراث الزيدي، ووصف ابن الوزير – مثلاً- بالزيدي(4) . ومضى في هذا الاتجاه كذلك بعض الباحثين الجُدد في رسائلهم العلمية أمثال عادل حيدان في رسالته للماجستير عن الهادوية في اليمن… (5).
وما تجدر الإشارة إليه في هذا السياق أن هذا الاتجاه كان سبباً في تخفيف الوطأة على المذهب الزيدي الهادوي، حيث كان بعض أصحاب المذاهب الأربعة السنيّة المعروفة يٌلحِقون الزيدية الهادوية بالجعفرية الإمامية، بوصفهم جميعاً (شيعة)، ويرون أن الفرق الوحيد بينهما أن الإمامية تحصر الإمامة في اثني عشر إماماً، في حين تحصرها الزيدية في ذريّة فاطمة من أبناء الحسن والحسين، وحسبوا أن هذا نتاج المذهب الزيدي الهادوي المباشر، ولايزال يمثّل – في نظرهم- الاتجاه السائد المعمول به اليوم لدى الزيدية المعاصرة، لكنهم بعد أن اطّلعوا على مؤلفات الوزير والمقبلي والأمير والشوكاني، عدلوا عن وجهتهم تلك(6).
الاتجاه الآخر: المجدّدون متحوّلون إلى الإطار السنّي العام
أما الاتجاه الآخر فيرى أنه لم تبق ثمّة علاقة لأولئك المجدّدين بمذهبهم الأصلي، وأنهم قد تحولوا كليّاً عن المذهب الزيدي الهادوي، إلى رحاب السنّة المطهرة، بعد أن نبذوا التقليد، حيث قطعوا صلتهم به، وفقاً لرأي القاضي المؤرّخ إسماعيل الأكوع مؤلِّف كتاب ” الزيدية : نشأتها ومعتقداتها”، الذي أبدى استغرابه من استمرار بعض علماء المذاهب السنيّة الأربعة في تصنيفهم أولئك المجدّدين على المذهب الزيدي، مع أنه لم يعد لهم به صلة، وربما ظنوا ذلك لكون المجدّدين نشأوا في البيئة الزيدية، وتلقّوا العلم على أيادي علماء المذهب، قبل أن يتحرّروا، ومن ثمّ فما نسبتهم إلى الزيدية إلا نسبة بيئة وواقع، بحكم المنشأ على المذهب الزيدي الهادوي في مراحلهم الأولى لطلب العلم(7).
ولكون هذا الرأي هو الأكثر شيوعًا – حسب متابعتي- فيتعذّر رصد القائلين به أو حتى بعضهم.، لكن أيّ الاتجاهين هو الأرجح؟ ذلك، ما سأكشف عنه لاحقاً- بعون الله-.
وقبل أن أبدي رأيي الخاص في ذلك؛ أرى أنه لابد من تحديد معايير رئيسة ضابطة للتصنيف، سواء في حال مشايعة الاتجاه القائل بالبقاء في إطار المذهب، وأن الامر لا يعدو عملية انفتاح زيدية داخلية، أم الذهاب نحو مشايعة الاتجاه الآخر القائل بأن الأمر تجاوز ذلك إلى مغادرة المذهب كليّة، مع بقاء الإفادة منه فحسب، والتقدير لرموزه، كأي مذهب إسلامي، ولكن دونما التزام أو متابعة تقليدية، من قِبل أيّ من الأعلام موضع الدراسة.
معايير تصنيف البقاء في المذهب أو التحوّل عنه:
وكي يكون التصنيف مبنياً على أساس موضوعي؛ فإنه ليس ثمة ما هو أكثر معيارية من تعريف المذهب لنفسه من خلال أئمته ومرجعياته، ومقارنة مدى قُرب أو بُعد أولئك الأعلام المجدّدين عنه في ضوء ذلك. وعلى هذا فإن المذهب الزيدي الهادوي كأي مذهب آخر يحمل منهجاً أيّاً ما قيل عن تداخل بعض أصوله أوالتقاء بعض مصادره ومنهج الاستدلال فيه مع غيره؛ فإنه لايزال يمتلك قسمات محدّدة في جوهرها، وأصولاً عامة معيّنة، سواء من حيث الأصول الفكرية، أم من حيث منهج الاستدلال ومصادر التلقّي، أم من حيث النظرية السياسية (نظرية الإمامة)، ويمكن الإشارة إلى ذلك بما يحقق المقصود في هذا المقام على النحو التالي:
1- الأصول الفكرية للزيدية الهادوية:
من المعلوم أن للزيدية أصولاً فكرية عامة عبّر عنها بعض أئمة المذهب كيحيى بن حمزة بقوله:
“فمن كان على عقيدته في الديانة والمسائل الإلهية والقول بالحكمة، والاعتراف بالوعد والوعيد، وحصر الإمامة في الفرقة الفاطمية، والنص في الإمامة على الثلاثة، الذين هم عليّ وولداه، وأن طريق الإمامة الدعوة فيمن عداهم كان مقرّاً في هذه الأصول فهو زيدي، فهذه هي معتقدات الزيدية التي مصداق اللقب عليها دون المسائل الاجتهادية”(8). ثم قال بعد تفصيل:” فمن كان جامعاً لهذه الأصول فهو زيدي، ومن خرج عن هذه الأصول فليس بزيدي”(9).
إن هذا النص جليّ صريح في شروط انطباق وصف الزيدي، وعدم انطباقه، فالأصول الفكرية الخمسة المعروفة عند الزيدية الهادوية، وهي: التوحيد، والعدل، والوعد والوعيد، والنبوات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفق شرائط ومواصفات خاصة(10)؛ لايلتزم بها أولئك المجّددون على نحو ما وردت في المصادر الزيدية، ولا يلقون لها بالاً، بل تجد عقيدتهم الفكرية قائمة على أصول أخرى غير متقيّدة بهذه الأصول وعددها، وتجدهم يقرنونها بالفكر الاعتزالي، ولهم منه موقف سلبي لا يخفى على الدارسين في هذا المجال، ولا يسلمون ببعض تطبيقات تلك الأصول ومضامينها العملية، بل تراهم يردّون عليها في الجملة، ويحاججون القائلين بها، لكن طبيعة المسائل الكلامية المتصلة بفروع العقيدة، ليست نسقاً واحداً حدّياً، حتى في إطار الفكر السنّي بقسميه الكبيرين الأشعري، ومعه الماتريدي، والأثري (السلفي)، فثمّة مسائل كلامية، تتصل بالأسماء والصفات، ناهيك عن جملة مسائل أخرى تتصل بفروع العقيدة في جوانبها المختلفة؛ تتباين فيها الوجهات، في إطار المدرسة الواحدة، لظنيّة الأدلة الواردة فيها، واحتمالها لأكثر من وجه، شأنها في ذلك شأن المسائل العملية ( مسائل الأحكام)، فهل خرج مجدّدو اليمن ومجتهدوها محلّ البحث هنا عن هذا المسار؟ الجواب: لا. ومن ثمّ فمن العسير القول بأن مجرّد احتواء بعض تراثهم على مثل تلك الرؤى والاجتهادات، يبقيهم في دائرة مذهبهم الأصلي (الزيدي الهادوي)، بشقيه الكلامي والفقهي. هذا مع التأكيد على أن المنظومة الكليّة لفكرهم تشهد باختلافهم مع منظومة الفكر الزيدي في الجملة.
الهوامش:
- راجع: محمّد بن إسماعيل العمراني، الزيدية باليمن، مرجع سابق، مكتبة دار التراث.
- راجع: أحمد صبحي، مرجع سابق، ص 435-575. وانظر: تأكيده على رأيه هذا في تعليقه على تعقيب الدكتور عبد العزيز المقالح على كتاب الأخير : قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة، 1982م، د.ط، بيروت: دار العودة، ص 69-70.
- انظر: محمد سرور بن نايف زين العابدين، دراسات في السيرة النبوية د.ت، د.ط، د.م: دار الأرقم، ص 309.
- انظر: طه جابر العلواني، إشكالية التعامل مع السنة النبوية، 1435هـ- 2014م، الطبعة الأولى، هرندن- فرجينيا- أمريكا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي،ص 309-310.
- راجع: عادل حيدان، الهادوية في اليمن: نشأتها وتطورها مع تحقيق كتاب البراهين الصريحة على العقيدة الصحيحة للإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم بن محمّد، 1431ه/ ـ2010م، رسالة ماجستير(غير منشورة)، جامعة القاهرة: كلية دار العلوم ، ص 517.
- إسماعيل الأكوع، الزيدية في اليمن (طبعة دار الفكر المعاصر)، مرجع سابق، ص 57؛ وانظر: محمد بن علي الأكوع الحوالي، اليمن الخضراء، مرجع سابق، ص 105.
- إسماعيل الأكوع، الزيدية في اليمن (طبعة دار الفكر المعاصر)، المرجع السابق، ص 59-60.
- يحيى بن حمزة، الرسالة الوازعة للمعتدين عن سبّ صحابة سيّد المرسلين، 1411هـ-1990م، ط الأولى، صنعاء: مكتبة دار التراث ، ص51.
- يحيى بن حمزة، الرسالة الوازعة، المصدر السابق، ص52.
- انظر التفصيل في: علي عبد الكريم الفضيل شرف الدين، الزيدية: نظرية وتطبيق،1405هـ- 1985م، ط الأولى، عمّان: جمعية عمال المطابع التعاونية ، ص 40-118.
*نقلاً عن موقع حكمة يمنية