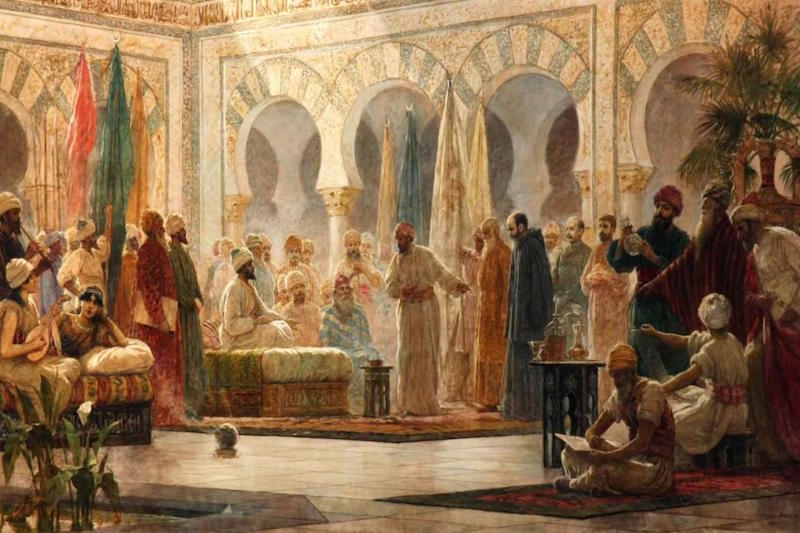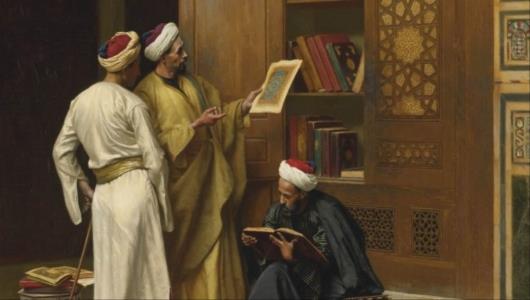2- مصادر التلقي ومنهج الاستدلال:
ومن جانب مصادر التلّقي ومنهج الاستدلال فصحيح أن الزيدية تجعل القرآن الكريم ثم السُنَّة المطهرة مصدرين أساسيين كليينّ، ثم تأتي المصادر الثانوية بعد ذلك(1) كما الأمر لدى أهل السنَّة من هذه الزاوية؛ بيد أن منهج التعامل مع هذه المصادر لدى كل منهما مختلف، إذ الأصل في الاعتماد الحديثي لدى الزيدية الهادوية ليست مصادر السنّة، ولا أن منهج الاستدلال لدى الهادوية يشابه منهج المحدّثين السنّة، كما أن التصنيف في مجال علم الحديث مختلف إلى حدّ بعيد بينهما، في طبيعة المجال ودلالة المصطلحات، على نحو يفضي إلى الاختلاف الكبير بين منهج المحدّثين السنّة، ومنهج المحدّثين، من الزيدية الهادوية، على قلتهم، بل يذهب أحد رجالات الزيدية الكبار، الذين تحوّلوا إلى اتجاه السنّة، وغدوا من أوائل مجدّدي الفكر الإسلامي في اليمن، وهو الإمام محمد بن إبراهيم الوزير(ت:840هـ)، ولا سيما في كتابه ” العواصم من القواصم” ومختصره “الروض الباسم في الذبِّ عن سنة أبي القاسم” إلى أن بعض علماء الزيدية الهادوية، ممن يعترض على أهل السنّة في علم الحديث خاصة، وترديده أن أئمة الزيدية الهادوية هم من ينبغي الاحتكام إليهم في هذا المجال؛ زعم قائم على افتراض ” أن يكون أئمة الزيدية؛ قد صنّفوا في معرفة صحيح الحديث ومعلوله، ومقبوله، ومردوده ما يكفي أهل الاجتهاد من أهل الإسلام، والمعلوم خلاف ذلك”(2) ، ثم يقرّر الوزير أنه ليس للزيدية حظ في علم العلل، الذي اشتهر به من علماء الحديث السنّة أمثال الدار قطني وغيره، ” وليس لأئمة الزيدية في ذلك تصنيف ألبتة، ومن لم يفرد للعل تأليفاً، من المحدِّثين ذكرها في تأليفه في الحديث، كما يصنع أبو داوود والنسائي وغيرهما، بخلاف من جمع الحديث من الزيدية، فإنه لايتعرّض لذلك، وكذلك المجتهد يحتاج عند تعارض الأحاديث إلى معرفة الراجح بكثرة الرواة، أو زيادة معدّليهم، أو كون بعضهم مجمعاً عليه، وبعضهم مختلفاً فيه، وهذا يحتاج إلى معرفة فنيّن عظيمين:
أحدهما: معرفة طرق الحديث، وهو فنّ واسع، لا نعرف للزيدية فيه تأليفاً…
الفنّ الثاني: علم الجرح والتعديل، وما فيه من تعريف مراتب الثقات والضعفاء، الذين لايتم ترجيح بعضهم على بعض إلا بعد معرفته… وهذه علوم جليلة لا بد من معرفتها، عند من يعتقد وجوب معرفتها من أهل الاجتهاد. فقول المعترض: إن الواجب هو الرجوع إلى أئمة الزيدية، في علوم الحديث؛ قولُ مغفَّلٍ” لايعرف أن ذلك مستحيل في حق أكثر أهل العلم، الذين يشترطون في علوم الاجتهاد، مالم تقم به الزيدية!! وإنما هذا مثل من يقول: إنه يجب الرجوع في علم الطب إلى الأحاديث النبوية والآثار الصحابية، ولا يجوز تعدّيها إلى غيرها، ومثل من يقول: إنه يجب الرجوع في علوم الأدب إلى أئمة الزهادة، وأقطاب أهل الرياضة”(3).
وخلص الوزير إلى تقرير أن ” أئمة الزيدية ليس لهم من التأليف في علم الحديث مايكفي المجتهدين، فما للمعترض والتعرّض لانتقاص المحدّثين، الذين قاموا بما قعد عنه غيرهم في علوم الدّين، وهذا أمر يعرفه من له أدنى تمييز، وإنما أُتي المعترض في انتقاد المحدِّثين، من قلة الإنصاف، ومحبّة الاعتساف، ولله درّ من قال:
أقلّوا عليهم لا أبا لأبيكمُ من اللوم
أو سدّوا المكان الذس سدّوا “(4)
أمّا نظرة الهادوية الزيدية إلى مصادر السنّة كصحيحي البخاري ومسلم، وعدّهما في أ‘لى درجات الصحة والقبول، ووصقهما بأصح مصدرين بعد القرآن الكريم؛ فلم تلفت الهادوية إلى ذلك مطلقاً، حيث لديها مصادرها الخاصة الواردة عن طريق العِترة (أهل البيت)، مهما تكن قليلة أو محدودة، وذلك كشرح التجريد لأحمد بن حسين بن هارون، وأمالي أحمد بن عيسى، أو الجامع لمحمد بن منصور المرادي، ومجموع زيد بن علي، وأمالي أبي طالب المسمّى تيسير المطالب، وأمالي المرشد بالله، والاعتصام للقاسم بن محمد(5)، وذكر محمد بن إبراهيم الوزير أن ممن اشتغل منهم بالحديث كذلك القاضي زيد بن محمد الكلاوي الجيلي، والإمام أحمد بن سليمان، والأمير الحسين، والإمام يحيى بن حمزة(6).
نعم تورد الكتابات الزيدية الهادوية بعض أمهات المصادر السنيّة وغيرها، ضمن ماتورد في بحوثها الفقهية أو العقائدية، إلى جانب مصادرها الخاصة، ولكنها لاتخرج بذلك عن نمط الاستئناس والمقارنة، وتوسيع أفق القارئ والمتعلّم، وأحياناً قد تورد ذلك على سبيل إلزام (الآخر) السنّي ومحاججته، وهو الغالب، ولاسيما في بعض الحقب والمراحل، وفيما يتصل بفضائل قرابة النبي – صلى الله عليه وسلّم- خاصة، لا أنها تورد ذلك على سبيل الاحتجاج والإلزام لذاتها، بما في ذلك ماتعدّه المذاهب السنيّة جميعها مصادر متلقاة بالقبول والاحتجاج والإلزام في جملتها، أعني ما يُعرف بـ(صحيحي البخاري ومسلم).
وها هو مؤسس الهادوية الأول الهادي يحيى بن الحسين الرسّي (ت:298هـ)، لا يكترث بصحيحي أهل السنة، أي البخاري ومسلم، ولا يعدّهما من الصحة في شيء، وحين يرد الاستشهاد منه بأحدهما أو بكليهما فإنما يرد ذلك في معرض المحاجّة للخصم والمجادلة والإلزام، وليس لقناعته بذلك، وإيمانه بصحتهما، وقد أورد الشيخ بدر الدّين الحوثي في كتابه السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية، نقلاً عن الإمام القاسم بن محمد، ما قاله الهادي الرسّي عن صحيحي البخاري ومسلم :” إن بينهما وبين الصحة مراحل ومسافات”(7) ، وهو ما أكّد عليه الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى (ت:840هـ)، وهو مؤلّف أهم مصدر فقهي معتمد لدى الزيدية الهادوية حتى اليوم، أعني كتاب (متن الأزهار) حين روى في كتاب (الغايات)- في سياق ذكر المخالف من أهل السنة وأبرز مصادرهم المعتمدة- عن الهادي قوله:
” ولهم كتابان يسمونهما بالصحيحين [صحيح البخاري وصحيح مسلم])، ولعمري إنهما عن الصحة لخليّان”(8).
ويعقّب على ذلك المهدي بقوله: ” ولعمري إنه -أي الهادي- لايقول ذلك على غير بصيرة، أو كما قال”(9).
بل يذهب المهدي نفسه إلى أبعد من ذلك بكثير إذ يقرِّر أنك: (10)
إذا شئت أن تختر لنفسك مذهباً
ينجيك يوم الحشر من لهب النار
فدع عنك قول الشافعي ومالك
وحنبل والمروي عن كعب أحبار
وخذ من أناس قولهم ورواتهم
روى جدّهم عن جبرائيل عن الباري
وهذا عبد الله بن حمزة يؤكّد على ذلك المعنى بقوله (11):
كم بين قولي عن أبي عن جدّه
وأبو أبي فهو النبي الهادي
وفتىً يقول روى لنا أشياخنا
ما ذلك الإسناد من إسنادي
ثم يقول في سياق حديثه عن الإمامة وإقامة الحجة على العامة ويقصد بهم (أهل السنّة):
“… فانقطع بذلك شغب المخالفين لنا من العامة، على اختلاف أقوالها، واتفاقها على خلافنا في الإمامة، وقامت لنا الحجة عليها بما ذكرناه، إذ قد احتججنا على العامّة من أقوالها وروايتها، التي لو شكت في سواد الليل وبياض النهار لما شكت فيها، وكيف تشك في أمرٍ صححته ونقلته وزيلته وغربلته “(12).
وينقل محمد بن إبراهيم الوزير عن عبد الله بن حمزة ذاته قوله في هذا :” ولم يزل أهل التحصيل يحتجون بأحاديث المخالفين في الاعتقاد بغير مناكرة، وهذه أصح أحاديث المخالفين، بغير مناكرة “” (13).
وتبع عبد الله بن حمزة في الإفصاح عن ذلك أبرز مرجعين معاصرين للزيدية الهادوية وهما مجد الدين المؤيدي (ت: 1428هـ/2007م) وبدر الدّين الحوثي(ت:1431هـ/2010م). وتطفح كتب كليهما بوصف أهل السنّة بـ” العامّة” وهو الوصف الذي سبقهما إليه عبد الله بن حمزة وغيره، في وصف أهل الُسنَّة. ولنبدأ ببعض ما تبناه مجد الدّين المؤيدي في هذا الباب، ثمّ نعود لبدر الدين الحوثي، وذلك على النحو التالي:
أ- مجد الدِّين المؤيدي:
حاول مجد الدّين المؤيدي أن يجد ضالته في القدح في علوم الحديث لدى السنّة من خلال كتاب ” تنقيح الأنظار في معرفة علوم الآثار” للإمام محمد بن إبراهيم الوزير (ت:840هـ)، فحين قال الوزير في مستهل كتابه :” وبعد فهذا مختصر يشمل على مهمات علوم الحديث واصطلاحات أهله” (14)؛ فتعقب المؤيدي ذلك القول للوزير بقوله:” أغلب تلك المصطلحات لا برهان عليه من عقل ولا نقل، وما كان معتمداً فقد بيّن بدليه في علم الأصول، ولكن معرفة الشيء خير من جهله، لمن رسخ قدمه، وثبت فهمه، لا لمن يقلِّد أقوال الرجال، فتميل به من يمين إلى شمال، ويكون من دين الله على أعظم زوال”(15)، فنصه هذا واضح الإنكار على هذا العلم لدى أهل السنّة، حيث زعم أنه يفتقد إلى دليل العقل والنقل معاً، وما تضمنه من فائدة من بعض الجوانب؛ فلا يحتاج إلى ما يسمّيه أهل السنّة بعلوم الحديث، بل يغني عنه علم أصول الفقه، ثمّ شرع المؤيدي في إيراد تقسيم علم الحديث عند هل السنة، ومراتب الصحيح، وعدد أحاديث الصحيحين، بحسب إيراد الوزير لهما معترضاً – أي المؤيدي- على بعضها (16). وحين بلغ الوزير المرتبة السابعة للصحيح وقال عقبها :” والوجه في هذا عند أهل الحديث هو تلقي الأمة للصحيحين بالقبول، ولا شك أنه وجه ترجيح”(17)؛ عقّب المؤيدي بوضع عنوان عريض يردّ فيه على الوزير ” إبطال القول بأن الصحيحين متلقاة بالقبول، والانتقاد عليهما” قائلاً :” قلت: الله أكبر، هذه دعوى مجرّدة عن البيان:
والدّعاوى إن لم تقيموا عليها
بيّنات أبناؤها أدعياء
كيف وقد قام على خلافها البرهان؟ فهي معلومة البطلان، كيف والمنازعة على صحتهما واقعة بين أصحابهم، فكيف بقرناء القرآن، وأماء الرحمن؟ وقد سلف في صدر هذا الكتاب مافيه ذكرى لأولي الألباب.
وقد انتقد البخاري على رجال لمسلم، ومسلم على رجال للبخاري، فهو أقرب نقض لدعوى الإجماع، فكلاهما أول قدح ونزاع(18).
ثمّ يفترض المؤيدي أنّ اعتماد أهل السنة للبخاري ومسلم مصدرين صحيحين يعني –بالضرورة- ردّ ماعداهما، ويبني على ذلك حكماً صرّح فيه بأن القول بذلك:
“من التحكّمات الواضحة، والتعصّبات الفاضحة، التي ليس عليها برهان، ولا أنزل الله تعالى بها من سلطان…وهذا على فرض صحة مازعموه لهما من المبالغة في الاحتياط، والتشدّد في الاشتراط، والواقع بخلافه، كما هو معلوم بشهادة الخصوم، ولكن يأبى الحق إلا أن يكون واضحاً ناطقاً، والباطل بالرغم على أصحابه فاضحاً زاهقاً”(19).
ثمّ نرى المؤيدي يزعم أن مما يعضد دعواه تلك بعض الاستخلاصات من تحقيقات العلامة محمد بن إسماعيل الأمير (ت:1182هـ)، والحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت:303هـ)، وما ذكره غير واحد من علماء الحديث ورجال الجرح والتعديل، حول بعض رجال البخاري ومسلم، مما هو معلوم لكل دارسي الحديث وعلم الرجال، ولا غريب فيه ولا مفاجأة، حين تدرس النصوص في سياقاتها، مع معرفة عمق تلك المسائل وخلفياتها ودلالاتها، إذ لم يخلص الأمير ولا صاحب السنن، إلى مثل نتيجة المؤيدي المشكّكة في جدوى علم الحديث عند السنّة من الأساس، واتهامه بالتناقض، لكنه تشهى من كلامهم ما يحلو له، ووظفه بطريقته، فصال وجال (20)، ليخلص في نهاية تقريره إلى القول:” فهذه نبذة كافية من كلامهم، فبحمد الله قد كفونا بالردّ على أنفسهم، وبتناقض أقوالهم عن النقض، وإنه تالله ليقضى بالعجب، من أن يدّعي مثل هذه الدعوى الباطلة، من له من العلم والدِّين أدنى مسكة، وما هي إلا من الهذيان المجازفة، التي لا تقدير لها بمكيال ولا ميزان، والعمدة في هذا مراقبة الملك الدّيان، ولد تهافت في تقليد هذه الدعوى الفارغة الرّعاع، وتهالك في أثرها الاتباع، فعميت عن إبصار الحق، وصمّت عن سماع التحقيق منهم الأبصار والأسماع.
ونهج سبيلي واضح لمن اهتدى
ولكنها الأهواء عمَّت فأعْمَتِ”(21)
ثم قال:” هذا ولعلم صاحب التنقيح [ يقصد محمد بن إبراهيم الوزير] بما في هذه الدعوى من الاختلال، وأنها ليست إلا من باب الرهاب وقعقة الجدال، الذي لا يتم على أولي الألباب، من فحول الرجال، أوردها كالمتبرِّي عنها، حيث قال: والوجه في هذا عند أهل الحديث. ولو تمّ على هذا لكان قد أجمل، ولكنه عمد إلى التغرير، بإظهار صورة التقرير، فقال: ولا شك أنّه وجه ترجيح…إلخ” (22). وهكذا يمضي في التشكيك والسخرية من علم الحديث ومحتوياته عند اهل السنة (23) ، في مقابل الإعلاء من شأن طريقة الهادوية الزيدية وما يصفه بمسلسل العترة، معرضاً بوجه أخص بالإمامين محمد بن إبراهيم الوزير، ومحمد بن إسماعيل الأمير، ومستشهداً- على سبيل المثال- ببيت شعري للإمام عبد الله بن حمزة(ت:614هـ):
كم بين قولي عن أبي عن جدّه
وأبو أبي فهو النّبي الهادي (24)
وفي هذا السياق يكشف أحد تلامذة مجد الدين المؤيدي ويدعى محمد بن إبراهيم المرتضى (قدّم لكتابه الشيخ المؤيدي بالثناء والإقرار) أنه ناقش أحد المرجعيات الشيعية الإمامية واسمه (آية الله العظمى محمد علي الطباطبائي) فيما تضمنه كتابه (تهذيب الأزهار في فقه الأئمة الأطهار) من معلومات خاطئة عن الزيدية، منها إيراد أن المصادر الزيدية تورد المرويات الحديثية (السنيّة) كالبخاري ومسلم وغيرهما مبيّناً – أي الباحث الزيدي- أن الحقيقة خلاف ذلك، حيث للزيدية مصادرهم الخاصة في الحديث والأسانيد، عن أهل البيت كمسند الإمام زيد، وأمالي أحمد بن عيسى، وأمالي المرشد بالله، وأبي طالب، والأسانيد اليحيوية وغيرها، ثم أعقب ذلك بقوله:
“وما رواية الحديث عن أهل السنّة إلا للاحتجاج عليهم من كتبهم مايؤيد مذهب الزيدية، لا للاعتماد عليها”(25). ثم أورد الباحث ذاته ماروي عن الهادي وقوله عن البخاري ومسلم:” بينهما وبين الصحة مراحل”(26)، ثم ماقاله مجد الدين المؤيدي نقلاً عن الإمام عبد الله بن حمزة بما فحواه أن طريقة النقل تعتمد على ماهو صحيح عند الزيدية، أو كان من رواية الخصوم للاحتجاج عليهم، واعتبار اسم الصحيح عَلَمَاً على البخاري ومسلم بمثابة لقب عُرفي، وذلك من التحكّم الواضح والتعصب الفاضح، حيث لابرهان عليها، وما أنزل الله بها من سلطان (27). ولعلّه يشير بذلك إلى قول عبد الله بن حمزة المتقدِّم.
الهوامش:
- محمد بن إبراهيم المرتضى، الزيدية والإمامية وجهاً لوجه، 1418هـ-1998م، ط الأولى، صعدة: مركز الهدى، 26.
- محمد بن إبراهيم الوزير، الروض الباسم في الذبّ عن سنّة أبي القاسم (تقديم بكر أبو زيد وعناية علي العمران)، د.ت، د.ط، دم: دار عالم الفوائد، ص 175.
- محمد بن إبراهيم الوزير، الروض الباسم ، المصدر السابق، ص 175-177.
- حمد بن إبراهيم الوزير، الروض الباسم، المصدر نفسه ،ص 178.
- بدر الدين الحوثي، الزيدية في اليمن، د.ت، (طباعة استنسل) ، د.م: دار الزهراء، ص 11.
- محمد بن إبراهيم الوزير، الروض الباسم، مصدر سابق، ص 178.
- بدر الدين الحوثي، السلسلة الذهبية في الرد على الوهابية (رسالة كشف التغرير)، 1437ه/2016م، ط الأولى، د.ت، د.ن: د.م، ، ص 145.
- صالح بن مهدي المقبلي، المنار في المختار من جواهر البحر الزخّار، 1408هـ-1988م، ط الأولى، بيروت: مؤسسة الرسالة، جـ1، ص 352.
- المقبلي، المنار في المختار، المصدر السابق، جـ1، ص 352.
- الأكوع، الزيدية (طبعة دار الفكر المعاصر) ، مرجع سابق، ص 28-29.
- حميدان القاسمي، مجموع حميدان القاسمي (تنبيه الغافلين على مغالط المتوهمين) ،د.ت، د.ط، د.م، د.ن، جـ2، ص170.
- عبد الله بن حمزة، المجموع المنصوري، العقد الثمين في تبيين أحكام الأئمة الهادين (تحقيق: عبد السلام الوجيه) ، (أمير المؤمنين وولديه) ، 1421هـ- 2001م، ط الأولى، صنعاء: مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية، جـ1، ص 43-44.
- انظر: محمد بن إبراهيم الوزير، تنقيح الأنظار في معرفة علوم الآثار (تحقيق: محمد صبحي حلّاق وعامر حسين)، 1420هـ/1999م، ط الأولى، بيروت: دار ابن حزم، ص45 (نقلاً عن نقله الوزير عن عبد الله ابن حمزة في كتاب المهذب).
- محمد بن إبراهيم الوزير،تنقيح الأنظار في معرفة علوم الآثار ، المصدر السابق، ص 25.
- مجد الدِّين المؤيدي، لوامع الأنوار في جوامع العلوم والآثار وتراجم أولي العلم والأنظار، 1440هـ/2019م، ط الرابعة: صعدة : مكتبة أهل البيت جـ2،ص 129-130.
- راجع: مجد الدين المؤيدي، لوامع الأنوار ، المرجع السابق، جـ ـ2، ص 130-136.
- راجع: مجد الدين المؤيدي، لوامع الأنوار ، المرجع نفسه، جـ ـ2، ص 136.
- المؤيدي، لوامع الأنوار ، نفسه، جـ ـ2، ص 136،
- المؤيدي، لوامع الأنوار ، نفسه، جـ ـ2، ص 423.
- المؤيدي، لوامع الانوار، نفسه، جـ2، ص 136-141.
- المؤيدي، لوامع الانوار، نفسه، جـ2، ص 141-142.
- المؤيدي، لوامع الانوار، نفسه، جـ2، ص 142.
- المؤيدي، لوامع الانوار، نفسه، ، جـ2، ص 141-142.
- راجع: المؤيدي، نفسه، جـ2، ص 142-158.
- انظر: محمد بن إبراهيم المرتضى، الزيدية والإمامية وجهاً لوجه، مرجع سابق، ص 151-155.
- محمد بن إبراهيم المرتضى، الزيدية والإمامية وجهاً لوجه، المرجع السابق، ص 30.
- محمد بن إبراهيم المرتضى، الزيدية والإمامية وجهاً لوجه، المرجع نفسه، ص 30.
*نقلاً عن موقع حكمة يمنية