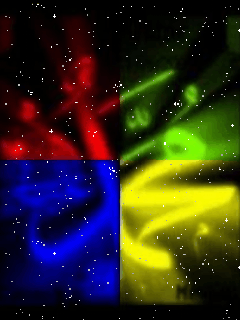في الواجهة الأخرى من الأخلاق
مهما طال بنا الحديثُ عن الأخلاق، فلن نكفَّ عن التطرق إلى هذا الموضوع بالذات في كلِّ مناسبة تُتاحُ لنا؛ نظرًا لحساسيتِه وأهميته، ودوره في توازن قُوَى الشرِّ والخير، ففي تعاطينا اليومي مع الناس والأهل والأصدقاء نواجه مشاكل مُعقَّدة، يَحتارُ أمامها العقلُ في الفهم وتَقبُّل محتواها، ومن ثَمَّ تطبيق ما نصَّت عليه من مضامينَ قد تبدو للوَهْلةِ الأولى سهلةً للغاية، لكن يَخفَى على كثير من مرضى القلوب أنهم يشكلون حجر عثرة في التقدُّم والتطور والاحتكام إلى نموذجِ الأخلاق الفاضلة عند أي اختلاف أو سوء فهم مع الغير؛ لأن مرجعيَّتنا في التصحيح موجودةٌ، وليست تَقتصِرُ على نهيٍّ عن منكرٍ، أو أمر بالمعروف باللسان وفقط؛ وإنما يمتد الأمرُ إلى ضرورة استسلام مرضى القلوب لحقيقة واقعهم الصحي أولاً، ومن ثَمَّ لحقيقةِ تلوُّنِ مِزاجهم أمام الناس في معاملاتهم، وليس يَكتشِفُ هذا الاضطرابَ فيهم إلا مَن عايشَهم عن قرب، وتلقَّى صَدَمات منهم.
إذًا معظمُهم يُتقِنون فنَّ الكلام، ويختارون الكلماتِ السَّلِسةَ والمُهذَّبةَ لإقناع الناس، إن هذا هو مستواهم في التعامل، ويزعمون أنهم نموذجٌ في الفضل والتربية الحسنة، فيُثنون على ماضيهم بلغةِ المبالغة؛ ليُؤكدوا أن زمرتَهم غيرُ موجود منها شبهٌ، وأنهم مُفضَّلون في تقبُّل الناس لشخصيَّاتهم، وبالتالي الإقبال المتزايد على التواصل معهم، وهم في حقيقة الأمر تَجِدُهم يَظلِمون ولا يشعرون، أو يشعرون بذلك ويتجاهلون، وتجدُهم يَفرُّون بسياسية التقدُّم للأمام دائمًا؛ بدافع من إعجاب بالنفس، وإعجاب بثناء الناس عليهم عن غلط، في حين أن هؤلاء المعجَبين يجهلون تمامًا حقيقةَ معاناتهم في البيت وحدهم؛ لأنهم في طبعهم الحقيقي هم منعزلون، ومتكبرون في تقبُّل المستوى المعيشي للغير، فلا يأكلون إلا أكلهم الذي جهزوه بأيديهم، ولا يدخلون منازلَ إلا إذا كانت ثريَّةً، وأصحابها من ذوي امتيازات الغِنى، إنه التكبُّر الذي يُغلَّفُ بابتسامة كاذبةٍ؛ لتُبيِّن أن التواضع من شِيَمِهم، وكلُّ هذا السلوك لقضاء حاجة أو مصلحةٍ، ولم يكن في سبيل الله حقًّا؛ ليتخلَّله الصبرُ والتناسي حالَ الأخطاء.
حقيقةً أحبُّ هذه الفئة من الناس، وأحبُّ اللقيا بهم؛ لأني سأشرح لهم نقطة البدء والنهاية في مكارم الأخلاق، هذه الفئة بحاجة لمن يَصفَعُها بالتذكير بالكلام الحقيقي والمتخلق، ويبين لهم أن نجاحهم في أي مجال هو مزيَّفٌ، ويُغلِّفُ حقيقة ضعفِهم، وأن جُبْنَهم هو مَن يرسم حقيقةَ شخصياتهم، ففي هذا المقام لستُ أذكر هذا أو ذاك، ولست أغتابُ أحدًا بقدر ما هو لازمٌ توضيحُ جانبٍ من أخلاقهم الرديئة، التي أثَّرتْ على كثير من المنخدعين بهم؛ إذ إن صفعَ هذه الفئة لا بد أن يتمَّ بإحدى الطريقتين:
إما النصح بالعودة إلى الله وتجديد الإيمان في القلب؛ ليحيا حقيقةً وبروح التواضع، والصدق، والنية الصافية، وإما بزيارة مختصٍّ نفساني؛ يُشخِّصُ العلةَ، ويُقدِّمُ النصيحةَ حيث تكون مسموعةً منه أكثر من أي شخص آخر؛ لأنها اختصاصُه، وليس يَكذِبُ في تشخيصه بقدر ما يقدم الحقيقة كما هي.
ثم هذه الفئة من الناس تربَّت على أن تبدوَ هي الأفضل ولو أخطأت فبإمكانها ألا تعتذِرَ؛ لأنها أخذت موضوع التنازع من باب أنه دفاعٌ عن النفس، أو تصويب وتصحيح لسلوك، في حين أن ردة الفعل هكذا تكون في شكل ظلمٍ وتجريحٍ وتعنُّتٍ، وهو يدخلُ في خانة الأخلاق الضائعة، فلا يَعرِفُ الحقَّ من الباطل، ولا يَفهَمُ العدلَ من الزيف وتضييع الحقوق، ويُشتِّتُ الفكر في تخمينه لإيجاد الحلِّ الأنسب لمثل هذه التجاوزات، فيصبحُ الكلام كمن يعملُ باستمرار لاستخراج زبدة من ماء وليس من حليب، أو كمَن يزرعُ قمحًا ويَنتظِرُ أن تنمُوَ له أشجارُ التفَّاح؛ فهذا نوعٌ من التغليط والطَّمع، والمبالغة في التمني، واستلطاف التحصيل السريع حتى لو كان عن خطأ، فإن لم يَستفِقْ هؤلاء من سُباتِهم ومن مرضِهم النفسيِّ فسيُصبحون خطرًا على المجتمع بتمويهِهم للناس، وبجُبنِهم السَّاذجِ، فيُصبحُ الحلُّ الأمثل هو صفعَهم بالكلام المُهذَّب، الذي يحمل في طيَّاته معانيَ كثيرة بضرورة التواضع على شكل تهديد، أكيد أن عذاب الله قريب من أي جاحدٍ!
فيا مَن تَغرُّك نفسُك، وتَظنُّ بها خيرًا وأنت في مهلكة ولستَ تدري، تَوقَّفْ مع نفسك، وجادلها جدالَ حقٍّ، وصَحِّحْ مسيرتَك، وكُفَّ أذاك عن الناس، وعمَّن استأمنوك، وإن لم تتدارك الأمر فستجد أبوابَ الخير والنجاح مقفلةً في وجهك؛ لدعاء أحد المنخدعين بمظاهرك وهو لا يدري؛ فتصبح في ملامٍ وتأسُّفٍ بعد محاولات كثيرة لتذكيرك عن العدول عن هذه التجاوزات.
فإن لم تنفعِ الموعظةُ في رَدْعِ أمثالِ هؤلاء، فحتمًا قدرةُ الله كفيلةٌ بإعطائهم دروسًا ليس يُعطيها أحدٌ من البشر، فيستفيقون على خسارة مالٍ، أو صحةٍ، أو مشروع، وساعتها فقط يتذكرون أن شخصًا ما وفي زاوية ما من زاويا بيتٍ أو مسجدٍ أو على ترابِ أيِّ أرضٍ سقطت فيها دمعة أسًى قد رفع فيها دعاءً، وفي لحظةِ استجابةٍ لُبِّي النداءُ؛ فكانت الموعظة بليغة جدًّا.
فهلا راجعنا أنفسَنا، وتوقفنا عن السخرية بمن استأمنونا على أنفسهم وأموالهم وأسرارهم، فكما تَدينُ تُدانُ، ودولة الحق إلى قيام الساعة؛ فلا تحتقرنَّ مستضعفًا مهما كان سنه؛ لأن الأيامَ كفيلةٌ بردِّ الحقوق لأهلها وهم في راحة تامة للضمير المُعذَّب.