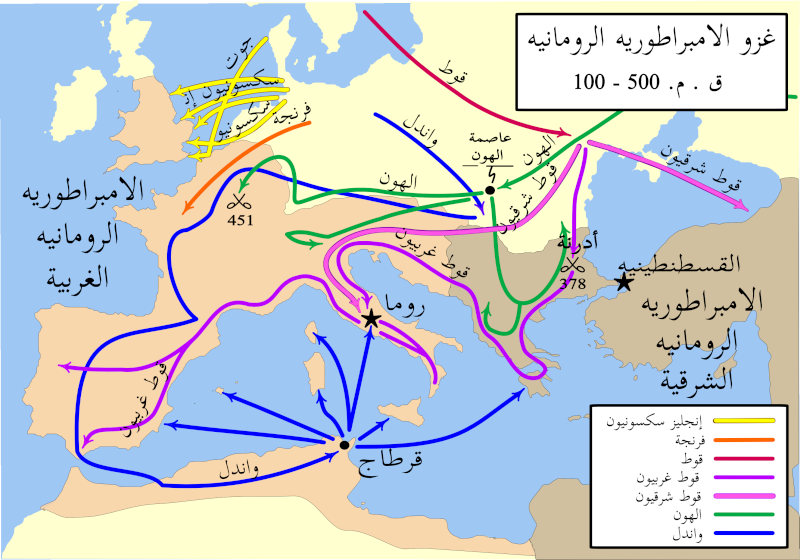العِبر من التاريخ الاستعماري في ليبيريا لقضايانا المعاصرة
* ملخص
تقدم لنا قراءة تاريخ الاستعمار في جمهورية ليبيريا الواقعة في غرب إفريقيا عبراً مهمة لمجموعة من قضايانا المعاصرة وهي:
1- تغير الممارسات الاستعمارية لا ينفي جوهر الاستغلال: ذلك أن شعار الحرية قد يكون غطاء لممارسات استعمارية بشعة تنتقل من شكل اضطهاد قديم إلى شكل جديد تحت ذرائع انسانية تصور عملية الانتقال من الاسترقاق إلى الاستعمار بأنه تطور أخلاقي مشهود.
2- زيف الذرائع الاستعمارية ولو كانت تحت اسم "العودة إلى أرض الآباء": فمهما كانت الصلة التاريخية للمستعمِرين بالأرضالتي يغزونها باسم "العودة" إليها، فإن الراية الاستعمارية التي ينضوون تحتها تخرجهم من كونهم مجرد "عائدين" وتجعلهم كأي صنف من الغزاة المحتلين، وتحوّل الضحية إلى جلاد مجرم، وتخلق من المشاكل الدموية مع السكان الأصليين الذين استمر وجودهم منذ الأزل على هذه الأرض ما يبرر لهم مقاومة هؤلاء الغزاة مقاومة ستوقع في النهاية من الخسائر ما يمحو أثر النتائج السعيدة التي تذرع الاستعمار بها ابتداء لتبرير مشروع "العودة".
3- الاستعمار لا يفيد إلا نفسه مستخدماً عملاءه ليمتص دماء ضحاياه: ذلك أن "التقدم" الذي تقدمه "التنمية" الاستعمارية يؤدي إلى خدمة أهداف المستعمِرين الذين قاموا بإنشاء البنية التحتية في المستعمرات، دون تحقيق أهداف الأهالي الأصليين، وقد يحول الاستعمار بلداً شديد الغنى بثروات ضخمة إلى أفقر بلد في العالم مع التبجح "بإنجازات" كبرى ولكن يعوزها الصلة بحياة الأهالي البائسين، مستخدماً في ذلك الاستغلال طبقة من المستفيدين من هذه العملية التي تقطع طريق التطور الذاتي في حياة الشعوب.
* مشروع "عودة" إلى إفريقيا لحل مشكلة العبيد المحررين يسبق مشروع "العودة" إلى فلسطين لحل المشكلة اليهودية في أوروبا
من القضايا التي واجهتها الثورة الأمريكية التي طرحت فكرة التحرر من الاستبداد، قضية الرق ومساوئه التي فرضت نفسها على الآباء المؤسسين ومنهم توماس جيفرسون الذي كتب مسودة إعلان الاستقلال وألصق فيها تهمة التجارة بالبشر بالملك البريطاني وحده، مع أنه برر استعمال الرقيق بكونه من متطلبات البقاء لسكان أمريكا وهو ما يتقدم على مبادئ العدالة، وكان جيفرسون يعتقد أن مآل العبودية إلى الزوال ولكن ذلك لن يؤدي إلى السلام وسيظل العنف الناتج عن تبعات الاسترقاق على السادة والعبيد والفروق الطبيعية في رأيه بين البيض والسود يلقي بظلاله على المجتمع الأمريكي، وحل هذه المشكلة التي تتعلق بفائض سكاني فقد وظيفته في هذا المجتمع وأصبح عبئاً عليه، يتمثل في رأيه في الفصل بين الشعبين و"عودة" هذا العنصر البشري الفائض إلى موطنه الأصلي بمساعدة سادته السابقين واستعماره في بلد خاص يصبح ملكاً له ويضمن فيه سلامة العبيد وسعادتهم ويمنحهم الحماية والرعاية ويمكن لأولئك السادة السابقين أن ينشئوا تحالفاً مع هذا الكيان الجديد، وكما كان صاحب فكرة هذا المشروع ضد اضطهاد العبيد في أمريكا فقد كان ضد العبيد أنفسهم وساقه حرصه على الهوية إلى اقتراح ترحيلهم مرة أخرى إلى إفريقيا بعدما تم ترحيلهم من إفريقيا أول مرة، وكذلك كان الوزير البريطاني آرثر جيمس بلفور صاحب الوعد المشئوم معادياً لوجود اليهود في بريطانيا فسن أثناء رئاسته للوزراء (1902- 1905) قانون الغرباء الذي يقيد هجرتهم إليها في نفس الوقت الذي كان فيه متعاطفاً مع فكرة ترحيلهم إلى فلسطين ومنسجماً مع الأحلام الصهيونية إلى حد التبني كما هي صفة معظم الصهاينة غير اليهود الذين يكرهون اليهود ولهذا يتعاطفون مع الهدف الصهيوني وهو التخلص منهم في أوروبا وترحيلهم إلى فلسطين.
ويلاحظ تشابه المسألة الإفريقية في أمريكا مع المسألة اليهودية في أوروبا، ففي الحالتين كان هناك فائض سكاني فقد عمله وأصبح عبئاً على مجتمع يرفض استيعابه، فكان الحل هو تصدير المشكلة إلى الخارج تحت ستار "العودة" بإنشاء كيان استعماري استيطاني يرعاه السادة السابقون، لهذا العنصر المرفوض ويتحالفون مع كيانه الجديد الذي سيصبح أداة في يد المصالح الجديدة لأولئك السادة في مكانه الجديد، وكما كان أعداء اليهود هم أنصار الحل الصهيوني الذي طالب بترحيل اليهود من أوروبا إلى فلسطين، فكذلك كان أنصار ترحيل العبيد المحررين هم أنفسهم أعداء بقائهم في أمريكا وكارهي عنصرهم الإفريقي، وكما ظلت الأفكار الصهيونية في عالم الأماني زمناً طويلاً فقد ظلت فكرة ترحيل العبيد السابقين حبيسة الفكر الجيفرسوني منذ نهاية الثورة الأمريكية لمدة أربعين عاماً بعد ذلك وظل يدافع عنها إلى يوم وفاته في ذكرى إعلان الاستقلال سنة 1826، وكان سابقاً زمنه في اختراع هذا الحل على غرار السابقين في اختراع الحل الصهيوني.وقد نتج عن هذا الحل الترحيلي في إفريقيا والذي أدى إلى قيام دولة ليبيريا من المشاكل بل الكوارث الدموية بين السكان الأصليين والوافدين الجدد ما يوازي النكبات التي حلت بالشعب الفلسطيني نتيجة الحل الصهيوني، رغم كون "العائدين" في الحالة الإفريقية ممن لا شك في أصولهم الإفريقية وهو ما يؤكد أن صلات النسب البعيد بالأرض ليست هي معيار الحقوق وأن عودة أي منفي بعد زمن طويل تحت راية أجنبية هدفها الطرد والإبادة والاستيطان سيواجهها أصحاب البلاد بنفس المقاومة التي يواجهون بها أي أجنبي محتل، خلافاً للترحيب باللاجئ طالب الأمان الذي يطلب المساعدة حتى لو كان غريباً، وأن اتخاذ الاستعمار أدوات تحت ذريعة العودة يختلف جذرياً عن العودة نفسها لأن العائد الحقيقي يحترم أصحاب الدار الذين ثبتوا في الأرض في الوقت الذي كان هو قد غادر فيه، وحتى لو كان مجرد لاجئ أجنبي وليس عائداً فإن الأبواب تكون أكثر تفتحاً له من محاولة اقتحامها قسراً بالقوة، وقد استقبلت بلادنا كثيراً من اللاجئين من الشرق والغرب (الأرمن والشركس والشيشان والبشناق) واستوعبتهم في نسيجها إلا أن الموجة الصهيونية لم تكن محاولة لجوء وإيجاد مأوى بل غزو استعماري استيطاني يستهدف الإبادة والإحلال لأجل قيام كيان مرتبط بالخارج الغربي ومن هنا كان رفض السكان الأصليين له ولم يكن رفضهم إفساح مجال لمجموعة هاربين من الاضطهاد كما يصور الصهاينة أنفسهم، وكذلك كانت ليبيريا كياناً مرتبطاً بالراية الأمريكية استبعد السكان الأصليين واضطهدهم ولذلك رفضوه وحاربوه بغض النظر عن أصول المستعمِرين الإفريقية، والخلاصة أن حجة العودة مرفوضة عندما يستخدمها كيان استعماري يعمل على استبعاد الأهالي، سواء كانت الأصول صحيحة كالحالة الإفريقية أو مشبوهة كالحالة الصهيونية أم مختلقة كالجذور الأوروبية التي حاول جيفرسون اختراعها في أمريكا الشمالية، وهذا الحل يؤدي دائماً إلى مشاكل متتالية بحجة إيجاد مأوى مع أن المأوى لا يتطلب الطرد والإبادة.
* نشأة ليبيريا وتاريخها
عندما بدأ الرق بالاضمحلال، ارتفعت الأصوات في الغرب الأوروبي الأمريكي لإعادة الرقيق المحررين إلى موطن أسلافهم في إفريقيا لعدة دوافع متباينة، فبينما أراد البعض التخلص من العنصر الملون لأنهم لا يريدون التعايش معه، رأى البعض الآخر أن وجود عبيد تم تحريرهم على مقربة ممن ظلوا في أغلال الرق يؤلف خطراً على الاستقرار، كما رأى غيرهم أن العبيد السابقين سيكونون أكثر حرية وازدهاراً في موطن آبائهم، وأن إبعاد الأفارقة عن أمريكا سيجعل عتقهم مقبولاً، وهو اعتراف بعنصرية المجتمع الأمريكي آنذاك والذي لا يقبل ملوناً حراً بين جنباته، ولم يغب دافع التنافس الاستعماري عن هذا المشهد فقد رأت السياسة إمكان استخدام هذا العنصر المنبوذ في حماية المصالح السياسية الغربية في منطقة غرب إفريقيا وبهذا يتم تحقيق هدفين بحركة واحدة هما التخلص من هذا العنصر واستخدامه في نفس الوقت بعيداً، وهذا ما حصل في المشروع الصهيوني في فلسطين تماماً، إذ تخلصت أوروبا من اليهود واستخدمتهم في نفس الوقت لحماية مصالحها بصفتهم "طليعة الحضارة" في الشرق البربري المعادي.
لقد كان القضاء على العبودية وتجارة الرقيق هو ذريعة الاستعمار الأوروبي للتكالب على إفريقيا، ويمكننا أن نضع إنشاء ليبيريا وسيراليون ضمن هذا البند، فبحجة تحرير الرقيق أقيم هذان الكيانان الاستعماريان لاستيعاب العبيد المحررين، وفي موضوعنا عن ليبيريا نتج عن شعارات الحرية هذه استعمار قامت به الأقلية الأمريكية واضطهدت به السكان الأصليين في ليبيريا، وإن الممارسات البشعة التي قام بها الاستعمار الأوروبي عموماً في إفريقيا بدعوى محاربة الرق تؤكد أن تطور أشكال الاستغلال لا تعني أي تطور أخلاقي عند المستغِلين.
تقول المراجع إنه في أواخر القرن الثامن عشر، ومع نمو حركة المطالبة بتحرير العبيد، ظهرت في الولايات المتحدة فكرة عودة الأفارقة إلى بلاد أجدادهم التي انتزعوا منها قسراً، لاسيما إفريقيا الغربية، وبذلك يصبح العبيد المحررون أسياد مصيرهم، وقد قامت أمريكا باستخدام هذه الفكرة لوقف محاولات التغلغل البريطانية والفرنسية في تلك البلاد التي كانت حتى ذلك الوقت غير منظمة في إطار حقوقي ومؤسسي.
وقد تأسست جمعية الاستعمار الأمريكية سنة 1816 برئاسة باشرود واشنطن شقيق الرئيس جورج واشنطن لتشجيع عودة العبيد المحررين إلى إفريقيا، وتم اختيار مرفأ لإنزالهم أصبح فيما بعد العاصمة مونروفيا نسبة إلى الرئيس الأمريكي المؤيد للفكرة جيمس مونرو، وصار من مهمة الجمعية الحصول على موافقة السكان الأصليين لإعطاء أراض لأنسبائهم الوافدين، وأصبحت الجزيرة التي نزل أوائل "العائدين" عليها هي مكان ولادة ليبيريا، أي أرض الحرية، وأطلق على تلك الجزيرة اسم جزيرة العناية الإلهية وأصبحت مزاراً رسمياً منذ سنة 1963.
فشلت في البداية مهمة المبعوثين الأمريكيين الرسميين إلى جانب مبعوثي جمعية الاستعمار في تأسيس مستوطنات إلا بعد الاتفاق مع الزعماء المحليين على منح أرض للمشروع، ومع تزايد الوافدين الجدد واجهوا من صعوبات التأقلم كالمناخ وعداوة السكان الأصليين الذين أدركوا فيما بعد حقيقة هذا المشروع الذي سيقوم بإخضاعهم سياسياً واقتصادياً فقاوموه وتمكن "العائدون" من فرض وجودهم بالقوة بمساعدة المدافع النارية التي تسلحوا بها ضد السكان الأكثر عدداً منهم "وقد ألقت الانتفاضات التي تعاقبت، والقمع الذي كانت تواجه به بثقلها على تاريخ ليبيريا الحديث" كما تقول موسوعة السياسة، وبسبب الاستيلاء على أراضي السكان الأصليين، لم تتحدد حدود ليبيريا إلا بنشوب المشاكل معهم.
في البداية حكم الأمريكيون البيض ليبيريا التي كانت محصورة في مدينة مونروفيا، ويعد جيهودي آشمون هو المؤسس الحقيقي للمستعمرة التي حكمها فيما بعد توماس بوكانان شقيق الرئيس الأمريكي الخامس عشر جيمس بوكانان، ونشأت فيها عدة مستوطنات على التتابع حمل بعضها أسماء أمريكية واضحة مثل ماريلاند وجرينفيل، وظلت تتحرر ببطء من السيطرة الأمريكية المباشرة، إلى أن أعلنت جمعية الاستعمار الأمريكية التي أشرفت على إنشاء ليبيريا أن على المستعمرة ألا تظل معتمدة على الجمعية، فأعلن الحاكم الأمريكي استقلالها وحصل الليبيريون على موافقة السلطات الأمريكية وتشجيعها لتحويل البلد إلى دولة حرة ومستقلة سنة 1847، وأصبحت جمهورية مستقلة وتم انتخاب أول رئيس من الوافدين بعد 25 عاماً من حكم البيض، واتخذت الدولة الجديدة علماً كعلم الولايات المتحدة ودستوراً شديد الشبه بالدستور الأمريكي، بالإضافة إلى رموز وشعارات ذات معنى للقادمين من أمريكا، وقد استمر تدخل جمعية الاستعمار في السياسة الليبيرية بعد الاستقلال، ولم يكن عدد الوافدين آنذاك (أقل من 3 آلاف) بكاف لاستمرارية المشروع الاستيطاني، وحاول الرئيس الليبيري الجديد الحصول على اعتراف دولي، فسافر إلى الولايات المتحدة في السنة التالية لانتخابه (1848) ولكن الأمريكيين في ذلك الوقت لم يقبلوا بوجود مبعوث دبلوماسي غير أبيض ولم يعترفوا بالدولة الجديدة إلا في سنة 1862 بعد اندلاع الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، وحاولت كل من بريطانيا وفرنسا انتهاز الفرصة بالاعتراف بليبيريا بعد العزوف الأمريكي وأرسلتا بواخر حربية إلى سواحلها في محاولة لربطها بهما عسكرياً و"مساعدتها على حماية نفسها" وفقاً لموسوعة السياسة، ولا ننسى أن مناطق النفوذ البريطاني والفرنسي كانت محاذية لليبيريا.
وكان السكان الأصليون في عمق البلاد يجهلون وصول الوافدين الجدد، وعندما قامت الدولة لم تكن إجراءاتها تعنيهم بشيء، وفي الفترة الواقعة بين تأسيس المستعمرة ونهاية الحرب الأهلية الأمريكية هاجر معظم الوافدين إلى ليبيريا، وكانت أهم المشاكل التي واجهت رؤساء ليبيريا الأوائل مشكلة التوتر بين الوافدين من أمريكا والسكان الأصليين، والمشاكل مع القبائل المحلية في عمق البلاد حيث كانت الدولة تحاول مد سيطرتها، وقد اندلعت حالات عصيان عديدة استمرت إلى سنة 1930، وظل السكان الأصليون مستبعدين من المواطنة الليبيرية إلى سنة 1904 حين بدأ الرئيس آرثر باركلي سياسة التعاون مع القبائل الأصلية، كما ألقت مشكلة الحدود مع الدول المجاورة التي تسيطر عليها بريطانيا وفرنسا بظلالها على أحوال ليبيريا وظلت مستمرة إلى ما بعد الحرب الكبرى الثانية، وكانت سلطة الدولة محصورة لمدة طويلة في المنطقة الساحلية التي تمتد عشرين ميلاً فقط إلى الداخل وظل الانقسام الاقتصادي بين الساحل والريف الداخلي شديداً.
لم يكن الاستعمار الاستيطاني براقاً لأفارقة الولايات المتحدة الذين أصروا على هويتهم الأمريكية وكانوا ضد فكرة "العودة إلى أرض الآباء"، ورأوا أن هذه "العودة" ترسخ فكرة الرق وتدعمها، وذلك كما عارض كثير من اليهود نشأة الصهيونية المنادية "بعودة" اليهود إلى فلسطين وعدوها مثيرة لمعاداة اليهود واستقرارهم في المجتمعات التي يعيشون فيها، ورغم الاهتمام الذي حظيت به فكرة الاستعمار الاستيطاني فقد تخلى عنها كثير من أنصار إلغاء الرق لما فيها من عدوانية ضد الملونين (في إفريقيا أم في أمريكا؟) وقال بعضهم إن جمعية الاستعمار بديل خبيث للعبودية، وإلى سنة 1865 كان عدد المستوطنين في ليبيريا خمسة آلاف فقط، ومن ضمن الأربعة ملايين عبد تم تحريرهم في الحرب الأهلية الأمريكية، لم يهاجر إلى ليبيريا سوى عدد قليل رجع بعضهم إلى أمريكا فيما بعد، وكان الذي جدد الاهتمام بفكرة الهجرة هو سوء الأحوال التي عاشها العبيد المحررون بعد الحرب الأهلية، وكانت عنصرية الشمال تجبرهم على البقاء في الجنوب ومنهم من فضلوا أن يقطنوا في الغرب للحفاظ على حريتهم رغم سوء الأحوال هناك، ومنهم من فضل العودة إلى الجنوب، وقد انقسموا في ذلك الزمن بين المطالبة بولاية زنجية خاصة في نبراسكا أو كانساس ومعارضة ذلك، وقد حظيت فكرة الولاية باهتمام واسع بين العبيد المحررين الذين استلهموا مثال خروج بني إسرائيل من مصر هرباً من اضطهاد فرعون، كما كانت نفس الفكرة السياسية عند السكان الهنود في نفس الفترة، ولكن عارضها قادة مشهورون من السود كفريدريك دوغلاس لأنها ستلغي حقوقهم خارج الولاية المقترحة، وهي معارضة شبيهة بالمعارضة اليهودية ضد الصهيونية، واستلهم بعضهم فكرة إعلان الاستقلال الأمريكي وطالبوا بالانضمام إلى مقاييس البيض لأنفسهم وهي كلها مطالب لم تتحقق إلى اليوم سواء لذوي الأصول الإفريقية أم للسكان الأصليين في أمريكا.
وعلى الجانب الآخر ايد قادة قوميون من ذوي الأصول الإفريقية في امريكا حل الهجرة والفصل بين الأجناس مثل المصلح مارتن ديلاني (1812- 1885) الذي أيد الهجرة إلى ليبيريا لتحل مشكلة التمييز العنصري وعقد مؤتمراً في أمريكا في سنوات 1854 و1856 و1858 لهذه الغاية كما عقد معاهدات مع زعماء أفارقة في حوض النيجر لإغراء ذوي الأصول الإفريقية في أمريكا بالهجرة والاستقرار في إفريقيا، ومثل المصلح القومي ماركوس جارفي (1887- 1940) والذي كان معجباً بقوة وتنظيم الأمم الغربية ولكنه قال إنها تركت الجماهير العالمية مستاءة وساخطة، وفي سبيل تنمية حضارة جديدة تزاوج بين التقدم العلمي وإشاعة الحرية لا بد من إيجاد أمم سوداء مستقلة وهذا لا يتم إلا باستعمار إفريقيا دون التخلي عن الكفاح داخل أمريكا من أجل العدالة ولكن دون اللهاث للحصول على قبول البيض كما تفعل البورجوازية السوداء، وقد ووجهت جهوده التي أثمرت أكبر جمعية للأمريكيين الأفارقة في التاريخ الأمريكي (جمعية تقدم الزنوج العالمية) بمعارضة امتدادها إلى إفريقيا من جانب أوروبا وقادة في إفريقيا.
الفرق بين المشروعين الاستيطانيين في ليبيريا وفلسطين أن الأول لم يحظ بالتأييد الحكومي الواسع رغم الاهتمام الذي أثارته الفكرة، فقد دفعت الحكومة لجمعية الاستعمار الأمريكية 100 ألف دولار عند تأسيسها بالإضافة إلى تبرعات فردية، وهي مبالغ لم تكن كافية لدعم مشروع ضخم كهذا وذلك رغم التأييد الذي حصلت عليه فكرة الاستعمار الاستيطاني عند شخصيات سياسية بارزة كالرئيسين جيمس ماديسون وجيمس مونرو والسياسي البارز هنري كلاي، وقد أعاد الاضطهاد الأبيض بعد الحرب الأهلية الأمريكية الاهتمام بفكرة "العودة" التي ظلت متداولة إلى عشرينيات القرن العشرين.
ولا يغيب عن الأذهان في هذه المناسبة أن فكرة ترحيل العبيد المحررين إلى ليبيريا تزامنت مع فكرة ترحيل الهنود الحمر من شرق الولايات المتحدة إلى الغرب، وكان ذلك في عشرينيات وثلاثينيات القرن التاسع عشر أيضاً، مما يدل على اتجاه تصدير المشاكل في الحضارة الغربية على حساب الآخرين، وهو ما مارسه الغربيون بتوسع في القرن التاسع عشر بهجرة عشرات الملايين من فائضهم السكاني إلى الخارج، كما تدل فكرة الترحيل على الجوهر العنصري الذي تتسم به هذه الحضارة التي لا تتحمل المخالفة والاختلاف ولا تقبل باستيعاب الآخرين في جنتها، ولكن ترحيل السكان الأصليين كان أكثر إلحاحاً في ذلك الزمن بسبب الطمع الشديد بالاستيلاء على أراضيهم في الوقت الذي لم يكن للعبيد المحررين ثروات يُطمع بها لو رحلوا، ومن هنا كانت الولايات المتحدة على استعداد للإنفاق على ترحيل قبيلة هندية واحدة خمسة ملايين دولار، وهو أكثر مما رصدته لترحيل جميع القبائل، وأكثر بالطبع مما أنفق على مشروع ليبيريا في نفس الوقت.
وقد ألف الوافدون من أمريكا إلى ليبيريا في سنة 1869 حزباً سياسياً اسمه حزب المحافظين الحقيقي The True Whig Party الذي كان يمثل السود في مواجهة المهجنين من الوافدين، ولم يكن يثق بأوروبا ولكنه انتهج سياسة اقتصادية ابتدأت بالاقتراض من بريطانيا (1871 و1907) كما تنازل لمستعمرات بريطانيا وفرنسا عن أراض ضخمة، وكانت معظم التجارة الليبيرية مع أوروبا لاسيما بريطانيا وألمانيا وهولندا، ثم تحولت ليبيريا إلى النفوذ الاقتصادي الأمريكي بداية من سنة 1926 بالاقتراض من الولايات المتحدة في الوقت الذي كانت الامتيازات الضخمة تمنح لشركاتها خلافاً لبقية الدول الإفريقية بعد استقلالها، إلى أن وضعت البلاد تحت الرقابة المالية الأمريكية، وتمكن هذا الحزب من احتكار السلطة بين 1870- 1980 دون انقطاع، وقد انحازت ليبيريا في الحربين الكبريين إلى جانب الحلفاء بعدما قررت في المرتين التزام الحياد، ومن مظاهر التغلغل الأمريكي الدور الهام الذي قامت به الجمعيات الماسونية التي دخلت مع الأمريكيين الليبيريين من الولايات المتحدة، وكان من لوازم منصب الرئاسة الليبيرية كون الرئيس ماسونياً بدرجة عليا.
كانت القومية الليبيرية مقصورة على سلالة الليبيريين الأمريكيين التي تخشى من قبائل المناطق الداخلية من السكان الأصليين أكثر من خشيتها من التهديدات الخارجية، وكانت هذه القومية مبنية على أساطير الاستيطان التي تستبعد الأهالي الأصليين كما استبعدت أساطير الاستيطان الأمريكي (الآباء الحجاج والآباء المؤسسون والثورة وإعلان الاستقلال والدستور والتوسع القاري والمصير الجلي وتحرير الرقيق...إلخ) الهنود الحمر من الدخول في العالم الذي صنعته، ولهذا كان عالم المستوطنين الليبيريين مليء بفتات الحداثة الذي سمحت لهم به الولايات المتحدة وبقية المستغِلين دون السكان الأصليين، وكان الليبيريون الأمريكيون الذين نبذتهم الولايات المتحدة في أراضيها قد تحولوا في إفريقيا إلى عنصريين يعاملون السكان الأصليين باحتقار ومهانة ويشعرونهم بتفوقهم عليهم في نفس الوقت الذي يخفضون فيه جناح الذل لمضطهديهم السابقين من الأمريكيين ولو تطاول الأمريكيون على منصب رئيس الجمهورية نفسه، وقد وصل الإذلال للسكان الأصليين إلى درجة التعاون مع أمريكا وإسبانيا في سبيل توفير أيد عاملة سواء عن طريق السخرة بواسطة تعاون زعماء القبائل أم عن طريق عمليات الصيد التي لا تختلف عن غارات تجار الرقيق لإرسال المختطفين إلى جزيرة فرناندوبو الإسبانية في خليج غانا، وكان ذلك الاضطهاد يذكرنا بطريقة تحول الصهاينة الذي اضطُهِدوا في أوروبا إلى عنصريين اضطهدوا العرب بدورهم.
وفي العهد الطويل للرئيس وليام توبمان الذي ترأس بلاده ست دورات ودخل السابعة قبل وفاته (1944- 1971) عمل على إلغاء التوتر بين الليبيريين الأمريكيين والسكان الأصليين من بداية عهده وباشر رأب الصدع وإلغاء الفوارق بين الساحل والداخل منذ سنة 1964، ومنح القبائل درجة من الحكم الذاتي، كما انتهج سياسة لرفع مكانة بلاده سياسياً كالمشاركة في تأسيس الأمم المتحدة (1945)، وأدت الضغوط الأمريكية عليه لتصويت ليبيريا إلى جانب مشروع تقسيم فلسطين بعد معارضتها إياه (1947)، وشاركت في مؤتمر عدم الانحياز في باندونغ (1955)، وأصبحت عضواً في مجلس الأمن سنة 1960 (دليل الرضا الأمريكي)، وساهمت في تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية (1963)، وأصبحت عضواً في مجلس الوصاية في نفس العام، وقد أدى ذلك لرفع درجة شعبيته رغم تسلطه وفساده ومحاباته لمجموعته العرقية ولابنه إذ جعل منه رئيساً للوزراء عند استحداث المنصب 1964، كما أنه على الجانب الاقتصادي انتهج سياسة الباب المفتوح التي قدمت ثروات ليبيريا للاستثمارات الأجنبية في المطاط والحديد وكانت سياسة مناسبة جداً لحاجات أمريكا التي استفادت كثيراً منها لأن الشركة الأمريكية التي هيمنت على محصول المطاط الرئيس (فايرستون) كانت لا تبيعه إلا للدولة التي تتبعها هي وهي أمريكا الحريصة جداً على الاستحواذ على المطاط الذي غطت ليبيريا منه ربع احتياجات الحلفاء في الحرب الكبرى الثانية، كما أن رئيس الجمهورية كان لا يخالف آراء مستشاره المالي الأمريكي، وهي سياسة تشبه سياسة معاصره رئيس الوزراء في سيراليون السير ملتون مارجاي الذي أكد أن سياسة بلاده هي الباب المفتوح مع عدم قبول أي تدخل أجنبي في الشئون الداخلية (وماذا يبتغي التدخل الأجنبي غير النهب من الباب المفتوح له؟)، ووُصِف حكم توبمان بالفساد المالي المحابي لليبيريين الأمريكيين، وكانت ليبيريا قد أصبحت الموضع الاستراتيجي الأمريكي الحساس في غرب إفريقيا وارتبطت باتفاقية دفاع ومساعدة عسكرية مع الولايات المتحدة سنة 1942 ودخلت الحرب الكبرى الثانية إلى جانبها بعد سنتين، وحصلت من هذه الارتباطات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية على بناء بنية تحتية على شكل مواصلات برية وبحرية وجوية كانت فوائدها الرئيسة تعود على الأجانب الذين أنشئوها وذلك بنقل الخامات إلى الخارج دون مساعدة التنمية خارج هذا الإطار فظلت البلاد زراعية ومن أفقر بلاد العالم رغم ثرواتها الضخمة، أما المساعدات المالية الأمريكية فكان نصفها تقريباً ينفق على الفنيين الأمريكيين، وفي زمن الرئيس توبمان وصف الصحفي الأمريكي سميث همبستون وضع ليبيريا بأنه أسوأ حكم في العالم وأن الفساد والرشوة والمحسوبية متفشية في أعلى المستويات فيه ومع ذلك فإن هذا الرئيس هو أفضل رجل لليبيريا وللغرب معاً(!)
نقلت الولايات المتحدة ميناء مونروفيا الحر إلى حكومة ليبيريا باتفاق وقع في سنة 1964، وتستفيد كثير من شركات الملاحة البحرية من يسر الشروط التي تفرضها ليبيريا على تسجيل السفن مما جعلها تفضل رفع العلم الليبيري حتى أصبح الأسطول الليبيري يساوي 30% من ناقلات النفط في العالم أجمع في ستينيات القرن العشرين ولكن هذا لم ينعكس على شكل فوائد للسكان المحليين الذين ظلوا يشتكون من ضعف البنية التحتية وغلاء المواصلات.
وبعد وفاة الرئيس توبمان خلفه الرئيس وليام تولبرت (1971- 1980) الذي واجه معارضة ضد هيمنة الليبيريين الأمريكيين التي لم يوافق على زحزحة أوضاعها، ووصِف حكمه بالفساد والتسلط كسلفه، كما واجه عدم تقبله من جانب طبقته القيادية، وفي سنة 1980 قام أعضاء من مجموعة الليبيريين الأصليين بقيادة صامويل دو بانقلاب ضده أثار موجة من العنف ضد الليبيريين الأمريكيين وانتهى بذلك عهد هيمنتهم الذي استمر منذ الاستقلال سنة 1847، وحاول الانقلاب وضع حد للخلافات بين المجموعتين بتعيين وزير للعدل من الأمريكيين، كما انفتحت سلطات الانقلاب على الاتحاد السوفييتي وليبيا ولكنها ما لبثت أن تراجعت وانتهجت سياسة موالية للغرب كالنظام السابق، وذلك في ظل اعتراف أمريكي بها وزيادة في المساعدات العسكرية وأعادت العلاقات مع الكيان الصهيوني في سنة 1983 وتبع ذلك تعزيز للعلاقات معه لاسيما في المجالات الأمنية والعسكرية، ودخل الانقلاب في دوامة التصفية الذاتية وسمح للعديد من أقطاب النظام السابق بالعودة وتسلم مناصب سياسية هامة وتخلى عن سياسة عدم الانحياز التي كانت الولايات المتحدة تتلاءم معها في السابق وانحاز كلياً إلى السياسة الأمريكية، وفي سنة 1989 قام انقلاب ضد دو مما أشعل حرباً أهلية استمرت إلى سنة 1996 وقتل فيها 200 ألف وتشرد مليون ليبيري في الدول المجاورة، وفي النهاية انتخب على إثرها رئيس جديد هو تشارلز تايلور الذي استمر في الحكم ثلاث سنوات قبل أن يعلن ثوار التمرد عليه (1999) مما أدى إلى حرب أهلية أخرى استمرت إلى سنة 2003 حين استقال تايلور من الحكم وأجريت انتخابات (2005) فازت فيها إلين جونسون سيرليف التي تنتمي إلى الأقلية الأمريكية ويشير كل ما يتعلق بها إلى توجهها: تعليمها الأمريكي في هارفارد وسيرة وظائفها في البنك الدولي والبنوك الأمريكية وفوزها بجائزة نوبل ومناصبها الرسمية في نظام الأقلية الذي حكم ليبيريا قبل انقلاب 1980 وانتماؤها الديني البروتستانتي المنهجي وسياستها التي عبر عنها دخولها في حوار الشراكة الأمريكية- الليبيرية لضمان التعاون الدبلوماسي والاقتصادي بين البلدين على مستوى رفيع (15/1/2013)، وقيامها بدخول الانتخابات ثانية (2011) مع سبق إعلانها أنها لن تتولى إلا فترة رئاسية واحدة.
* خلاصة التاريخ الليبيري
ليبيريا دولة تقع في غرب إفريقيا أنشأتها الولايات المتحدة سنة 1820 لترحل إليها العبيد المحررين الذين لم تشأ أن تستوعبهم في أراضيها بسبب دوافع تتراوح بين الرغبة في "عودتهم" إلى وطنهم إفريقيا وعدم الرغبة في التعايش مع الملونين والاختلاط بهم على أرض واحدة، وكثيراً ما كان العبيد المختطَفون من غرب إفريقيا لا يصلون إلى الولايات المتحدة وتقوم سفن الحراسة "بإعادتهم" إلى ليبيريا بدلاً من مواطنهم الأصلية، المهم أن الدولة التي نشأت على أراضي ليبيريا كانت تابعة للنفوذ الأمريكي في مواجهة النفوذ البريطاني في سيراليون المجاورة (غرباً) والتي أنشأها الإنجليز بنفس الطريقة ولنفس الهدف، والنفوذ الفرنسي في ساحل العاج (شرقاً)، وقد أعلنت استقلالها سنة 1847، ويتضح الأثر الأمريكي في علم ليبيريا المشابه لعلم الولايات المتحدة ومن اسمها المشتق من كلمة ليبرتي أي الحرية ومن اسم عاصمتها مونروفيا الذي أطلق عليها تيمناً بالرئيس الأمريكي جيمس مونرو المؤيد لمشروع استيطان العبيد المحررين، ومن مؤسسات الحكم فيها والتي أنشئت على غرار المؤسسات الأمريكية، ومن انتشار العمارة الأمريكية والانضمام إلى الماسونية فيها، ومن سياستها الموالية للولايات المتحدة والتي اتضحت من دخولها الحربين الكبريين إلى جانب الحلفاء ضد ألمانيا، ومن تصويتها ضمن مجموعة المستعمرات الأمريكية لصالح قرار تقسيم فلسطين (1947) بعدما اتصل صاحب شركة فايرستون بالرئيس الليبيري بعد معارضته فكرة التقسيم وأخبره أن مناوأة القرار ستؤلف خطراً على استيراد أمريكا المطاط من بلاده، ويتضح الأثر الأمريكي كذلك من علاقات ليبيريا المميزة بالكيان الصهيوني خلافاً لبقية الدول الإفريقية، ومن التغلغل الأمريكي فيها وسيطرته على المالية الليبيرية بعد حصولها على القروض الأمريكية
وبعد إنشائها حكمها الأفارقة الأمريكيون واحتكروا القطاعات السياسية والاقتصادية واستبعدوا السكان الأصليين من المواطنة إلى سنة 1904 وظلوا مهيمنين على البلاد إلى سنة 1980 رغم كونهم أقلية لا تتجاوز 5% من مجموع السكان، وهناك مصادر تقلص الرقم إلى 3% فقط، ورغم أن هناك من يرى أن ليبيريا لم تعان من الاستعمار، وذلك لأن الجيوش الغربية لم تحتلها كبقية محيطها الإفريقي، فإن الأقلية الأمريكية التي حكمتها كانت استعماراً في حد ذاتها إذ حصدت في المناطق الساحلية معظم الفوائد الاقتصادية، وكان ذلك صورة من صور اتخاذ تحرير الرقيق ذريعة لممارسة أشكال جديدة وبشعة من الاستغلال الاستعماري، ولكن كل ذلك لم يعجب السكان الأصليين رغم الرابطة الإفريقية بين الطرفين واندلعت المقاومة منذ بداية الاستيطان وسالت كثير من الدماء إلى أن استولى السكان الأصليون على الحكم سنة 1980 ثم دخلت البلاد في حربين أهليتين طاحنتين 1989- 1996 و1999- 2003 نتج عنهما 250 ألف قتيل، ومليون لاجئ مشرد، وهي أرقام ضخمة نظراً لعدد سكان ليبيريا البالغ آنذاك 2.6 مليون نسمة تقريباً (1993)
وتزخر ليبيريا بالثروات ولكنها بلد فقير فقراً مركباً، بل تتميز وهي وسيراليون التي تشبهها كثيراً في الظروف عمن حولهما في درجة الفقر، وثرواتها ومرافقها تحت سيطرة الأجانب أولاً، ثم تحت سيطرة سوء التوزيع بين الساحل حيث يعيش سلالة العبيد الأمريكيين المحررين ويحصلون على الجزء الأكبر من الثروة الوطنية، والداخل حيث السكان الأصليين، ولولا الهيمنة الأجنبية على ثروة ليبيريا باسم الباب المفتوح والتجارة الحرة لكان شعبها غنياً جداً، ومن المفارقات الواضحة لبناء البنية التحتية الذي شهدته ليبيريا مستعمرة العبيد أن أمريكا ارتبطت معها باتفاقية دفاع ومساعدة عسكرية لتكون قاعدة لنفوذها في المنطقة وبنت لها مطار العاصمة مونروفيا الذي وُصف في زمنه بكونه أحدث موانئ غرب إفريقيا ومن أعظم ما صنعته يد الإنسان في العالم كما يقول الأستاذ محمد اسماعيل محمد في مؤلفه عن ليبيريا، ولأن ليبيريا تمتلك أكبر مزارع المطاط في العالم ومن أضخم خامات الحديد بالإضافة إلى الأخشاب والذهب والألماس كذلك فقد تهافتت الدول والشركات الكبرى عليها وحصلت على امتيازات بمليارات الدولارات، وكانت ليبيريا هي الدولة الإفريقية الوحيدة التي تقبل التنازل عن مساحات واسعة من الأرض لمدة طويلة بإيجار رمزي، وكانت ثرواتها هي السر الذي بنيت لأجله البنية التحتية فيها لخدمة الحصول عليها، فبُنيت لها شبكة من طرق المواصلات والموانئ لتوصيل هذه الخامات إلى الخارج، كما ولدت الكهرباء اللازمة لمشاريع المطاط والحديد، وقد تربعت ليبيريا على عرش تسجيل أكبر أسطول بحري في العالم لمدة طويلة وأصبحت الآن في المرتبة الثانية بعد بنما ليُسر شروط تسجيل السفن فيها وعدم فرض الضرائب وانخفاض شروط السلامة التي تشترطها مما يغري الشركات الكبرى برفع العلم الليبيري، وتحصل ليبيريا على أعلى نسبة من الاستثمارات الأجنبية في العالم، ولكن في مقابل كل ذلك، وفي مقابل كونها في زمن من أسرع الاقتصاديات نمواً في العالم وكانت لبرهة تلي اليابان مباشرة (!) نجد على أرض الواقع أن ليبيريا من أفقر الدول في العالم ومتوسط دخل الفرد فيها هو ثالث أدنى دخل في العالم ويعيش ما يقارب 85% من السكان تحت خط الفقر الدولي، وديونها ضخمة جداً تصل أضعاف الناتج المحلي الإجمالي وتمتلك عجزاً في الحساب الجاري وصل قريباً من 60% سنة 2008، وعانت من أسرع عمليات الهبوط الاقتصادي في التاريخ في أثناء حروبها الأهلية التي نتجت عن تركيبتها السكانية غير المتجانسة بفعل التدخل الأمريكي بتوطين العبيد المحررين فيها والتي أدت إلى خسائر جسيمة، ومن ضمن عقبات الاقتصاد الليبيري الافتقار إلى البنية التحتية والتي تخضع فيها للمصالح الخاصة ويؤدي ذلك إلى ارتفاع نفقات النقل رغم شبكة المواصلات آنفة الذكر، كما تعيش في عزلة عن محيطها وتفتقر إلى الصلات التجارية بمن حولها وترتبط في المقابل تجارياً بالولايات المتحدة والعالم الغربي وذيوله العربية والآسيوية، وتؤلف الدولرة، أو إحلال الدولار مكان العملة الوطنية، واحدة من عقبات التطور الاقتصادي في ليبيريا، ورغم إفادتها من المرافق التي بناها الأمريكيون لإحكام الاستغلال والتبعية فإن البلاد كان من الممكن أن تفيد أكثر كثيراً لو ظلت ثرواتها بأيدي أبنائها، وهذه هي الفكرة التي أحب التأكيد عليها دائماً وهي قطع الغرب طرق التطور الحضاري على غيره من الشعوب
المراجع
1- موسوعة ويكيبيديا العربية: ليبيريا (2014/8/15).
2- الدكتور عبد الوهاب الكيالي (تحرير)، موسوعة السياسة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1999، ص 568- 581.
3- محمد اسماعيل محمد، سيراليون وليبيريا، سلسلة الألف كتاب (449)، مؤسسة سجل العرب، القاهرة، 1963
4- محمد شعبان صوان، معضلة التنمية الاستعمارية: نظرات في دعاوى إيجابيات الاستعمار، دار الروافد الثقافية- ناشرون، بيروت، ودار ابن النديم، الجزائر، (تحت الطبع).
5- The New Encyclopedia Britannica, 15th Edition, 1987, Vol. 29, pp. 883- 887.
6- New Standard Encyclopedia, Ferguson Publishing Company, Chicago, 1999, Vol. 10, pp. L- 187- 189.
7- John A. Garraty and Jerome L. Sternstein, Encyclopedia of American Biography, Harper Collins Publishers, New York, 1996, pp. 278- 279, 427- 428.
8- Robert A. Rosenbaum, The Penguin Encyclopedia of American History, Viking, New York, 2003, p. 80.
9- Eric Foner, Reconstruction: America's Unfinished Revolution: 1863- 1877, History Book Club, New York, 2005, p. 598.
10- James Oliver Horton and Lois E. Horton, Slavery and the Making of America, Oxford University Press, 2004, pp. 95- 97, 225.
11- Peter S. Onuf, Jefferson's Empire: The Language of American Nationhood, University Press of Virginia, London, 2000, pp. 147- 188.
12- Francis Paul Prucha, The Great Father: The United States Government and the American Indians, University of Nebraska Press, Lincoln, 1995, p. 219.
13- Simon Schama, Rough Crossing: Britain, The Slaves and the American Revolution, Harper Collins Publishers, New York, 2006, pp. 410- 411.
*التجديد