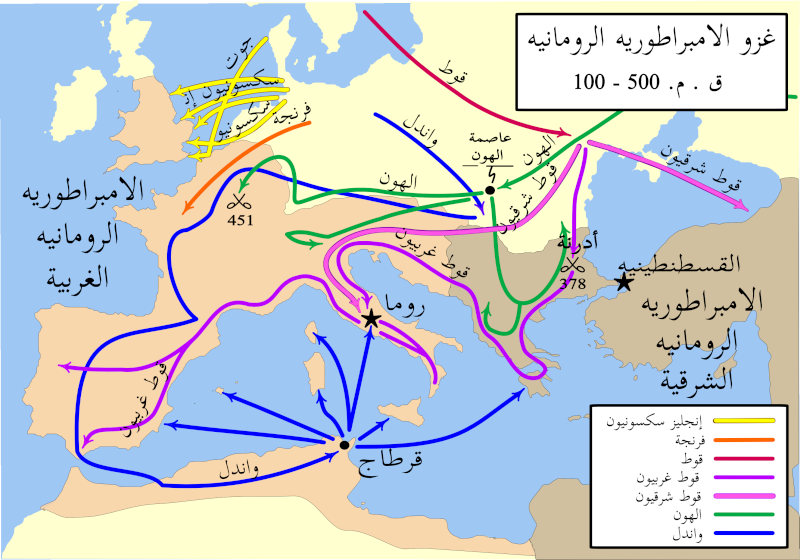محمد شعبان صوان
’’إن تقسيم الامبراطورية العثمانية وتجزئتها بين الدول كانت قضية أوروبية، وما لا شك فيه أنها كانت العامل الرئيس في نشوب الحرب العالمية الأولى، كما أنها كانت من أعقد المشكلات التي طرحت على رقعة شطرنج السياسة الأوروبية’’ المؤرخ العربي زين نور الدين زين.[1]
’’فَهُم (أي المستعمرون) يؤيدون المشروع العربي لمحمد علي، فإذا أوشك أن ينجح، وقفوا ضده، مع الإسلام العثماني، ثم هم يناصرون العروبة بالمشرق، ضد إسلام آل عثمان، وفي ذات الوقت يقتسمون الوطن العربي، ويخرجون من الحرب العالمية الأولى بتصفية الخلافة الإسلامية ومشروع الدولة العربية جميعاً، وفي مواجهة الفكر الإسلامي زرعوا العلمانية والتغريب، ولمحاربة المد القومي الناصري سعوا لإقامة الأحلاف تحت أعلام الإسلام’’ الدكتور محمد عمارة.[2]
* تطورات الحرب الكبرى الأولى هي الفصل الأخير في مسلسل القضاء على الخلافة الإسلامية
في يوم 28 يوليو/ تموز/ جويلية سنة 1914 اندلعت الحرب الكبرى الأولى بعد شهر من اغتيال ولي عهد النمسا على يد الصرب، وشهدت هذه الحرب تطورات سريعة كنشوب الثورة العربية الكبرى ضد الدولة العثمانية بتحريض من بريطانيا التي كانت تتفق مع حلفائها على تقسيم البلاد العربية في اتفاقية سايكس- بيكو في نفس العام (1916) ثم صدور وعد بلفور لمنح اليهود وطناً قومياً في فلسطين، وقد غيرت هذه التطورات شكل الشرق العربي الإسلامي الذي قُسم ووقع تحت الاحتلال ونُصب على حكمه دمى غربية لتنفيذ سياسات الاستعمار، وهذه التبعات مازالت مستمرة إلى اليوم، وكان الختم الرسمي الذي صادق على هذه التغيرات هو تنازل النظام الكمالي في مؤتمر لوزان (1923) عن أملاك الدولة العثمانية ثم قيامه بإلغاء منصب الخلافة الإسلامية نفسه (1924) بعدما كان قد ألغى السلطنة العثمانية (1922) في حدث تجهد كثير من الكتابات لاستخراج دليل على تورط الغرب فيه في مؤتمر لوزان وحده، ولكن متتبع سير الأحداث التاريخية يجد أن إلغاء الخلافة كان تتويجاً لجهود غربية سابقة عملت على تقليص الحضور الموحد لبلاد الشرق العثماني ومنعه من النهوض ثانية بعد تسرب علامات الضعف الشديد إلى جسده وعدم قدرته على مواجهة العدوان الأوروبي في الوقت الذي كان نجم أوروبا في صعود منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر، ومما يؤكد حقيقة الهدف من هذه الجهود الغربية اختلاف مصير الدولة العثمانية عن مصائر بقية المهزومين في الحرب الكبرى التي كانت الفصل الأخير في مسلسل القضاء على الخلافة الإسلامية.
* هل الدليل على تورط الغرب محصور في مؤتمر لوزان؟
عند الحديث عن إلغاء الخلافة الإسلامية تزخر كثير من الأدبيات بذكر ما يُعرف بالشروط الأربعة التي فرضها وزير خارجية بريطانيا اللورد كيرزون على تركيا الكمالية في مؤتمر لوزان سنة 1923 للاعتراف باستقلالها وهي: إلغاء الخلافة وطرد الخليفة ومصادرة أمواله وإعلان علمانية الدولة، وتختلف المراجع فيما بينها على هذه الشروط ولكنها تجمع على كونها أربعة وكون إلغاء الخلافة من ضمنها بل على رأسها، وفي نفس الوقت تخلو الكتب الغربية المعتمدة على الوثائق الرسمية من ذكر هذه الشروط، ورغم أنه لا يُستبعد إملاؤها في ذلك الزمن الذي تميز بالمؤامرات والاتفاقيات السرية، فإن تتبع سير العلاقة بين الدولة العثمانية بصفتها آخر خلافة إسلامية والدول الغربية الكبرى يبين أن هذه الشروط لو صحت فإنها وليدة سلسلة طويلة من الحوادث التي تبين المخطط الغربي المستمر والمعبر عن مصالح ثابتة يلتزم بها الساسة المتعاقبون مهما تباينت انتماءاتهم الحزبية، وليس مجرد مؤامرة عابرة في غرفة مظلمة في ليلة غير مقمرة، وذلك في سبيل إبقاء منطقة الشرق العربي الإسلامي بلا قوة ذاتية، ومن ثم كان القضاء على الخلافة بصفتها رمز وحدة بلادنا من مستلزمات السياسة الغربية في هذه المنطقة وهو ما دلت عليه كثير من الأحداث غير المحتاجة لإثبات شروط كيرزون بصفتها الدليل الدامغ والوحيد على ضلوع الغرب عامة وبريطانيا خاصة في القضاء على رمز وحدة هذه الأمة.
* تطور المصالح الغربية في الشرق العربي الإسلامي:
منذ ظهور علامات الضعف على الدولة العثمانية التي كانت توحد كيان الشرق العربي، لم تكن مصالح الغرب الجمعية تنسجم مع بروز كيان قوي مرة أخرى، ولهذا قامت الدول الغربية على اختلافها بوأد أية محاولة نهضوية تنشأ في بلادنا لأنها ستهدد المصالح الغربية كما شخصها أصحابها، وقد تغيرت هذه المصالح مع تغير الظروف العالمية ولكنها كانت تقتضي باستمرار عرقلة قيام كيان قوي: فموقع الشرق العربي كان منذ قديم الزمن ملتقى طرق التجارة العالمية وموضع اهتمام الكيانات القائمة على أطرافه، وقد استمر هذا الاهتمام في العصر الحديث، إذ أن موقع الدولة العثمانية بين البحر المتوسط والهند، درة التاج البريطاني، وضعها في مواجهة مباشرة مع بريطانيا التي تريد ضمان الوصول إلى مستعمرتها باحتلال مواقع عثمانية مثل عدن (1839)، والتمدد داخل الخليج، وهذا ما حفز سياستها المعارضة لمشروع محمد علي باشا في البلاد العربية إذ كانت تريد الإبقاء على ضعف الدولة العثمانية وعدم تجديد شبابها كي لا تقف في وجه الوصول إلى الهند، ولما اكتملت الثورة الصناعية وزاد رأس المال الأوروبي سعت الدول الاستعمارية الغربية لتسويق بضائعها واستثمار رأسمالها في بقية العالم وهذا ما جعل لها مصلحة في عرقلة أية صناعة محلية بالإضافة إلى حاجتها لتأمين وصول المواد الأولية إلى مصانعها في الغرب، ولما حفرت قناة السويس وأصبحت طريقاً مختصراً إلى الهند اهتمت بريطانيا بالسيطرة عليها بعد شراء أسهمها من الخديو اسماعيل الذي ورطته الاستثمارات الأجنبية بالديون، فأصبح لبريطانيا في مصر أكثر من مصلحة: قناة السويس بصفتها معبراً، وأموال الدائنين، فاحتلتها سنة 1882، وفكرت منذ هزيمة محمد علي بإنشاء كيان يهودي ليكون حاجزاً في وجه طموحات الوالي المصري المستقبلية ثم حارساً لقناة السويس وطريق الهند، هذا بالإضافة إلى الكيان الاستيطاني الفرنسي في الجزائر والذي قام بتلبية مجموعة من المصالح المادية والثقافية لفرنسا، وكان هناك أيضاً الحضور الأجنبي الثقافي لاسيما الفرنسي والأمريكي المركز في الإرساليات التبشيرية والمدارس والكليات والمستشفيات الأجنبية والمحاولات الاستيطانية التي كانت طلائع الغزو الاستعماري وتتطلب حماية خاصة بصفتها مصالح أجنبية، كما كانت الامتيازات الأجنبية التي منحتها الدولة العثمانية زمن قوتها للتجار والمواطنين الأجانب مصلحة حيوية للدول الغربية وهي مستعدة للتدخل بالقوة المسلحة للحفاظ عليها، وقد أدت هذه الامتيازات إلى توسع آخر في المصالح الغربية باتخاذ الأقليات الدينية والقومية موضعاً للحماية الأجنبية.
هذا كله قبل اكتشاف النفط، فلما اكتشف أصبحت السيطرة على مصادره المتركزة في الشرق العربي وإيران مصلحة جديدة للغرب تقتضي عدم التعامل مع جهة شرقية واحدة قوية تتحكم بآباره أو بعوائده الضخمة أو بالاستثمارات الأجنبية والتجارة العربية الضخمة، وأصبحت قناة السويس هي المعبر الرئيس للنفط إلى بريطانيا وفرنسا والغرب عموماً الأمر الذي سيبقي على أهميتها حتى بعد استقلال الهند، هذا بالإضافة إلى كونها معبراً بريطانياً وعالمياً تملك بريطانيا نصف أسهمه تقريباً، وبقيام الثورة البلشفية في روسيا (1917) وفشل العدوان الغربي عليها لوأدها، أصبح الحفاظ على بلادنا خارج النفوذ الشيوعي مصلحة جديدة للغرب في بلادنا اقتضت إقامة القواعد العسكرية التي لن يقبل بها نظام قوي مستقل ولكن أنظمة التجزئة ترحب بها بصفتها حماية لوجودها ومصدراً لرزقها حين تقبض ثمن أجرتها، كما اقتضى إبعاد الخطر الشيوعي دعم الكيان الصهيوني الذي أقيم في البداية لغايات مختلفة تماماً هي: حماية المصالح البريطانية في المشرق العربي وتثبيت الوجود البريطاني في مصر وتأمين قناة السويس والطرق التجارية إلى الشرق، والحؤول دون تحقيق الأطماع الفرنسية في شرق المتوسط وإقامة جسر بين البحر المتوسط وحقول النفط في العراق،[3] ولكن هذا الكيان احتفظ بأهميته الاستراتيجية المستمدة من كونه طليعة للغرب على أرض الشرق كما نوى منشئوه ولهذا أصبح في خدمة الأهداف الغربية عموماً مثلما ثبت في خدمته المصالح الفرنسية إضافة للبريطانية في العدوان الثلاثي 1956 ثم في وكالته المفتوحة عن المصالح الأمريكية بعد ذلك، ومن ثم أصبح مصلحة حضارية غربية مستقلة قائمة بذاتها في هذه المنطقة الحيوية حتى بعد زوال الاتحاد السوفييتي، وأصبحت الملاحة في قناة السويس مصلحة حيوية لهذا الكيان الذي هو بدوره مصلحة غربية أخرى قائمة بذاتها ويقتضي بمفرده سعي الغربيين لإركاع كل منطقتنا لقيادته كما تشير مشاريع الشرق أوسطية المتعاقبة مع ما يستلزمه هذا من عرقلة وحدة بلادنا ومنع القوة بكل أشكالها عنا كي لا نقاومه أو حتى نهدده من جهة ولا ننافسه من جهة أخرى، ومن هنا التعهد الأمريكي والغربي العلني والمجمع عليه بإبقاء الكيان الصهيوني متفوقاً نوعياً على مجموع البلاد العربية، وعلى ذلك المنطق التفتيتي سارت سياسة الغرب المعاصر كما سيأتي.
كما استمر الاهتمام الغربي بموقع ’’الشرق الأوسط’’ بين قارات العالم القديم وكونه صلة الوصل بينها وهو بذلك ’’أهم المناطق الاستراتيجية في العالم’’ ولهذا ’’نحن ملزمون بإعطاء الشرق الأوسط أولوية عالية جداً، ولا نستطيع أن نتخلى عن وضعنا الخاص في المنطقة... والسماح لوضعنا بأن يكون عالة على ترتيبات ذات طابع دولي’’ كما قال رئيس الوزراء البريطاني السابق أنتوني إيدن في مذكرة حكومية عندما كان وزير خارجية وعضواً في لجنة قناة السويس ويرد في طرحه على اقتراحات التخلي عن المسئوليات الامبراطورية سنة 1945،[4] وإذا كانت الأمور قد سارت بعد ذلك بغير ما يشير هنا فكلامه يدل على التوجهات البريطانية التي حكمت فيما سبق، ورفض الترتيبات الدولية يدل على النزعة الاحتكارية التي حكمت السياسة البريطانية في بلادنا وعملت على استمرار التفرد بها، وفي سنة 1947 حدد ناحوم غولدمان الذي سيصبح رئيس المنظمة الصهيونية أهمية فلسطين قائلاً إن اهتمام اليهود بها ليس لأسباب دينية أو اقتصادية ’’بل لأن فلسطين هي ملتقى الطرق بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، ولأنها المركز الحقيقي للقوة السياسية العالمية، والمركز العسكري الاستراتيجي للسيطرة على العالم’’،[5] وفي نفس العام أجمع موظفو الخارجية البريطانية على رفض فكرة الانسحاب من الشرق الأوسط ووصفوا جعله حيادياً بالحماقة،[6] فما بالنا ببروز قوة محلية مستقلة؟، وهو أيضاً ما يشير إلى النزعة الاستئثارية التي تميزت بها السياسة البريطانية في شرقنا زمناً طويلاً، كما جاء في اجتماع لحلف شمال الأطلسي سنة 1965 على لسان الممثل الأمريكي أن الشرق الأوسط هو الجناح الأيمن لأوروبا عسكريا ويحتوي على ثلثي احتياطيات النفط المعروفة آنذاك،[7] وكان صناع السياسة البريطانيون والأمريكيون قد أشاروا منذ سنة 1950 إلى أن التحكم ’’بالشرق الأوسط’’ يعني التحكم في الوصول إلى ثلاث قارات.[8]
ويمكننا أن نضيف إلى سلسلة المصالح السابقة قرب ’’الشرق الأوسط’’ من أوروبا ووقوعه في دائرة الأطماع الإقليمية لدولها حيث خيّل لفرنسا في العصر الحديث أن الجزائر جزء منها، وأن لها روابط تاريخية بسوريا تعود إلى حروب الفرنجة، كما حدث الأمر نفسه لإيطاليا مع ليبيا، هذا إضافة إلى أطماع روسيا في البلقان باسم الجامعة السلافية وباسطنبول ومضائقها بحجج دينية تخفي أسباباً استراتيجية، وبشرق الأناضول بحجة الأرمن رغم أنها تقمعهم في بلادها، وأطماع امبراطورية الهابسبورغ النمساوية في البلقان أيضا، وإضافة إلى ذلك أطماع الاستعمار التقليدي كأطماع بريطانيا في مصر والعراق، وأطماع فرنسا في تونس، كل هذه الأطماع الإقليمية كلفت الدولة العثمانية حروباً طاحنة وثورات عاتية ومعارك حامية أدت إلى استنزافها ولم يكن من مصلحة الغرب الأوروبي أن تقف هذه الدولة ثانية على رجليها وذلك كي لا تستعيد ما سلب منها، ومن أدل الوقائع على ذلك رفض أوروبا مجتمعة تدخل محمد علي باشا بصفته والياً عثمانياً لإخماد الثورة اليونانية بقوته الصاعدة وقيامها بتحطيم الأسطول العثماني المصري في معركة نافارين (1827) وكانت فرنسا التي دعمت الوالي المصري سابقاً على رأس مهاجميه في المعركة لأنها كانت تريد قوته في سبيل مصالحها،[9] أي أن يكون عميلاً لها وينفذ مخططاتها، كحملة على شمال إفريقيا مثلاً حيث ستحتل الجزائر قريباً، وليس لأجل القوة الذاتية للعثمانيين.
وتدل حوادث الثورات العربية الأخيرة على محاولات الغرب الحثيثة الإبقاء على نفوذه وعدم إحداث تغييرات ثورية في أوضاعنا، يشهد على هذا بقاء نفس الأطقم القديمة في مواقع اتخاذ القرار وهي الوجوه التي اعتاد الغرب على التعامل معها والاطمئنان إليها فيما سبق ولا يغير من الأمر أن يكون شخص واحد من هذا الطقم أو ذاك قد اعتزل حتى لو كان رأس النظام، ولو استعملنا التعبير الماركسي فإن أدوات الإنتاج الغربية ’’الجديدة’’ لم تؤد إلى علاقات إنتاج جديدة، هي نفسها مازالت في كل مكان، ولهذا فإن هذه الأدوات التي يستعملها الغرب في إخضاع أمتنا ليست جديدة على الإطلاق.
وخلاصة الأمر أنه رغم تغير المصالح الغربية في منطقتنا، من الوصول إلى الهند والشرق الأقصى إلى صد التوسع الروسي ثم السوفييتي إلى تأمين وصول إمدادات النفط إلى الغرب، فإنها لم تفقد بريقها رغم استقلال الهند وزوال الاتحاد السوفييتي وتطور وسائل المواصلات والأسلحة الجوية التي قللت من أهمية الحدود البرية والحواجز الطبيعية، ولم تصرف أنظار الغربيين عن بلادنا بل تطورت مصالحهم بما يزيد من تشبثهم بالهيمنة عليها مع مرور السنين وتغير اللاعبين، وفي هذا المجال يشير المؤرخ زين نور الدين زين إلى ’’خطورة الدور الذي يلعبه الموقع الجغرافي في مشكلات العالم’’ ولهذا كان جملة من الكتاب البارزين يؤمنون أن دراسة الجغرافيا أمر ضروري لفهم تطور أي بلد من البلدان، ويضيف قائلا إن ’’الجغرافيا تعد من أقل العوامل تعرضا للتغير في تاريخ الشعوب’’.[10]
وقد عبر الرئيس الأمريكي السابق ترومان عن أهمية منطقتنا في سنة 1946 بقوله في خطاب الجيش: ’’في هذه المنطقة موارد طبيعية هائلة، فضلاً عن أنها منطقة تقع عبر أفضل الطرق البرية والمواصلات الجوية والمائية، فهي لذلك بقعة ذات أهمية اقتصادية وستراتيجية عظيمة، غير أن شعوبها ليست من القوة بحيث أن الدولة الواحدة، أو كلها مجتمعة تستطيع أن تقاوم العدوان القوي إذا أتاها من الخارج’’،[11] وهذه هي نظرية الفراغ[12] التي يعتنقها وينشرها الغربيون لتبرير تطفلهم على بلادنا التي لم تكن على الدوام ضعيفة ومقسمة بل كانت فيما سبق دولة واحدة قوية ’’تشيع الرعب في أوروبا’’ وووصفها المؤرخ جيبون بالصاعقة العثمانية التي نشأت عنها ’’المسألة الشرقية’’ التي كانت في مرحلتها الأولى تعني ’’مشكلة القضاء على قوة الإسلام السياسية’’ - وفقا لإدوارد دريو- بعدما أنشأ الأتراك العثمانيون أكبر وأقوى امبراطورية إسلامية منذ ظهور الإسلام،[13] وذلك قبل أن يضعف الكيان العثماني وتتحول المسألة إلى طريقة تقسيمه بين الطامعين فيه من أسلاف ترومان الذي أتى فيما بعد ليعيرنا بضعفنا، فما هو الدور الغربي في هذا التحول؟
* البداية: تخريب ما هو قائم والحؤول دون عودة الروح إليه
لقد ظهرت فكرة مواجهة الدولة العثمانية منذ نشوئها حتى أن وزيراً رومانياً أصدر في سنة 1914 كتاباً بعنوان مئة مشروع لتقسيم تركيا (الدولة العثمانية) عد فيه عشرات المشاريع التي قدمت للبابوات وساسة أوروبا للهجوم على الشرق وتقسيمه بين دول أوروبا والاستيلاء على بيت المقدس منذ نهاية حروب الفرنجة بفتح عكا سنة 1291،[14] وهو ما يشير إلى طبيعة المخططات الغربية المستمرة والتي فرضتها ظروف العداء الموضوعية التي عبرت عنها حروب الفرنجة، وهذا أمر لا يتعلق بمؤامرات سرية تدبر في الليالي المظلمة بل بتعارض موضوعي فرض نفسه على الأجيال المتعاقبة من الساسة والمسئولين والشعوب أيضاً، وبصعود نجم الدولة العثمانية كان الهدف الغربي هو القضاء على قوتها كما مر، وقد استفادت الدول الكبرى كثيراً من الضعف الذي طرأ على الدولة العثمانية التي تخللت جيوشها الظافرة أوروبا فيما سبق ووصلت أسوار فيينا عاصمة امبراطورية الهابسبورغ، وأرادت لها بريطانيا وفرنسا أن تكون في مرحلة ضعفها حاجزاً في وجه الأطماع الروسية بالإضافة إلى استخدامها سوقا لترويج البضائع الغربية المصنعة بعد اكتمال الثورة الصناعية،[15] وقد استمرت سياسة الحفاظ على الأملاك العثمانية واتخذت طابعاً رسمياً في حرب القرم (1853- 1856) ومعاهدة باريس التي تلتها (1856)، ولكنها مع ذلك لم تمنع عملية تشجيع الثورات الانفصالية ضد العثمانيين، وفي ذلك يوجز المؤرخ دونالد كواترت القول إن الدول الكبرى لم تكن ترى مصلحة لها في تفكك الدولة العثمانية ومن ثم تعاظم النفوذ الروسي في منطقة البلقان، وإن الكثير من قادة أوروبا ’’كانوا يخشون أن يؤدي انهيار الدولة العثمانية إلى تهديد السلام الإقليمي وزرع الفوضى التي لا تحمد عقباها، لذلك اتفقوا فيما بينهم على الحرص على وحدة كيان الدولة العثمانية، ويمكن القول بأن موقف هذه الدول الأوروبية كان يتلخص في إجماع هذه الدول على أن مصلحتهم المشتركة تقضي بترك بنية الدولة تتصدع شريطة ألا يؤدي هذا التصدع إلى الانهيار التام إن صح التعبير، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فما من شك أن دعم الدول الأوروبية للحركات الانفصالية والثورات الداخلية قد أسهم في تعجيل انهيار الدولة العثمانية وهو الحدث الذي كان يخشاه الأوروبيون ويسعون لتجنب وقوعه’’.[16]
ثم غيرت بريطانيا سياستها بعد الحرب الروسية العثمانية (1877- 1878) في مؤتمر برلين الذي تلاها (1878) لتتجه نحو اقتطاع أجزاء من الدولة العثمانية وتقسيمها على مهل بين الحلفاء فاحتلت هي جزيرة قبرص (1878) ومصر (1882) واحتلت فرنسا تونس (1881) واحتلت النمسا البوسنة والهرسك (1878) واستقل جزء من بلغاريا، ويحلل بعض المؤرخين سبب هذا التغير في السياسة البريطانية بالقول إن بريطانيا فقدت الأمل في شفاء ’’الرجل المريض’’ بعد هزيمته أمام الروس في حرب 1877 التي جعلت الساسة الإنجليز يعتقدون أن معارك هذه الحرب أثبتت بجلاء أن المحاولات العديدة التي بذلت طوال القرن التاسع عشر لتمكين الدولة العثمانية من البقاء دولة قوية متماسكة الأجزاء، إنما هي سياسة عقيمة وأنها مضيعة للوقت والجهد والأموال والأرواح، وأن بقاءها دولة متداعية يؤلف خطراً جسيماً على المصالح البريطانية ويفسح المجال للنفوذ الروسي، ولذلك قررت بريطانيا تطوير سياستها واتباع سياسة جديدة تقسم بموجبها الممتلكات العثمانية وتستأثر لنفسها بالمناطق الواقعة على طريق الهند وتصلح لضمان الوصول إليها،[17] وسنرى أن قوة الدولة العثمانية لم تكن أولوية حقيقية لدول أوروبا وأن هذه الدول فضلت مصالحها المادية على بقاء الدولة وأنها شجعت الحركات الانفصالية التي استنزفتها ومن ثم لا يمكن أن تكون النتيجة النهائية لهذا الدعم إلا مزيداً من الضعف ولم يكن لأوروبا حق في التعجب من استمرار التراجع العثماني بعد كل جهودها في استنزافها اقتصادياً وعسكرياً الأمر الذي يجعل العجب من الاستمرار العثماني وليس من هزيمة الدولة وتراجعها، وكيف يمكن القول إن أوروبا كانت تعمل لتقوية الدولة العثمانية وتتجنب انهيارها وفي نفس الوقت تشجع الحركات الانفصالية وتستنزف الاقتصاد العثماني كما سيأتي؟
* سبب بقاء الدولة العثمانية رغم الضعف في آخر أيامها
عند الحديث عن سبب استمرار الدولة العثمانية رغم الضعف والتراجع، لا يمكننا أن نعزو حركة التاريخ إلى عامل واحد هو الإرادة البريطانية ضد الأطماع الروسية كما شاع في بعض الأدبيات المثبطة، لاسيما أن بريطانيا تخلت عن سياسة تأييد العثمانيين بعد مؤتمر برلين (1878)، وكان التنافس الأوروبي واختلاف الدول الكبرى هو العامل الأهم من التأييد البريطاني في ظاهرة استمرار الدولة العثمانية، مع عدم إغفال أن القوة العسكرية العثمانية لم تكن قد انتهت في ذلك الوقت ولم تكن الدولة كياناً عاجزاً لا حول ولا قوة لها، من الناحية العسكرية على الأقل كما يقول المؤرخ المعروف إريك هوبزباوم[18] مضيفاً: ’’وتمتع الأتراك بسمعة رفيعة بوصفهم جنوداً أشداء، وكان لهم دور حاسم في التصدي الفاعل لعدوهم الأخطر، وهو الجيش الروسي والدول الأوروبية المتنافسة، وفي الحيلولة دون تفكك الإمبراطورية العثمانية أو إرجائه على الأقل’’،[19] ويقول أيضاً: ’’وكان الأوروبيون يكنون احتراماً مشوباً بالحسد تجاه الإمبراطورية العثمانية لأن قوات المشاة لديها كانت قادرة على الوقوف في وجه الجيوش الأوروبية’’،[20] وذلك في أوج التوسع الاستعماري الأوروبي حين بقيت الدولة العثمانية ’’أقوى دولة إسلامية صامدة في وجه الإمبريالية الأوروبية’’[21] كما يقول كواترت، وظل الجيش العثماني حتى لحظاته الأخيرة في الحرب الكبرى الأولى سنة 1917 ’’أبعد ما يكون عن الهزيمة’’[22] رغم انتصارات الحلفاء في قول مؤرخ ثالث هو مايكل أورين.
ومما يؤكد ذلك ما لاحظه المؤرخون من تحقيق انتصارات عثمانية مهمة في ساحة الحرب الكبرى الأولى (1914- 1918) في جبهات عديدة (القوقاز والبلقان والعراق وفلسطين والجزيرة العربية ومضائق اسطنبول) جعلت من هزيمة العثمانيين مهمة ليست سهلة، وعن بقاء الدولة العثمانية يقول المؤرخ دونالد كواترت: ’’في تقويمنا للعوامل التي ساعدت الدولة العثمانية على البقاء، عندما كانت جاراتها الأوروبيات تتفوق عليها عسكرياً واقتصادياً (تفوقاً) واضحاً، نحن نسلم بأثر عاملين: منافسات القوى العظمى والمهارات الديبلوماسية العثمانية على السواء’’،[23] ولعل هذا يفسر نجاة الدولة من الاحتلال العسكري الذي لقيته الولايات التي استقلت عنها كتونس (1881) ومصر (1882) بعد إفلاس الجميع وتخلي الإنجليز عن تأييد العثمانيين، وكانت الأهمية الدولية للدولة العثمانية هي التي جنبتها مصير الاحتلال كما يقول المؤرخ الاقتصادي شارل عيساوي،[24] ويلاحظ كثير من المؤرخين أن الدولة العثمانية ظلت ضمن مساحات قليلة من العالم خارج إطار الاستعمار الأوروبي في زمن التزاحم الاستعماري الذي هيمن على معظم الكرة الأرضية باستثناء الصين واليابان وفارس والدولة العثمانية.[25]
* بقاء الدولة العثمانية مع ضعفها لم يكن الأولوية الأولى للغرب
وكانت دول أوروبا وبخاصة بريطانيا تفضل مصالحها التجارية على مصلحتها في استغلال بقاء الدولة العثمانية ولو بصورة هزيلة،[26] وقد تجسد هذا التعارض الموضوعي في المصالح في وقوف الغرب الأوروبي ضد كل مشاريع الإحياء التي نفذتها أو حاولت تنفيذها دولة الخلافة مثل فكرة الجامعة الإسلامية ومشروع سكة الحجاز أو سكة حديد بغداد أو مشاريع الإصلاح الاقتصادي والقضائي التي مست الامتيازات الأوروبية في الدولة العثمانية، حتى أن السلطان عبد الحميد الثاني تمنى في سنة 1902 أن تحظى دولته بفترة هدوء لمدة عشر سنوات فقط تتوقف فيها مؤامرات الدول الكبرى عليها ليتمكن من السير في الطريق الذي سارت فيه اليابان البعيدة عن ’’الوحوش الأوروبية الكاسرة’’ التي صرف العثمانيون الملايين على إخماد مؤامراتها بدل ’’أن تصرف على مشاريع حيوية نستفيد منها’’،[27] ولم يكن تصدي الغرب لهذه المشاريع من باب الشر المحض الذي يبغي إلحاق الأذى بالآخرين بلا سبب بقدر ما كان تعبيراً عن التناقض الموضوعي بين مصالح كيانات الغرب ونهضة كيان يجمع بلاد الشرق تحت لواء واحد، وبدا هذا التعارض أيضاً في سياسة التصدي العنيف لأية محاولة نهضوية في البلاد العثمانية كما حدث مع نهضة محمد علي باشا في مصر والتي لاحظ كثير من المؤرخين وقوف أوروبا في وجه طموحاتها بعنف، وفي ذلك يقول كواترت إن الدول الأوروبية لم تكن لتسمح بظهور دولة مصرية قوية وما يترتب على ذلك من اختلال ميزان القوى الذي كانت الدول الأوروبية تود المحافظة عليه،[28] ويقول بيتر مانسفيلد إن محمد علي كان بوسعه تحدي السلطان وانتظار سقوطه لكن بريطانيا فضلت أن تبقي على الإمبراطورية مترابطة على أن تكون مجزأة يسهل ابتلاعها من قبل المتمردين والمنافسين، ولذلك لم تكن متحمسة لإحلال قوة إسلامية توسعية متحركة محل الامبراطورية العثمانية، وكان هذا بالضبط ما يقلق قادة الدول الأوروبية، وقد صممت بريطانيا آنذاك على إحباط طموحات محمد علي بإفشال كل المساعي السلمية ورفض قاطع للعرض الذي تقدم به للاتفاق مع السلطان[29] رغم أنها كانت من شجع الوالي نفسه على الثورة على العثمانيين، ويشير مؤرخ ثالث إلى أن بريطانيا أحبطت جهود محمد علي لكونها لا تريد تكوين امبراطورية إسلامية جديدة لاسيما واحدة تحاول إيجاد قاعدتها الصناعية الخاصة.[30]
وقد ظهر التعارض بين القوى الغربية وقوة الشرق العثماني في الزحف التدريجي واحتلال البلاد العثمانية الواحدة تلو الأخرى في سياسة اتخذت من فكرة الاستقلال قناعاً لفصل الولايات عن الدولة تمهيداً لوقوعها في براثن الهيمنة الغربية كما حدث مع الجزائر وتونس ومصر وبلدان الخليج، ثم مع القومية العربية كلها بإثارتها بفكرة الاستقلال العربي والخلافة العربية تمهيداً لاحتلال شرق المتوسط بعد إعلان الثورة العربية ونهاية الحرب الكبرى الأولى.
* مناوأة منصب السلطنة العثمانية ومحاولة نزع الخلافة الإسلامية منها ضمن جهود بريطانيا للقضاء على الخلافة
يلاحظ زعيم الوطنيين المصريين وداعية الجامعة الإسلامية مصطفى كامل باشا أن جهود أعداء الدولة العثمانية لتأسيس خلافة عربية تأتي في إطار محاولتهم القضاء على هذه الدولة التي تخشى أوروبا من قوتها ونفوذها وأعداء الإسلام يودون ان يزول اسمها من الوجود حتى تموت قوة الإسلام وتقبر سلطته السياسية وتقوم بدلاً من الدولة العثمانية خلافة تكون ألعوبة في يد إحدى الدول الكبرى، ورأوا أن فصل الخلافة الإسلامية من السلطنة العثمانية يضعف الأتراك ويقتل نفوذهم بين المسلمين ويجعلهم أمة إسلامية عادية، وقد تلقف الإنجليز مشروع الخلافة العربية لأنهم أدركوا أن احتلالهم الأبدي لمصر سبباً للعداوة بينهم وبين الدولة العثمانية لأن السلطان العثماني لا يقبل مطلقاً الاتفاق معهم على بقائهم في مصر، وأن خير وسيلة تضمن لبريطانيا البقاء في مصر ووضع يدها على وادي النيل هو هدم السلطنة العثمانية ونقل الخلافة الإسلامية إلى أيدي رجل يكون تحت وصاية الإنجليز وآلة في أيديهم، ولهذا أخرج ساسة بريطانيا مشروع الخلافة العربية.[31]
وقد أثبتت الأيام صحة تحليل الباشا، فقد استمرت بريطانيا في تبني مشروع الخلافة العربية إلى أن حفزت إعلان الثورة العربية ضد العثمانيين سنة 1916 تحت شعار عودة الخلافة للعرب، بل إنها عمدت بعد اندلاع الحرب الكبرى سنة 1914 إلى إنهاء السيادة العثمانية على مصر وخلع الخديو عباس حلمي الثاني من منصبه بحجة ارتباطه بالعثمانيين، ونصبت عمه حسين كامل سلطاناً على مصر لمناوأة منصب السلطنة العثمانية،[32] ومما يلفت الأنظار رفض شعب مصر لهذا السلطان الألعوبة بمحاولة اغتياله مرتين مع بعض وزرائه،[33] وكل تلك الجهود البريطانية استهدفت محاربة دولة الخلافة وإضعاف نفوذها ولا يمكن إلا أن تدرج ضمن محاولة القضاء على منصب الخلافة نفسه لاسيما بعدما رفض الإنجليز حتى منصب الخليفة الألعوبة وذلك بعدم اعترافهم بانتقال الخلافة إلى العرب الذين أعلنوا بيعة الشريف حسين بعدما حاربوا تحت لواء بريطانيا في أعقاب حصولهم على الوعد بعودة الخلافة إليهم.
* أوروبا لم تكن سعيدة بالتغريب العثماني المستقل وفضلت مصالحها الآنية على رعاية تلاميذها مما أدى إلى الحرب بين التغريب والغرب
هذا الزحف التدريجي اتخذ صورة عنيفة مع انفجار الحرب الكبرى الأولى سنة 1914، مع أن وصول مدرسة التغريب المتمثلة في حزب الاتحاد والترقي إلى الحكم سنة 1909 بعد الانقلاب على السلطان عبد الحميد بشر بانسجام بين الغرب والمعارضة العثمانية السابقة التي رعاها الغربيون في بلادهم والبلاد التي تحت حكمهم، وقد حاول الحكام الجدد مد يد السلام إلى القوى الغربية وقدموا لها بلادهم على طبق من ذهب،[34] ولكن أوروبا كانت أكثر اهتماماً بمصالحها منها برعاية التغريب الديمقراطي في الدولة العثمانية وأثبتت طمعها بأرض العثمانيين الدستوريين الديمقراطيين كطمعها بأرض الاستبداد الحميدي، مما دمر إمكانات التطور الديمقراطي في الدولة العثمانية كما يقول المؤرخان شو،[35] وفي ذلك يقول مانسفيلد: ’’على الرغم من نظر بريطانيا وفرنسا بعين العطف والاستحسان لثورة الأتراك القوميين الشباب، فإنهما لم تكونا على استعداد لتقديم أية ضمانات إقليمية لموقع تركيا المتبقي في أوروبة في ضمن الولايات البلقانية ضمن نطاق الإمبراطورية التركية’’،[36] ورغم الميول الغربية الواضحة للحكام الجدد فإن تعارض مصلحة بلادهم بصفتها دولة عظمى لها كيانها المستقل مع مصالح الغرب الذي يريد الهيمنة جعلهم يتراجعون عن الميل للتحالف مع بريطانيا لما قامت الحرب الكبرى نظراً لأن هذا الخيار لم يكن متاحاً بسبب تضارب المصالح،[37] وهذا هو الفرق بين التغريب العثماني بصفته اتجاهاً يبحث عن مصالح دولته المستقلة عن الغرب، وإن كان باتباع نهج الغرب، وتغريب دولة التجزئة الذي أحس بضآلة كياناته ومن ثم عدم قدرتها على فرض مصالح مستقلة عن الدول العظمى مما جعله يتبع سبيل خدمة هذه المصالح لعله يصيب شيئاً في ظلها.
’’وقد أدرك الساسة العثمانيون أن اتخاذ الدولة العثمانية موقفاً محايداً في هذه الحرب لن يكون في مصلحتها وذلك لأن الطرف المنتصر سيعمد لا محالة إلى تجزئة الدولة العثمانية’’،[38] ولأن الحلفاء كانوا يطمعون في الأراضي العثمانية فضلاً عن احتلالهم الفعلي أجزاء كبرى منها،[39] قرر الساسة العثمانيون دخول الحرب إلى جانب ألمانيا[40] حين خطت الدولة العثمانية بدخولها الحرب خطوة مصيرية هدفت إلى تحرير نفسها من كل القيود التي فرضتها حالة الضعف عليها كسوء استخدام الامتيازات الأجنبية والديون، والعودة إلى مكانتها السابقة بين الكبار واستعادة كل ما سلب منها من أقطار وحماية نفسها من مزيد من الغزو،[41] ورغم الانتصارات التي حققتها جيوش الخلافة في هذه الحرب على جبهات اسطنبول والعراق وفلسطين والحجاز والقوقاز والبلقان، كانت النتيجة النهائية في غير صالحها، ويلاحظ المؤرخون أن الحرب الكبرى أصبحت نقطة تحول في السياسة الغربية تجاه الدولة العثمانية، وفي ذلك تقول موسوعة التاريخ والحضارة إن الحلفاء اغتنموا ظروف الحرب لتقسيم السلطنة ووضع نهاية للمسألة الشرقية وتم وضع المشاريع التقسيمية، وكان لبريطانيا الدور البارز فيها وكانت محور السياسات والاتفاقات السرية المتناقضة أحياناً، وإنه منذ دخول السلطنة العثمانية الحرب، بدأت المشاورات السرية لتقسيمها،[42] وكانت بريطانيا تراسل الشريف حسين ’’والفرنسيون يحذرون من قيام دولة عربية كبرى، خوفاً على مصالحهم في شمال إفريقيا - أي تونس والجزائر والمغرب- كما يخافون على مستقبل مصالحهم في شرق المتوسط، وكذلك كان الإنكليز يخافون من قيام دولة عربية كبرى ولو تظاهروا بالموافقة على قيام هذه الدولة’’،[43] ولهذا لم يعترف الحلفاء بالخلافة العربية بعد قيامها في أعقاب إلغاء الخلافة العثمانية[44] رغم كونهم من شجعوا الدعاية لها سابقاً لطعن شرعية العثمانيين بها وحاولوا زمناً أن يستغلوا إحياء المنصب لصالحهم إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل،[45] وهو ما يؤكد حرص الغرب على إبقاء منطقتنا ضعيفة تحت هيمنته دون قوة ذاتية بغض النظر عمن يحكمها، ولهذا عارضت الدول الكبرى قيام الخلافة العربية رغم تعهداتها لحلفائها العرب واتفقت مع مصطفى كمال على إنهاء الخلافة العثمانية رغم العداوة الظاهرة بين الطرفين الكمالي والأوروبي، وإن هذا الإصرار على مقاومة إحياء الخلافة حتى في الحجاز لا يمكن أن يفسر بمجرد ضعفها أمام الأطماع الروسية لأن الدول التي قامت على الأنقاض العثمانية لم تكن أكثر قوة منها، كما أن روسيا نفسها أصبحت من معسكر الحلفاء ضد دول الوسط وصارت الدولة العثمانية عائقاً في وجه وصول الدعم الغربي إليها في الحرب الكبرى الأولى،[46] ولهذا توجب البحث عن السبب في إلغاء الخلافة في مكان آخر ستفصح عنه الوثائق كما سيأتي.
وفي هذا الموضوع تقول موسوعة السياسة إن هذه الحرب كانت فصل الختام في حياة الإمبراطورية العثمانية ’’فبعد أن مكثت حاجزاً، حقيقياً أو شكلياً، في وجه أطماع أوروبا الاستعمارية عدة قرون، جاءت الفرصة عندما تحالفت مع ألمانيا والنمسا ضد الحلفاء، فقرروا الانتقال من مرحلة المحافظة على ضعفها ووراثتها بالتدريج إلى مرحلة اقتسام بقايا أملاكها والإجهاز عليها مرة واحدة، وكانت اتفاقية سايكس- بيكو سنة 1916 إطاراً لهذا المخطط الجديد، الذي توج بانتزاع كل أملاك الدولة العثمانية في آسيا بموجب معاهدة سيفر، وذلك عندما انتصر الحلفاء سنة 1918، ثم قام كمال أتاتورك (1298- 1357 هجرية، 1880- 1938 م) بإنقاذ الوطن الأصلي للأتراك، وأراد انتزاع عداء أوروبا وإزالة مخاوفها، فأدار ظهر دولته التركية الحديثة لماضي العثمانيين الإسلامي... (و) أعلن إلغاء الخلافة رسمياً ونهائياً في 3 آذار- مارس 1924 م’’،[47] وفي سبيل استرضاء أوروبا قدم لها أتاتورك ما رغبت به في معاهدة سيفر التي وصفت بالمذلة ومع ذلك تم تطبيقها على كل الأراضي العثمانية بما في ذلك المصادقة على وعد بلفور في فلسطين مقابل استثناء تركيا وحدها،[48] وقد أفصح ضابط المخابرات التابعة للجيش البريطاني لورنس العرب من ميدان المعارك التي انهمك فيها ضد الدولة العثمانية عن الأهداف الحقيقية لبلاده في هذه الحرب.
* الصمود العثماني الأخير وعلاقته بإنهاء الخلافة
ولكن بقاء الكيان العثماني الموحد حمل في طياته خطر عودة الروح إلى هذا المجال الهائل، فبريطانيا لم تغفل يوماً عن خطر السيادة الدينية للخليفة العثماني على ملايين المسلمين الذين يحكمهم الاستعمار البريطاني، ولكنها أجلت مواجهة هذا الخطر لتواجه خطر سقوط الدولة العثمانية وما سيعقبه من فوضى دموية بين الذئاب الأوروبية في المنافسة على اقتسام التركة،[49] وبعدما تغيرت الظروف باندلاع الحرب الكبرى واللجوء إلى القوة العسكرية لحل الخلافات الأوروبية بين الأعداء والاتفاقيات والمساومات السرية مع القوة العسكرية لحل الخلافات بين الحلفاء أولاً، وانضمام روسيا إلى الحلفاء ثانياً ثم قيام الثورة البلشفية التي أسقطت الحكم القيصري وتدخل الغرب عسكرياً لإسقاطها ثالثاً، لم يعد الخطر الروسي هو المحرك لفكرة التخلي عن بقاء الدولة العثمانية، واستجد مكانه الخطر الألماني الذي لاحظ لورنس العرب وغيره أنه نقل فاعلية الخطر العثماني إلى مستوى أكبر مما سبق[50] كما سيأتي في رسائله السرية، ولكن العثمانيين لم يكونوا مجرد أدوات بأيدي الألمان وكان لهم جدولهم ومصالحهم الخاصة،[51] وقد أفصحت نتائج الحرب عن إدراك الحلفاء ذلك إذ لم ينل الخطر الألماني من التصدي والمواجهة ما نالته الدولة العثمانية، وعن مكانة العثمانيين في هذه الحرب تقول الدكتورة تهاني عبد الرحمن: ’’ولم تكن الدولة العثمانية في ذلك الوقت تقع في مصاف الدول الصغرى، رغم كل ما فقدته في فترات ضعفها واضمحلالها، من ولايات تابعة، بل كانت تُعد دولة كبرى، ومن ثم حرصت ألمانيا على جرها للصراع الدائر فوق أرض القارة الأوروبية’’،[52] ورغم تردد دول الوسط في ضم العثمانيين في البداية وخشيتها من تحولهم إلى عبء عليها فقد أثبت الجيش العثماني فعالية لم يتوقعها أحد،[53] وفي ذلك يقول المؤرخ بيتر مانسفيلد ’’عندما اندلعت الحرب، ورغم عدم شك معارضي تركيا ببسالة وإقدام وشجاعة الجنود الأتراك في الحروب، فإنهم فوجئوا بأدائهم المتطور وازدياد معارفهم في فنون القتال كما أن جاهزيتهم العالية في خوض الحروب الحديثة فاقت التوقعات،[54] وستفصح الوثائق الغربية عن حقيقة النوايا تجاه الخطر الإسلامي، وبعد إلغاء الخلافة العثمانية نفسها ومحاولة إحياء الخلافة العربية سنجد استمرار المعارضة الغربية لهذا المشروع الذي رعته دول أوروبا بأنفسها في البداية.
* علاقة الغرب بإلغاء الخلافة الإسلامية
1- وثائق دامغة
لما بدأت الحرب الكبرى الأولى (1914) أصبح القضاء على الدولة العثمانية هدفاً متداولاً ومعلناً بين الحلفاء كما صرحت بذلك الصحف البريطانية فور الدخول العثماني في الحرب، فما ’’أن بدأت الأعمال العسكرية ضد تركيا، في 5 تشرين الثاني، سنة 1914، حتى شرعت الصحافة البريطانية بإيضاح ما سيحل بتركيا، وما عسى أن يكون مصيرها، ففي يوم 23 تشرين الثاني كتبت جريدة الدايلي مايل (Daily Mail) تقول: ’’لسنا نشك في أن الامبراطورية العثمانية على الأرض الأوروبية التي أنشأها الأتراك بحد السيف، سيُقضى عليها بحد السيف’’، وفي 31 تشرين الثاني كتبت جريدة الدايلي نيوز (Daily News) تقول: ’’إذا خسرت ألمانيا الحرب فإن عقاب تركيا لدخولها الحرب إلى جانب ألمانيا سيكون القضاء التام عليها كدولة’’، وبما أن هدف بريطانيا كان القضاء على تركيا قضاء مبرماً، فإنها وجدت نفسها عالقة في ديبلوماسية شائكة معقدة’’.[55]
بل إننا نجد قبل بداية الحرب الكبرى ما يشير إلى نوايا التقسيم والتجزئة منذ سنة 1912عند اللورد كتشنر القائد الأعلى للقوات المسلحة في مصر وسفاح السودان ثم المعتمد البريطاني في مصر ثم وزير الدفاع البريطاني، إذ تبين أنه كان أثناء وجوده في مصر راسخ الاعتقاد بأن سوريا الجنوبية من خليج العقبة إلى حيفا وعكا تؤلف ’’منطقة ذات مغنم لا يستغنى عنها بالنسبة إلى الإمبراطورية البريطانية’’ وذلك بعد دراسة عسكرية لصحراء سيناء أمر بإجرائها سنة 1913.[56]
وقد صرحت الدوائر الرسمية للحلفاء بعد اندلاع الحرب بهذا الهدف كما كشف عن ذلك ’’بيان عن السياسة الخارجية مرفوع إلى المجلس الحربي الملكي’’ الذي قام اللورد بلفور وزير الخارجية البريطاني وصاحب الوعد المشئوم ورئيس البعثة البريطانية الخاصة الذي كان في زيارة للولايات المتحدة بتسليم نسخة منه إلى وزير الدولة الأمريكي وجاء في هذا البيان الصادر في سنة 1917: ’’لاشك أن القضاء على الامبراطورية العثمانية قضاء تاماً هو من أهدافنا التي نريد تحقيقها، وقد يظل الشعب التركي، ونأمل أن يظل، مستقلاً أو شبه مستقل في آسيا الصغرى، فإذا نجحنا فلا شك أن تركيا ستفقد كل الأجزاء التي نطلق عليها عادة اسم الجزيرة العربية (Arabia) وستفقد كذلك أهم المناطق في وادي الفرات ودجلة، كما أنها ستفقد استانبول، أما سوريا وأرمينيا والأقسام الجنوبية من آسيا الصغرى فإنها، إن لم تضم إلى الحلفاء، فمن المرجح أنها ستبقى ضمن حكمها’’،[57] هذا بالإضافة إلى وثائق كتبها لورنس العرب أثناء الثورة العربية.
ففي تقرير كتبه لورنس في يناير/ كانون الثاني/ جانفي 1916 تحت عنوان سياسات مكة قال: ’’إن تحرك (الشريف حسين) يبدو مفيداً لنا، لأنه ينسجم مع أهدافنا المباشرة: تحطيم الجبهة الإسلامية الموحدة وهزيمة وتمزيق الامبراطورية العثمانية، ولأن الدول التي سيقيمها (الشريف) خلفاً لتركيا ستكون غير ضارة بنا كما كانت تركيا قبل أن تصبح أداة في أيدي الألمان. إن العرب أقل توازناً من الأتراك، وإذا عولج أمرهم بشكل مناسب فإنهم سيظلون في حالة من الشرذمة السياسية، نسيج من الإمارات الصغيرة المتحاسدة غير القابلة للتوحد، ومع ذلك يمكنها الاجتماع في مواجهة أية قوة خارجية’’،[58] وهذا الاجتماع الذي يقلق لورنس ورؤساءه هو ما يعمل الغرب جاهداً لمنعه منذ تلك الأيام.
ويختم تقريره قائلا إن الشريف حسيناً ’’يفكر يوماً بالحلول محل السلطة التركية في الحجاز، ولو تمكنا من ترتيب هذا التغير السياسي ليكون بالعنف، سنقضي على خطر الإسلام بجعله ينقسم على نفسه في عقر داره، وسيكون هناك خليفة في تركيا وخليفة في الجزيرة العربية في حالة حرب دينية، وسيصبح عجز الإسلام كما كان عجز البابوية عندما كان الباباوات في أفنيون’’[59] (وهي فترة تراجعت فيها هيمنة البابوية وسميت الأسر البابلي للكنيسة 1309- 1377 تشبيها بأسر بني إسرائيل على أيدي البابليين في القرن السادس ق. م، وقد أعقبها انقسام وصف بالعظيم نتيجة وجود بابا في روما وآخر في أفنيون 1378- 1417).
وفي تقرير حمل عنوان’’لو تم احتلال سوريا’’ وكتبه لورنس سنة 1916 أيضاً لاقتراح حل للمشكلة التي يسببها إعلان الخليفة العثماني الجهاد ضد الحلفاء الذين يحتلون بلاداً يقطنها ملايين المسلمين، قال لورنس: ’’مهما نتج عن هذه الحرب، فإنها يجب أن تقضي تماماً ونهائياً على السيادة الدينية للسلطان’’.[60]
2- اختلاف مصير الدولة العثمانية عن مصير ألمانيا بعد الحرب
وكان المصير الذي تعرضت له الدولة العثمانية التي ساحت جيوش المحتلين في أراضيها يختلف عما نال ألمانيا التي لم تحطم في نهاية الحرب، وهذا ما صرحت به الصحافة البريطانية منذ بداية الحرب كما سبق، ولم تخف هذه المفارقة عن ملاحظة المؤرخين: ’’إن الامبراطورية العثمانية لم (تنهار). هذا تعبير شديد السلبية. لقد مزقوها إرباً مثلما تخلع مفاصل الدجاجة قبل الأكل، حتى ألمانيا نفسها لم تتكبد تقطيع الأوصال وانتزاع الأحشاء ’’كما يقول المؤرخ جيرمي سولت.[61]
وقد لاحظ المؤرخ فيليب كورتن نفس الملاحظة حين قال إن الحلفاء وضعوا أثناء الحرب خططاً متنوعة لتقسيم تركيا (الدولة العثمانية)، وكان هناك تفكير مسيطر وراء العهود المحددة التي أطلقتها الطبقة السياسية في بريطانيا، وفرنسا وإيطاليا يتمثل بعدم عد الدولة العثمانية دولة مهزومة وعدواً متحضراً مثل ألمانيا، بل كدولة يجب أن تعامل كما عوملت ممالك أخرى غير غربية أثناء العهود الاستعمارية الكبرى، وكانت غايتهم تجزئة الإمبراطورية العثمانية وتقسيم الباقي إلى مناطق نفوذ مما أعطى فرنسا وبريطانيا وإيطاليا على التوالي سلطات واسعة في الإمبراطورية العثمانية السابقة وعلى ما تبقى منها.[62]
وقد شاركت الولايات المتحدة أوروبا في كراهية العثمانيين بشكل خاص، وفي ذلك يقول المؤرخ أورين إن الرئيس الأمريكي وودرو ويلسن عندما حضر إلى مؤتمر السلام في باريس سنة 1919 كان يحمل قيمه ومثله وأفكاره المسبقة كذلك، فقد ’’كان يحتقر كل أشكال الاستعمار الأوروبي، ومنها الاستعمار البريطاني (ونسي استعمار القارة الأمريكية الذي كان قد اكتمل قبل سنوات قليلة)، وأظهر نفوراً خاصاً للأتراك، ومنذ 1889 كان يصف الإمبراطورية العثمانية بأنها غير طبيعية ومثال متأخر على الأشكال غير المتقنة للسياسة التي نمت عليها أوروبا’’، ويقر المؤرخ نفسه أن الرئيس كان ’’لا يعرف عن جغرافية المنطقة وثقافتها وتقاليدها أكثر مما قرأ في الإنجيل’’.[63]
وكان التقارب الحضاري بين ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة مما دفع المنتصرين لتشخيص مصالحهم في بقاء القوة الألمانية وعدم الموافقة على تحطيمها لتظل عامل حفظ للتوازن الأوروبي تجاه فرنسا وللوقوف في وجه المد الشيوعي،[64] كل هذا يختلف عن حالة العداء الحضاري تجاه العثمانيين الذين كان القضاء عليهم قضاء مبرماً هو المصلحة الغربية، ومع ذلك لم تعجب الالمان سياسة الإملاء للحفاظ عليهم على مقاس المصالح المنتصرة وأدت شروط الصلح القاسية إلى اندلاع الحرب الكبرى الثانية في الوقت الذي كان الإجهاز على وحدتنا دافعاً لنا للتلاؤم مع المصالح الغربية والانسجام معها إلى حد أداء الخدمات لها.
* عمر التآمر طويل وسياسة فرّق تسد
إن الضربات المتلاحقة التي وجهت للدولة العثمانية تثبت النوايا الغربية بشكل يلغي الحاجة إلى إثبات أن بريطانيا اشترطت إلغاء منصب الخلافة الإسلامية على الجانب التركي في مؤتمر لوزان سنة 1923، لأن الموقف الغربي عموماً والبريطاني خصوصاً لم يقتصر على لحظة واحدة فقط من التآمر السري على منصب أصبح هزيلاً وشبيهاً بوزارة أوقاف في ظل إعلان قيام الجمهورية التركية، بل كان عداء علنياً لفكرة الخلافة نفسها حتى مع وجود مصلحة في بقائها ضد التوسع الروسي، وقد اتضح ذلك من سياسة الدول الغربية تجاه إضعافها ونهش أطرافها لمدة تزيد على قرن من الزمان أثبتت فيها الحوادث والحروب الكبرى حقيقة النوايا التي اختلفت فيما بينها فقط على طريقة اقتسام الغنائم، التي هي بلادنا، ولم تختلف على فكرة التقسيم ذاتها، وكان هذا هو محتوى ’’المسألة الشرقية’’التي تريد حلاً، أو كما قال مراقب أكاديمي أمريكي عاصر الحرب الكبرى الأولى وكتب في سنة 1917 أن ’’الأمم الأوروبية منذ بداية القرن التاسع عشر اجتمعت كالصقور حول الجثة لاقتطاع ما يمكنها من الامبراطورية التركية’’،[65] فكان احتلال الجزائر (1830) ضمن هذا الإطار وتبعه احتلال عدن (1839) ثم قبرص والبوسنة والهرسك (1878) ثم احتلال تونس (1881) ثم جاء احتلال مصر (1882) ليكون ضربة قاصمة للعثمانيين، ثم جاء احتلال ليبيا (1911) وتبعه مباشرة حربا البلقان (1912- 1913) والتي سلخت جميعها أجزاء كبرى من الدولة بعد قرن من إثارة صربيا (1817) ثم اليونان (1821- 1830) ثم بلغاريا (1878).
ويلاحظ المؤرخ جستن مكارثي أن الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر كانت مطوقة بخصوم أقوياء لم يتيحوا لها ’’فسحة للتنفس’’ لترتيب بيتها الداخلي ببناء دولة حديثة وجيش قوي واقتصاد صناعي، واضطروها لخوض حروب متتالية في الأعوام التالية كالحرب مع روسيا (1806- 1812) والحرب الثانية مع روسيا أيضاً (1828- 1829) والحرب مع محمد علي باشا التي أججتها أوروبا ومنعت التفاهم بين طرفيها[66] (1832- 1833) و(1839- 1840) وحرب القرم مع روسيا (1853- 1856) والحرب الرابعة مع روسيا كذلك (1877- 1878) والحرب مع اليونان (1897) وحروب البلقان (1911- 1913) والحرب الكبرى الأولى (1914- 1918) وحرب الاستقلال (1919- 1923)، إضافة إلى حوادث العصيان المسلح الكبرى في مصر عام (1804) والانتفاضة الصربية (1815- 1817) والثورة اليونانية (1821- 1830) والثورة في جزيرة كريت (1866- 1868) والثورة في بلغاريا (1875) و(1876) والتمرد الأرمني (1896- 1897)، وهلكت الجيوش العثمانية التي كانت في طور التدريب وأُجبرت على خوض الحروب وهي غير مهيأة، وأُنفقت الموارد المالية الازمة للتحديث على هزائم أدت إلى خسارة الأرض والدخل، فكان الضعف هو سبب خسائر العثمانيين التي أبقتهم أضعف من القدرة على النهوض.[67]
وكانت الاتفاقيات السرية التي قسمت المشرق العربي وبقية الأراضي العثمانية والتي جرت أثناء الحرب الكبرى جهداً واضحاً موجهاً لإنهاء الدولة العثمانية (مثل اتفاقيات سايكس- بيكو ولندن والآستانة وغيرها) وتندرج الثورة العربية برعاية بريطانيا (1916) ثم وعد بلفور (1917) ضمن محاولات تحطيمها وتقسيمها أيضاً، ولهذا كانت النهاية المنطقية لكل هذه الجهود السابقة هي القضاء الفعلي على الدولة العثمانية بعد فقدانها مساحاتها الممتدة، ولم يكن انهيارها وليد لحظة تآمر نظري في مؤتمر لوزان، وقد كان إنهاؤها من أبرز ’’إنجازات’’ الحرب الكبرى كما صرح بذلك ساسة ومؤرخون من أوروبا وأمريكا،[68] ويؤكد مصير الشرق العربي بعد الحرب حين اتفقت أوروبا على اقتسام بلادنا وفق اتفاقات التجزئة آنفة الذكر ونكثت بوعود التحرر التي بذلتها للعرب أن عداءها ليس مع كيان سياسي محدد، كما ادعت كذباً لتغوي العرب، بقدر ما هو عداء مع أي وحدة شاملة تلم شعث بلادنا كما أثبتت الأحداث لاسيما برفض الاعتراف بالخلافة العربية التي طالما رعى الغربيون الدعوة إليها، وفي هذا السياق قال ونستون تشرتشل عندما كان وزيراً للمستعمرات سنة 1920 تعليقاً على محاولات التعاون العربي مع الأتراك مرة ثانية لمواجهة غدر الحلفاء، تلك المحاولات التي أقلقت بريطانيا فقال الوزير البريطاني: ’’هنالك جماعة من العرب تبدي تخوفاً من احتلال (الفرنسيين) سوريا، وهي تميل الآن، ولأول مرة، لضم صفوفها، بطرق مختلفة، إلى الأتراك الوطنيين على أن قضيتهم واحدة مشتركة، وهكذا تتم وحدة بين قوتين كنا نفيد دوماً من انقسامهما لا من وحدتهما’’،[69] وهكذا أسفر البريطانيون عن حقيقة نواياهم بأنها مجرد الإفادة من الانقسام العربي التركي وليس تحقيق أماني العرب ولهذا احتلوا بلادهم غنيمة بينهم وبين الفرنسيين ولم يحققوا لهم آمالهم، وهذه هي النتيجة المثالية للاستقواء بالأعداء وتمكينهم من الهيمنة على الدار ليقوموا بضرب كل محاولات التوحد والنهوض فيما بعد، وها نحن مازلنا في نتائج تلك الحقبة المريرة إلى اليوم.
* الغرب يمنح أرباب التجزئة ’’انتصارات’’ منسجمة مع مصالحه لأن طموحاتهم لا تتحدى هذه المصالح بل تخدمها ولا تنهض بالأمة
ولهذا فإن ما قام به مصطفى كمال عندما ألغى السلطنة العثمانية والخلافة الإسلامية يلتقي موضوعيا مع أهداف الحلفاء الغربيين ولم تخرج إنجازاته الجغرافية عما رسمه بلفور أمام الأمريكيين، وما رسمه الرئيس الأمريكي ويلسن الذي صرح في سنة 1912 قبل اندلاع الحرب الكبرى بأنه إذا دخل العالم الحرب فلن يكون هناك وجود للدولة العثمانية،[70] ثم كرر ذلك في نقاطه ’’المثالية’’ الأربعة عشر التي لم تطبق جميعها ولكنها تفصح عن رؤية الولايات المتحدة تجاه تركيا كما جاء في النقطة الثانية عشر التي طبق شطر منها يناسب خطط بريطانيا وفرنسا: ’’يجب أن يُضمن الاستقلال الثابت لأجزاء الإمبراطورية العثمانية الحالية التي أغلب سكانها من الأتراك، وأما الأقوام الآخرون الخاضعون الآن للحكم التركي فيجب أن يُضمن لهم أمن على حياتهم لا شك فيه، وأن تُعطى لهم فرصة مطلقة لا يجدون فيها ما يعوقهم عن بلوغ استقلالهم، وأما الدردنيل فيجب أن يظل مفتوحاً ويصير ممراً حراً لسفن جميع الأمم وتجارتها في ظل ضمانات دولية’’،[71] ولقد استقل الأناضول بالفعل واستقلت القوميات غير التركية عن الدولة العثمانية وفتحت المضائق ولكن الانتداب حل بالبلدان غير التركية فلم يكن استقلالها كاملاً وفق البند الأمريكي، وقد أوضح مصطفى كمال للأوروبيين أهدافه بالقول ’’إنكم تستطيعون أن تنالوا سوريا وبلاد العرب، ولكن كفوا أيديكم عن تركيا، فنحن نطالب بحق كل شعب داخل حدود بلاده الضيقة’’[72] وهو ما يتفق مع المخطط الأوروبي السابق، ولهذا لم يمانع الحلفاء في إلغاء معاهدة سيفر المذلة (1920) بعدما منحهم النظام الكمالي في معاهدة لوزان (1923) الموافقة على تطبيق تلك المعاهدة السابقة على كل البلاد غير التركية وهو ما قامت به الدول الأوروبية بموافقة عصبة الأمم التي جعلت هذه البلدان العثمانية السابقة خاضعة للانتداب، واستثنيت تركيا من ذلك، فكان هذا الاستسلام هو ’’أهم الانتصارات السياسية’’ لاتجاه التجزئة القومية،[73] ولم تمانع أوروبا في المصادقة على ذلك التحجيم الذي ’’كرس دولياً نهاية السلطنة العثمانية وقيام الجمهورية التركية’’ الذي حقق حلم القوميين الأتراك وسياسة التتريك التي طبقوها وصار هذا هو الانتصار الكبير للدولة التركية،[74] ولكنه لم يكن انتصاراً على الأعداء بل بموافقتهم وتصديقهم وإقرارهم، فقد ’’أجبرت انتصارات مصطفى كمال – آنذاك- الدول الأوروبية على الاعتراف بأهمية حركة الأناضول، سيما وأن برنامجه استند على أسس قومية وانبثقت عنها مبادئ الميثاق التركي الذي أُعلن في 28 يناير 1920 محدداً أبعاد الدولة سياسياً وجغرافياً، وتنازلها عن كل المناطق المسكونة بأغلبية غير تركية، رفعاً عن كاهلها مشاكل إمبراطورية كاملة، وقد توالت اعترافات الحلفاء بالحركة الكمالية، واعترفت فرنسا رسمياً بحكومة أنقرة، مما أنهى حالة الحرب بين الدولتين، وتجاوبت الدول الأوروبية كلها مع نظرية مصطفى كمال بشأن الإمبراطورية العثمانية، وحمدوا له نظرته المختلفة تماما عمن سبقوه في اعتبار مشاكل الإمبراطورية عبئاً ثقيلاً على كاهل الأتراك ينبغي عليهم أن يتخلصوا منه ليتفرغوا لحركتهم الوطنية القومية’’،[75] والغريب أن لا تنصح الإمبراطوريات الغربية أنفسها بنفس النصيحة فتتخلص من الأعباء الإمبراطورية وتتفرغ لشئونها القومية(!)
وقد ظهر هذا الاتفاق بين توجهات الحلفاء وتوجهات أتاتورك أثناء حربه الاستقلالية حين ’’اتفق مع فرنسا فسحبت جيشها من كيليكيا، واتفق مع الطليان فانسحبوا من الأناضول’’ فتفرغ لقمع الأكراد فضربهم وأخضعهم بعنف ثم ضرب الأرمن بقساوة وقاد ضدهم حرب إبادة وتهجير وقتل الألوف وهجر الباقين، والغرب الذي تاجر بدمائهم يقف متفرجاً، ولزم الإنجليز الحياد فيما هو يقود جيشه ويدخل إزمير ويحرقها وينكل بأهلها ’’وبعد أن أتم مصطفى كمال السيطرة على آسيا الصغرى، انتقل إلى اسطنبول وفيها جيش إنكليزي، لكن لم يطلق النار’’،[76] ويتحدث الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى عن توقيع الفرنسيين اتفاقية أنقرة مع الكماليين في سنة 1921 وتركوا لهم بعدها كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة مما ساعد الأتراك على القتال ضد اليونانيين وأن هذه المعاهدة أكدت توجهات فرنسية سابقة لمساندة الحركة القومية التركية ضمن الصراع بين نفوذ الحلفاء في الأناضول وبموجب ذلك ’’أقرت فرنسا الميثاق الوطني وتخلت عن معاهدة سيفر وتفرغت بعد ذلك لمواجهة الحركة الوطنية السورية، كما جلا الإيطاليون عن المناطق التي كانوا قد احتلوها في جنوبي الأناضول وإن احتفظوا بجزر الدوديكانيز، وقد تخلوا هم الاخرون للوطنيين عن كميات من الأسلحة مما عزز مركزهم وجعلهم يقررون استكمال تحرير الأناضول وأراضي تركيا الأوروبية’’.[77]
وكما سبق ذكره لقد اتفقت توجهات الغرب مع توجهات الحكم الكمالي الذي منح الغربيين كثيراً مما طلبوه فلم يروا تضحية كبرى فيما طلبه لاسيما أنه ينطبق على ما كانوا قد خططوه لمستقبل المنطقة بعد الحرب إذ لم يكن احتلال الأناضول من ضمن أهدافهم بعد تقسيم الشرق العربي والقضاء على الخلافة العثمانية عملياً باحتلال معظم عمقها الجغرافي ولم يتبق سوى الإجهاز الرسمي عليها، وفي هذا يقول المؤرخ كواترت إن دفاع الأتراك عن موطنهم القومي دفع بريطانيا وفرنسا إلى العدول عن احتلال البلاد بعد أن شعروا بأن ذلك سيكلفهم غالياً، والحق أن القادة الأتراك آنذاك كانوا على استعداد للتفاوض مع الحلفاء حول قضايا معينة مثل (1) تسديد الديون التي تراكمت على الدولة العثمانية قبل الحرب، و(2) الممرات البحرية التي تصل البحر الأسود ببحر إيجه، و(3) التنازل عن سيادتهم على الأقطار العربية، وأخيراً تم الاتفاق بين القوى العظمى والقوميين الأتراك على الإقرار بزوال الإمبراطورية العثمانية الذي أصبح حقيقة واقعة’’.[78]
ويظل النقاش بعد ذلك على ما سمي شروط كيرزون الأربعة الخاصة باشتراط إلغاء الخلافة في مؤتمر لوزان سنة 1923 ومحاولة إثباتها مقابل نفيها مما لا طائل منه، لأن مصطفى كمال تشرب الأهداف الغربية وتبناها - كما فعل غيره من دعاة النهوض عن طريق استرضاء الغرب- ونفذها من تلقاء نفسه ولا حاجة لإثبات أنه تلقى أمراً بذلك في عرض مسرحي أو لم يتلق، فما هو مثبت أنه تبني وجهة نظر العدو وهذا أسوأ من تنفيذ أوامره بالإكراه، ومع ذلك لا يغيب عن ملاحظة المؤرخين الصلات الموضوعية التي ربطت بين الحكم الكمالي والغرب الأوروبي: ذلك أن النظام الدولي الجديد الذي أنشأته الدول الكبرى في منطقة الشرق العثماني بعد الحرب الكبرى قام على أساس إنهاء الدولة العثمانية وتقطيع أوصال البلاد العربية،[79] وقد تعاون الكماليون مع الغرب في النقطتين معاً بإلغاء الخلافة وبالتنازل عن الأملاك العربية للدولة العثمانية وهو أمر كان ذا أهمية قصوى للحلفاء المستعدين للانقضاض على أملاكها كي يرتبوا تقسيمها فيما بينهم بشكل قانوني يمنع التنازع فيما بينهم، ولهذا قال وزير الخارجية البريطاني اللورد كيرزون في برقية إلى اللورد اللنبي في مارس 1920 إن نظام الانتداب يقتضي أن تعترف الدولة التي كانت صاحبة السيادة على إقليم بتنازلها عنه،[80] فلم يكن من الغريب بعد ذلك أن تؤيد الدول الكبرى النظام الكمالي الجديد.[81]
وهناك ما يشير إلى سعي مصطفى كمال المبكر، سواء لأسباب قومية أو غيرها، لإفشال محاولات رأب الصدع ورص الصفوف العثمانية، ومن ذلك قيامه بحض الأمير فيصل بن الحسين على عدم الإصغاء لعروض الصلح التي قدمها جمال باشا للعرب بعد إعلان ثورتهم، وقد وعد كمال فيصلاً بدعم المعارضة التركية ومهاجمة الجيش العثماني وحلفائه الألمان من الأراضي التي تسيطر عليها عندما يستقل العرب ويستقرون في عاصمتهم دمشق، وقد تحدث لورنس العرب عن ذلك بالتفصيل،[82] وغني عن التوضيح من هي الجهات المستفيدة من الغدر بالجيش العثماني في أثناء الحرب الكبرى ضد الحلفاء، وعن الجهود البريطانية يقول كواترت: ’’كانت جهود بريطانيا لطرد العثمانيين من مكة والمدينة وتدمير خط حديد الحجاز أثناء الحرب الأولى ترمي إلى تجريد السلطان من مكانته الدينية في أعين المسلمين، وهو الهدف الذي سعى السلفيون لتحقيقه قبل أكثر من قرن’’،[83] ولهذا لم يكن من الغريب تعاون كبار السلفيين كمحمد رشيد رضا ومحب الدين الخطيب مع الثورة العربية.
* الاستقلال السياسي لم يكن يعني استقلالاً حقيقياً عن الغرب بل ربما كان باب التبعية
مع سريان موجة الثورات التحررية من الاستعمار في العالم الثالث كان كثير من قادتها معجبين بالغرب إلى حد الانبهار والهوس، ولكنهم كانوا يطلبون الاستقلال السياسي مع التبعية الحضارية دون فك عرى الروابط السياسية التي ظنوا أنهم سيحققون بها المصالح الضيقة للأمم الصغيرة المكونة حديثاً على أنقاض الوحدة العثمانية السابقة، ولأن حجم الأمة يفرض عليها حجم طموحاتها ومدى إدراكها فإن طموحات الصِغار فرضت عليهم منطق الصَغار، فمن زعماء ’’التحرير’’ من قاتل المستعمر للحصول على الاستقلال السياسي ضمن التبعية الحضارية لنفس الدولة التي يقاتلها، ومنهم من استقوى بدول غربية أخرى تنافس الدولة المستعمرة لبلاده وراهن على هذا التنسيق ليحقق به شيئاً وليظل فيما بعد في ظله أو ليخيب أمله بعد اكتشافه أن الغربيين لا يختلفون عن بعضهم البعض، ومنهم من كان المستعمر يحركهم للقيام بثورات تستبق تحركات شعبية متوقعة بعدما وصل السيل الاستعماري إلى الزبى، أما من أصيب بجنون العظمة من الحكام فكان أقصى ما يرجوه هو دور الوكيل الإقليمي للدول الكبرى ليتباهى به على أقرانه الصغار، أما من تجاوز هذا الحد بعد زمن من التنسيق مع الكبار وأخذته العزة بالإثم من وجهة نظر المستعمرين فلم يكن له إلا المقصلة، ولكن في جميع الأحوال لم يتحقق التحرير الحقيقي من الروابط الاستعمارية نتيجة قلة إمكانات وقدرات دولة التجزئة المجهرية التي فقدت العمق الجغرافي والقدرات السكانية والموارد المادية الضخمة التي كان من الممكن أن يحركها حكم قوي للوصول إلى مكانة الدولة العظمى، والغريب أن زعماء التغريب لم يسعوا لتقليد الغرب في وحداته السياسية الكبرى العابرة للقوميات لاسيما الولايات المتحدة التي كانت محط الأنظار آنذاك.
ويندرج الحكم الكمالي ضمن الفئة التي قاتلت للحصول على الاستقلال السياسي مع الهوس بالتبعية الحضارية التي تشترط نسيان كل الروابط والجذور الحضارية والمصالح الكبرى المتخطية للحدود التي رسمها الاستعمار، ومن ذلك أنه ’’كان يثمن إنكلترا ويحترمها، ولكنه كان يؤمن إيماناً راسخاً بمبدأ الاستقلالية والذي ربطه بمقولته الشهيرة: لكي تعيش في سلم وصداقة مع إنكلترا، فقد ترتب على تركيا أولاً أن تقاتل’’،[84] ولعل هذه الفكرة تذكرنا بقتال قادة مثل الرئيس اللبناني السابق كميل شمعون ضد الاحتلال الفرنسي للبنان مع إعجابه الشديد بالثقافة الفرنسية وإيمانه بضرورة الاحتفاظ بعلاقات خاصة مع فرنسا بعد الاستقلال، وقد رأينا ما جرته هذه الأفكار على استقرار لبنان ومحيطها فيما بعد، ومن أقوال مصطفى كمال في شأن التبعية والاستسلام الحضاري بعد ’’الاستقلال’’: ’’إن هناك الآن طريقين علينا أن نتبعهما، فإما أن نقبل الهزيمة والفناء أو أن نقبل ذات المبادئ التي أوجدت الحضارة الغربية المعاصرة، وإذا كنا نرغب في البقاء، فإن علينا علمنة نظرتنا للدين والأخلاق والعلاقات الاجتماعية والقانون... إن هذا ممكن فقط بقبولنا بشكل علني وغير مشروط لذهنية وسلوك الحضارة التي نحن ملزمون بمحاكاتها’’،[85] ويتضح من الفقرة أن صاحبها يعتقد أن عدم الاستسلام المطلق يعني الفناء الفوري، وهي قدرية سبق أن عرضتها حضارة الحرية الغربية على شعوب أخرى كسكان أمريكا الأصليين: الاستسلام للتحضر أو الفناء،[86] ولكن هذه الشعوب لم تجن البقاء المتوقع وذلك بسبب أنانية الغربيين الذين دفعوها إلى الفناء ولم يرغبوا في نشر التحضر بينها بالفعل سواء بعد مقاومتها أو استسلامها، وكان تصوره للتمدن متعلقاً’’ بالتصرفات، القيم الجديدة المأخوذة نماذجها عن تفكير الأوروبيين، التقويم الغربي، الحروف اللاتينية، الموديلات، الأزياء وأشكالها، القبعة الأوروبية’’،[87] ولو رأينا حياته الشخصية بصفته حامل رسالة وفكرة لرأينا أنه ’’كان دمثاً وعاقلاً، إلا أنه كان رديء السمعة، سكيراً، مع حياة عائلية فظة، مولع بالمقامرة والنساء.. وكان قاسياً متحجر القلب في التخلص من الذين خاصموه سياسياً وأيديولوجياً، وكانت لهم خطورتهم عليه وعلى حكمه، فنفى بعضهم، وشنق بعضهم الآخر.. كانت له طاقة هائلة، واقتدارات ذاتية ثابتة’’.[88]
ولم يكن مصير المحاولة التركية بعد جهود جاهدة بذلها أتاتورك للحاق بالغرب سوى البقاء ضمن البلدان النامية وعدم القدرة على الوصول إلى مصاف الدول الصناعية واستمرار الاعتماد على الأموال الخارجية لسد الاحتياجات المحلية،[89] وهي تبعية كان يتوقع منها حصول التابع على القوة وعدم التهديد من المصالح الدولية الكبرى ما أثبتت التبعية جدواها للدول الكبرى وهو ما سيواصل التابع السعي إليه،[90] ولكنها أنتجت ما رضي أن يمنحه الكبار فقط بما يتلاءم ومصالحهم[91] كما فعلوا مع من قبلنا والفرق أنهم احتاجوا بقاءنا في الوقت الذي أفنوا غيرنا، وإن ظن المستظلون بحماية الدول الكبرى المنتفعة بهم أنهم حصلوا على ما يبتغون،[92] أو تخيلوا ذلك لعدم وجود بديل أمامهم، أي أن مصطفى كمال قدم استعداداً كاملاً لخدمة الأهداف الغربية مع محاولة تقمص هذه الأهداف وتصويرها أهدافاً ذاتية وهذا لم يكن تصوراً حقيقياً لأنه بمجرد النظر نعرف أن الانضمام لحلف شمال الأطلسي مثلاً، وهو إجراء يصنف ضمن سياساته التي حكمت خلفاءه ضمن نظرته الخاصة للعلاقة بالآخرين[93] وهي العمل على ’’كسب القبول في الغرب’’،[94] يلبي أهداف من بادر لتأسيسه وليس من كان على هامشه يقدم الخدمات العسكرية والاستراتيجية دون أن يكون حراً في الإفادة من التطوير الذي حصل عليه إلا بمقدار ما يقدم الخدمات لسادته (كوريا مثلاً حيث لا مصلحة وطنية لتركيا)[95] أو بمقدار فسحة الخلاف الموجودة بين السادة أنفسهم (الحرب الكبرى الثانية مثلاً)،[96] فأتاتورك مثلا وخلفاؤه اتبعوا قوله إنه بدلاً من ملاحقة أهداف مثالية لم ولن نقدر على تحقيقها لنتمسك بالعقل ونعرف حدودنا، ومن ذلك مثلاً قوله: ’’أليس من أجل الخلافة والإسلام ورجال الدين قاتل القرويون الأتراك، وماتوا طوال خمسة قرون؟ لقد آن الأوان أن تنظر تركيا إلى مصالحها، وتتجاهل الهنود، والعرب، وتنقذ نفسها من تزعم الدول الإسلامية’’،[97] وقال أيضاً: ’’إن شعبنا قد ترك ملايين البشر في كل مكان ذهب إليه ليخدم فيه، هل تعرفون عدد أبناء الأناضول الذين ماتوا ودفنوا في صحراء اليمن؟ وكم من البشر ماتوا من أجل المحافظة على العراق وسوريا، ومن أجل السيطرة على مصر، ومن أجل الاستحواذ على إفريقيا، هل تعرفون هذا؟’’.[98]
وبالطبع فإن هذا ليس منطق الولايات المتحدة مع نفسها، فهي لا تريد أن ’’تنقذ’’ نفسها من زعامة العالم الغربي، بل العالم كله، ولا تعد الزعامة مصيبة أصلاً يجب التخلص منها، لأن هذا منطق الصغير العاجز وهي ليست كذلك، ولا تتساءل عن جدوى موت أبنائها في أطراف العالم البعيدة مثل أوروبا وفيتنام وكوريا وأفغانستان والعراق وعشرات الدول التي تدخلت فيها أكثر من 130 تدخلاً عسكرياً قبل احتلال العراق،[99] ومازالت تتغنى بتدخلها في تلال المكسيك وشواطئ طرابلس الغرب في القرن التاسع عشر، ولا تصف أي هدف مهما بعد بكونه مستحيلاً بل تستمر في السعي كي لا يكون كبيراً في العالم غيرها، وهذا هو الفرق بين منطق الكبار المتبوعين ومنطق الصغار التابعين، وبين مصالح الكبار المستقلة ومصالح الصغار التابعة، وبنفس المنطق الصغير يرفض الكماليون زعامة المسلمين والموت لأجل القضية الإسلامية وينسى أتاتورك أو يتناسى ما ذكره بنفسه من استشهاد غير الأتراك كآلاف المصريين والسوريين والعراقيين دفاعاً عن عاصمة الخلافة في الحرب الكبرى الأولى[100] في دولة كان جميع من فيها يعمل ويقدم لأجل بنيانها الإسلامي الجامع دون حسابات وفواتير الانقسامات الإقليمية، ولكن الكماليين في الوقت الذي يضنون فيه بدمائهم الغالية على قضايا ’’مثالية’’ لا يرفضون أن يموتوا هم لأجل الولايات المتحدة في حرب كوريا مثلاً وينتشون بكلمات الإعجاب الغربي الفارغ بشجاعتهم،[101] دون أن يشركهم الغربيون إشراكاً فعلياً في مغانمهم بقبول تركيا مثلاً في مجتمع الاتحاد الأوروبي الذي لم يترك متسولاً أوروبياً دون ضمه مع الضن على تركيا بهذا المقام.
* هل كانت بلادنا ضعيفة في ظل الدولة العثمانية وهل أدى زوالها إلى قوتنا
نشأت الدولة العثمانية في نهاية القرن الثالث عشر (1299) وظلت مندفعة حتى هزيمتها الثانية على أسوار فيينا (1683) وشملت بلاداً لم تصلها الدول الإسلامية الكبرى قبلها، وقد قوّمها كثير من المؤرخين بكونها ’’من أعظم الإمبراطوريات في التاريخ وأكبرها وأطولها عمراً’’[102] كما يقول دونالد كواترت، وبكونها ’’أعظم امبراطورية إسلامية وأقواها’’[103] كما يقول زين زين، كما قال زاكري كارابل بأن انتصارات العثمانيين ’’لا يضارعها إلا انتصارات الخلفاء في القرنين السابع والثامن الميلاديين’’،[104] ورغم عدم شمول السيادة العثمانية جميع العالم الإسلامي أصبح الخلفاء العثمانيون يتولون ’’المسئولية العليا للسلطة الزمنية على المسلمين إلى حدود بعيدة كالسنغال وسومطرة’’ كما يقول المؤرخ نيكولاس دومانيس،[105] ولكن المعضلة التي وجد العثمانيون أنفسهم فيها هي معاصرتهم صعود القوة الأوروبية في نفس الوقت الذي كان منحنى قوتهم يتجه للهبوط، وبدأ تراجع الدولة العثمانية بعد هزيمة فيينا كما تجسد في معاهدة كارلوفتج (1699) ومعاهدة بساروفتش (1718) اللتين خسرت بموجبهما مناطق في أوروبا وليست في صلب العالم الإسلامي، أول خسارة إسلامية ملحوظة هي الاحتلال الروسي للقرم في معاهدة كوجك قينارجة (1774) التي تبعتها الحملة الفرنسية على مصر (1798)، ’’لكن تقهقر الدولة العثمانية في الحقبة التي نتحدث عنها (1683- 1798) لم يكن أمراً واضحاً لأولئك الذين عاصروا تلك الأحداث وذلك لأن العثمانيين حققوا أيضاً عدداً من الانتصارات الهامة وخاصة في النصف الأول من القرن الثامن عشر’’ كما يقول المؤرخ دونالد كواترت،[106] أي أن فترة الضعف الملحوظ بدأت بخسارة مصر في نهاية القرن الثامن عشر، ولهذا يؤكد المؤرخ زين نور الدين زين أنه ’’ليصح القول بأن الحكم العثماني حمى الأقطار العربية والإسلام من التعدي الخارجي قرابة أربع مئة سنة’’،[107] مما يؤكد أن حالة التراجع كانت طارئة في عمر الخلافة العثمانية ولم تشمل سوى قرنها الأخير بحكم سنة الحياة والموت التي تسري على البشر والدول، وحتى في زمن ضعفها كانت صامدة صموداً تحسد عليه كما يؤكد ذلك المؤرخ الشهير إريك هوبزباوم بكلام كثير عن هذا الصمود العثماني في القرن التاسع عشر وذلك في ثلاثيته المعروفة (عصر الثورة وعصر رأس المال وعصر الإمبراطورية) كما سبق ذكره، وليس من الإنصاف مطالبة الدولة العثمانية بالخروج على سنة الحياة والبقاء قوية أبد الدهر، أي عكس ما يسري على الجميع، فقد أدت ما عليها بكفاءة والعيب فينا إذ لم نستطع القيام بمسئوليتنا بعدها وتلقفتنا دولة الاستقلال الوهمي والتجزئة المجهرية التي انبطحت لمنشئيها المستعمرين، فماذا أنجزنا نحن بها بعد قرن من رحيل العثمانيين وهي فترة شهدت صعود السوفييت من مستوى روسيا القيصرية الذي كان يوازي المستوى الذي تركتنا الدولة العثمانية فيه في نفس الزمن (1917) وساد الروس نصف العالم بعد مدة قصيرة ثم انهار الاتحاد السوفييتي ونحن ما نزال نلوم حظنا العثماني على تراجعنا المستمر.
المهم أنه بعد زوال الدولة العثمانية لاحظ كثير من المؤرخين تدهور المكانة السياسية للشرق الذي كان عثمانياً، ذلك أن ’’نظام الشرق الأوسط كان كسيحاً منذ ولادته من خلال الانقسامات التي حلت به وتبعيته لدول أعظم من نظام سائد، وطبقاً لذلك، قد يبدو الشرق الأوسط برمته، فعلياً، وتركيا الاستثناء الرئيسي، أنه انتقل من تعددية المسألة الشرقية إلى ثنائية المستعمِر/ المستعمَر’’،[108] و’’مع تقهقر وتجزئة الإمبراطورية العثمانية عام 1918، والتي كانت القوة الإسلامية العظمى الأخيرة في العالم، فقد انتقل العالم الإسلامي ليصبح في مواقع دفاع هشة للغاية’’.[109]
* زوال الخلافة لم يأت بالديمقراطية
أذاع الغربيون، لاسيما الأمريكيون ورئيسهم ويلسن، في الحرب الكبرى الأولى (1914- 1918) أنهم يقاتلون لأجل عالم ديمقراطي وليس للحصول على مكاسب مادية،[110] وتمسك الضحايا العرب بهذه الشعارات والمثاليات لتحقيق أهدافهم، ولم يكن عندهم من القوة ما يفرضون بها سياستهم على الواقع الأوروبي الذي ساوم أعضاؤه بعضهم بعضاً حتى كان كل ما تمكن منه ويلسن في صراعه مع أوروبا هو القيام بتغييرات شكلية لا قيمة لها بأن حولت ’’مثاليته’’ الهيمنة على البلاد الأخرى من اسم الاستعمار إلى اسم الانتداب دون تغيير في الجوهر الحقيقي للعملية بعد رفض الأوروبيين تطبيق نقاطه الأربعة عشر إلا فيما يتفق مع أطماعهم.
وعندما زالت الخلافة الإسلامية من الشرق العثماني لم يكن البديل أنظمة ديمقراطية على الطراز الغربي الداخلي، ففي تركيا الجمهورية ’’اعتبر الحكام الجدد لتركيا الشعب التركي قاصراً عن ممارسة الحكم والحقوق السياسية، وزعم مصطفى كمال أن هذا الشعب لا يعرف كيف يقرر مصيره، فراح يقول: إن نظام الحزب الواحد يعد أنسب التنظيمات السياسية... واستمرت أعمال القمع في البلاد، بينما كان النائب بالمجلس الكبير إذا لم يلتزم بطاعة الغازي، عند التصويت على مشروعات القوانين، أو جرؤ عضو الحزب الجمهوري على مخالفة النظام الحاكم، سرعان ما يُفصل من الحزب المهيمن، ويفقد تبعاً لذلك عمله، ويتعذر عليه إيجاد البديل ولو مات جوعاً، وتزايدت سطوة الحزب بعد هدم الكيان السياسي للدولة وتم فصل الدين عن الحكم... ورفعت الثورة الكمالية شعار: (إن الثورات يجب أن تبنى على الدم وإلا انهارت ولا تدوم)، ورغم ذلك لم يخل الحال.. من قيام معارضة عنيفة ضد النظام.. وقُدم الجميع لمحاكم الاستقلال.. وتتابع صدور أحكام الإعدام’’ كما تقول الدكتورة تهاني عبد الرحمن،[111] وظل مصطفى كمال إلى آخر حياته يعتقد أن الشعب التركي ’’لم ينضج بعد ليستحق نظاماً تسوده حرية التعبير’’ كما يقول الكاتب الفرنسي بنوا ميشان،[112] وقد كان الغرب يرفض هذه الحجة من أمثال السلطان عبد الحميد رغم التطورات التحديثية الضخمة التي قام بها، ويقبل الغرب في نفس الوقت هذه الحجة من أنظمة أكثر استبداداً ودموية لكونها أقل حجماً وأكثر تعاطفاً مع الأهداف والمصالح الغربية لا يألوا الغربيون جهداً في دعمها وإسنادها وما زال التنظير الغربي يرجو لنا مثل أتاتورك حتى اليوم،[113] ويمتدحه بالبطولة والعبقرية السياسية والعسكرية رغم شح الإنجازات لكونه حافظ على استقلال تركيا، وهو هدف تناغم مع أهداف الحلفاء كما رأينا، ولكونه ’’حوّل تركيا من دولة إسلامية إلى دولة قومية علمانية’’،[114] وهذا هو المهم عند الغرب، أما كونه ’’سحق حركة الاستقلال الأرمنية (التي دعمها الغرب) وأخمد الأكراد الانفصاليين، وفي منطقة سميرنا (أزمير) قتل عشرات الآلاف من الأرمن واليونانيين، وتم تشريد 250 ألف شخص عندما هاجمت القوات التركية المدينة وأحرقتها’’،[115] فأمر لا يهم عملية التقويم الغربية، ولكنه يهمها جداً عندما تدافع سلطة إسلامية عن شعبها ضد التدخلات والمؤامرات الغربية التي أذكت نار الكراهية ضد الحكم العثماني ثم اتخذت من هذه الكراهية التي اختلقتها ذريعة أخلاقية لتفكيك الدولة العثمانية،[116] والخلاصة أنه لا الحرية ولا الديمقراطية ولا التقدم ولا الإنسانية هي المهمة، ولكن لو جاء متغرب شبيه بأتاتورك وحاول لأي سبب الخروج من الطوق الغربي سرعان ما يجري تحجيمه ثانية بالاستعانة بقذف كل تهم الاستبداد والدموية والديكتاتورية في وجهه مع أن نفس هذه التهم لم توجه لأول من علّمها لجميع حكام التجزئة وهو أتاتورك نفسه بسبب تناغمه مع الغرب.
* تبعات إلغاء الخلافة على بلادنا
ينقل المؤرخ زين نور الدين زين عن مجموعة من الساسة الأوروبيين في القرن التاسع عشر أقوالهم بضرورة الحفاظ على بقاء الدولة العثمانية صوناً للسلام، فقد كان الإيرل بيكونسفيلد يرى أن المحافظة على استقلال الدولة العثمانية وسلامة أراضيها أحسن ضمان للسلام في أوروبا، وفي بيان للورد ألنبورو قال ’’إن الامبراطورية العثمانية قائمة ليس لصالح الأتراك أنفسهم وحسب، بل لصالح أوروبا المسيحية، وليس بغية المحافظة على بقاء المسلمين في الحكم بقدر ما هو لإنقاذ المسيحيين من حرب لا يمكن تحديد الغاية من شنها ولا معرفة الزمن الذي تستغرقه هذه الحرب’’، ويعلق زين على ذلك بالقول إن تقسيم الدولة العثمانية كان العامل الرئيس في نشوب الحرب الكبرى الأولى، وإنه بعد انتهاء الحرب الكبرى الثانية انسحبت الدول التي تنافست في السابق في المسألة الشرقية من حلبة السباق ونالت دول الشرق العربي الإسلامي استقلالها، ولكن هذا الجزء من العالم وجد نفسه متورطاً في مشكلات معقدة جداً بسبب قيام الكيان الصهيوني والصراع بين العملاقين السوفييتي والأمريكي، وتتابعت الانتفاضات ومحاولات حل المشكلات القديمة المتجددة بالمساعدات أحياناً وبالقوة أحياناً أخرى، ونشأت حالة من اليأس والقنوط، فمنذ ’’سقوط الامبراطورية العثمانية، لم تحسم قط، في هذه البقعة من الدنيا، قضية واحدة حسماً نهائياً، ولا يزال الشرق الأدنى منطقة يكتنفها الإبهام، كما أن شئونه ومشكلاته لا تزال تنتظر حلاً’’.[117]
* النهاية: الغرب يواصل عرقلة النهوض والوحدة في سبيل الحفاظ على مصالحه
استمرت جهود الغرب في عرقلة نهوض بلادنا واتحادها، وليس هنا مجال تفصيل ما حدث بعد الحقبة العثمانية، ولكن الجهود المستمرة متصلة منذ ما قام الغربيون به لإلغاء الخلافة، وفي ذلك يلاحظ الدكتور ناظم الجاسور أن الوطن العربي شهد منذ بروز شخصيته الدولية العديد من مشاريع التقسيم والتفتيت وطمس الهوية واللغة والانتماء، وكان لكل طرف دولي أدواته الخاصة ’’إلا أنها تجتمع على هدف واحد أصبح جزءً من التراث الفكري والسياسي والأمني والثقافي والعسكري للقوى الغربية، التي تعد أي تلاق أو اندماج، وإن كان على الورق، بين هذه الدولة العربية وتلك، يعني تهديداً لمصالحها، ولا بد من تقويضه وتحطيم أي أسس يمكن أن تبرز في المستقبل من شأنها تهديد المصالح الغربية ووجود إسرائيل’’.[118]
وأصبح مجرد وجود الصهاينة في بلادنا عاملاً في تفتتها ’’فثمة أمر ليس بوسع إسرائيل أن تطيقه، وهو وحدة الدول العربية المجاورة لحدودها، لأنها تدرك أن بقاءها مرهون بتشرذم هذه الدول’’، وفقاً لاستنتاج الكاتب الفرنسي المعروف بنوا ميشان،[119] وقد قام الأستاذ الدكتور أحمد سعيد نوفل بتوثيق ’’دور إسرائيل في تفتيت الوطن العربي’’ في كتاب شامل خاص جال في مخططات التفتيت الصهيونية في العالم العربي من مشرقه إلى مغربه ومن شماله إلى جنوبه.[120]
ويؤكد الدور الغربي في عملية تحطيم الوحدة والنهوض في بلادنا عميد السياسة الخارجية الأمريكية المعاصرة هنري كيسنجر في أحد مقالاته: ’’لمدة أكثر من نصف قرن، وجهت عدة أهداف أمنية السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط: منع أية قوة في المنطقة من الظهور والهيمنة، ضمان تدفق موارد الطاقة التي مازالت ضرورية لتشغيل الاقتصاد العالمي، ومحاولة القيام بدور الوسيط بين إسرائيل وجيرانها من أجل قيام سلام دائم’’ وزير الخارجية الأمريكي السابق هنري كيسنجر في مقال بعنوان: ’’توجه جديد للتدخل’’ (صحيفة الواشنطن بوست 2012/3/31).
ومما يؤكد تواصل هذه الجهود استخدام ساسة الغرب حديثاً بعبع الخلافة في دعايتهم ضد العالم الإسلامي أثناء الحملة ضده لاحتلال أفغانستان والعراق ’’إذ مضى كل من الرئيس بوش (الإبن) ووزير دفاعه رامسفيلد إلى مستشاره للشئون الأمنية ستيفن هاولي، وكذلك الجنرال جون أبي زيد، ونائب الرئيس تشيني وإريك إيدلمان ووكيل وزير الدفاع للسياسات وغيرهم إلى التحذير جميعاً من خطر قيام إمبراطورية إسلامية شمولية على امتداد الشرق الأوسط كله’’[121] ولا يهمنا مدى مصداقية هذه الدعاية وهل هناك مبرر فعلي آنذاك لاستخدام هذا البعبع أم لا، أو مدى انطباق دعوات التنظيمات التي ترعب الغرب على فكرة الخلافة الجامعة كما تمثلت في تاريخ الإسلام، وهو ما لا دليل عليه حتى الآن، ما يهم هو مدى تجذر فكرة معاداة وحدة المسلمين في هواجس الغربيين إلى درجة جعلت الساسة الغربيين يستدعونها لدعم مشاريع احتلال ضخمة كتلك، فمجرد استخدام هذه المادة في الدعاية يدل على إدراك الساسة أنها محرك مقنع لجماهيرهم التي ترعبها وحدة المسلمين تحت راية واحدة وإلا فإنها لن تلتفت إلى هذه الأحاديث وسيكون ذكر الساسة لها مجرد لغو لن يقدم عليه سياسي يحرص على شعبيته.
ومما يؤكد معارضة الرأي العام الغربي لأية وحدة في بلادنا ما يقصه الأستاذ احمد الشقيري أول رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية من ذكرياته أيام الوحدة الثلاثية بين مصر وسوريا والعراق (1963) بعد فشل الوحدة الثنائية بين مصر وسوريا (1958- 1961)، إذ يقول في كتابه حوار وأسرار مع الملوك والرؤساء: ’’في تلك الفترة امتلأت ملفاتي بقصاصات من الصحافة الغربية، وكلها تصب جام غضبها على الجمهورية العربية المتحدة الجديدة التي تضم أقوى أقطار العرب الثلاثة، مصر وسوريا والعراق... وكلها تدعو إلى حماية إسرائيل من الخطر الذي يحدق بها... وكلها تدعو إلى المحافظة على مصالح الدول الغربية من هذا العملاق العربي الذي يوشك أن يهوي على المصالح الغربية، ويشعلها ناراً ودماراً... أما إسرائيل، فقد تهيبت المصير قبل أن يحل المصير، فاستنفرت الرأي العام الدولي، ونشط سفراؤها في كل أنحاء العالم، وتحركت القوى الصهيونية في واشنطن ولندن، واقتحمت البيت الأبيض وقصر باكنغهام، فاستجاب لها أعضاء الكونغرس الأمريكي، ونواب مجلس العموم البريطاني، وجميعهم يطلب حماية إسرائيل، فإن العرب، الهمج، الوحوش، يوشكون أن ينشبوا مخالبهم، في إسرائيل، ويلقوها في أعماق البحر!! ولقد كانت هذه المخاوف في محلها، سواء على المصالح الغربية أو على إسرائيل نفسها، وإسرائيل هي في رأس هذه المصالح الغربية... فإن الجمهورية العربية الجديدة تملك إمكانات ومقدرات ضخمة، بشرية مادية وروحية، فضلاً عن أن هذه الدولة التي تقوم من النيل إلى الفرات ستتبعها خطوات وحدوية أخرى، ستفضي في النهاية إلى قيام دولة الوحدة الكبرى من المحيط إلى الخليج، ولكن الاستعمار، ومعه إسرائيل، لم يكن جاهلاً بالأمور التي تجري في الغرف العربية المقفلة... لقد كان يعرف دخائل النفوس... دون أن تخدعه العناوين الحمراء في صحافتنا، والأصوات الساخنة في إذاعتنا... ودون أن يرتجف أمام الحماسة المتصاعدة في الآفاق، المتبخرة في الهواء!!’’.[122]
ورغم فشل مشروع الوحدة الثلاثية فقد ظل شبحها مهيمناً على المشاعر الغربية المتحفزة ضد أية عملية نهوض من كبوتنا الطويلة، فقد طرح ممثل الولايات المتحدة في اجتماع مجلس حلف شمال الأطلسي الذي عقد في الربع الأول من سنة 1965 أهمية ’’الشرق الأوسط’’ بصفته جناح أوروبا الأيمن عسكرياً ومخزن ثلثي احتياطي النفط العالمي، وأشار إلى أهم الأخطار التي هددت المصالح الغربية في ذلك الزمن ومنها مشروع الوحدة العربية المدعومة بأموال الكويت (إذ طرح العراق اقتراح انضمام الكويت لمشروع تلك الوحدة المجهضة بين مصر وسوريا والعراق)، وزيادة مبيعات الأسلحة المتقدمة لدول المنطقة، والاشتراكية العربية التي اقترح محاولة استيعابها وعدم مواجهتها عسكرياً لما في ذلك من مجازفة لا حدود لها،[123] فإذا كانت الولايات المتحدة ترفض وضع ثروة الكويت وحدها في خدمة مشروع وحدوي بين ثلاث دول أو أربع فقط، وظلت كوابيس هذا المشروع تلازمها حتى بعد فشله، فإنها ستخوض حرب حياة أو موت لإجهاض وحدة الأمة كلها بما
’’إن تقسيم الامبراطورية العثمانية وتجزئتها بين الدول كانت قضية أوروبية، وما لا شك فيه أنها كانت العامل الرئيس في نشوب الحرب العالمية الأولى، كما أنها كانت من أعقد المشكلات التي طرحت على رقعة شطرنج السياسة الأوروبية’’ المؤرخ العربي زين نور الدين زين.[1]
’’فَهُم (أي المستعمرون) يؤيدون المشروع العربي لمحمد علي، فإذا أوشك أن ينجح، وقفوا ضده، مع الإسلام العثماني، ثم هم يناصرون العروبة بالمشرق، ضد إسلام آل عثمان، وفي ذات الوقت يقتسمون الوطن العربي، ويخرجون من الحرب العالمية الأولى بتصفية الخلافة الإسلامية ومشروع الدولة العربية جميعاً، وفي مواجهة الفكر الإسلامي زرعوا العلمانية والتغريب، ولمحاربة المد القومي الناصري سعوا لإقامة الأحلاف تحت أعلام الإسلام’’ الدكتور محمد عمارة.[2]
* تطورات الحرب الكبرى الأولى هي الفصل الأخير في مسلسل القضاء على الخلافة الإسلامية
في يوم 28 يوليو/ تموز/ جويلية سنة 1914 اندلعت الحرب الكبرى الأولى بعد شهر من اغتيال ولي عهد النمسا على يد الصرب، وشهدت هذه الحرب تطورات سريعة كنشوب الثورة العربية الكبرى ضد الدولة العثمانية بتحريض من بريطانيا التي كانت تتفق مع حلفائها على تقسيم البلاد العربية في اتفاقية سايكس- بيكو في نفس العام (1916) ثم صدور وعد بلفور لمنح اليهود وطناً قومياً في فلسطين، وقد غيرت هذه التطورات شكل الشرق العربي الإسلامي الذي قُسم ووقع تحت الاحتلال ونُصب على حكمه دمى غربية لتنفيذ سياسات الاستعمار، وهذه التبعات مازالت مستمرة إلى اليوم، وكان الختم الرسمي الذي صادق على هذه التغيرات هو تنازل النظام الكمالي في مؤتمر لوزان (1923) عن أملاك الدولة العثمانية ثم قيامه بإلغاء منصب الخلافة الإسلامية نفسه (1924) بعدما كان قد ألغى السلطنة العثمانية (1922) في حدث تجهد كثير من الكتابات لاستخراج دليل على تورط الغرب فيه في مؤتمر لوزان وحده، ولكن متتبع سير الأحداث التاريخية يجد أن إلغاء الخلافة كان تتويجاً لجهود غربية سابقة عملت على تقليص الحضور الموحد لبلاد الشرق العثماني ومنعه من النهوض ثانية بعد تسرب علامات الضعف الشديد إلى جسده وعدم قدرته على مواجهة العدوان الأوروبي في الوقت الذي كان نجم أوروبا في صعود منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر، ومما يؤكد حقيقة الهدف من هذه الجهود الغربية اختلاف مصير الدولة العثمانية عن مصائر بقية المهزومين في الحرب الكبرى التي كانت الفصل الأخير في مسلسل القضاء على الخلافة الإسلامية.
* هل الدليل على تورط الغرب محصور في مؤتمر لوزان؟
عند الحديث عن إلغاء الخلافة الإسلامية تزخر كثير من الأدبيات بذكر ما يُعرف بالشروط الأربعة التي فرضها وزير خارجية بريطانيا اللورد كيرزون على تركيا الكمالية في مؤتمر لوزان سنة 1923 للاعتراف باستقلالها وهي: إلغاء الخلافة وطرد الخليفة ومصادرة أمواله وإعلان علمانية الدولة، وتختلف المراجع فيما بينها على هذه الشروط ولكنها تجمع على كونها أربعة وكون إلغاء الخلافة من ضمنها بل على رأسها، وفي نفس الوقت تخلو الكتب الغربية المعتمدة على الوثائق الرسمية من ذكر هذه الشروط، ورغم أنه لا يُستبعد إملاؤها في ذلك الزمن الذي تميز بالمؤامرات والاتفاقيات السرية، فإن تتبع سير العلاقة بين الدولة العثمانية بصفتها آخر خلافة إسلامية والدول الغربية الكبرى يبين أن هذه الشروط لو صحت فإنها وليدة سلسلة طويلة من الحوادث التي تبين المخطط الغربي المستمر والمعبر عن مصالح ثابتة يلتزم بها الساسة المتعاقبون مهما تباينت انتماءاتهم الحزبية، وليس مجرد مؤامرة عابرة في غرفة مظلمة في ليلة غير مقمرة، وذلك في سبيل إبقاء منطقة الشرق العربي الإسلامي بلا قوة ذاتية، ومن ثم كان القضاء على الخلافة بصفتها رمز وحدة بلادنا من مستلزمات السياسة الغربية في هذه المنطقة وهو ما دلت عليه كثير من الأحداث غير المحتاجة لإثبات شروط كيرزون بصفتها الدليل الدامغ والوحيد على ضلوع الغرب عامة وبريطانيا خاصة في القضاء على رمز وحدة هذه الأمة.
* تطور المصالح الغربية في الشرق العربي الإسلامي:
منذ ظهور علامات الضعف على الدولة العثمانية التي كانت توحد كيان الشرق العربي، لم تكن مصالح الغرب الجمعية تنسجم مع بروز كيان قوي مرة أخرى، ولهذا قامت الدول الغربية على اختلافها بوأد أية محاولة نهضوية تنشأ في بلادنا لأنها ستهدد المصالح الغربية كما شخصها أصحابها، وقد تغيرت هذه المصالح مع تغير الظروف العالمية ولكنها كانت تقتضي باستمرار عرقلة قيام كيان قوي: فموقع الشرق العربي كان منذ قديم الزمن ملتقى طرق التجارة العالمية وموضع اهتمام الكيانات القائمة على أطرافه، وقد استمر هذا الاهتمام في العصر الحديث، إذ أن موقع الدولة العثمانية بين البحر المتوسط والهند، درة التاج البريطاني، وضعها في مواجهة مباشرة مع بريطانيا التي تريد ضمان الوصول إلى مستعمرتها باحتلال مواقع عثمانية مثل عدن (1839)، والتمدد داخل الخليج، وهذا ما حفز سياستها المعارضة لمشروع محمد علي باشا في البلاد العربية إذ كانت تريد الإبقاء على ضعف الدولة العثمانية وعدم تجديد شبابها كي لا تقف في وجه الوصول إلى الهند، ولما اكتملت الثورة الصناعية وزاد رأس المال الأوروبي سعت الدول الاستعمارية الغربية لتسويق بضائعها واستثمار رأسمالها في بقية العالم وهذا ما جعل لها مصلحة في عرقلة أية صناعة محلية بالإضافة إلى حاجتها لتأمين وصول المواد الأولية إلى مصانعها في الغرب، ولما حفرت قناة السويس وأصبحت طريقاً مختصراً إلى الهند اهتمت بريطانيا بالسيطرة عليها بعد شراء أسهمها من الخديو اسماعيل الذي ورطته الاستثمارات الأجنبية بالديون، فأصبح لبريطانيا في مصر أكثر من مصلحة: قناة السويس بصفتها معبراً، وأموال الدائنين، فاحتلتها سنة 1882، وفكرت منذ هزيمة محمد علي بإنشاء كيان يهودي ليكون حاجزاً في وجه طموحات الوالي المصري المستقبلية ثم حارساً لقناة السويس وطريق الهند، هذا بالإضافة إلى الكيان الاستيطاني الفرنسي في الجزائر والذي قام بتلبية مجموعة من المصالح المادية والثقافية لفرنسا، وكان هناك أيضاً الحضور الأجنبي الثقافي لاسيما الفرنسي والأمريكي المركز في الإرساليات التبشيرية والمدارس والكليات والمستشفيات الأجنبية والمحاولات الاستيطانية التي كانت طلائع الغزو الاستعماري وتتطلب حماية خاصة بصفتها مصالح أجنبية، كما كانت الامتيازات الأجنبية التي منحتها الدولة العثمانية زمن قوتها للتجار والمواطنين الأجانب مصلحة حيوية للدول الغربية وهي مستعدة للتدخل بالقوة المسلحة للحفاظ عليها، وقد أدت هذه الامتيازات إلى توسع آخر في المصالح الغربية باتخاذ الأقليات الدينية والقومية موضعاً للحماية الأجنبية.
هذا كله قبل اكتشاف النفط، فلما اكتشف أصبحت السيطرة على مصادره المتركزة في الشرق العربي وإيران مصلحة جديدة للغرب تقتضي عدم التعامل مع جهة شرقية واحدة قوية تتحكم بآباره أو بعوائده الضخمة أو بالاستثمارات الأجنبية والتجارة العربية الضخمة، وأصبحت قناة السويس هي المعبر الرئيس للنفط إلى بريطانيا وفرنسا والغرب عموماً الأمر الذي سيبقي على أهميتها حتى بعد استقلال الهند، هذا بالإضافة إلى كونها معبراً بريطانياً وعالمياً تملك بريطانيا نصف أسهمه تقريباً، وبقيام الثورة البلشفية في روسيا (1917) وفشل العدوان الغربي عليها لوأدها، أصبح الحفاظ على بلادنا خارج النفوذ الشيوعي مصلحة جديدة للغرب في بلادنا اقتضت إقامة القواعد العسكرية التي لن يقبل بها نظام قوي مستقل ولكن أنظمة التجزئة ترحب بها بصفتها حماية لوجودها ومصدراً لرزقها حين تقبض ثمن أجرتها، كما اقتضى إبعاد الخطر الشيوعي دعم الكيان الصهيوني الذي أقيم في البداية لغايات مختلفة تماماً هي: حماية المصالح البريطانية في المشرق العربي وتثبيت الوجود البريطاني في مصر وتأمين قناة السويس والطرق التجارية إلى الشرق، والحؤول دون تحقيق الأطماع الفرنسية في شرق المتوسط وإقامة جسر بين البحر المتوسط وحقول النفط في العراق،[3] ولكن هذا الكيان احتفظ بأهميته الاستراتيجية المستمدة من كونه طليعة للغرب على أرض الشرق كما نوى منشئوه ولهذا أصبح في خدمة الأهداف الغربية عموماً مثلما ثبت في خدمته المصالح الفرنسية إضافة للبريطانية في العدوان الثلاثي 1956 ثم في وكالته المفتوحة عن المصالح الأمريكية بعد ذلك، ومن ثم أصبح مصلحة حضارية غربية مستقلة قائمة بذاتها في هذه المنطقة الحيوية حتى بعد زوال الاتحاد السوفييتي، وأصبحت الملاحة في قناة السويس مصلحة حيوية لهذا الكيان الذي هو بدوره مصلحة غربية أخرى قائمة بذاتها ويقتضي بمفرده سعي الغربيين لإركاع كل منطقتنا لقيادته كما تشير مشاريع الشرق أوسطية المتعاقبة مع ما يستلزمه هذا من عرقلة وحدة بلادنا ومنع القوة بكل أشكالها عنا كي لا نقاومه أو حتى نهدده من جهة ولا ننافسه من جهة أخرى، ومن هنا التعهد الأمريكي والغربي العلني والمجمع عليه بإبقاء الكيان الصهيوني متفوقاً نوعياً على مجموع البلاد العربية، وعلى ذلك المنطق التفتيتي سارت سياسة الغرب المعاصر كما سيأتي.
كما استمر الاهتمام الغربي بموقع ’’الشرق الأوسط’’ بين قارات العالم القديم وكونه صلة الوصل بينها وهو بذلك ’’أهم المناطق الاستراتيجية في العالم’’ ولهذا ’’نحن ملزمون بإعطاء الشرق الأوسط أولوية عالية جداً، ولا نستطيع أن نتخلى عن وضعنا الخاص في المنطقة... والسماح لوضعنا بأن يكون عالة على ترتيبات ذات طابع دولي’’ كما قال رئيس الوزراء البريطاني السابق أنتوني إيدن في مذكرة حكومية عندما كان وزير خارجية وعضواً في لجنة قناة السويس ويرد في طرحه على اقتراحات التخلي عن المسئوليات الامبراطورية سنة 1945،[4] وإذا كانت الأمور قد سارت بعد ذلك بغير ما يشير هنا فكلامه يدل على التوجهات البريطانية التي حكمت فيما سبق، ورفض الترتيبات الدولية يدل على النزعة الاحتكارية التي حكمت السياسة البريطانية في بلادنا وعملت على استمرار التفرد بها، وفي سنة 1947 حدد ناحوم غولدمان الذي سيصبح رئيس المنظمة الصهيونية أهمية فلسطين قائلاً إن اهتمام اليهود بها ليس لأسباب دينية أو اقتصادية ’’بل لأن فلسطين هي ملتقى الطرق بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، ولأنها المركز الحقيقي للقوة السياسية العالمية، والمركز العسكري الاستراتيجي للسيطرة على العالم’’،[5] وفي نفس العام أجمع موظفو الخارجية البريطانية على رفض فكرة الانسحاب من الشرق الأوسط ووصفوا جعله حيادياً بالحماقة،[6] فما بالنا ببروز قوة محلية مستقلة؟، وهو أيضاً ما يشير إلى النزعة الاستئثارية التي تميزت بها السياسة البريطانية في شرقنا زمناً طويلاً، كما جاء في اجتماع لحلف شمال الأطلسي سنة 1965 على لسان الممثل الأمريكي أن الشرق الأوسط هو الجناح الأيمن لأوروبا عسكريا ويحتوي على ثلثي احتياطيات النفط المعروفة آنذاك،[7] وكان صناع السياسة البريطانيون والأمريكيون قد أشاروا منذ سنة 1950 إلى أن التحكم ’’بالشرق الأوسط’’ يعني التحكم في الوصول إلى ثلاث قارات.[8]
ويمكننا أن نضيف إلى سلسلة المصالح السابقة قرب ’’الشرق الأوسط’’ من أوروبا ووقوعه في دائرة الأطماع الإقليمية لدولها حيث خيّل لفرنسا في العصر الحديث أن الجزائر جزء منها، وأن لها روابط تاريخية بسوريا تعود إلى حروب الفرنجة، كما حدث الأمر نفسه لإيطاليا مع ليبيا، هذا إضافة إلى أطماع روسيا في البلقان باسم الجامعة السلافية وباسطنبول ومضائقها بحجج دينية تخفي أسباباً استراتيجية، وبشرق الأناضول بحجة الأرمن رغم أنها تقمعهم في بلادها، وأطماع امبراطورية الهابسبورغ النمساوية في البلقان أيضا، وإضافة إلى ذلك أطماع الاستعمار التقليدي كأطماع بريطانيا في مصر والعراق، وأطماع فرنسا في تونس، كل هذه الأطماع الإقليمية كلفت الدولة العثمانية حروباً طاحنة وثورات عاتية ومعارك حامية أدت إلى استنزافها ولم يكن من مصلحة الغرب الأوروبي أن تقف هذه الدولة ثانية على رجليها وذلك كي لا تستعيد ما سلب منها، ومن أدل الوقائع على ذلك رفض أوروبا مجتمعة تدخل محمد علي باشا بصفته والياً عثمانياً لإخماد الثورة اليونانية بقوته الصاعدة وقيامها بتحطيم الأسطول العثماني المصري في معركة نافارين (1827) وكانت فرنسا التي دعمت الوالي المصري سابقاً على رأس مهاجميه في المعركة لأنها كانت تريد قوته في سبيل مصالحها،[9] أي أن يكون عميلاً لها وينفذ مخططاتها، كحملة على شمال إفريقيا مثلاً حيث ستحتل الجزائر قريباً، وليس لأجل القوة الذاتية للعثمانيين.
وتدل حوادث الثورات العربية الأخيرة على محاولات الغرب الحثيثة الإبقاء على نفوذه وعدم إحداث تغييرات ثورية في أوضاعنا، يشهد على هذا بقاء نفس الأطقم القديمة في مواقع اتخاذ القرار وهي الوجوه التي اعتاد الغرب على التعامل معها والاطمئنان إليها فيما سبق ولا يغير من الأمر أن يكون شخص واحد من هذا الطقم أو ذاك قد اعتزل حتى لو كان رأس النظام، ولو استعملنا التعبير الماركسي فإن أدوات الإنتاج الغربية ’’الجديدة’’ لم تؤد إلى علاقات إنتاج جديدة، هي نفسها مازالت في كل مكان، ولهذا فإن هذه الأدوات التي يستعملها الغرب في إخضاع أمتنا ليست جديدة على الإطلاق.
وخلاصة الأمر أنه رغم تغير المصالح الغربية في منطقتنا، من الوصول إلى الهند والشرق الأقصى إلى صد التوسع الروسي ثم السوفييتي إلى تأمين وصول إمدادات النفط إلى الغرب، فإنها لم تفقد بريقها رغم استقلال الهند وزوال الاتحاد السوفييتي وتطور وسائل المواصلات والأسلحة الجوية التي قللت من أهمية الحدود البرية والحواجز الطبيعية، ولم تصرف أنظار الغربيين عن بلادنا بل تطورت مصالحهم بما يزيد من تشبثهم بالهيمنة عليها مع مرور السنين وتغير اللاعبين، وفي هذا المجال يشير المؤرخ زين نور الدين زين إلى ’’خطورة الدور الذي يلعبه الموقع الجغرافي في مشكلات العالم’’ ولهذا كان جملة من الكتاب البارزين يؤمنون أن دراسة الجغرافيا أمر ضروري لفهم تطور أي بلد من البلدان، ويضيف قائلا إن ’’الجغرافيا تعد من أقل العوامل تعرضا للتغير في تاريخ الشعوب’’.[10]
وقد عبر الرئيس الأمريكي السابق ترومان عن أهمية منطقتنا في سنة 1946 بقوله في خطاب الجيش: ’’في هذه المنطقة موارد طبيعية هائلة، فضلاً عن أنها منطقة تقع عبر أفضل الطرق البرية والمواصلات الجوية والمائية، فهي لذلك بقعة ذات أهمية اقتصادية وستراتيجية عظيمة، غير أن شعوبها ليست من القوة بحيث أن الدولة الواحدة، أو كلها مجتمعة تستطيع أن تقاوم العدوان القوي إذا أتاها من الخارج’’،[11] وهذه هي نظرية الفراغ[12] التي يعتنقها وينشرها الغربيون لتبرير تطفلهم على بلادنا التي لم تكن على الدوام ضعيفة ومقسمة بل كانت فيما سبق دولة واحدة قوية ’’تشيع الرعب في أوروبا’’ وووصفها المؤرخ جيبون بالصاعقة العثمانية التي نشأت عنها ’’المسألة الشرقية’’ التي كانت في مرحلتها الأولى تعني ’’مشكلة القضاء على قوة الإسلام السياسية’’ - وفقا لإدوارد دريو- بعدما أنشأ الأتراك العثمانيون أكبر وأقوى امبراطورية إسلامية منذ ظهور الإسلام،[13] وذلك قبل أن يضعف الكيان العثماني وتتحول المسألة إلى طريقة تقسيمه بين الطامعين فيه من أسلاف ترومان الذي أتى فيما بعد ليعيرنا بضعفنا، فما هو الدور الغربي في هذا التحول؟
* البداية: تخريب ما هو قائم والحؤول دون عودة الروح إليه
لقد ظهرت فكرة مواجهة الدولة العثمانية منذ نشوئها حتى أن وزيراً رومانياً أصدر في سنة 1914 كتاباً بعنوان مئة مشروع لتقسيم تركيا (الدولة العثمانية) عد فيه عشرات المشاريع التي قدمت للبابوات وساسة أوروبا للهجوم على الشرق وتقسيمه بين دول أوروبا والاستيلاء على بيت المقدس منذ نهاية حروب الفرنجة بفتح عكا سنة 1291،[14] وهو ما يشير إلى طبيعة المخططات الغربية المستمرة والتي فرضتها ظروف العداء الموضوعية التي عبرت عنها حروب الفرنجة، وهذا أمر لا يتعلق بمؤامرات سرية تدبر في الليالي المظلمة بل بتعارض موضوعي فرض نفسه على الأجيال المتعاقبة من الساسة والمسئولين والشعوب أيضاً، وبصعود نجم الدولة العثمانية كان الهدف الغربي هو القضاء على قوتها كما مر، وقد استفادت الدول الكبرى كثيراً من الضعف الذي طرأ على الدولة العثمانية التي تخللت جيوشها الظافرة أوروبا فيما سبق ووصلت أسوار فيينا عاصمة امبراطورية الهابسبورغ، وأرادت لها بريطانيا وفرنسا أن تكون في مرحلة ضعفها حاجزاً في وجه الأطماع الروسية بالإضافة إلى استخدامها سوقا لترويج البضائع الغربية المصنعة بعد اكتمال الثورة الصناعية،[15] وقد استمرت سياسة الحفاظ على الأملاك العثمانية واتخذت طابعاً رسمياً في حرب القرم (1853- 1856) ومعاهدة باريس التي تلتها (1856)، ولكنها مع ذلك لم تمنع عملية تشجيع الثورات الانفصالية ضد العثمانيين، وفي ذلك يوجز المؤرخ دونالد كواترت القول إن الدول الكبرى لم تكن ترى مصلحة لها في تفكك الدولة العثمانية ومن ثم تعاظم النفوذ الروسي في منطقة البلقان، وإن الكثير من قادة أوروبا ’’كانوا يخشون أن يؤدي انهيار الدولة العثمانية إلى تهديد السلام الإقليمي وزرع الفوضى التي لا تحمد عقباها، لذلك اتفقوا فيما بينهم على الحرص على وحدة كيان الدولة العثمانية، ويمكن القول بأن موقف هذه الدول الأوروبية كان يتلخص في إجماع هذه الدول على أن مصلحتهم المشتركة تقضي بترك بنية الدولة تتصدع شريطة ألا يؤدي هذا التصدع إلى الانهيار التام إن صح التعبير، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فما من شك أن دعم الدول الأوروبية للحركات الانفصالية والثورات الداخلية قد أسهم في تعجيل انهيار الدولة العثمانية وهو الحدث الذي كان يخشاه الأوروبيون ويسعون لتجنب وقوعه’’.[16]
ثم غيرت بريطانيا سياستها بعد الحرب الروسية العثمانية (1877- 1878) في مؤتمر برلين الذي تلاها (1878) لتتجه نحو اقتطاع أجزاء من الدولة العثمانية وتقسيمها على مهل بين الحلفاء فاحتلت هي جزيرة قبرص (1878) ومصر (1882) واحتلت فرنسا تونس (1881) واحتلت النمسا البوسنة والهرسك (1878) واستقل جزء من بلغاريا، ويحلل بعض المؤرخين سبب هذا التغير في السياسة البريطانية بالقول إن بريطانيا فقدت الأمل في شفاء ’’الرجل المريض’’ بعد هزيمته أمام الروس في حرب 1877 التي جعلت الساسة الإنجليز يعتقدون أن معارك هذه الحرب أثبتت بجلاء أن المحاولات العديدة التي بذلت طوال القرن التاسع عشر لتمكين الدولة العثمانية من البقاء دولة قوية متماسكة الأجزاء، إنما هي سياسة عقيمة وأنها مضيعة للوقت والجهد والأموال والأرواح، وأن بقاءها دولة متداعية يؤلف خطراً جسيماً على المصالح البريطانية ويفسح المجال للنفوذ الروسي، ولذلك قررت بريطانيا تطوير سياستها واتباع سياسة جديدة تقسم بموجبها الممتلكات العثمانية وتستأثر لنفسها بالمناطق الواقعة على طريق الهند وتصلح لضمان الوصول إليها،[17] وسنرى أن قوة الدولة العثمانية لم تكن أولوية حقيقية لدول أوروبا وأن هذه الدول فضلت مصالحها المادية على بقاء الدولة وأنها شجعت الحركات الانفصالية التي استنزفتها ومن ثم لا يمكن أن تكون النتيجة النهائية لهذا الدعم إلا مزيداً من الضعف ولم يكن لأوروبا حق في التعجب من استمرار التراجع العثماني بعد كل جهودها في استنزافها اقتصادياً وعسكرياً الأمر الذي يجعل العجب من الاستمرار العثماني وليس من هزيمة الدولة وتراجعها، وكيف يمكن القول إن أوروبا كانت تعمل لتقوية الدولة العثمانية وتتجنب انهيارها وفي نفس الوقت تشجع الحركات الانفصالية وتستنزف الاقتصاد العثماني كما سيأتي؟
* سبب بقاء الدولة العثمانية رغم الضعف في آخر أيامها
عند الحديث عن سبب استمرار الدولة العثمانية رغم الضعف والتراجع، لا يمكننا أن نعزو حركة التاريخ إلى عامل واحد هو الإرادة البريطانية ضد الأطماع الروسية كما شاع في بعض الأدبيات المثبطة، لاسيما أن بريطانيا تخلت عن سياسة تأييد العثمانيين بعد مؤتمر برلين (1878)، وكان التنافس الأوروبي واختلاف الدول الكبرى هو العامل الأهم من التأييد البريطاني في ظاهرة استمرار الدولة العثمانية، مع عدم إغفال أن القوة العسكرية العثمانية لم تكن قد انتهت في ذلك الوقت ولم تكن الدولة كياناً عاجزاً لا حول ولا قوة لها، من الناحية العسكرية على الأقل كما يقول المؤرخ المعروف إريك هوبزباوم[18] مضيفاً: ’’وتمتع الأتراك بسمعة رفيعة بوصفهم جنوداً أشداء، وكان لهم دور حاسم في التصدي الفاعل لعدوهم الأخطر، وهو الجيش الروسي والدول الأوروبية المتنافسة، وفي الحيلولة دون تفكك الإمبراطورية العثمانية أو إرجائه على الأقل’’،[19] ويقول أيضاً: ’’وكان الأوروبيون يكنون احتراماً مشوباً بالحسد تجاه الإمبراطورية العثمانية لأن قوات المشاة لديها كانت قادرة على الوقوف في وجه الجيوش الأوروبية’’،[20] وذلك في أوج التوسع الاستعماري الأوروبي حين بقيت الدولة العثمانية ’’أقوى دولة إسلامية صامدة في وجه الإمبريالية الأوروبية’’[21] كما يقول كواترت، وظل الجيش العثماني حتى لحظاته الأخيرة في الحرب الكبرى الأولى سنة 1917 ’’أبعد ما يكون عن الهزيمة’’[22] رغم انتصارات الحلفاء في قول مؤرخ ثالث هو مايكل أورين.
ومما يؤكد ذلك ما لاحظه المؤرخون من تحقيق انتصارات عثمانية مهمة في ساحة الحرب الكبرى الأولى (1914- 1918) في جبهات عديدة (القوقاز والبلقان والعراق وفلسطين والجزيرة العربية ومضائق اسطنبول) جعلت من هزيمة العثمانيين مهمة ليست سهلة، وعن بقاء الدولة العثمانية يقول المؤرخ دونالد كواترت: ’’في تقويمنا للعوامل التي ساعدت الدولة العثمانية على البقاء، عندما كانت جاراتها الأوروبيات تتفوق عليها عسكرياً واقتصادياً (تفوقاً) واضحاً، نحن نسلم بأثر عاملين: منافسات القوى العظمى والمهارات الديبلوماسية العثمانية على السواء’’،[23] ولعل هذا يفسر نجاة الدولة من الاحتلال العسكري الذي لقيته الولايات التي استقلت عنها كتونس (1881) ومصر (1882) بعد إفلاس الجميع وتخلي الإنجليز عن تأييد العثمانيين، وكانت الأهمية الدولية للدولة العثمانية هي التي جنبتها مصير الاحتلال كما يقول المؤرخ الاقتصادي شارل عيساوي،[24] ويلاحظ كثير من المؤرخين أن الدولة العثمانية ظلت ضمن مساحات قليلة من العالم خارج إطار الاستعمار الأوروبي في زمن التزاحم الاستعماري الذي هيمن على معظم الكرة الأرضية باستثناء الصين واليابان وفارس والدولة العثمانية.[25]
* بقاء الدولة العثمانية مع ضعفها لم يكن الأولوية الأولى للغرب
وكانت دول أوروبا وبخاصة بريطانيا تفضل مصالحها التجارية على مصلحتها في استغلال بقاء الدولة العثمانية ولو بصورة هزيلة،[26] وقد تجسد هذا التعارض الموضوعي في المصالح في وقوف الغرب الأوروبي ضد كل مشاريع الإحياء التي نفذتها أو حاولت تنفيذها دولة الخلافة مثل فكرة الجامعة الإسلامية ومشروع سكة الحجاز أو سكة حديد بغداد أو مشاريع الإصلاح الاقتصادي والقضائي التي مست الامتيازات الأوروبية في الدولة العثمانية، حتى أن السلطان عبد الحميد الثاني تمنى في سنة 1902 أن تحظى دولته بفترة هدوء لمدة عشر سنوات فقط تتوقف فيها مؤامرات الدول الكبرى عليها ليتمكن من السير في الطريق الذي سارت فيه اليابان البعيدة عن ’’الوحوش الأوروبية الكاسرة’’ التي صرف العثمانيون الملايين على إخماد مؤامراتها بدل ’’أن تصرف على مشاريع حيوية نستفيد منها’’،[27] ولم يكن تصدي الغرب لهذه المشاريع من باب الشر المحض الذي يبغي إلحاق الأذى بالآخرين بلا سبب بقدر ما كان تعبيراً عن التناقض الموضوعي بين مصالح كيانات الغرب ونهضة كيان يجمع بلاد الشرق تحت لواء واحد، وبدا هذا التعارض أيضاً في سياسة التصدي العنيف لأية محاولة نهضوية في البلاد العثمانية كما حدث مع نهضة محمد علي باشا في مصر والتي لاحظ كثير من المؤرخين وقوف أوروبا في وجه طموحاتها بعنف، وفي ذلك يقول كواترت إن الدول الأوروبية لم تكن لتسمح بظهور دولة مصرية قوية وما يترتب على ذلك من اختلال ميزان القوى الذي كانت الدول الأوروبية تود المحافظة عليه،[28] ويقول بيتر مانسفيلد إن محمد علي كان بوسعه تحدي السلطان وانتظار سقوطه لكن بريطانيا فضلت أن تبقي على الإمبراطورية مترابطة على أن تكون مجزأة يسهل ابتلاعها من قبل المتمردين والمنافسين، ولذلك لم تكن متحمسة لإحلال قوة إسلامية توسعية متحركة محل الامبراطورية العثمانية، وكان هذا بالضبط ما يقلق قادة الدول الأوروبية، وقد صممت بريطانيا آنذاك على إحباط طموحات محمد علي بإفشال كل المساعي السلمية ورفض قاطع للعرض الذي تقدم به للاتفاق مع السلطان[29] رغم أنها كانت من شجع الوالي نفسه على الثورة على العثمانيين، ويشير مؤرخ ثالث إلى أن بريطانيا أحبطت جهود محمد علي لكونها لا تريد تكوين امبراطورية إسلامية جديدة لاسيما واحدة تحاول إيجاد قاعدتها الصناعية الخاصة.[30]
وقد ظهر التعارض بين القوى الغربية وقوة الشرق العثماني في الزحف التدريجي واحتلال البلاد العثمانية الواحدة تلو الأخرى في سياسة اتخذت من فكرة الاستقلال قناعاً لفصل الولايات عن الدولة تمهيداً لوقوعها في براثن الهيمنة الغربية كما حدث مع الجزائر وتونس ومصر وبلدان الخليج، ثم مع القومية العربية كلها بإثارتها بفكرة الاستقلال العربي والخلافة العربية تمهيداً لاحتلال شرق المتوسط بعد إعلان الثورة العربية ونهاية الحرب الكبرى الأولى.
* مناوأة منصب السلطنة العثمانية ومحاولة نزع الخلافة الإسلامية منها ضمن جهود بريطانيا للقضاء على الخلافة
يلاحظ زعيم الوطنيين المصريين وداعية الجامعة الإسلامية مصطفى كامل باشا أن جهود أعداء الدولة العثمانية لتأسيس خلافة عربية تأتي في إطار محاولتهم القضاء على هذه الدولة التي تخشى أوروبا من قوتها ونفوذها وأعداء الإسلام يودون ان يزول اسمها من الوجود حتى تموت قوة الإسلام وتقبر سلطته السياسية وتقوم بدلاً من الدولة العثمانية خلافة تكون ألعوبة في يد إحدى الدول الكبرى، ورأوا أن فصل الخلافة الإسلامية من السلطنة العثمانية يضعف الأتراك ويقتل نفوذهم بين المسلمين ويجعلهم أمة إسلامية عادية، وقد تلقف الإنجليز مشروع الخلافة العربية لأنهم أدركوا أن احتلالهم الأبدي لمصر سبباً للعداوة بينهم وبين الدولة العثمانية لأن السلطان العثماني لا يقبل مطلقاً الاتفاق معهم على بقائهم في مصر، وأن خير وسيلة تضمن لبريطانيا البقاء في مصر ووضع يدها على وادي النيل هو هدم السلطنة العثمانية ونقل الخلافة الإسلامية إلى أيدي رجل يكون تحت وصاية الإنجليز وآلة في أيديهم، ولهذا أخرج ساسة بريطانيا مشروع الخلافة العربية.[31]
وقد أثبتت الأيام صحة تحليل الباشا، فقد استمرت بريطانيا في تبني مشروع الخلافة العربية إلى أن حفزت إعلان الثورة العربية ضد العثمانيين سنة 1916 تحت شعار عودة الخلافة للعرب، بل إنها عمدت بعد اندلاع الحرب الكبرى سنة 1914 إلى إنهاء السيادة العثمانية على مصر وخلع الخديو عباس حلمي الثاني من منصبه بحجة ارتباطه بالعثمانيين، ونصبت عمه حسين كامل سلطاناً على مصر لمناوأة منصب السلطنة العثمانية،[32] ومما يلفت الأنظار رفض شعب مصر لهذا السلطان الألعوبة بمحاولة اغتياله مرتين مع بعض وزرائه،[33] وكل تلك الجهود البريطانية استهدفت محاربة دولة الخلافة وإضعاف نفوذها ولا يمكن إلا أن تدرج ضمن محاولة القضاء على منصب الخلافة نفسه لاسيما بعدما رفض الإنجليز حتى منصب الخليفة الألعوبة وذلك بعدم اعترافهم بانتقال الخلافة إلى العرب الذين أعلنوا بيعة الشريف حسين بعدما حاربوا تحت لواء بريطانيا في أعقاب حصولهم على الوعد بعودة الخلافة إليهم.
* أوروبا لم تكن سعيدة بالتغريب العثماني المستقل وفضلت مصالحها الآنية على رعاية تلاميذها مما أدى إلى الحرب بين التغريب والغرب
هذا الزحف التدريجي اتخذ صورة عنيفة مع انفجار الحرب الكبرى الأولى سنة 1914، مع أن وصول مدرسة التغريب المتمثلة في حزب الاتحاد والترقي إلى الحكم سنة 1909 بعد الانقلاب على السلطان عبد الحميد بشر بانسجام بين الغرب والمعارضة العثمانية السابقة التي رعاها الغربيون في بلادهم والبلاد التي تحت حكمهم، وقد حاول الحكام الجدد مد يد السلام إلى القوى الغربية وقدموا لها بلادهم على طبق من ذهب،[34] ولكن أوروبا كانت أكثر اهتماماً بمصالحها منها برعاية التغريب الديمقراطي في الدولة العثمانية وأثبتت طمعها بأرض العثمانيين الدستوريين الديمقراطيين كطمعها بأرض الاستبداد الحميدي، مما دمر إمكانات التطور الديمقراطي في الدولة العثمانية كما يقول المؤرخان شو،[35] وفي ذلك يقول مانسفيلد: ’’على الرغم من نظر بريطانيا وفرنسا بعين العطف والاستحسان لثورة الأتراك القوميين الشباب، فإنهما لم تكونا على استعداد لتقديم أية ضمانات إقليمية لموقع تركيا المتبقي في أوروبة في ضمن الولايات البلقانية ضمن نطاق الإمبراطورية التركية’’،[36] ورغم الميول الغربية الواضحة للحكام الجدد فإن تعارض مصلحة بلادهم بصفتها دولة عظمى لها كيانها المستقل مع مصالح الغرب الذي يريد الهيمنة جعلهم يتراجعون عن الميل للتحالف مع بريطانيا لما قامت الحرب الكبرى نظراً لأن هذا الخيار لم يكن متاحاً بسبب تضارب المصالح،[37] وهذا هو الفرق بين التغريب العثماني بصفته اتجاهاً يبحث عن مصالح دولته المستقلة عن الغرب، وإن كان باتباع نهج الغرب، وتغريب دولة التجزئة الذي أحس بضآلة كياناته ومن ثم عدم قدرتها على فرض مصالح مستقلة عن الدول العظمى مما جعله يتبع سبيل خدمة هذه المصالح لعله يصيب شيئاً في ظلها.
’’وقد أدرك الساسة العثمانيون أن اتخاذ الدولة العثمانية موقفاً محايداً في هذه الحرب لن يكون في مصلحتها وذلك لأن الطرف المنتصر سيعمد لا محالة إلى تجزئة الدولة العثمانية’’،[38] ولأن الحلفاء كانوا يطمعون في الأراضي العثمانية فضلاً عن احتلالهم الفعلي أجزاء كبرى منها،[39] قرر الساسة العثمانيون دخول الحرب إلى جانب ألمانيا[40] حين خطت الدولة العثمانية بدخولها الحرب خطوة مصيرية هدفت إلى تحرير نفسها من كل القيود التي فرضتها حالة الضعف عليها كسوء استخدام الامتيازات الأجنبية والديون، والعودة إلى مكانتها السابقة بين الكبار واستعادة كل ما سلب منها من أقطار وحماية نفسها من مزيد من الغزو،[41] ورغم الانتصارات التي حققتها جيوش الخلافة في هذه الحرب على جبهات اسطنبول والعراق وفلسطين والحجاز والقوقاز والبلقان، كانت النتيجة النهائية في غير صالحها، ويلاحظ المؤرخون أن الحرب الكبرى أصبحت نقطة تحول في السياسة الغربية تجاه الدولة العثمانية، وفي ذلك تقول موسوعة التاريخ والحضارة إن الحلفاء اغتنموا ظروف الحرب لتقسيم السلطنة ووضع نهاية للمسألة الشرقية وتم وضع المشاريع التقسيمية، وكان لبريطانيا الدور البارز فيها وكانت محور السياسات والاتفاقات السرية المتناقضة أحياناً، وإنه منذ دخول السلطنة العثمانية الحرب، بدأت المشاورات السرية لتقسيمها،[42] وكانت بريطانيا تراسل الشريف حسين ’’والفرنسيون يحذرون من قيام دولة عربية كبرى، خوفاً على مصالحهم في شمال إفريقيا - أي تونس والجزائر والمغرب- كما يخافون على مستقبل مصالحهم في شرق المتوسط، وكذلك كان الإنكليز يخافون من قيام دولة عربية كبرى ولو تظاهروا بالموافقة على قيام هذه الدولة’’،[43] ولهذا لم يعترف الحلفاء بالخلافة العربية بعد قيامها في أعقاب إلغاء الخلافة العثمانية[44] رغم كونهم من شجعوا الدعاية لها سابقاً لطعن شرعية العثمانيين بها وحاولوا زمناً أن يستغلوا إحياء المنصب لصالحهم إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل،[45] وهو ما يؤكد حرص الغرب على إبقاء منطقتنا ضعيفة تحت هيمنته دون قوة ذاتية بغض النظر عمن يحكمها، ولهذا عارضت الدول الكبرى قيام الخلافة العربية رغم تعهداتها لحلفائها العرب واتفقت مع مصطفى كمال على إنهاء الخلافة العثمانية رغم العداوة الظاهرة بين الطرفين الكمالي والأوروبي، وإن هذا الإصرار على مقاومة إحياء الخلافة حتى في الحجاز لا يمكن أن يفسر بمجرد ضعفها أمام الأطماع الروسية لأن الدول التي قامت على الأنقاض العثمانية لم تكن أكثر قوة منها، كما أن روسيا نفسها أصبحت من معسكر الحلفاء ضد دول الوسط وصارت الدولة العثمانية عائقاً في وجه وصول الدعم الغربي إليها في الحرب الكبرى الأولى،[46] ولهذا توجب البحث عن السبب في إلغاء الخلافة في مكان آخر ستفصح عنه الوثائق كما سيأتي.
وفي هذا الموضوع تقول موسوعة السياسة إن هذه الحرب كانت فصل الختام في حياة الإمبراطورية العثمانية ’’فبعد أن مكثت حاجزاً، حقيقياً أو شكلياً، في وجه أطماع أوروبا الاستعمارية عدة قرون، جاءت الفرصة عندما تحالفت مع ألمانيا والنمسا ضد الحلفاء، فقرروا الانتقال من مرحلة المحافظة على ضعفها ووراثتها بالتدريج إلى مرحلة اقتسام بقايا أملاكها والإجهاز عليها مرة واحدة، وكانت اتفاقية سايكس- بيكو سنة 1916 إطاراً لهذا المخطط الجديد، الذي توج بانتزاع كل أملاك الدولة العثمانية في آسيا بموجب معاهدة سيفر، وذلك عندما انتصر الحلفاء سنة 1918، ثم قام كمال أتاتورك (1298- 1357 هجرية، 1880- 1938 م) بإنقاذ الوطن الأصلي للأتراك، وأراد انتزاع عداء أوروبا وإزالة مخاوفها، فأدار ظهر دولته التركية الحديثة لماضي العثمانيين الإسلامي... (و) أعلن إلغاء الخلافة رسمياً ونهائياً في 3 آذار- مارس 1924 م’’،[47] وفي سبيل استرضاء أوروبا قدم لها أتاتورك ما رغبت به في معاهدة سيفر التي وصفت بالمذلة ومع ذلك تم تطبيقها على كل الأراضي العثمانية بما في ذلك المصادقة على وعد بلفور في فلسطين مقابل استثناء تركيا وحدها،[48] وقد أفصح ضابط المخابرات التابعة للجيش البريطاني لورنس العرب من ميدان المعارك التي انهمك فيها ضد الدولة العثمانية عن الأهداف الحقيقية لبلاده في هذه الحرب.
* الصمود العثماني الأخير وعلاقته بإنهاء الخلافة
ولكن بقاء الكيان العثماني الموحد حمل في طياته خطر عودة الروح إلى هذا المجال الهائل، فبريطانيا لم تغفل يوماً عن خطر السيادة الدينية للخليفة العثماني على ملايين المسلمين الذين يحكمهم الاستعمار البريطاني، ولكنها أجلت مواجهة هذا الخطر لتواجه خطر سقوط الدولة العثمانية وما سيعقبه من فوضى دموية بين الذئاب الأوروبية في المنافسة على اقتسام التركة،[49] وبعدما تغيرت الظروف باندلاع الحرب الكبرى واللجوء إلى القوة العسكرية لحل الخلافات الأوروبية بين الأعداء والاتفاقيات والمساومات السرية مع القوة العسكرية لحل الخلافات بين الحلفاء أولاً، وانضمام روسيا إلى الحلفاء ثانياً ثم قيام الثورة البلشفية التي أسقطت الحكم القيصري وتدخل الغرب عسكرياً لإسقاطها ثالثاً، لم يعد الخطر الروسي هو المحرك لفكرة التخلي عن بقاء الدولة العثمانية، واستجد مكانه الخطر الألماني الذي لاحظ لورنس العرب وغيره أنه نقل فاعلية الخطر العثماني إلى مستوى أكبر مما سبق[50] كما سيأتي في رسائله السرية، ولكن العثمانيين لم يكونوا مجرد أدوات بأيدي الألمان وكان لهم جدولهم ومصالحهم الخاصة،[51] وقد أفصحت نتائج الحرب عن إدراك الحلفاء ذلك إذ لم ينل الخطر الألماني من التصدي والمواجهة ما نالته الدولة العثمانية، وعن مكانة العثمانيين في هذه الحرب تقول الدكتورة تهاني عبد الرحمن: ’’ولم تكن الدولة العثمانية في ذلك الوقت تقع في مصاف الدول الصغرى، رغم كل ما فقدته في فترات ضعفها واضمحلالها، من ولايات تابعة، بل كانت تُعد دولة كبرى، ومن ثم حرصت ألمانيا على جرها للصراع الدائر فوق أرض القارة الأوروبية’’،[52] ورغم تردد دول الوسط في ضم العثمانيين في البداية وخشيتها من تحولهم إلى عبء عليها فقد أثبت الجيش العثماني فعالية لم يتوقعها أحد،[53] وفي ذلك يقول المؤرخ بيتر مانسفيلد ’’عندما اندلعت الحرب، ورغم عدم شك معارضي تركيا ببسالة وإقدام وشجاعة الجنود الأتراك في الحروب، فإنهم فوجئوا بأدائهم المتطور وازدياد معارفهم في فنون القتال كما أن جاهزيتهم العالية في خوض الحروب الحديثة فاقت التوقعات،[54] وستفصح الوثائق الغربية عن حقيقة النوايا تجاه الخطر الإسلامي، وبعد إلغاء الخلافة العثمانية نفسها ومحاولة إحياء الخلافة العربية سنجد استمرار المعارضة الغربية لهذا المشروع الذي رعته دول أوروبا بأنفسها في البداية.
* علاقة الغرب بإلغاء الخلافة الإسلامية
1- وثائق دامغة
لما بدأت الحرب الكبرى الأولى (1914) أصبح القضاء على الدولة العثمانية هدفاً متداولاً ومعلناً بين الحلفاء كما صرحت بذلك الصحف البريطانية فور الدخول العثماني في الحرب، فما ’’أن بدأت الأعمال العسكرية ضد تركيا، في 5 تشرين الثاني، سنة 1914، حتى شرعت الصحافة البريطانية بإيضاح ما سيحل بتركيا، وما عسى أن يكون مصيرها، ففي يوم 23 تشرين الثاني كتبت جريدة الدايلي مايل (Daily Mail) تقول: ’’لسنا نشك في أن الامبراطورية العثمانية على الأرض الأوروبية التي أنشأها الأتراك بحد السيف، سيُقضى عليها بحد السيف’’، وفي 31 تشرين الثاني كتبت جريدة الدايلي نيوز (Daily News) تقول: ’’إذا خسرت ألمانيا الحرب فإن عقاب تركيا لدخولها الحرب إلى جانب ألمانيا سيكون القضاء التام عليها كدولة’’، وبما أن هدف بريطانيا كان القضاء على تركيا قضاء مبرماً، فإنها وجدت نفسها عالقة في ديبلوماسية شائكة معقدة’’.[55]
بل إننا نجد قبل بداية الحرب الكبرى ما يشير إلى نوايا التقسيم والتجزئة منذ سنة 1912عند اللورد كتشنر القائد الأعلى للقوات المسلحة في مصر وسفاح السودان ثم المعتمد البريطاني في مصر ثم وزير الدفاع البريطاني، إذ تبين أنه كان أثناء وجوده في مصر راسخ الاعتقاد بأن سوريا الجنوبية من خليج العقبة إلى حيفا وعكا تؤلف ’’منطقة ذات مغنم لا يستغنى عنها بالنسبة إلى الإمبراطورية البريطانية’’ وذلك بعد دراسة عسكرية لصحراء سيناء أمر بإجرائها سنة 1913.[56]
وقد صرحت الدوائر الرسمية للحلفاء بعد اندلاع الحرب بهذا الهدف كما كشف عن ذلك ’’بيان عن السياسة الخارجية مرفوع إلى المجلس الحربي الملكي’’ الذي قام اللورد بلفور وزير الخارجية البريطاني وصاحب الوعد المشئوم ورئيس البعثة البريطانية الخاصة الذي كان في زيارة للولايات المتحدة بتسليم نسخة منه إلى وزير الدولة الأمريكي وجاء في هذا البيان الصادر في سنة 1917: ’’لاشك أن القضاء على الامبراطورية العثمانية قضاء تاماً هو من أهدافنا التي نريد تحقيقها، وقد يظل الشعب التركي، ونأمل أن يظل، مستقلاً أو شبه مستقل في آسيا الصغرى، فإذا نجحنا فلا شك أن تركيا ستفقد كل الأجزاء التي نطلق عليها عادة اسم الجزيرة العربية (Arabia) وستفقد كذلك أهم المناطق في وادي الفرات ودجلة، كما أنها ستفقد استانبول، أما سوريا وأرمينيا والأقسام الجنوبية من آسيا الصغرى فإنها، إن لم تضم إلى الحلفاء، فمن المرجح أنها ستبقى ضمن حكمها’’،[57] هذا بالإضافة إلى وثائق كتبها لورنس العرب أثناء الثورة العربية.
ففي تقرير كتبه لورنس في يناير/ كانون الثاني/ جانفي 1916 تحت عنوان سياسات مكة قال: ’’إن تحرك (الشريف حسين) يبدو مفيداً لنا، لأنه ينسجم مع أهدافنا المباشرة: تحطيم الجبهة الإسلامية الموحدة وهزيمة وتمزيق الامبراطورية العثمانية، ولأن الدول التي سيقيمها (الشريف) خلفاً لتركيا ستكون غير ضارة بنا كما كانت تركيا قبل أن تصبح أداة في أيدي الألمان. إن العرب أقل توازناً من الأتراك، وإذا عولج أمرهم بشكل مناسب فإنهم سيظلون في حالة من الشرذمة السياسية، نسيج من الإمارات الصغيرة المتحاسدة غير القابلة للتوحد، ومع ذلك يمكنها الاجتماع في مواجهة أية قوة خارجية’’،[58] وهذا الاجتماع الذي يقلق لورنس ورؤساءه هو ما يعمل الغرب جاهداً لمنعه منذ تلك الأيام.
ويختم تقريره قائلا إن الشريف حسيناً ’’يفكر يوماً بالحلول محل السلطة التركية في الحجاز، ولو تمكنا من ترتيب هذا التغير السياسي ليكون بالعنف، سنقضي على خطر الإسلام بجعله ينقسم على نفسه في عقر داره، وسيكون هناك خليفة في تركيا وخليفة في الجزيرة العربية في حالة حرب دينية، وسيصبح عجز الإسلام كما كان عجز البابوية عندما كان الباباوات في أفنيون’’[59] (وهي فترة تراجعت فيها هيمنة البابوية وسميت الأسر البابلي للكنيسة 1309- 1377 تشبيها بأسر بني إسرائيل على أيدي البابليين في القرن السادس ق. م، وقد أعقبها انقسام وصف بالعظيم نتيجة وجود بابا في روما وآخر في أفنيون 1378- 1417).
وفي تقرير حمل عنوان’’لو تم احتلال سوريا’’ وكتبه لورنس سنة 1916 أيضاً لاقتراح حل للمشكلة التي يسببها إعلان الخليفة العثماني الجهاد ضد الحلفاء الذين يحتلون بلاداً يقطنها ملايين المسلمين، قال لورنس: ’’مهما نتج عن هذه الحرب، فإنها يجب أن تقضي تماماً ونهائياً على السيادة الدينية للسلطان’’.[60]
2- اختلاف مصير الدولة العثمانية عن مصير ألمانيا بعد الحرب
وكان المصير الذي تعرضت له الدولة العثمانية التي ساحت جيوش المحتلين في أراضيها يختلف عما نال ألمانيا التي لم تحطم في نهاية الحرب، وهذا ما صرحت به الصحافة البريطانية منذ بداية الحرب كما سبق، ولم تخف هذه المفارقة عن ملاحظة المؤرخين: ’’إن الامبراطورية العثمانية لم (تنهار). هذا تعبير شديد السلبية. لقد مزقوها إرباً مثلما تخلع مفاصل الدجاجة قبل الأكل، حتى ألمانيا نفسها لم تتكبد تقطيع الأوصال وانتزاع الأحشاء ’’كما يقول المؤرخ جيرمي سولت.[61]
وقد لاحظ المؤرخ فيليب كورتن نفس الملاحظة حين قال إن الحلفاء وضعوا أثناء الحرب خططاً متنوعة لتقسيم تركيا (الدولة العثمانية)، وكان هناك تفكير مسيطر وراء العهود المحددة التي أطلقتها الطبقة السياسية في بريطانيا، وفرنسا وإيطاليا يتمثل بعدم عد الدولة العثمانية دولة مهزومة وعدواً متحضراً مثل ألمانيا، بل كدولة يجب أن تعامل كما عوملت ممالك أخرى غير غربية أثناء العهود الاستعمارية الكبرى، وكانت غايتهم تجزئة الإمبراطورية العثمانية وتقسيم الباقي إلى مناطق نفوذ مما أعطى فرنسا وبريطانيا وإيطاليا على التوالي سلطات واسعة في الإمبراطورية العثمانية السابقة وعلى ما تبقى منها.[62]
وقد شاركت الولايات المتحدة أوروبا في كراهية العثمانيين بشكل خاص، وفي ذلك يقول المؤرخ أورين إن الرئيس الأمريكي وودرو ويلسن عندما حضر إلى مؤتمر السلام في باريس سنة 1919 كان يحمل قيمه ومثله وأفكاره المسبقة كذلك، فقد ’’كان يحتقر كل أشكال الاستعمار الأوروبي، ومنها الاستعمار البريطاني (ونسي استعمار القارة الأمريكية الذي كان قد اكتمل قبل سنوات قليلة)، وأظهر نفوراً خاصاً للأتراك، ومنذ 1889 كان يصف الإمبراطورية العثمانية بأنها غير طبيعية ومثال متأخر على الأشكال غير المتقنة للسياسة التي نمت عليها أوروبا’’، ويقر المؤرخ نفسه أن الرئيس كان ’’لا يعرف عن جغرافية المنطقة وثقافتها وتقاليدها أكثر مما قرأ في الإنجيل’’.[63]
وكان التقارب الحضاري بين ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة مما دفع المنتصرين لتشخيص مصالحهم في بقاء القوة الألمانية وعدم الموافقة على تحطيمها لتظل عامل حفظ للتوازن الأوروبي تجاه فرنسا وللوقوف في وجه المد الشيوعي،[64] كل هذا يختلف عن حالة العداء الحضاري تجاه العثمانيين الذين كان القضاء عليهم قضاء مبرماً هو المصلحة الغربية، ومع ذلك لم تعجب الالمان سياسة الإملاء للحفاظ عليهم على مقاس المصالح المنتصرة وأدت شروط الصلح القاسية إلى اندلاع الحرب الكبرى الثانية في الوقت الذي كان الإجهاز على وحدتنا دافعاً لنا للتلاؤم مع المصالح الغربية والانسجام معها إلى حد أداء الخدمات لها.
* عمر التآمر طويل وسياسة فرّق تسد
إن الضربات المتلاحقة التي وجهت للدولة العثمانية تثبت النوايا الغربية بشكل يلغي الحاجة إلى إثبات أن بريطانيا اشترطت إلغاء منصب الخلافة الإسلامية على الجانب التركي في مؤتمر لوزان سنة 1923، لأن الموقف الغربي عموماً والبريطاني خصوصاً لم يقتصر على لحظة واحدة فقط من التآمر السري على منصب أصبح هزيلاً وشبيهاً بوزارة أوقاف في ظل إعلان قيام الجمهورية التركية، بل كان عداء علنياً لفكرة الخلافة نفسها حتى مع وجود مصلحة في بقائها ضد التوسع الروسي، وقد اتضح ذلك من سياسة الدول الغربية تجاه إضعافها ونهش أطرافها لمدة تزيد على قرن من الزمان أثبتت فيها الحوادث والحروب الكبرى حقيقة النوايا التي اختلفت فيما بينها فقط على طريقة اقتسام الغنائم، التي هي بلادنا، ولم تختلف على فكرة التقسيم ذاتها، وكان هذا هو محتوى ’’المسألة الشرقية’’التي تريد حلاً، أو كما قال مراقب أكاديمي أمريكي عاصر الحرب الكبرى الأولى وكتب في سنة 1917 أن ’’الأمم الأوروبية منذ بداية القرن التاسع عشر اجتمعت كالصقور حول الجثة لاقتطاع ما يمكنها من الامبراطورية التركية’’،[65] فكان احتلال الجزائر (1830) ضمن هذا الإطار وتبعه احتلال عدن (1839) ثم قبرص والبوسنة والهرسك (1878) ثم احتلال تونس (1881) ثم جاء احتلال مصر (1882) ليكون ضربة قاصمة للعثمانيين، ثم جاء احتلال ليبيا (1911) وتبعه مباشرة حربا البلقان (1912- 1913) والتي سلخت جميعها أجزاء كبرى من الدولة بعد قرن من إثارة صربيا (1817) ثم اليونان (1821- 1830) ثم بلغاريا (1878).
ويلاحظ المؤرخ جستن مكارثي أن الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر كانت مطوقة بخصوم أقوياء لم يتيحوا لها ’’فسحة للتنفس’’ لترتيب بيتها الداخلي ببناء دولة حديثة وجيش قوي واقتصاد صناعي، واضطروها لخوض حروب متتالية في الأعوام التالية كالحرب مع روسيا (1806- 1812) والحرب الثانية مع روسيا أيضاً (1828- 1829) والحرب مع محمد علي باشا التي أججتها أوروبا ومنعت التفاهم بين طرفيها[66] (1832- 1833) و(1839- 1840) وحرب القرم مع روسيا (1853- 1856) والحرب الرابعة مع روسيا كذلك (1877- 1878) والحرب مع اليونان (1897) وحروب البلقان (1911- 1913) والحرب الكبرى الأولى (1914- 1918) وحرب الاستقلال (1919- 1923)، إضافة إلى حوادث العصيان المسلح الكبرى في مصر عام (1804) والانتفاضة الصربية (1815- 1817) والثورة اليونانية (1821- 1830) والثورة في جزيرة كريت (1866- 1868) والثورة في بلغاريا (1875) و(1876) والتمرد الأرمني (1896- 1897)، وهلكت الجيوش العثمانية التي كانت في طور التدريب وأُجبرت على خوض الحروب وهي غير مهيأة، وأُنفقت الموارد المالية الازمة للتحديث على هزائم أدت إلى خسارة الأرض والدخل، فكان الضعف هو سبب خسائر العثمانيين التي أبقتهم أضعف من القدرة على النهوض.[67]
وكانت الاتفاقيات السرية التي قسمت المشرق العربي وبقية الأراضي العثمانية والتي جرت أثناء الحرب الكبرى جهداً واضحاً موجهاً لإنهاء الدولة العثمانية (مثل اتفاقيات سايكس- بيكو ولندن والآستانة وغيرها) وتندرج الثورة العربية برعاية بريطانيا (1916) ثم وعد بلفور (1917) ضمن محاولات تحطيمها وتقسيمها أيضاً، ولهذا كانت النهاية المنطقية لكل هذه الجهود السابقة هي القضاء الفعلي على الدولة العثمانية بعد فقدانها مساحاتها الممتدة، ولم يكن انهيارها وليد لحظة تآمر نظري في مؤتمر لوزان، وقد كان إنهاؤها من أبرز ’’إنجازات’’ الحرب الكبرى كما صرح بذلك ساسة ومؤرخون من أوروبا وأمريكا،[68] ويؤكد مصير الشرق العربي بعد الحرب حين اتفقت أوروبا على اقتسام بلادنا وفق اتفاقات التجزئة آنفة الذكر ونكثت بوعود التحرر التي بذلتها للعرب أن عداءها ليس مع كيان سياسي محدد، كما ادعت كذباً لتغوي العرب، بقدر ما هو عداء مع أي وحدة شاملة تلم شعث بلادنا كما أثبتت الأحداث لاسيما برفض الاعتراف بالخلافة العربية التي طالما رعى الغربيون الدعوة إليها، وفي هذا السياق قال ونستون تشرتشل عندما كان وزيراً للمستعمرات سنة 1920 تعليقاً على محاولات التعاون العربي مع الأتراك مرة ثانية لمواجهة غدر الحلفاء، تلك المحاولات التي أقلقت بريطانيا فقال الوزير البريطاني: ’’هنالك جماعة من العرب تبدي تخوفاً من احتلال (الفرنسيين) سوريا، وهي تميل الآن، ولأول مرة، لضم صفوفها، بطرق مختلفة، إلى الأتراك الوطنيين على أن قضيتهم واحدة مشتركة، وهكذا تتم وحدة بين قوتين كنا نفيد دوماً من انقسامهما لا من وحدتهما’’،[69] وهكذا أسفر البريطانيون عن حقيقة نواياهم بأنها مجرد الإفادة من الانقسام العربي التركي وليس تحقيق أماني العرب ولهذا احتلوا بلادهم غنيمة بينهم وبين الفرنسيين ولم يحققوا لهم آمالهم، وهذه هي النتيجة المثالية للاستقواء بالأعداء وتمكينهم من الهيمنة على الدار ليقوموا بضرب كل محاولات التوحد والنهوض فيما بعد، وها نحن مازلنا في نتائج تلك الحقبة المريرة إلى اليوم.
* الغرب يمنح أرباب التجزئة ’’انتصارات’’ منسجمة مع مصالحه لأن طموحاتهم لا تتحدى هذه المصالح بل تخدمها ولا تنهض بالأمة
ولهذا فإن ما قام به مصطفى كمال عندما ألغى السلطنة العثمانية والخلافة الإسلامية يلتقي موضوعيا مع أهداف الحلفاء الغربيين ولم تخرج إنجازاته الجغرافية عما رسمه بلفور أمام الأمريكيين، وما رسمه الرئيس الأمريكي ويلسن الذي صرح في سنة 1912 قبل اندلاع الحرب الكبرى بأنه إذا دخل العالم الحرب فلن يكون هناك وجود للدولة العثمانية،[70] ثم كرر ذلك في نقاطه ’’المثالية’’ الأربعة عشر التي لم تطبق جميعها ولكنها تفصح عن رؤية الولايات المتحدة تجاه تركيا كما جاء في النقطة الثانية عشر التي طبق شطر منها يناسب خطط بريطانيا وفرنسا: ’’يجب أن يُضمن الاستقلال الثابت لأجزاء الإمبراطورية العثمانية الحالية التي أغلب سكانها من الأتراك، وأما الأقوام الآخرون الخاضعون الآن للحكم التركي فيجب أن يُضمن لهم أمن على حياتهم لا شك فيه، وأن تُعطى لهم فرصة مطلقة لا يجدون فيها ما يعوقهم عن بلوغ استقلالهم، وأما الدردنيل فيجب أن يظل مفتوحاً ويصير ممراً حراً لسفن جميع الأمم وتجارتها في ظل ضمانات دولية’’،[71] ولقد استقل الأناضول بالفعل واستقلت القوميات غير التركية عن الدولة العثمانية وفتحت المضائق ولكن الانتداب حل بالبلدان غير التركية فلم يكن استقلالها كاملاً وفق البند الأمريكي، وقد أوضح مصطفى كمال للأوروبيين أهدافه بالقول ’’إنكم تستطيعون أن تنالوا سوريا وبلاد العرب، ولكن كفوا أيديكم عن تركيا، فنحن نطالب بحق كل شعب داخل حدود بلاده الضيقة’’[72] وهو ما يتفق مع المخطط الأوروبي السابق، ولهذا لم يمانع الحلفاء في إلغاء معاهدة سيفر المذلة (1920) بعدما منحهم النظام الكمالي في معاهدة لوزان (1923) الموافقة على تطبيق تلك المعاهدة السابقة على كل البلاد غير التركية وهو ما قامت به الدول الأوروبية بموافقة عصبة الأمم التي جعلت هذه البلدان العثمانية السابقة خاضعة للانتداب، واستثنيت تركيا من ذلك، فكان هذا الاستسلام هو ’’أهم الانتصارات السياسية’’ لاتجاه التجزئة القومية،[73] ولم تمانع أوروبا في المصادقة على ذلك التحجيم الذي ’’كرس دولياً نهاية السلطنة العثمانية وقيام الجمهورية التركية’’ الذي حقق حلم القوميين الأتراك وسياسة التتريك التي طبقوها وصار هذا هو الانتصار الكبير للدولة التركية،[74] ولكنه لم يكن انتصاراً على الأعداء بل بموافقتهم وتصديقهم وإقرارهم، فقد ’’أجبرت انتصارات مصطفى كمال – آنذاك- الدول الأوروبية على الاعتراف بأهمية حركة الأناضول، سيما وأن برنامجه استند على أسس قومية وانبثقت عنها مبادئ الميثاق التركي الذي أُعلن في 28 يناير 1920 محدداً أبعاد الدولة سياسياً وجغرافياً، وتنازلها عن كل المناطق المسكونة بأغلبية غير تركية، رفعاً عن كاهلها مشاكل إمبراطورية كاملة، وقد توالت اعترافات الحلفاء بالحركة الكمالية، واعترفت فرنسا رسمياً بحكومة أنقرة، مما أنهى حالة الحرب بين الدولتين، وتجاوبت الدول الأوروبية كلها مع نظرية مصطفى كمال بشأن الإمبراطورية العثمانية، وحمدوا له نظرته المختلفة تماما عمن سبقوه في اعتبار مشاكل الإمبراطورية عبئاً ثقيلاً على كاهل الأتراك ينبغي عليهم أن يتخلصوا منه ليتفرغوا لحركتهم الوطنية القومية’’،[75] والغريب أن لا تنصح الإمبراطوريات الغربية أنفسها بنفس النصيحة فتتخلص من الأعباء الإمبراطورية وتتفرغ لشئونها القومية(!)
وقد ظهر هذا الاتفاق بين توجهات الحلفاء وتوجهات أتاتورك أثناء حربه الاستقلالية حين ’’اتفق مع فرنسا فسحبت جيشها من كيليكيا، واتفق مع الطليان فانسحبوا من الأناضول’’ فتفرغ لقمع الأكراد فضربهم وأخضعهم بعنف ثم ضرب الأرمن بقساوة وقاد ضدهم حرب إبادة وتهجير وقتل الألوف وهجر الباقين، والغرب الذي تاجر بدمائهم يقف متفرجاً، ولزم الإنجليز الحياد فيما هو يقود جيشه ويدخل إزمير ويحرقها وينكل بأهلها ’’وبعد أن أتم مصطفى كمال السيطرة على آسيا الصغرى، انتقل إلى اسطنبول وفيها جيش إنكليزي، لكن لم يطلق النار’’،[76] ويتحدث الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى عن توقيع الفرنسيين اتفاقية أنقرة مع الكماليين في سنة 1921 وتركوا لهم بعدها كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة مما ساعد الأتراك على القتال ضد اليونانيين وأن هذه المعاهدة أكدت توجهات فرنسية سابقة لمساندة الحركة القومية التركية ضمن الصراع بين نفوذ الحلفاء في الأناضول وبموجب ذلك ’’أقرت فرنسا الميثاق الوطني وتخلت عن معاهدة سيفر وتفرغت بعد ذلك لمواجهة الحركة الوطنية السورية، كما جلا الإيطاليون عن المناطق التي كانوا قد احتلوها في جنوبي الأناضول وإن احتفظوا بجزر الدوديكانيز، وقد تخلوا هم الاخرون للوطنيين عن كميات من الأسلحة مما عزز مركزهم وجعلهم يقررون استكمال تحرير الأناضول وأراضي تركيا الأوروبية’’.[77]
وكما سبق ذكره لقد اتفقت توجهات الغرب مع توجهات الحكم الكمالي الذي منح الغربيين كثيراً مما طلبوه فلم يروا تضحية كبرى فيما طلبه لاسيما أنه ينطبق على ما كانوا قد خططوه لمستقبل المنطقة بعد الحرب إذ لم يكن احتلال الأناضول من ضمن أهدافهم بعد تقسيم الشرق العربي والقضاء على الخلافة العثمانية عملياً باحتلال معظم عمقها الجغرافي ولم يتبق سوى الإجهاز الرسمي عليها، وفي هذا يقول المؤرخ كواترت إن دفاع الأتراك عن موطنهم القومي دفع بريطانيا وفرنسا إلى العدول عن احتلال البلاد بعد أن شعروا بأن ذلك سيكلفهم غالياً، والحق أن القادة الأتراك آنذاك كانوا على استعداد للتفاوض مع الحلفاء حول قضايا معينة مثل (1) تسديد الديون التي تراكمت على الدولة العثمانية قبل الحرب، و(2) الممرات البحرية التي تصل البحر الأسود ببحر إيجه، و(3) التنازل عن سيادتهم على الأقطار العربية، وأخيراً تم الاتفاق بين القوى العظمى والقوميين الأتراك على الإقرار بزوال الإمبراطورية العثمانية الذي أصبح حقيقة واقعة’’.[78]
ويظل النقاش بعد ذلك على ما سمي شروط كيرزون الأربعة الخاصة باشتراط إلغاء الخلافة في مؤتمر لوزان سنة 1923 ومحاولة إثباتها مقابل نفيها مما لا طائل منه، لأن مصطفى كمال تشرب الأهداف الغربية وتبناها - كما فعل غيره من دعاة النهوض عن طريق استرضاء الغرب- ونفذها من تلقاء نفسه ولا حاجة لإثبات أنه تلقى أمراً بذلك في عرض مسرحي أو لم يتلق، فما هو مثبت أنه تبني وجهة نظر العدو وهذا أسوأ من تنفيذ أوامره بالإكراه، ومع ذلك لا يغيب عن ملاحظة المؤرخين الصلات الموضوعية التي ربطت بين الحكم الكمالي والغرب الأوروبي: ذلك أن النظام الدولي الجديد الذي أنشأته الدول الكبرى في منطقة الشرق العثماني بعد الحرب الكبرى قام على أساس إنهاء الدولة العثمانية وتقطيع أوصال البلاد العربية،[79] وقد تعاون الكماليون مع الغرب في النقطتين معاً بإلغاء الخلافة وبالتنازل عن الأملاك العربية للدولة العثمانية وهو أمر كان ذا أهمية قصوى للحلفاء المستعدين للانقضاض على أملاكها كي يرتبوا تقسيمها فيما بينهم بشكل قانوني يمنع التنازع فيما بينهم، ولهذا قال وزير الخارجية البريطاني اللورد كيرزون في برقية إلى اللورد اللنبي في مارس 1920 إن نظام الانتداب يقتضي أن تعترف الدولة التي كانت صاحبة السيادة على إقليم بتنازلها عنه،[80] فلم يكن من الغريب بعد ذلك أن تؤيد الدول الكبرى النظام الكمالي الجديد.[81]
وهناك ما يشير إلى سعي مصطفى كمال المبكر، سواء لأسباب قومية أو غيرها، لإفشال محاولات رأب الصدع ورص الصفوف العثمانية، ومن ذلك قيامه بحض الأمير فيصل بن الحسين على عدم الإصغاء لعروض الصلح التي قدمها جمال باشا للعرب بعد إعلان ثورتهم، وقد وعد كمال فيصلاً بدعم المعارضة التركية ومهاجمة الجيش العثماني وحلفائه الألمان من الأراضي التي تسيطر عليها عندما يستقل العرب ويستقرون في عاصمتهم دمشق، وقد تحدث لورنس العرب عن ذلك بالتفصيل،[82] وغني عن التوضيح من هي الجهات المستفيدة من الغدر بالجيش العثماني في أثناء الحرب الكبرى ضد الحلفاء، وعن الجهود البريطانية يقول كواترت: ’’كانت جهود بريطانيا لطرد العثمانيين من مكة والمدينة وتدمير خط حديد الحجاز أثناء الحرب الأولى ترمي إلى تجريد السلطان من مكانته الدينية في أعين المسلمين، وهو الهدف الذي سعى السلفيون لتحقيقه قبل أكثر من قرن’’،[83] ولهذا لم يكن من الغريب تعاون كبار السلفيين كمحمد رشيد رضا ومحب الدين الخطيب مع الثورة العربية.
* الاستقلال السياسي لم يكن يعني استقلالاً حقيقياً عن الغرب بل ربما كان باب التبعية
مع سريان موجة الثورات التحررية من الاستعمار في العالم الثالث كان كثير من قادتها معجبين بالغرب إلى حد الانبهار والهوس، ولكنهم كانوا يطلبون الاستقلال السياسي مع التبعية الحضارية دون فك عرى الروابط السياسية التي ظنوا أنهم سيحققون بها المصالح الضيقة للأمم الصغيرة المكونة حديثاً على أنقاض الوحدة العثمانية السابقة، ولأن حجم الأمة يفرض عليها حجم طموحاتها ومدى إدراكها فإن طموحات الصِغار فرضت عليهم منطق الصَغار، فمن زعماء ’’التحرير’’ من قاتل المستعمر للحصول على الاستقلال السياسي ضمن التبعية الحضارية لنفس الدولة التي يقاتلها، ومنهم من استقوى بدول غربية أخرى تنافس الدولة المستعمرة لبلاده وراهن على هذا التنسيق ليحقق به شيئاً وليظل فيما بعد في ظله أو ليخيب أمله بعد اكتشافه أن الغربيين لا يختلفون عن بعضهم البعض، ومنهم من كان المستعمر يحركهم للقيام بثورات تستبق تحركات شعبية متوقعة بعدما وصل السيل الاستعماري إلى الزبى، أما من أصيب بجنون العظمة من الحكام فكان أقصى ما يرجوه هو دور الوكيل الإقليمي للدول الكبرى ليتباهى به على أقرانه الصغار، أما من تجاوز هذا الحد بعد زمن من التنسيق مع الكبار وأخذته العزة بالإثم من وجهة نظر المستعمرين فلم يكن له إلا المقصلة، ولكن في جميع الأحوال لم يتحقق التحرير الحقيقي من الروابط الاستعمارية نتيجة قلة إمكانات وقدرات دولة التجزئة المجهرية التي فقدت العمق الجغرافي والقدرات السكانية والموارد المادية الضخمة التي كان من الممكن أن يحركها حكم قوي للوصول إلى مكانة الدولة العظمى، والغريب أن زعماء التغريب لم يسعوا لتقليد الغرب في وحداته السياسية الكبرى العابرة للقوميات لاسيما الولايات المتحدة التي كانت محط الأنظار آنذاك.
ويندرج الحكم الكمالي ضمن الفئة التي قاتلت للحصول على الاستقلال السياسي مع الهوس بالتبعية الحضارية التي تشترط نسيان كل الروابط والجذور الحضارية والمصالح الكبرى المتخطية للحدود التي رسمها الاستعمار، ومن ذلك أنه ’’كان يثمن إنكلترا ويحترمها، ولكنه كان يؤمن إيماناً راسخاً بمبدأ الاستقلالية والذي ربطه بمقولته الشهيرة: لكي تعيش في سلم وصداقة مع إنكلترا، فقد ترتب على تركيا أولاً أن تقاتل’’،[84] ولعل هذه الفكرة تذكرنا بقتال قادة مثل الرئيس اللبناني السابق كميل شمعون ضد الاحتلال الفرنسي للبنان مع إعجابه الشديد بالثقافة الفرنسية وإيمانه بضرورة الاحتفاظ بعلاقات خاصة مع فرنسا بعد الاستقلال، وقد رأينا ما جرته هذه الأفكار على استقرار لبنان ومحيطها فيما بعد، ومن أقوال مصطفى كمال في شأن التبعية والاستسلام الحضاري بعد ’’الاستقلال’’: ’’إن هناك الآن طريقين علينا أن نتبعهما، فإما أن نقبل الهزيمة والفناء أو أن نقبل ذات المبادئ التي أوجدت الحضارة الغربية المعاصرة، وإذا كنا نرغب في البقاء، فإن علينا علمنة نظرتنا للدين والأخلاق والعلاقات الاجتماعية والقانون... إن هذا ممكن فقط بقبولنا بشكل علني وغير مشروط لذهنية وسلوك الحضارة التي نحن ملزمون بمحاكاتها’’،[85] ويتضح من الفقرة أن صاحبها يعتقد أن عدم الاستسلام المطلق يعني الفناء الفوري، وهي قدرية سبق أن عرضتها حضارة الحرية الغربية على شعوب أخرى كسكان أمريكا الأصليين: الاستسلام للتحضر أو الفناء،[86] ولكن هذه الشعوب لم تجن البقاء المتوقع وذلك بسبب أنانية الغربيين الذين دفعوها إلى الفناء ولم يرغبوا في نشر التحضر بينها بالفعل سواء بعد مقاومتها أو استسلامها، وكان تصوره للتمدن متعلقاً’’ بالتصرفات، القيم الجديدة المأخوذة نماذجها عن تفكير الأوروبيين، التقويم الغربي، الحروف اللاتينية، الموديلات، الأزياء وأشكالها، القبعة الأوروبية’’،[87] ولو رأينا حياته الشخصية بصفته حامل رسالة وفكرة لرأينا أنه ’’كان دمثاً وعاقلاً، إلا أنه كان رديء السمعة، سكيراً، مع حياة عائلية فظة، مولع بالمقامرة والنساء.. وكان قاسياً متحجر القلب في التخلص من الذين خاصموه سياسياً وأيديولوجياً، وكانت لهم خطورتهم عليه وعلى حكمه، فنفى بعضهم، وشنق بعضهم الآخر.. كانت له طاقة هائلة، واقتدارات ذاتية ثابتة’’.[88]
ولم يكن مصير المحاولة التركية بعد جهود جاهدة بذلها أتاتورك للحاق بالغرب سوى البقاء ضمن البلدان النامية وعدم القدرة على الوصول إلى مصاف الدول الصناعية واستمرار الاعتماد على الأموال الخارجية لسد الاحتياجات المحلية،[89] وهي تبعية كان يتوقع منها حصول التابع على القوة وعدم التهديد من المصالح الدولية الكبرى ما أثبتت التبعية جدواها للدول الكبرى وهو ما سيواصل التابع السعي إليه،[90] ولكنها أنتجت ما رضي أن يمنحه الكبار فقط بما يتلاءم ومصالحهم[91] كما فعلوا مع من قبلنا والفرق أنهم احتاجوا بقاءنا في الوقت الذي أفنوا غيرنا، وإن ظن المستظلون بحماية الدول الكبرى المنتفعة بهم أنهم حصلوا على ما يبتغون،[92] أو تخيلوا ذلك لعدم وجود بديل أمامهم، أي أن مصطفى كمال قدم استعداداً كاملاً لخدمة الأهداف الغربية مع محاولة تقمص هذه الأهداف وتصويرها أهدافاً ذاتية وهذا لم يكن تصوراً حقيقياً لأنه بمجرد النظر نعرف أن الانضمام لحلف شمال الأطلسي مثلاً، وهو إجراء يصنف ضمن سياساته التي حكمت خلفاءه ضمن نظرته الخاصة للعلاقة بالآخرين[93] وهي العمل على ’’كسب القبول في الغرب’’،[94] يلبي أهداف من بادر لتأسيسه وليس من كان على هامشه يقدم الخدمات العسكرية والاستراتيجية دون أن يكون حراً في الإفادة من التطوير الذي حصل عليه إلا بمقدار ما يقدم الخدمات لسادته (كوريا مثلاً حيث لا مصلحة وطنية لتركيا)[95] أو بمقدار فسحة الخلاف الموجودة بين السادة أنفسهم (الحرب الكبرى الثانية مثلاً)،[96] فأتاتورك مثلا وخلفاؤه اتبعوا قوله إنه بدلاً من ملاحقة أهداف مثالية لم ولن نقدر على تحقيقها لنتمسك بالعقل ونعرف حدودنا، ومن ذلك مثلاً قوله: ’’أليس من أجل الخلافة والإسلام ورجال الدين قاتل القرويون الأتراك، وماتوا طوال خمسة قرون؟ لقد آن الأوان أن تنظر تركيا إلى مصالحها، وتتجاهل الهنود، والعرب، وتنقذ نفسها من تزعم الدول الإسلامية’’،[97] وقال أيضاً: ’’إن شعبنا قد ترك ملايين البشر في كل مكان ذهب إليه ليخدم فيه، هل تعرفون عدد أبناء الأناضول الذين ماتوا ودفنوا في صحراء اليمن؟ وكم من البشر ماتوا من أجل المحافظة على العراق وسوريا، ومن أجل السيطرة على مصر، ومن أجل الاستحواذ على إفريقيا، هل تعرفون هذا؟’’.[98]
وبالطبع فإن هذا ليس منطق الولايات المتحدة مع نفسها، فهي لا تريد أن ’’تنقذ’’ نفسها من زعامة العالم الغربي، بل العالم كله، ولا تعد الزعامة مصيبة أصلاً يجب التخلص منها، لأن هذا منطق الصغير العاجز وهي ليست كذلك، ولا تتساءل عن جدوى موت أبنائها في أطراف العالم البعيدة مثل أوروبا وفيتنام وكوريا وأفغانستان والعراق وعشرات الدول التي تدخلت فيها أكثر من 130 تدخلاً عسكرياً قبل احتلال العراق،[99] ومازالت تتغنى بتدخلها في تلال المكسيك وشواطئ طرابلس الغرب في القرن التاسع عشر، ولا تصف أي هدف مهما بعد بكونه مستحيلاً بل تستمر في السعي كي لا يكون كبيراً في العالم غيرها، وهذا هو الفرق بين منطق الكبار المتبوعين ومنطق الصغار التابعين، وبين مصالح الكبار المستقلة ومصالح الصغار التابعة، وبنفس المنطق الصغير يرفض الكماليون زعامة المسلمين والموت لأجل القضية الإسلامية وينسى أتاتورك أو يتناسى ما ذكره بنفسه من استشهاد غير الأتراك كآلاف المصريين والسوريين والعراقيين دفاعاً عن عاصمة الخلافة في الحرب الكبرى الأولى[100] في دولة كان جميع من فيها يعمل ويقدم لأجل بنيانها الإسلامي الجامع دون حسابات وفواتير الانقسامات الإقليمية، ولكن الكماليين في الوقت الذي يضنون فيه بدمائهم الغالية على قضايا ’’مثالية’’ لا يرفضون أن يموتوا هم لأجل الولايات المتحدة في حرب كوريا مثلاً وينتشون بكلمات الإعجاب الغربي الفارغ بشجاعتهم،[101] دون أن يشركهم الغربيون إشراكاً فعلياً في مغانمهم بقبول تركيا مثلاً في مجتمع الاتحاد الأوروبي الذي لم يترك متسولاً أوروبياً دون ضمه مع الضن على تركيا بهذا المقام.
* هل كانت بلادنا ضعيفة في ظل الدولة العثمانية وهل أدى زوالها إلى قوتنا
نشأت الدولة العثمانية في نهاية القرن الثالث عشر (1299) وظلت مندفعة حتى هزيمتها الثانية على أسوار فيينا (1683) وشملت بلاداً لم تصلها الدول الإسلامية الكبرى قبلها، وقد قوّمها كثير من المؤرخين بكونها ’’من أعظم الإمبراطوريات في التاريخ وأكبرها وأطولها عمراً’’[102] كما يقول دونالد كواترت، وبكونها ’’أعظم امبراطورية إسلامية وأقواها’’[103] كما يقول زين زين، كما قال زاكري كارابل بأن انتصارات العثمانيين ’’لا يضارعها إلا انتصارات الخلفاء في القرنين السابع والثامن الميلاديين’’،[104] ورغم عدم شمول السيادة العثمانية جميع العالم الإسلامي أصبح الخلفاء العثمانيون يتولون ’’المسئولية العليا للسلطة الزمنية على المسلمين إلى حدود بعيدة كالسنغال وسومطرة’’ كما يقول المؤرخ نيكولاس دومانيس،[105] ولكن المعضلة التي وجد العثمانيون أنفسهم فيها هي معاصرتهم صعود القوة الأوروبية في نفس الوقت الذي كان منحنى قوتهم يتجه للهبوط، وبدأ تراجع الدولة العثمانية بعد هزيمة فيينا كما تجسد في معاهدة كارلوفتج (1699) ومعاهدة بساروفتش (1718) اللتين خسرت بموجبهما مناطق في أوروبا وليست في صلب العالم الإسلامي، أول خسارة إسلامية ملحوظة هي الاحتلال الروسي للقرم في معاهدة كوجك قينارجة (1774) التي تبعتها الحملة الفرنسية على مصر (1798)، ’’لكن تقهقر الدولة العثمانية في الحقبة التي نتحدث عنها (1683- 1798) لم يكن أمراً واضحاً لأولئك الذين عاصروا تلك الأحداث وذلك لأن العثمانيين حققوا أيضاً عدداً من الانتصارات الهامة وخاصة في النصف الأول من القرن الثامن عشر’’ كما يقول المؤرخ دونالد كواترت،[106] أي أن فترة الضعف الملحوظ بدأت بخسارة مصر في نهاية القرن الثامن عشر، ولهذا يؤكد المؤرخ زين نور الدين زين أنه ’’ليصح القول بأن الحكم العثماني حمى الأقطار العربية والإسلام من التعدي الخارجي قرابة أربع مئة سنة’’،[107] مما يؤكد أن حالة التراجع كانت طارئة في عمر الخلافة العثمانية ولم تشمل سوى قرنها الأخير بحكم سنة الحياة والموت التي تسري على البشر والدول، وحتى في زمن ضعفها كانت صامدة صموداً تحسد عليه كما يؤكد ذلك المؤرخ الشهير إريك هوبزباوم بكلام كثير عن هذا الصمود العثماني في القرن التاسع عشر وذلك في ثلاثيته المعروفة (عصر الثورة وعصر رأس المال وعصر الإمبراطورية) كما سبق ذكره، وليس من الإنصاف مطالبة الدولة العثمانية بالخروج على سنة الحياة والبقاء قوية أبد الدهر، أي عكس ما يسري على الجميع، فقد أدت ما عليها بكفاءة والعيب فينا إذ لم نستطع القيام بمسئوليتنا بعدها وتلقفتنا دولة الاستقلال الوهمي والتجزئة المجهرية التي انبطحت لمنشئيها المستعمرين، فماذا أنجزنا نحن بها بعد قرن من رحيل العثمانيين وهي فترة شهدت صعود السوفييت من مستوى روسيا القيصرية الذي كان يوازي المستوى الذي تركتنا الدولة العثمانية فيه في نفس الزمن (1917) وساد الروس نصف العالم بعد مدة قصيرة ثم انهار الاتحاد السوفييتي ونحن ما نزال نلوم حظنا العثماني على تراجعنا المستمر.
المهم أنه بعد زوال الدولة العثمانية لاحظ كثير من المؤرخين تدهور المكانة السياسية للشرق الذي كان عثمانياً، ذلك أن ’’نظام الشرق الأوسط كان كسيحاً منذ ولادته من خلال الانقسامات التي حلت به وتبعيته لدول أعظم من نظام سائد، وطبقاً لذلك، قد يبدو الشرق الأوسط برمته، فعلياً، وتركيا الاستثناء الرئيسي، أنه انتقل من تعددية المسألة الشرقية إلى ثنائية المستعمِر/ المستعمَر’’،[108] و’’مع تقهقر وتجزئة الإمبراطورية العثمانية عام 1918، والتي كانت القوة الإسلامية العظمى الأخيرة في العالم، فقد انتقل العالم الإسلامي ليصبح في مواقع دفاع هشة للغاية’’.[109]
* زوال الخلافة لم يأت بالديمقراطية
أذاع الغربيون، لاسيما الأمريكيون ورئيسهم ويلسن، في الحرب الكبرى الأولى (1914- 1918) أنهم يقاتلون لأجل عالم ديمقراطي وليس للحصول على مكاسب مادية،[110] وتمسك الضحايا العرب بهذه الشعارات والمثاليات لتحقيق أهدافهم، ولم يكن عندهم من القوة ما يفرضون بها سياستهم على الواقع الأوروبي الذي ساوم أعضاؤه بعضهم بعضاً حتى كان كل ما تمكن منه ويلسن في صراعه مع أوروبا هو القيام بتغييرات شكلية لا قيمة لها بأن حولت ’’مثاليته’’ الهيمنة على البلاد الأخرى من اسم الاستعمار إلى اسم الانتداب دون تغيير في الجوهر الحقيقي للعملية بعد رفض الأوروبيين تطبيق نقاطه الأربعة عشر إلا فيما يتفق مع أطماعهم.
وعندما زالت الخلافة الإسلامية من الشرق العثماني لم يكن البديل أنظمة ديمقراطية على الطراز الغربي الداخلي، ففي تركيا الجمهورية ’’اعتبر الحكام الجدد لتركيا الشعب التركي قاصراً عن ممارسة الحكم والحقوق السياسية، وزعم مصطفى كمال أن هذا الشعب لا يعرف كيف يقرر مصيره، فراح يقول: إن نظام الحزب الواحد يعد أنسب التنظيمات السياسية... واستمرت أعمال القمع في البلاد، بينما كان النائب بالمجلس الكبير إذا لم يلتزم بطاعة الغازي، عند التصويت على مشروعات القوانين، أو جرؤ عضو الحزب الجمهوري على مخالفة النظام الحاكم، سرعان ما يُفصل من الحزب المهيمن، ويفقد تبعاً لذلك عمله، ويتعذر عليه إيجاد البديل ولو مات جوعاً، وتزايدت سطوة الحزب بعد هدم الكيان السياسي للدولة وتم فصل الدين عن الحكم... ورفعت الثورة الكمالية شعار: (إن الثورات يجب أن تبنى على الدم وإلا انهارت ولا تدوم)، ورغم ذلك لم يخل الحال.. من قيام معارضة عنيفة ضد النظام.. وقُدم الجميع لمحاكم الاستقلال.. وتتابع صدور أحكام الإعدام’’ كما تقول الدكتورة تهاني عبد الرحمن،[111] وظل مصطفى كمال إلى آخر حياته يعتقد أن الشعب التركي ’’لم ينضج بعد ليستحق نظاماً تسوده حرية التعبير’’ كما يقول الكاتب الفرنسي بنوا ميشان،[112] وقد كان الغرب يرفض هذه الحجة من أمثال السلطان عبد الحميد رغم التطورات التحديثية الضخمة التي قام بها، ويقبل الغرب في نفس الوقت هذه الحجة من أنظمة أكثر استبداداً ودموية لكونها أقل حجماً وأكثر تعاطفاً مع الأهداف والمصالح الغربية لا يألوا الغربيون جهداً في دعمها وإسنادها وما زال التنظير الغربي يرجو لنا مثل أتاتورك حتى اليوم،[113] ويمتدحه بالبطولة والعبقرية السياسية والعسكرية رغم شح الإنجازات لكونه حافظ على استقلال تركيا، وهو هدف تناغم مع أهداف الحلفاء كما رأينا، ولكونه ’’حوّل تركيا من دولة إسلامية إلى دولة قومية علمانية’’،[114] وهذا هو المهم عند الغرب، أما كونه ’’سحق حركة الاستقلال الأرمنية (التي دعمها الغرب) وأخمد الأكراد الانفصاليين، وفي منطقة سميرنا (أزمير) قتل عشرات الآلاف من الأرمن واليونانيين، وتم تشريد 250 ألف شخص عندما هاجمت القوات التركية المدينة وأحرقتها’’،[115] فأمر لا يهم عملية التقويم الغربية، ولكنه يهمها جداً عندما تدافع سلطة إسلامية عن شعبها ضد التدخلات والمؤامرات الغربية التي أذكت نار الكراهية ضد الحكم العثماني ثم اتخذت من هذه الكراهية التي اختلقتها ذريعة أخلاقية لتفكيك الدولة العثمانية،[116] والخلاصة أنه لا الحرية ولا الديمقراطية ولا التقدم ولا الإنسانية هي المهمة، ولكن لو جاء متغرب شبيه بأتاتورك وحاول لأي سبب الخروج من الطوق الغربي سرعان ما يجري تحجيمه ثانية بالاستعانة بقذف كل تهم الاستبداد والدموية والديكتاتورية في وجهه مع أن نفس هذه التهم لم توجه لأول من علّمها لجميع حكام التجزئة وهو أتاتورك نفسه بسبب تناغمه مع الغرب.
* تبعات إلغاء الخلافة على بلادنا
ينقل المؤرخ زين نور الدين زين عن مجموعة من الساسة الأوروبيين في القرن التاسع عشر أقوالهم بضرورة الحفاظ على بقاء الدولة العثمانية صوناً للسلام، فقد كان الإيرل بيكونسفيلد يرى أن المحافظة على استقلال الدولة العثمانية وسلامة أراضيها أحسن ضمان للسلام في أوروبا، وفي بيان للورد ألنبورو قال ’’إن الامبراطورية العثمانية قائمة ليس لصالح الأتراك أنفسهم وحسب، بل لصالح أوروبا المسيحية، وليس بغية المحافظة على بقاء المسلمين في الحكم بقدر ما هو لإنقاذ المسيحيين من حرب لا يمكن تحديد الغاية من شنها ولا معرفة الزمن الذي تستغرقه هذه الحرب’’، ويعلق زين على ذلك بالقول إن تقسيم الدولة العثمانية كان العامل الرئيس في نشوب الحرب الكبرى الأولى، وإنه بعد انتهاء الحرب الكبرى الثانية انسحبت الدول التي تنافست في السابق في المسألة الشرقية من حلبة السباق ونالت دول الشرق العربي الإسلامي استقلالها، ولكن هذا الجزء من العالم وجد نفسه متورطاً في مشكلات معقدة جداً بسبب قيام الكيان الصهيوني والصراع بين العملاقين السوفييتي والأمريكي، وتتابعت الانتفاضات ومحاولات حل المشكلات القديمة المتجددة بالمساعدات أحياناً وبالقوة أحياناً أخرى، ونشأت حالة من اليأس والقنوط، فمنذ ’’سقوط الامبراطورية العثمانية، لم تحسم قط، في هذه البقعة من الدنيا، قضية واحدة حسماً نهائياً، ولا يزال الشرق الأدنى منطقة يكتنفها الإبهام، كما أن شئونه ومشكلاته لا تزال تنتظر حلاً’’.[117]
* النهاية: الغرب يواصل عرقلة النهوض والوحدة في سبيل الحفاظ على مصالحه
استمرت جهود الغرب في عرقلة نهوض بلادنا واتحادها، وليس هنا مجال تفصيل ما حدث بعد الحقبة العثمانية، ولكن الجهود المستمرة متصلة منذ ما قام الغربيون به لإلغاء الخلافة، وفي ذلك يلاحظ الدكتور ناظم الجاسور أن الوطن العربي شهد منذ بروز شخصيته الدولية العديد من مشاريع التقسيم والتفتيت وطمس الهوية واللغة والانتماء، وكان لكل طرف دولي أدواته الخاصة ’’إلا أنها تجتمع على هدف واحد أصبح جزءً من التراث الفكري والسياسي والأمني والثقافي والعسكري للقوى الغربية، التي تعد أي تلاق أو اندماج، وإن كان على الورق، بين هذه الدولة العربية وتلك، يعني تهديداً لمصالحها، ولا بد من تقويضه وتحطيم أي أسس يمكن أن تبرز في المستقبل من شأنها تهديد المصالح الغربية ووجود إسرائيل’’.[118]
وأصبح مجرد وجود الصهاينة في بلادنا عاملاً في تفتتها ’’فثمة أمر ليس بوسع إسرائيل أن تطيقه، وهو وحدة الدول العربية المجاورة لحدودها، لأنها تدرك أن بقاءها مرهون بتشرذم هذه الدول’’، وفقاً لاستنتاج الكاتب الفرنسي المعروف بنوا ميشان،[119] وقد قام الأستاذ الدكتور أحمد سعيد نوفل بتوثيق ’’دور إسرائيل في تفتيت الوطن العربي’’ في كتاب شامل خاص جال في مخططات التفتيت الصهيونية في العالم العربي من مشرقه إلى مغربه ومن شماله إلى جنوبه.[120]
ويؤكد الدور الغربي في عملية تحطيم الوحدة والنهوض في بلادنا عميد السياسة الخارجية الأمريكية المعاصرة هنري كيسنجر في أحد مقالاته: ’’لمدة أكثر من نصف قرن، وجهت عدة أهداف أمنية السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط: منع أية قوة في المنطقة من الظهور والهيمنة، ضمان تدفق موارد الطاقة التي مازالت ضرورية لتشغيل الاقتصاد العالمي، ومحاولة القيام بدور الوسيط بين إسرائيل وجيرانها من أجل قيام سلام دائم’’ وزير الخارجية الأمريكي السابق هنري كيسنجر في مقال بعنوان: ’’توجه جديد للتدخل’’ (صحيفة الواشنطن بوست 2012/3/31).
ومما يؤكد تواصل هذه الجهود استخدام ساسة الغرب حديثاً بعبع الخلافة في دعايتهم ضد العالم الإسلامي أثناء الحملة ضده لاحتلال أفغانستان والعراق ’’إذ مضى كل من الرئيس بوش (الإبن) ووزير دفاعه رامسفيلد إلى مستشاره للشئون الأمنية ستيفن هاولي، وكذلك الجنرال جون أبي زيد، ونائب الرئيس تشيني وإريك إيدلمان ووكيل وزير الدفاع للسياسات وغيرهم إلى التحذير جميعاً من خطر قيام إمبراطورية إسلامية شمولية على امتداد الشرق الأوسط كله’’[121] ولا يهمنا مدى مصداقية هذه الدعاية وهل هناك مبرر فعلي آنذاك لاستخدام هذا البعبع أم لا، أو مدى انطباق دعوات التنظيمات التي ترعب الغرب على فكرة الخلافة الجامعة كما تمثلت في تاريخ الإسلام، وهو ما لا دليل عليه حتى الآن، ما يهم هو مدى تجذر فكرة معاداة وحدة المسلمين في هواجس الغربيين إلى درجة جعلت الساسة الغربيين يستدعونها لدعم مشاريع احتلال ضخمة كتلك، فمجرد استخدام هذه المادة في الدعاية يدل على إدراك الساسة أنها محرك مقنع لجماهيرهم التي ترعبها وحدة المسلمين تحت راية واحدة وإلا فإنها لن تلتفت إلى هذه الأحاديث وسيكون ذكر الساسة لها مجرد لغو لن يقدم عليه سياسي يحرص على شعبيته.
ومما يؤكد معارضة الرأي العام الغربي لأية وحدة في بلادنا ما يقصه الأستاذ احمد الشقيري أول رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية من ذكرياته أيام الوحدة الثلاثية بين مصر وسوريا والعراق (1963) بعد فشل الوحدة الثنائية بين مصر وسوريا (1958- 1961)، إذ يقول في كتابه حوار وأسرار مع الملوك والرؤساء: ’’في تلك الفترة امتلأت ملفاتي بقصاصات من الصحافة الغربية، وكلها تصب جام غضبها على الجمهورية العربية المتحدة الجديدة التي تضم أقوى أقطار العرب الثلاثة، مصر وسوريا والعراق... وكلها تدعو إلى حماية إسرائيل من الخطر الذي يحدق بها... وكلها تدعو إلى المحافظة على مصالح الدول الغربية من هذا العملاق العربي الذي يوشك أن يهوي على المصالح الغربية، ويشعلها ناراً ودماراً... أما إسرائيل، فقد تهيبت المصير قبل أن يحل المصير، فاستنفرت الرأي العام الدولي، ونشط سفراؤها في كل أنحاء العالم، وتحركت القوى الصهيونية في واشنطن ولندن، واقتحمت البيت الأبيض وقصر باكنغهام، فاستجاب لها أعضاء الكونغرس الأمريكي، ونواب مجلس العموم البريطاني، وجميعهم يطلب حماية إسرائيل، فإن العرب، الهمج، الوحوش، يوشكون أن ينشبوا مخالبهم، في إسرائيل، ويلقوها في أعماق البحر!! ولقد كانت هذه المخاوف في محلها، سواء على المصالح الغربية أو على إسرائيل نفسها، وإسرائيل هي في رأس هذه المصالح الغربية... فإن الجمهورية العربية الجديدة تملك إمكانات ومقدرات ضخمة، بشرية مادية وروحية، فضلاً عن أن هذه الدولة التي تقوم من النيل إلى الفرات ستتبعها خطوات وحدوية أخرى، ستفضي في النهاية إلى قيام دولة الوحدة الكبرى من المحيط إلى الخليج، ولكن الاستعمار، ومعه إسرائيل، لم يكن جاهلاً بالأمور التي تجري في الغرف العربية المقفلة... لقد كان يعرف دخائل النفوس... دون أن تخدعه العناوين الحمراء في صحافتنا، والأصوات الساخنة في إذاعتنا... ودون أن يرتجف أمام الحماسة المتصاعدة في الآفاق، المتبخرة في الهواء!!’’.[122]
ورغم فشل مشروع الوحدة الثلاثية فقد ظل شبحها مهيمناً على المشاعر الغربية المتحفزة ضد أية عملية نهوض من كبوتنا الطويلة، فقد طرح ممثل الولايات المتحدة في اجتماع مجلس حلف شمال الأطلسي الذي عقد في الربع الأول من سنة 1965 أهمية ’’الشرق الأوسط’’ بصفته جناح أوروبا الأيمن عسكرياً ومخزن ثلثي احتياطي النفط العالمي، وأشار إلى أهم الأخطار التي هددت المصالح الغربية في ذلك الزمن ومنها مشروع الوحدة العربية المدعومة بأموال الكويت (إذ طرح العراق اقتراح انضمام الكويت لمشروع تلك الوحدة المجهضة بين مصر وسوريا والعراق)، وزيادة مبيعات الأسلحة المتقدمة لدول المنطقة، والاشتراكية العربية التي اقترح محاولة استيعابها وعدم مواجهتها عسكرياً لما في ذلك من مجازفة لا حدود لها،[123] فإذا كانت الولايات المتحدة ترفض وضع ثروة الكويت وحدها في خدمة مشروع وحدوي بين ثلاث دول أو أربع فقط، وظلت كوابيس هذا المشروع تلازمها حتى بعد فشله، فإنها ستخوض حرب حياة أو موت لإجهاض وحدة الأمة كلها بما