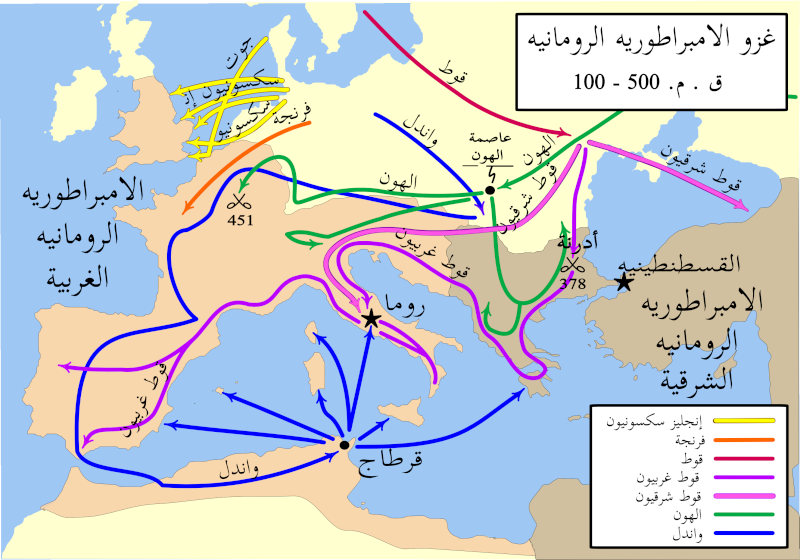محمد شعبان
* معضلة النزعات الاستقلالية عن الكيان الوحدوي الجامع: الاستقلال مقدمة الاحتلال
كانت فكرة الاستقلال عن الكيان العثماني الجامع هي البوابة التي دخل منها الاحتلال الأجنبي الغربي في أمثلة عديدة، وقبل العصر العثماني بقليل ’’لم يجد الإسبان من الدويلات المسلمة في شمال أفريقيا مواجهة تذكر لتوسعهم الكاسح...
تعاوُن الحكام المسلمين مع الغزاة الإسبان أفقدهم مصداقيتهم لدى العامة’’،[1] فلما جاء العثمانيون قضوا على التجزئة والخيانة، ومما له دلالة مهمة أن ذلك تم بمعاونة طليعية من الموريسكيين الأندلسيين في المغرب العربي[2] والذين كانوا يدركون أبعاد معركة المصير ضد الصليبية الإيبيرية، ويلاحظ كثير من مؤرخي حوادث القرن التاسع عشر الأثر السلبي الذي خلفته النزعة الاستقلالية لبعض الولايات العثمانية على مستقبلها الذي أصبح رهينة التسلط والاحتلال الأجنبي، ومن هؤلاء المؤرخين يوجين روجان الذي قال: ’’كانت دمشق وحلب جزءاً لا يتجزأ من الإمبراطورية العثمانية، في حين أصبحت تونس ومصر دولاً مستقلة تابعة للإمبراطورية العثمانية، وصارت بلاد شمال أفريقيا أكثر عرضة للاحتلال الأوروبي بسبب نفس التطورات التي عززت استقلالها والتي تمثلت في ظهور أسر حاكمة مستقلة ترأست حكومات زادت مساحات استقلالها مع الوقت’’،[3] ويقول عن الجزائر: ’’استغل دايات الجزائر استقلالهم، وبنوا علاقات تجارية وسياسية مع أوروبا بعيداً عن سلطة اسطنبول، لكنهم حين فقدوا ثقل الإمبراطورية العثمانية لم يعد لهم وزن أمام الأوروبيين الذين شاركوهم التجارة، ولذا لم يجد الدايات آذاناً صاغية عندما طالبوا الحكومة الفرنسية مراراً وتكراراً بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليها... (و) مرت عقود طويلة دون أن يسدد الفرنسيون ديونهم’’ مما أدى إلى توتر العلاقات الذي انتهى بالاحتلال الفرنسي،[4] ويقول أيضاً عند الحديث عن محاولة الخديو إسماعيل ’’تأمين مكان مصر بين الدول المتحضرة’’ التي ألجأته إلى الاستدانة: ’’والمفارقة في هذا الموقف هي أن مصر أخذت على عاتقها القيام بمشروعات التنمية من أجل ضمان الاستقلال عن الهيمنة العثمانية والأوروبية، لكن الحكومة المصرية كانت تجعل نفسها أكثر عرضة للانتهاكات الأوروبية لسيادتها مع كل امتياز جديد تمنحه للأجانب’’،[5] ويلاحظ كل من المؤرخين شارل عيساوي وروجر أوين أن استقلال مصر عن الدولة العثمانية وعدم تمتعها بثقل العثمانيين الدولي أديا إلى تكالب الدائنين عليها ومن ثم وقوعها في براثن الاحتلال البريطاني بعد إفلاسها سنة 1876،[6] ثم كان فصلها رسمياً عن التبعية العثمانية هو المقدمة القانونية لإعلان الحماية البريطانية عليها بعد اندلاع الحرب الكبرى (1914)، ومن الطريف أن بريطانيا خلعت الخديو عباس حلمي الثاني المحسوب على العثمانيين لتنصب محله عمه حسين كامل سلطاناً على مصر ليكون محسوباً عليها وأرفع مقاماً من مقام الخديو السابق وليناوئ السلطان العثماني بمقام السلطنة في نفس الوقت[7] ولكن كان منصبه في الحقيقة أقل صلاحيات من منصب الخديو ومجرد ألعوبة في يد الاحتلال لفظها شعب مصر بأكثر من محاولة اغتيال، وقد لاحظنا دائماً أن حكام الاستقلال والتجزئة يبالغون في الألقاب والأبهة من حولهم لتعوض ضعفهم وتبعيتهم ويبالغ الاستعمار في مسايرة تضخيم ذواتهم ليركنوا إليه في حكم امبراطورياتهم المجهرية.
ويلاحظ المؤرخون أن النفوذ الأجنبي الذي اتخذ صيغة الامتيازات الأجنبية والذي انتهى بالاحتلال الأجنبي في أمثلة عديدة، كان أكثر قوة في البلاد التي انتهجت سياسة ’’مستقلة’’ منه في الكيان العثماني الجامع، فقد لاحظ الرافعي ذلك عند المقارنة بين ’’حدود الامتيازات الأجنبية في تركيا’’ و’’اتساع حدود الامتيازات في مصر’’، ’’ولقد كان من أسباب هذا الطغيان مجاملة الخديو إسماعيل لقناصل الدول لكي ينال رضا حكوماتهم ويكسب تأييدهم إياه في خلافه مع تركيا’’،[8] وهو ما انتهى بمصر إلى الاحتلال العسكري البريطاني، كما لاحظ لوتسكي أن مراكش التي كانت مستقلة عن الدولة العثمانية شهدت فيها الامتيازات الأجنبية أنظمة لم تعرفها الامتيازات الأجنبية العثمانية، ورغم احتفاظها باستقلالها الشكلي طيلة القرن التاسع عشر فإنها ’’تحولت في الواقع في غضون القرن ذاته إلى شبه مستعمرة للدول الأوروبية، وأعدت هذه الدول العدة للاستيلاء عليها مستغلة ضعفها وتأخرها’’.[9]
كما كان الدفاع عن استقلال تونس عن الدولة العثمانية هو البوابة التي دخل منها الاستعمار الفرنسي كما سيأتي، وكان ’’تحرير’’ العراق من العثمانيين هو الاحتلال البريطاني نفسه، ثم توجت الميول الاستقلالية بالثورة العربية الكبرى (1916) والتي كانت البوابة التي خرجت منها الدولة العثمانية من بلادنا العربية لتدخلها دول الاحتلال الأجنبي التي تقاسمت أراضينا في نفس الوقت الذي كانت تعدنا فيه بالحرية والاستقلال، وبهذا احتلت بلادنا في البداية سواء كانت دائنة أو مدينة نتيجة استقلالها عن الكيان الموحد فخالفت بذلك الحكمة القديمة والبسيطة والتي تؤكد أن العصي تأبى إذا اجتمعن تكسراً وإذا تفرقت تكسرت آحاداً، ثم أصبح التحرر من الدولة العثمانية هو نفسه الوقوع في براثن الاحتلال الأجنبي الذي استدعينا جيوشه لتنقذنا فانقضت علينا.
* معضلة المشاريع النهضوية في القرن التاسع عشر هي الدوافع الذاتية
إن نقطة الضعف الرئيسة في المشاريع النهضوية التي أقامها الولاة العثمانيون في القرن التاسع عشر هي اختلاط الدوافع الذاتية بالعوامل الموضوعية، وقد اشتركت في ذلك مع مجمل الثورات التي قادها الزعماء الطامحون والتي لم يكن يحركها أكثر من هذا الطموح الشخصي،[10] فعندما شرع محمد علي باشا في نهضته، سخّر في البداية قوته لصالح عموم الدولة العثمانية، ولكن مع تزايد انتصاراته وتراكم إنجازاته، بدأت المشاعر الذاتية تطغى على مشروعه وأصبح يرى أنه يستحق مكانة أكبر مما أعطاه السلطان،[11] ولو كانت الساحة العالمية آنذاك خالية من الدول الكبرى المعادية لأمكن له أن يحسم خلافه مع السلطان محمود الثاني بالقوة فتصبح قوته قوة لتجديد شباب الدولة الإسلامية، ولكن حضور القوى العظمى كان يفرض على الطرفين المصري والعثماني شيئاً من الحذر في التعامل لئلا يتلاعب الأوروبيون بهما، فيشجعون محمد علي على العصيان لشق الدولة العثمانية إلى نصفين: عربي وتركي[12] فتستنجد هي بأي طرف خارجي - وهو هنا روسيا ألد الأعداء- لإنقاذها بحكم الغريزة، ولما يتجاوز الوالي الحد المرسوم ويهدد بإعادة القوة الإسلامية ينقلب الجميع ضده ويؤازرون السلطان العثماني عليه لتظل الأطراف الإسلامية جميعها ضعيفة، ثم تقوم بريطانيا التي قادت لعبة تحجيم محمد علي سابقاً بحجة الانتصار للسلطان العثماني، بتشجيع خلفاء محمد علي على الاستقلال عن العثمانيين ثانية بعدما منعت جدهم من ذلك أولاً عندما كان استقلاله مرتبطاً بإنشاء كيان موحد كبير ولكنها شجعت الأحفاد على الاستقلال بكيان صغير، لتنفرد بمصر وتحتلها هذه المرة، وقد سقط الخديو إسماعيل في الفخ وتنازل لأوروبا لتؤيده في خلافه مع السلطنة كما مر، مما جعل المؤرخ الكبير عبد الرحمن الرافعي يعجب من هذه النزعة التغريبية عند الخديو لأن ’’الخطر الذي يتهدد كيان مصر لم يكن آتياُ من تركيا الضعيفة، بل كان مصدره الاستعمار الأوروبي السياسي والمالي، وقد دلت الحوادث على هذه الحقيقة، ولكن نزعة إسماعيل الأوروبية كانت تحجب عنه كثيراً من الحقائق’’ وهذا ما أدى إلى الاحتلال البريطاني (1882)،[13] والحديث نفسه ينطبق على داود باشا في العراق الذي سار على خطى محمد علي في نفس الفترة، إذ اختلطت مشاريعه النهضوية بالدوافع الذاتية التي دفعته لتسخير نهضته في سبيل علو شأنه ومكانته ولم يتردد في انتهاز فرصة هزيمة الدولة العثمانية أمام روسيا في حرب 1827- 1829 ليعلن الخروج عليها مما أدى لهزيمته وهزيمة مشروعه في النهاية (1831)،[14] وكان العامل الموضوعي الذي دفع السلطنة العثمانية للوقوف ضد داود باشا هو’’أن السلطان كان ينظر إلى النفوذ الأجنبي في الدولة العثمانية وفي الولايات التابعة لها والشبه مستقلة منها بنوع خاص على أنه أداة لهدم الدولة وتفككها إلى ولايات مستقلة أو شبه مستقلة يسهل على الدول الاستعمارية ابتلاعها’’، ولأن مشروع داود باشا توقف تحقيقه على إنجازات الإنجليز، فقد كان من شأن ذلك أن يصبح العراق مطمعاً للاستعمار البريطاني ولم يكن يمكن لولاية أن تصمد في وجه الإمبراطورية البريطانية ’’ومن ثم وجب أن تكون العراق تحت عين الباب العالي وفي متناول يده لتدبر الأمور وفق مصالح الدولة العثمانية كلها لا وفق مصالح ولاية بعينها’’ كما يقول الدكتور عبد العزيز نوار،[15] والخلاصة أن المشاريع التي تستهدف إنهاض الأمة يجب ألا تؤثر العوامل الشخصية فيها على مصالح الأمة عامة، فلو سخّر كل من السلطان العثماني وولاة مصر والعراق وتونس جهودهم للنهوض بالدولة عموما وتهاونوا في المصالح الشخصية لأمكن لبلادنا تحقيق ما هو أفضل مما حدث.
* حجب الحقائق هو دور النزعات التغريبية الذي أدى إلى فشل المشاريع النهضوية
الحديث عن فشل المشاريع النهضوية وعدم تحققها كما أرادها القائمون عليها بسبب غلبة دوافع الطموح الذاتي عندهم، لا يعني عدم وجود ثغرات أخرى في هذه المشاريع، فالنزعة التغريبية التي اعتنقها ولاة مصر بدءاً من محمد علي باشا جعلتهم يطلبون رضا الغرب[16] عن مشاريعهم ظناً منهم أنه لا يمانع في تطور بلادنا، وكانت هذه النظرة استمراراً لنظرة الزعماء الطامحين من غير أصحاب المشاريع والذين وجد الغرب في طموحاتهم منفذاً للتدخل في شئون المجتمع الإسلامي، وكان هذا بدء الوهن، إذ أن دخول الغربيين في المشاريع النهضوية جعلهم يسيرونها وفقاً لمصالحهم، ’’فهم يؤيدون المشروع العربي لمحمد علي، فإذا أوشك أن ينجح، وقفوا ضده، مع الإسلام العثماني، ثم هم يناصرون العروبة بالمشرق، ضد إسلام آل عثمان، وفي ذات الوقت يقتسمون الوطن العربي، ويخرجون من الحرب العالمية الأولى بتصفية الخلافة الإسلامية ومشروع الدولة العربية جميعاً، وفي مواجهة الفكر الإسلامي زرعوا العلمانية والتغريب، ولمحاربة المد القومي الناصري سعوا لإقامة الأحلاف تحت أعلام الإسلام’’ كما يقول الدكتور محمد عمارة،[17] وقد ورث خلفاء محمد علي هذه النزعة التغريبية التي فصلتهم عن الرابطة العثمانية وفتحت أبواب مصر للمغامرين والأفاقين والباحثين عن الثراء من الأوروبيين - وليس العلماء وحدهم كما اقتضت النهضة- والذين قال عنهم المؤرخ هرشلاغ: ’’في الإسكندرية وحدها كان يوجد أكثر من 70 ألف هيئة تجارية أجنبية في 1837، تمثل مصالح يونانية وفرنسية وبريطانية ونمسوية وإيطالية... إلخ. إن موجات الأجانب التي غمرت مصر أصبحت عديدة، خاصة أثناء الفترات اللاحقة، بين 1857 و 1861، عندما كان يدخل البلاد 30 ألف أجنبي في المتوسط كل سنة’’،[18] ثم ورطت هذه المصالح الأجنبية مصر في الديون التي عبرت عن مصالح غربية للإقراض أكثر من مصالح مصرية للإقتراض،[19] وغرق في تلك الديون الخديو إسماعيل الذي أراد - نتيجة لنزعته التغريبية- تحويل مصر إلى قطعة من أوروبا، فكانت خطيئة الاستدانة من الأجانب - أكثر من خطيئة التبديد الداخلي- هي التي قادت إلى الإفلاس فالهيمنة الأجنبية على الوزارة ثم الاحتلال العسكري البريطاني (1882)، وذلك بعدما دفعت النزعة التغريبية الخديو نفسه إلى طلب الاستقلال عن الدولة العثمانية مستنداً إلى الدعم الأوروبي الذي لم يقدم إلا بثمن باهظ من التنازلات التي لم يجد بها الخديو ورئيس وزرائه نوبار باشا أية غضاضة بسبب ’’نزعتهما الأوروبية’’ التي حجبت الحقائق عن الخديو كما مر حين صورت له الخطر آتياً من جهة الدولة العثمانية الضعيفة وليس من قبل الاستعمار الغربي، وهي تنازلات جعلت الإصلاح ’’معكوساً مشوهاً.. ومهد لتغلغل النفوذ الأجنبي في سلطة القضاء والتشريع وفي كيان البلاد المالي والاقتصادي’’[20] وهو ما جعل مصر وحيدة في مواجهة الغرب الأوروبي الذي انتهز الفرصة وقام بالهجوم الاقتصادي ثم السياسي ثم العسكري.
وعلى الضفة التونسية فإن الإصلاحات التي قام بها البايات ’’مهدت الطريق في آخر المطاف إلى الصيارفة الأوروبيين الذين كانوا على أهبة الاستعداد للاستيلاء على تونس واستعبادها’’،[21] وقد ’’تسببت تجربة الإصلاح التي خاضتها تونس وما تبعها من إفلاس في نقل البلاد من الخضوع غير الرسمي للسيطرة الأوروبية إلى الهيمنة الإمبريالية التامة’’،[22] وكانت مشاريع داود باشا في العراق معتمدة على جهود بريطانيا الفنية والاقتصادية ومن ضمن ذلك مشروع الملاحة البخارية الذي ربط العراق بمواصلات الإمبراطورية البريطانية وأصبح محط آمال الاستعمار البريطاني ولكنه كان أضعف من أن يقف وحده في وجه السياسة الاستعمارية الأوروبية التي تعنى كلها بمشكلة المواصلات بين الهند وأوروبا،[23] وهذا هو ملخص لأثر النزعة التغريبية التي كانت فرعاً من دوافع الولاة الاستقلالية عن الدولة العثمانية، والمعجبة إلى حد الانبهار بأوروبا، إرضاء لشهوة السلطة والحكم.
* التجزئة مطلب غربي يقوم على حراسة مقدار التغريب المسموح به
وفي العصر الحديث كانت الدولة الاستعمارية الكبرى التي تنشأ لها مصالح في ولاية عثمانية تقوم بمحاولة سلخها عن الدولة العثمانية بالدفاع عن فكرة استقلالها الأزلي وتتشبث بأدلة واهية كانت هي نفسها في السابق لا تلقي إليها بالاً ولكن عندما تستجد المصلحة تغير الحقائق وتبدل الوقائع وتشجع الولاة من أصحاب النزعات التغريبية كأبناء محمد علي باشا في مصر وبايات تونس على الانسلاخ عن الخلافة وإثبات استقلالهم وتقدم في سبيل ذلك ’’مبالغ ضخمة’’ من الأموال للمساعدة على تفكيك الرابطة مع اسطنبول كما فعلت بريطانيا وإيطاليا وفرنسا حينما أقرضت البايات التونسيين لتحقيق هذه الغاية،[24] كما مهدت فرنسا لاستيلائها على تونس بالإعلان أن تونس دولة مستقلة عن تركيا وأنها تنوي الدفاع عن استقلال هذا البلد،[25] وذلك تماماً كما وقفت أوروبا بجانب الخديو إسماعيل لإثبات استقلاله عن اسطنبول فكانت النتيجة هي الوقوع في براثن الاحتلال العسكري الغربي في كل من مصر وتونس، وكذلك دافعت بريطانيا عن استقلال الكويت عن العثمانيين لتحقق المصلحة البريطانية في تعطيل وصول سكة حديد بغداد إلى ساحل الخليج مع وجود مصلحة أكيدة للكويت في هذه السكة إذ كانت ستحولها إلى ميناء عالمي مزدهر ومحطة نهائية لخط طويل يربطها بعواصم أوروبا واسطنبول وبغداد قبل ظهور النفط بعشرات السنين فلا يصبح اقتصادها بعد ذلك مجرد معتمد على تصدير منتج واحد.
ثم أصبح القضاء على الكيان العثماني الموحد هدفاً متداولاً بين الدول الغربية لا سيما بعد اندلاع الحرب الكبرى الأولى (1914- 1918) كما أفصحت عن ذلك رسائل ومذكرات من بلفور ولورنس (دراسة: لماذا يحطم الغرب نهضاتنا/ 1، ودراسة: آثار التغريب السياسي على المجتمع الإسلامي/ 1)، وسياسات الحلفاء التي مزقت الدولة العثمانية بعد الحرب بطريقة لم تحدث حتى مع ألمانيا نفسها التي قادت الحرب ضد هؤلاء الحلفاء، هذا بالإضافة إلى إصرار المنتصرين في الحرب على الحصول على تنازل تركي عن الأملاك العثمانية وهو ما حصلوا عليه في معاهدة لوزان (1923) التي أكدت على ما جاء في معاهدة الاستسلام في سيفر (1920) في ذلك المجال مما جعل الحلفاء يتهاونون في بقية المطالب ويمنحون الكيان الكمالي تنازلات شكلية، إذ لم تعد الدول الغربية بحاجة إلى استنزاف دولة معادية تسيطر على الشرق بعد انتفاء وجودها ولهذا تم إلغاء الامتيازات الأجنبية التي حفزت شركة الهند الشرقية البريطانية في الماضي على إعلان حرب بالمدافع والبوارج على والي العراق داود باشا عندما جرؤ على إلغائها (1821)،[26] فلما قسمت المنطقة إلى دول صغيرة يسيطر الحلفاء عليها وعلى مجرى الحوادث في منطقتها لم يعد هناك حاجة لمثل هذه الامتيازات فقام الغرب بالتنازل عنها بسهولة نسبية مع احتفاظ مندوبيه بالغطرسة الاستعمارية في عملية التنازل.[27]
ثم كان الغرب هو من قام برسم وتخطيط وفرض التقسيم على أجزاء الدولة العثمانية التي وضع أيديه عليها قبل وبعد هزيمة الحرب الكبرى الأولى، فشطر وادي النيل في اتفاقية الحكم الثنائي (1899) ثم تقاسمت دوله شرق المتوسط في اتفاقية سايكس بيكو (1916) ثم رعت بريطانيا سلسلة من اتفاقيات التجزئة في الخليج والجزيرة العربية كالعقير (1922) وحداء (11-1925) وبحرة (12-1925)، ولم يكتف الإنجليز بشطر وادي النيل حتى أصروا قبل مغادرته (1953) على عدم عودة وحدته بعد خروجهم منه،[28] وكانوا منذ البداية قد بذروا بذور تقسيم آخر هو الانفصال الجنوبي[29] الذي رعته الولايات المتحدة والصهيونية وثوار عرب فيما بعد حتى أثمر دولة ثالثة في الوادي سنة 2011.
وكثيراً ما كان الموظفون الاستعماريون البريطانيون يتفاوضون فيما بينهم ممثلين عن الدول العربية لتقرير الحدود بين أصحاب الملك والصولجان، وتزخر الوثائق البريطانية بالمفاوضات والمراسلات بين الموظفين الإنجليز أنفسهم نيابة عن حكام كل من العراق والكويت بعد الحرب الكبرى الأولى، حين تُرك موضوع الحدود برمته بين أيدي حكومة صاحبة الجلالة، لتقرير ما تراه مناسباً، ومن الطرائف التي تدل على حقيقة الأهداف والمتحكمين في مسار الأحداث أنه بينما كان العراق والكويت يتجادلان بواسطة الموظفين البريطانيين على موقع نخلة مندثرة تفصل البلدين وتقسم الشعبين وتحدد ملكية ميناء أم قصر، وذلك أثناء الحرب الكبرى الثانية، ’’قررت بريطانيا إدارة هذا الميناء عسكرياً أثناء فترة الحرب وعدم عائديته لأي من الطرفين، ومن ثم تفكيكه وهدمه وإزالته بعد انتهاء الحرب’’ (1942)،[30] وبهذا انتهكت قدسية النخلة التي سالت لأجلها أنهار من الدماء فيما بعد وأما البريطاني فلم يرد على انتهاكه أحد (!)، وهكذا نختلف فيما بيننا دائماً حتى ينقض الأجنبي على ما نختلف عليه فنخسر جميعاً ونحن راضون بالهزيمة للعدو الخارجي الذي يخرج وحده غالباً من بيننا.
ولم يكن منح الاستقلال للبلدان المستعمَرة إلا شكلاً جديداً من عملية إحكام السيطرة عليها وتأقلماً مع الظروف التي استجدت في عالم الاستعمار، وفي ذلك يقول المؤرخ روجان إن النفقات الرسمية للحفاظ على الإمبراطورية الاستعمارية البريطانية تصاعدت نتيجة المقاومة العنيفة التي واجهتها في الشرق في كل من مصر والعراق وفلسطين، فحاولت بريطانيا ’’تخفيف شروط الإمبراطورية بمنح مستعمراتها استقلالاً صورياً وتأمين مصالحها الاستراتيجية من خلال المعاهدات.. ومع إفلات العالم العربي من سيطرة بريطانيا، أصبحت الإمبراطورية البريطانية في الشرق الأوسط عائقاً أكثر منها مصدر قوة’’، ولم تكن فرنسا أوفر حظاً من الإنجليز.[31]
ووجد الغربيون أنفسهم منسجمين مع دول الاستقلال والتجزئة التي قامت على أنقاض الكيان العثماني الموحد أكثر من انسجامهم مع هذا الكيان في الماضي، ولهذا بادروا بمساعدة هذه الكيانات حتى بعد استقلالها وكانوا يقدمون لها مبالغ كبيرة كونت نسباً عالية من ميزانيات بعضها مقابل الخدمات التي تقدمها،[32] وإن الانسجام بين الغرب والحكومات التي تبنت التغريب في إيران البهلوية وتركيا الكمالية بالإضافة إلى الحكومات الليبرالية والتغريبية في المملكة المصرية والمملكة العراقية والجمهورية التونسية والجمهورية اللبنانية بعد الاستقلال والحكومات التقليدية في ممالك الجزيرة العربية وبقية الممالك في الشام وشمال إفريقيا يدلنا على النموذج الأمثل الذي يريده الغرب لنا بعيداً عن أي نهوض أو توحد، وقد جاء في وثيقة أمريكية رسمية صيغت في سنة 1992- 1993 بعنوان ’’مخطط البرنامج الدفاعي’’ ما يلي: ’’لا بد من منع كل قوة معادية من التحكم في منطقة تؤهلها مواردها للارتقاء إلى مصاف القوى العظمى، وكذا إفشال محاولة أي دولة مصنعة متقدمة من منازعة زعامتنا الدولية، وقلب الوضع السياسي والاقتصادي القائم’’،[33] ويرجى ملاحظة الحرص على الوضع القائم أي على إدامة التخلف والضعف، وقد اعترف عميد السياسة الخارجية الأمريكية المعاصر هنري كيسنجر في مقال كتبه إنه لمدة أكثر من نصف قرن، وجهت عدة أهداف أمنية السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط منها منع أية قوة في المنطقة من الظهور والهيمنة (صحيفة الواشنطن بوست 31-3-2012).
ومما يؤكد ذلك ما يتسم به التأريخ الغربي لبلادنا من تأييد للجبرية السياسية المناقضة لديمقراطيته إذا اقتصرت إنجازاتها على تقليد الغرب في القوانين الشخصية وشرب الخمر والتفسخ الاجتماعي واستعمال اللغات الأجنبية بدلاً من الوطنية ولبس الزي الأوروبي وبقية المظاهر الفارغة، وعندئذ يُمدح المستبد الذي يقود هذه التغيرات حتى لو كان ذلك بطرق دموية فيوصف بإعجاب بأنه ’’المصلح الذي لا يعرف الرحمة’’ كما قيل عن كمال أتاتورك مثلاً الذي مدحه مستشرقون ومؤرخون غربيون كبار بل لقد جعل منه عميد المحافظين الجدد برنارد لويس علاجاً شاملاً للعرب تصور أن يُستنسخ مثيل له في العراق بعد اجتياحه[34] رغم أن إنجازاته لم تنقل تركيا نقلة نوعية مقارنة بثورات أخرى معاصرة بل أدت إلى تراجعها السياسي من دولة عظمى إلى إحدى دول العالم الثالث[35] واقتصرت جذريتها على مظاهر سطحية فارغة كالأزياء الأوروبية والحروف اللاتينية وتغيير يوم العطلة، وعن هذه الإنجازات تتحدث الموسوعة البريطانية فتقول إن المصلح المتميز مصطفى كمال كان يطمح إلى تغيير الحياة الاجتماعية في تركيا بضربة واحدة، فلما واتته الفرصة ألغى الخلافة الإسلامية وأغلق جميع المؤسسات القائمة على الشريعة بالإضافة إلى الطرق الصوفية، كما ألغى التعليم التقليدي وأسس تعليماً علمانياً مكانه، وحدّث القضاء بقوانين جديدة بدلاً من الشريعة الإسلامية، وتخللت إصلاحاته الحياة اليومية للشعب التركي فاستبدل بالملابس القديمة الملابس الأوروبية، وانتشر الرقص والحفلات المختلطة والمسرح والموسيقى، وساوى بين الجنسين، واستبدل بالحروف العربية الحروف اللاتينية، وعمل على إحلال الرابطة القومية مكان الرابطة الإسلامية، وحكم بواسطة نظام الحزب الواحد وقمع المعارضة بعنف، وباختصار فقد شملت إصلاحاته السياسة والثقافة والقانون فتمكنت وجهة النظر الغربية من اكتساب نفوذ بين الطبقة المتعلمة مما جعل العودة إلى النظام القديم مستحيلة، أما عن التصنيع، وهو مربط الفرس في المشاريع النهضوية، فتقول الموسوعة ’’إنه لم يحقق أي نجاح مهم’’، سواء بواسطة رأس المال الخاص أم بواسطة التدخل الحكومي، وذلك رغم أنه برر إصلاحاته بكون العلم هو الموجه الأمثل للحياة.[36]
وعن نتيجة هذه التجربة الإصلاحية والمحاولة النهضوية يلاحظ فيليب روبنس أن ’’تركيا المعاصرة التي أسست على أيديولوجية الدولة- الأمة؛ أي النزعة القومية العلمانية؛ والتطلع نحو غرب الصناعة والعلم والحداثة سرعان ما أجبرتها وقائع التاريخ الصلبة على اكتشاف أن حلم التماثل مع الغرب عسير المنال؛ إذ لا يكفي لتحقيقه التنكر لهوية الشعب الدينية والثقافية وفرض نظام قانوني غربي محل الشريعة الإسلامية وإلغاء التعليم الديني والأخذ بالرموز المسيحية بدلاً من الإسلامية وبالأبجدية اللاتينية عوضاً عن العربية وإحلال الزي الأوروبي مقابل اللباس المحلي... إلخ من مظاهر خيّل لنخبة أنها تختزل جوهر الغرب ولبه’’،[37] ويلاحَظ أن هذه السطحية تشبه إلى حد بعيد سطحية كثير من إجراءات التنظيمات العثمانية التي أدخلت النماذج الأوروبية في الموسيقى والمسرح والأزياء والمعمار، وزادت الإجراءات الكمالية عليها بمزيد من فرض سطحية التقليد بالعنف.
هذا هو النموذج الذي حاز على رضا الغرب وثنائه وتقديس أتباع التغريب وتأليههم، استبداد سياسي يقود إلى التبعية الحضارية والفشل الصناعي، فكيف إذا أضاف المستبد لما سبق صداقة حميمة مع الكيان الصهيوني ممثل الحضارة الغربية في الشرق، وهو أمر يضفي على من يقوم به مدائح التسامح العصري، بل الدعم المادي السخي،[38] ولكن مع كل التنازلات التي قدمتها الجمهورية الكمالية والتبعية التي دانت بها للغرب لم تحصل على عضوية النادي الأوروبي في الوقت الذي قُبلت فيه في عضوية التحالف الأطلسي منذ البداية كما قبلت عضوية بلاد عربية وإسلامية في أحلاف عسكرية غربية كحلف بغداد مثلاً دون الوصول إلى مستوى المعيشة الغربية، وهي مفارقة تدل على المكانة القصوى التي يسمح لأي تابع من بلادنا أن يتبوأها مهما بالغ في التشبه بالغرب الذي لا يكف عن الحرص على حصرية امتيازاته ولهذا يتقبل من الأتباع أن يقوموا بالخدمات السياسية والاقتصادية والعسكرية ولكنه لا يقبل أن يشاركهم في التمتع بمزاياه.
أما إذا رام هذا المصلح أو ذاك المشاركة في مزايا الحضارة الغربية والحصول على ما هو أكثر من تلك الشكليات التي طبقتها الثورة الكمالية، للوصول إلى ما هو أكثر من التقليد السطحي لما عند الغرب أيضاً كالوحدة والتصنيع الثقيل والتسلح والمقاومة فإنه يصبح حينئذ فقط ديكتاتوراً متوحشاً ويُنسى المديح الذي كان يُكال لعدم رحمته من قبل، ويتم تحطيم إنجازاته فلا يجد في إمكانات الدولة القُطرية ما يواجه به العدوان، وخلاصة الأمر أن هنالك جرعة محددة من التغريب مسموح لنا بها وهذا سر إغداق الإطراء حديثاً على نموذج دبي[39] رغم أنه لا يقدم وصفة عامة قادرة على الحياة المكتفية المستمرة حتى لنخبتها فضلاً عن حشود الجماهير الفقيرة في منطقة الشرق العربي الإسلامي، وهو مديح يذكرنا بإطراء النموذج التونسي ودعمه زمن بورقيبة[40] وبن علي حين أُطلق على تونس لقب الدولة- النموذج[41] بسبب نجاحات وقتية وجزئية استكثِرت على بلادنا ولكنها لا تمثل انتقالاً حاسماً في مسيرات النهوض.
* الفرق بين التغريب العثماني المستقل والتغريب التابع عند كيانات التجزئة
عندما ظهر الضعف بوضوح في المجتمع الإسلامي زمن الدولة العثمانية، استخدم الغرب لواء الإصلاح وفق نموذجه حجة لتبرير تدخلاته وتحقيق الربح على حساب هذا المجتمع الشرقي، وقد تمكن بهذه الأداة من القيام بعمليات هدم في بناء هذا المجتمع الذي تراجعت قوته باتباع هذه الوصفة الخارجية (يمكن مراجعة سلسلة دراسات آثار التغريب على المجتمع الإسلامي)، وحين كانت المبادئ لا تحقق الهدف المنشود كان الغرب يعامل الآخرين بغير ما يرضاه لنفسه ويطلب منهم ما لا يطبقه داخل بلاده بكل صفاقة وعدم حياء، فوقف في وجه كل إصلاح ابتغى به العثمانيون تقدم بلادهم حتى لو كان مما يطبقه الغربيون أنفسهم في بلادهم هم في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية والقضائية، ويكفي في هذا المقام الإشارة إلى إصرار الأوروبيين على العمل بالامتيازات الأجنبية رغم علمهم بآثارها الضارة على الدولة العثمانية وإصرارهم كذلك على ابتزازها في لحظات الهزيمة بمعاهدات التجارة الحرة رغم اتباعهم سياسات الحماية الجمركية، وتدخلهم في الشئون العثمانية الداخلية بحماية الأقليات وهو ما لا يقبلوه في دواخلهم، ومعارضتهم كذلك لمشروع سكة حديد الحجاز ومشروع سكة حديد بغداد بصفتهما مشروعين حيويين، ولم يكن من الغريب أن تستهدف بريطانيا خط حديد الحجاز بالتدمير في الحرب الكبرى بعد أن بنته أموال المسلمين وجهودهم دون الحاجة إلى قروض الغرب، هذا بالإضافة إلى معارضة مشروع الإصلاح الضريبي والبريد العثماني والإصلاح القضائي ثم دعم بريطانيا وفرنسا للمعارضة الدستورية ضد الحكم الحميدي رغم أن المستعمرين كانوا يعترضون على الحكم الدستوري في محمياتهم ومستعمراتهم ثم انقلبوا على الحكم الدستوري العثماني نفسه وكان جشع أوروبا وطمعها بممتلكات العثمانيين أقوى من التزامها الديمقراطي تجاههم كما يقول المؤرخان شو،[42] ولهذا وجد أنصار التغريب في المجتمع الإسلامي أنفسهم بين خيارين: إما الخضوع لحاضر الغرب الذي يتضمن القبول بما لا يقبله الغربيون لأنفسهم ومن ثم عدم تطبيق النموذج الغربي كاملاً، وهؤلاء كان مصيرهم الدخول في قفص الاحتلال الأجنبي المباشر مثل بايات تونس (1881) وخديويي مصر (1882)، أما الخيار الثاني فهو الإصرار على تحقيق ما حققه الغرب لنفسه وفق نموذجه وهذا ما لم يكن مقبولاً لدى الغربيين أنفسهم الذين تأمرهم مبادئهم بالربح والمنفعة ولو على حساب المبادئ التي ينادون بها، ويعملون بلا كلل على منع ظهور أقطاب كبرى تنافس هيمنتهم، ولأن ساسة التغريب العثمانيين كانوا ينتمون لدولة كبرى رغم ضعفها ويحتم عليها وضعها أن تسعى للتكافؤ مع أقرانها العظام فإن منطق الاستقلالية فرض نفسه عليهم فكانوا - مثل المحافظين من ساسة الدولة أيضاً- يرون مكان دولتهم بين الكبار[43]، و’’يعتقدون بجلاء بأن مكان الإمبراطورية العثمانية هو بين دول أوروبا العظمى وأن تقوية هذه الدولة هو السبيل الذي لا غنى عنه لتحقيق هذا الهدف’’،[44] ’’ولم يكونوا مجرد أدوات للنفوذ الغربي بل طبقوا جدولهم الخاص وسعوا لدعم برنامجهم السياسي الذاتي’’،[45] وكانوا يتبعون نهج التغريب آملين به دعم دولتهم العثمانية لتتمكن من مواجهة التحديات الأوروبية وهو أمر لم يخطر ببال أنصار التغريب في دول الاستقلال الوهمي والتجزئة المجهرية التي قامت فيما بعد وكان أقصى ما تسعى إليه هو الازدهار في كنف قوة غربية عظمى مهما بلغت درجة التبعية والاستغلال، وهذا المنطق بالطبع لم يناسب دولة كبرى وإن كانت ضعيفة كالدولة العثمانية ولهذا فإن النتائج التي أسفر عنها التغريب أدت إلى استياء أتباعه وعدم موافقتهم على فقدان الاستقلال العثماني في مواجهة الأطماع الغربية، وكان من أوائل منتقدي هذه النتائج التغريبية الوزير العثماني ورائد التغريب مصطفى رشيد باشا الذي استنكر إلحاق فرمان الإصلاح الهمايوني سنة 1856 بمعاهدة باريس التي أنهت حرب القرم وجعله التزاماً دولياً على السلطنة لأن ذلك خطر على شرف السلطان واستقلال الدولة، ومن المنتقدين أيضا الأديب الشهير نامق كمال (ت 1888) الذي اتهم الإداريين العثمانيين بإفساح المجال للتوغل الاقتصادي الغربي وعدم إدراك أهمية التقاليد الإسلامية الإيجابية،[46] وقد وصل الأمر بأصحاب هذا الخيار بالانتقال من الارتباط الفكري والسياسي الوثيق بالغرب الأوروبي إلى الانفصال السياسي الحاسم عنه وإعلان الحرب على أطماعه كما حدث لأتباع جمعية الاتحاد والترقي زمن الحرب الكبرى الأولى (1914- 1918) بعدما نشئوا في الحضن الغربي، وهذا ما أحب لفت النظر إليه دائماً من فرق بين التغريب المستقل الذي يعمل لما يتصوره صالح الذات مما يؤدي لاصطدامه بالتربص الغربي بهذه المصالح، والتغريب التابع الذي يعمل على خدمة مصالح الغرب حتى ولو تناقضت مع الفكر الغربي ومصالح الذات مما يجعله مجرد أداة بيد سادته فلا يقدم تطوراً لأمته، فكانت هذه هي دائما معضلة التغريب في دولة التجزئة مع غرب لا يرى إدخال الآخرين في جنته المزعومة ومع ذلك لا يكف عن تقديمها بصيغة موعودة.
* معضلة التغريب التابع هي نخبوية الحضارة الغربية
ومنشأ هذه المعضلة هي في كون الإنسان يشعر بالتآلف مع من يتفق معه في الفكر، ومن الطبيعي أن يشعر المتغربون بالميل إلى جهة مرجعيتهم الفكرية، ولكن المشكلة أن الحضارة الغربية لا تؤمن بدخول الآخرين جنتها الموعودة لأنها حضارة حصرية وتؤصل هذه النخبوية بفكرة المنفعة المغروسة في النفس البشرية والتي تسعى إلى احتكار اللذة والفائدة لصاحبها المدعوم بالفكر الدارويني الذي يرى أن لا بقاء إلا للأقوى وليس هناك مكان للضعيف رغم كل الكلام الإنساني الأجوف عن الإخاء والمساواة والقانون وغير ذلك، وبهذا يجد أتباع الغرب أنفسهم في مشكلة أمام جمهورهم وليس أمام أنفسهم لأن ألفتهم مع الغرب تجعلهم تبعاً لمصالحه الحصرية التي تستثنيهم من نعمها وتقودهم لأن يصبحوا عملاء وليسوا أصدقاء ولا نصيب لهم من التقدم الغربي إلا بما يبقيهم أتباعاً ضعفاء محتاجين إليه ولا أمل لهم بتكرار نموذج النهضة الغربية الذي حتى لو كان ممكناً فإن الغربيين لن يسمحوا به حتى لا يخلقوا عمالقة تنافسهم ولهذا انتهت كل المحاولات للنهوض المستقل على خطى الغرب بالتدمير والتحطيم بالقوة الغربية نفسها لأن الغرب لا يؤمن إلا بالاستتباع وليس بالتكافؤ في التعامل.
ولو وضعنا الأمر في سياقه التاريخي لقلنا إنه من الطبيعي أن يشعر الإنسان بالألفة مع من يماثله فكرياً، وقد كان التقدم الأوروبي حافزاً لنخبة متعلمة في بلادنا أن تنبهر بالحضارة الغربية، كما كانت حالة التراجع والضعف التي عاشتها دولة الخلافة في مراحلها الأخيرة مبرراً إضافياً لأصحاب التوجهات التغريبية للشعور بالغربة من مجتمعهم والمراهنة على التطور عن طريق التبعية للغرب المتقدم، حتى لو كانت هذه التبعية مفضية إلى تأييد الاستعمار الذي تصوروا أنه سيأتي لنا بالخروج من التخلف، ولكن المعضلة التي واجهت التغريب أن الحضارة الغربية حضارة منفعة واستئثار لا تؤمن بالمشاركة، أي أن مكان ’’الآخر’’ فيها هو مكان التابع الذي يخدم المصالح الغربية ولكنه لا يصعد إلى درجة التكافؤ مع أصحاب هذه الحضارة، وكان على أنصار التغريب الاختيار بين خيارين: إما التبعية وخدمة المصالح الغربية على حساب أمتهم دون الحصول على مركز متقدم كتقدم الغرب، وهذا هو السبب الذي دعا القيادات القومية، التي نادت بالاستقلال العربي والوحدة العربية زمن الدولة العثمانية بتحريض من الحلفاء، للتخلي عن هذا الحلم لما تخلت عنه المصالح البريطانية[47] بعدما استفادت منه في القضاء على الخلافة، فأصبح دعاة الاستقلال والوحدة هم قادة الانفصال والتجزئة[48] الذين كانوا يتلقون ’’النصائح’’ من سفراء بريطانيا[49] أو ضباط المخابرات البريطانية الذين يوجهونهم ويملون عليهم ما تتطلبه مصالحهم الغربية،[50] ولم يتردد رؤساء الدول العربية ورؤساء الحكومات من إفشاء قراراتهم ’’السرية’’ونقلها حرفياً إلى سفراء بريطانيا المعتمدين لديهم،[51] ولم يتحرج أصحاب الفخامة والسمو والصولجان من العمل كالموظفين عند الموظفين بتقديم التقارير السرية إلى الموظفين الإنجليز،[52] وهذا ما يريده الغربيون ويسعون له تحت لافتات الإصلاح الذي ينادون به، أما الخيار الثاني أمام المتغربين فكان الصدام مع الغربيين الذين لا يسمحون بتكرار تجربتهم لكي لا تظهر أقطاب قوية أخرى تنافسهم، وهذا ما حدث مع بعض أنصار التغريب مثل جمعية الاتحاد والترقي التي دخلت الحرب الكبرى 1914 ضد الحلفاء الذين كانوا أصدقاءها بالأمس بعدما اكتشفت حقيقة الأهداف الغربية والتي تحدث عنها السلطان عبد الحميد مبكراً وأشار إلى غفلة رجال التغريب عن الأطماع الأوروبية[53] وفضح شعارات الإصلاح الغربية التي لا يراد منها سوى تدمير الدولة العثمانية.[54]
وقد واصل الغرب معاملة دولة التجزئة بخلاف ما يقبله لنفسه، كما عامل العثمانيين من قبل، وذلك رغم اختلاف الظروف وخضوع حكام العرب له، ولم يصغ لتوسلات ساسة التغريب الذين وضعوا الآمال العربية تحت رحمة السياسات الاستعمارية وطالما طالبوا الحكومات الغربية المسيطرة بدعم تطلع العرب لأية صيغة وحدوية حتى لو اقتصرت على كيانات أصغر من وحدة المشرق العربي كسوريا الكبرى مثلاً أو الهلال الخصيب، لأن الحوادث التي جرت في البلاد العربية أثبتت ضعف الدويلات كما قال نوري السعيد للإنجليز سنة 1942 مضيفاً أنه ’’لا بد من نبذ الفكرة القديمة الرامية إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ودولة لبنانية سورية مستقلة والنظر في حل جديد’’ مبيناً حاجة العراق إلى منفذ بحري وحاجة فلسطين إلى سوق كبير لصناعتها ولهذا فإن’’الحل المنصف الوحيد’’ هو إعادة توحيد بلاد الشام ونشوء عصبة عربية بين الشام والعراق يباح لبقية العرب الدخول فيها لو شاءوا، وذلك ’’لضمان دوام السلم والاطمئنان والتقدم في هذه المناطق العربية’’،[55] وكأن غاية غايات الدول الكبرى من الاستعمار والانتداب والحماية هي سعادة العرب وهناؤهم يا دولة الباشا (!)، وكانت النتيجة هي نبذ كل هذه الاقتراحات حتى لو بنيت على أساس الحرص على حماية وتحصين مصالح الحلفاء ضد استغلال ودعاية المحور في زمن الحرب الكبرى الحرج، وكذلك ضمان الأمن والسعادة للوجود الصهيوني الذي سيزول القلق منه عند أهل فلسطين وسيتقبلونه ضمن دولة الوحدة السورية وستتوقف المقاومة ضده، وكان الرد على كل هذه الضمانات هو الإمعان في التجزئة والتقسيم والتهويد مما أثبت بُعد النوايا الغربية عن آمال النهوض العربي مهما تنازل، وعن آمال التغريب في الغربيين مهما تجمل لهم، ولهذا ظل البريطانيون يصمون آذانهم عن نصائح نوري السعيد حتى عندما قدم تنازلاً جديداً ونصح العرب بالإيجابية والاعتدال والعقلانية في المطالب (1951) وذلك بالرجوع إلى خطوط تقسيم فلسطين معتمداً على أننا ’’نستطيع بواسطة أصدقائنا في لندن أن نرغم إسرائيل على قبول هذا الحل’’ (!)، وهو أمر يذكرنا بوضع 99% من أوراق الحل في يد أمريكا بعد ذلك بعشرات السنين، والحال يغني عن بيان ما أسفرت عنه هذه العقلانية والثقة في الغرب.
وحتى عندما ’’لم يبق بين الرجال الذين تعتمد بريطانيا عليهم في المنطقة، بعد إعفاء غلوب (1956)، سوى نوري السعيد في بغداد’’،[56] لم يتم الإصغاء إلى مشاريعه وآرائه، وحتى عندما دخل العراق في الاتحاد العربي مع الأردن استجابة لمصلحة بريطانيا في مناوأة الجمهورية العربية المتحدة (1958) رفضت الحكومة البريطانية بقوة مشروعه لمنح الكويت استقلالها وضمها إلى الاتحاد دون أن تجعله يفقد الثقة فيها أو تضعف حماسته في مقاومة مصر وسوريا، أي أن وظيفته هو خدمة المصالح البريطانية دون التدخل فيها أو الحصول على مكاسب منها، وكان سبب الرفض هو شعور بريطانيا أن العراق والأردن يريدان وضع الأيدي على ثروة الكويت في الوقت الذي تحرص فيه بريطانيا على بقاء هذه الثروة ذخراً لها كما اتضح بعد أشهر عند قيام ثورة14 تموز في العراق فصرح رئيس الوزراء البريطاني معبراً عن القلق من امتدادها إلى الخليج حيث ’’الكويت بإنتاجها الضخم من النفط مفتاح لحياة بريطانيا وأوروبا’’،[57] وظل الاهتمام البريطاني منصباً على استغلال العرب في مشاريعهم الخاصة المفصلة على المقاس الإنجليزي وحده كحلف بغداد (1955) دون محاولة تقديم أي تنازل ولو كان شكلياً للجانب العربي المخلص لهم، كما كان الإنجليز قد تحفظوا على مشروع الوحدة العربية لرئيس الوزراء العراقي الآخر فاضل الجمالي (1954) ورفضوا السير قدماً في تنفيذه رغم تأكيده أنه مستعد لحماية المصالح البريطانية في أي اتحاد فيدرالي يتم التوصل إليه، وأنه لا يمكن تحقيق الخطوة الأولى إلا بالاتفاق مع البريطانيين،[58] وقد ساهم كل ما سبق في النهاية الدموية للحكم الملكي في العراق ولعرابه نوري السعيد شخصياً.
ومن الأمثلة الدامغة التي قررت مستقبل بلادنا خلافاً لأوضاع الغربيين الذين سيطروا علينا أنهم قسموا هذه البلاد ووضعوا الحدود الفاصلة بينها في الوقت الذي كانت فيه أممهم تتجه للتكتل، وانسجموا مع قيادات مستبدة وحكومات فاسدة لا يقبلون بها في الغرب، وأيدوا إقامة دولة تعتمد الهوية الدينية على أنقاض شعب فلسطين رغم أن الغرب نفسه يرفض اعتماد التصنيفات الدينية في الكيانات السياسية، وحدث ذلك بإهمال حق تقرير المصير الذي رفعوا لواءه منذ الحرب الكبرى الأولى وميثاق الأمم المتحدة التي نشأت بعد الحرب الثانية،[59] كما أنشأ الفرنسيون كياناً طائفياً في لبنان يخالف كل أعراف الغرب العلمانية ومن أعجب مظاهره أن آخر إحصاء تم فيه كان منذ أكثر من ثمانين عاماً وذلك بسبب الخشية من اهتزاز الصيغة الطائفية التي رسمها الغرب ويريدها لهذا البلد، كما ابتلى الغربيون مصر بزراعة المحصول الواحد لتكون ممولاً لصناعات القطن في بلادهم وتهمل اكتفاءها الذاتي الذي عمر فيها قروناً ماضية، كما فرض الغرب على إيران حكماً مستبداً لعشرات السنين على أنقاض حكم منتخب ديمقراطياً (1953)، ومازال الغرب يثير نعرات العصبية والانفصال والتقسيم في بلادنا بعد أن قضى على معظم الجيوب الإثنية داخله بالعنف.
ولعل الفرق بين سويسرا الغرب وسويسرا الشرق، أي لبنان، يلخص معضلة التغريب بين واقع الغرب المبهر وما يريده الغربيون لنا من تخلف: فمنذ مؤتمر فيينا سنة 1815 أقرت أوروبا حياد سويسرا وظل الفرقاء الأوروبيون جميعاً يحترمون هذا القرار حتى أثناء الحربين العظميين إذ لم يقدم أحد حتى النازيون على خرقه، أما سويسرا الشرق التي صنعها الغرب أيضا فقد سمح لذيله الصهيوني باتخاذها مسرحاً لمغامراته الدموية ولو دون سبب كما حدث في غزو 1982، كما أن النموذج السياسي الطائفي الذي صنعه الغرب في لبنان والذي ولد سيولاً من الدماء لا يمكن أن نعثر عليه في مكان في الغرب حتى سويسرا المتنوعة دينياً، الفرق بين السويسرتين هو الفرق بين ما يصنعه الغرب بإتقان لنفسه وما يصدره لنا من قمامته الفكرية فضلاً عن قمامته النووية وهو درس عجز الكثيرون عن التقاطه والاعتبار به، وما زال أنصار التبعية يصرون على عدم الاعتبار بدروس الماضي وينادون بالخضوع للغرب ليأتي لنا بالتقدم رغم كل النتائج السلبية التي أسفر عنها اتباع نهجه والكوارث التي حلت بنا من التعامل معه، وهذا الخضوع هو سر تفضيلهم الحكم الاستعماري على الحكم العثماني أو حتى على أي حكم وطني وإن حاول الخروج من نفق التخلف بنفس الآليات التي اتبعها الغرب في تاريخه الطويل.
* تواضع إنجازات التغريب وأسبابه والدروس المستفادة من التحدي النهضوي ضد الهيمنة الغربية
وفي الوقت الذي اهتمت فيه بدايات نهضات القرن العشرين في الاتحاد السوفييتي والصين بمناوأة المشاريع الغربية التي تشدها إلى الوراء، انشغل ساسة العالم العربي بالتأقلم مع المصالح الغربية، فالقيادات التقليدية كانت لا ترى إلا ما تراه حكومة ’’الدولة البهية القيصرية الإنكليس’’، إذ ’’هل يقول (المسئول البريطاني) كوكرين إلا الخير؟’’!، ولهذا كان الغرب يفضل هذا النوع التقليدي المتسم بالجهل من القيادات، ورغم ادعاء الغربيين العمل على تطوير الممتلكات والمحميات الاستعمارية فإنهم كانوا يفضلون التعامل مع الزعامات التقليدية المطواعة على التعامل مع المتعلمين،[60] وقد أوضحت حوادث الثورة العربية (1916) سهولة انقياد الجمهور التقليدي من زعماء القبائل ورجالها للرغبات الأجنبية التي مثلها الجاسوس البريطاني لورنس الذي حرضهم وقادهم لتدمير معلم حضاري بارز هو سكة حديد الحجاز التي قامت قيادات التجزئة فيما بعد بحراسة تعطيل تشغيلها كاملة إلى اليوم، وهو حدث يبين بوضوح ارتباط التجزئة بالغرب والتخلف كما يبين بوضوح موقف الغرب من تنمية بلادنا رغم ادعاءاته ودعاياته عن جلب الحضارة والتمدن.
أما القيادات الليبرالية المثقفة فقد آمنت أن مصالح بلادها مرهونة بالاتفاق مع السيد الاستعماري الديمقراطي رغم وضوح القمع والطمع اللذين كانا من المفترض أن ينتهيا نهاية سعيدة إذا اندمج العرب في مخططات الغرب (!)،[61] وبهذا كان العمل للاستقلال الحقيقي بواسطة التغريب كمحاولة الخروج من الرمال المتحركة لا تزيد الغريق إلا غرقاً كما سبق توضيح تجربة نوري السعيد الذي وضح أول رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية الأستاذ أحمد الشقيري بعدما حل بالباشا المصير المحتوم أن إيجابيته وصداقته الممتدة مع بريطانيا لمدة أربعين عاماً لم تحقق شيئاً مذكوراً،[62] وأما القيادات الثورية فقد لعبت على وتر الخلافات بين الأقطاب الدولية فارتبط كثير منها بمركز ضد آخر حتى أننا رأينا تواطؤاً بين الشيوعيين والمستعمرين الغربيين عامة وبريطانيا خاصة ضد نفوذ دول كبرى أخرى كألمانيا مرة والولايات المتحدة مرة أخرى،[63] هذا إضافة لقيادات ثورية أخرى اعتقدت صدق الأمريكيين في مناوأة الاستعمار[64] ولهذا تورطت زمناً بالميل إليهم والتنسيق معهم رغم تناقض الأهداف والذي أدى في النهاية إلى الصدام المسلح وتدمير المحاولات النهضوية، وخلاصة الحديث أن الانصياع للمصالح الغربية طبع دولة التجزئة منذ سقوط الخلافة العثمانية مما أدى إلى تراجع إنجازاتها كما ينبئ عن ذلك واقع جميع الدول التي انسجم حكامها مع المصالح الغربية وخدموها بإخلاص، ولا عجب في ذلك فقد كان الغربيون هم الذين أوجدوا هذه الكيانات ونصبوا عليها هذه الزعامات، وما زال كثير من أقطار التجزئة يبني شرعية وجوده على لحظة تحالفه مع بريطانيا التي فصلته عن كيان الخلافة الإسلامية ويشعر بالامتنان لها على ذلك ووجوب استمرار دفع الثمن الباهظ سداداً لديْن الميلاد.
هذا في الوقت الذي نهضت فيه بلاد ناوأت الغرب ثم انتقلت إلى التفاوض معه من موقع القوة وليس التبعية التي طبعت سلوكنا منذ ولادة دولة الاستقلال والتجزئة التي وجدت أن مصالحها تابعة لمصالح مؤسسيها من السادة الاستعماريين بصورة موضوعية لا دخل للميول الذاتية في تقريرها، ولهذا لم يتمكن حتى المؤيدون لسياسات زعامات التجزئة الخاضعة من الفخر إلا بإنجازات متواضعة كتحقيق استقلال منقوص أو دخول منظمة دولية في المجال السياسي[65]وهي إنجازات لا تحسب ضمن الجهود النهضوية الكبرى، أو كالتعليم وزيادة أعداد السكان والرعاية الصحية وتراجع معدلات الوفيات وزيادة الرقعة المزروعة ونشوء صناعات حديثة وتطور وسائل المواصلات والاتصالات في المجال الاقتصادي،[66] وهي كلها إنجازات إما: 1- سخرت لإفادة الغرب بثرواتنا كالمحاصيل الزراعية التي توسعت رقعتها ورغم ذلك عجزت عن إطعام زراعها في الوقت الذي تزود فيه مصانع الغرب بالمواد الخام، وكالنفط الذي توصله وسائل المواصلات الحديثة فيحرك مصانع الغرب ولا يستفيد أصحابه إلا من ثمنه لتمويل ترف يعود على الغرب ذاته بالفائدة سواء عند الشراء أو الادخار، أو 2- لم تستفد دولنا منها كأعداد السكان التي أصبحت عبئاً بدلاً من مزية وصار معظمها غارقاً في الفقر والمرض، أو 3- هي في النهاية فوائد قاصرة كالتعليم الذي لا يجد فرصه للتطبيق إلا بالأعمال المكتبية والخدمية أو بالهجرة إلى الغرب، وهي أيضاً غير مرشحة للنمو إلى درجة تنافسية كالصناعة التي ما زالت تحبو وقصرت عن المنافسة في أي مجال حديث حتى فيما تحتكره بلادنا من ثروات معدنية أو يتوفر فيها على الأقل من إمكانات.
وفي الوقت الذي قصرت فيه فوائد الاندماج بالنظام الدولي الغربي عن بناء نموذج نهضوي كالغرب ذاته أو حتى عن إنشاء كيانات مستقلة ومكتفية وقابلة للحياة المستمرة دون التطفل على غيرها، وذلك رغم الخطوات الواسعة التي حققها غيرنا في الشرق والغرب، فقد فاقت أضرار هذا الاندماج محاسنه وذلك بتكريس تقسيمنا وشرذمتنا وضعفنا عن طريق حماية الصيغة السياسية التي تقوم عليها دولنا بتوافق دولي يحرس التجزئة المضادة للنهوض كما سيأتي.
* التقليد مضاد لنهوض الضعفاء ومقدمة لانهيار الأقوياء
وكان من مظاهر تبعية التغريب وخضوعه للجداول الغربية تقليده الحرفي للنموذج الغربي وعدم بذل أي جهد في تطويع الأفكار الغربية للحاجات العربية المحلية رغم محاولة فرض هذه الأفكار على الشعب العربي، وفي ذلك يقول الدكتور مجيد خدوري إن الدول الغربية لما استعمرت بلادنا كانت تقدم مصالحها على بناء المؤسسات الديمقراطية على غرار المؤسسات القائمة في أوروبا، وإنها استغلت الأوضاع المناقضة للديمقراطية لتقوية مواقعها في هذه البلاد، ولم تتردد في دعم الاستبداد أو إلغاء الحياة النيابية عندما تقتضي مصالحها، وإنها لم تكن تهتم بمدى ملاءمة هذه المؤسسات للواقع المحلي في البلاد العربية، مما أفقد العملية الديمقراطية الحماس الشعبي لأن الشعوب أحست بأن هذه المؤسسات لم تقم لأجل المصلحة القومية، كما أحست بالمذلة نتيجة الخضوع السياسي للهيمنة الأجنبية، وأصبحت الديمقراطية تقليداً زائفاً لمن رام الديمقراطية الحقيقية.
أما مدرسة التغريب الحاكمة التي خضعت للتوجيه الغربي بعد توليها السلطة بعد الحرب الكبرى الأولى فلم تر تناقضاً بين هذا الخضوع والمؤسسات الديمقراطية، وكان أمل المتغربين أن تزول السيطرة الأوروبية لتحل محلها مؤسسات جديدة توفق بين المصالح الأجنبية والوطنية، مما جعل هذه المؤسسات منذ البداية غير مستمدة من الواقع الاجتماعي وغير معبرة عن الرغبات الشعبية الحقيقية، ولم تنظر مدرسة التغريب إلى مدى ملاءمة الأفكار المستوردة للواقع العربي التقليدي، ولم تبذل أي جهد لتمحيص هذه الأفكار وهضمها ودمجها بالمفاهيم الإسلامية أو تعديلها وفق الأوضاع القائمة، ولما فشلت في تحقيق التطور المنشود أو تضميد جرح الكرامة، أدى ذلك إلى انهيار المؤسسات التي أنشأتها هذه المدرسة بعد فشلها في اكتساب ولاء الشعوب واحترامها.[67]
ويتحدث في هذا الموضوع المفكر الراحل الدكتور عبد الوهاب المسيري قائلاً إن الإنسان الذي لا هوية له لا يمكنه أن يبدع، لأن الإبداع مرهون بأن ينظر للعالم بمنظاره هو وليس بمناظير الآخرين، ولو فقد هويته ونظر بمنظار غيره فإنه سيكرر ما يقوله الآخرون ويصبح تابعاً لهم همه التقليد والإبداع داخل إطار مغاير كما يحدث للعلماء العرب المهاجرين للخارج، كما كان القضاء على التراث الروحي والثقافي للهند ضرورياً للقضاء على ثرائها ورقيها وأخلاقها ومن ثم هزيمتها وجعلها تابعة لبريطانيا، وإن تفعيل الهوية جزء رئيس في عملية النهوض الحضاري،[68] والانفتاح لا يعني الخضوع والتبعية بل تفاعلاً يأخذ ويعطي، وليس من الممكن أن نبدع عندما نتبنى مفاهيم الآخرين، وإذا أردنا تحقيق ما حققوه فإن ذلك لن يتم بالتقليد الذي ينقل الشيء بحذافيره كما يفعل دعاة التغريب، بل بالمحاكاة وهي الوصول إلى جوهر الشيء وتوليد ما يتناسب مع زمان المحاكي ومكانه وليس مجرد استنساخ أعمى يؤدي إلى عدم الإفادة من النموذج المحاكى كما يحدث لبعض دعاة التنوير العرب الذين لا يطبقون آليات النقد والتحليل الغربية على الحضارة الغربية واكتفوا بتطبيقها على التراث الإسلامي بطريقة ثأرية، ولقد أدت محاولة اللحاق بالغرب إلى انهيار الاتحاد السوفييتي الذي أسقط نموذجه الخاص بما فيه من مثل إنسانية وحاول تقليد النموذج الاستهلاكي الغربي،[69] وقد سقط العرب في التبعية الإدراكية فصاروا يدركون الغرب كما يريد هو ولا يطرحون الأسئلة التي تحتمها أوضاعنا ومصالحنا ومبادئنا، ومن ذلك مثلاً أننا نعتقد أن الثورة الفرنسية (1789) هي ثورة الحرية والإخاء والمساواة دون طرح الأسئلة التي تتعارض مع هذه الرؤية حتى لو كان الغرب هو الذي يطرحها فضلاً عما علينا نحن أن نطرحه فيما يتعلق بالحملة الفرنسية على مصر (1798) أو احتلال الجزائر (1830)، بل لقد أصبحنا ندرك أنفسنا كما يريد لنا الآخرون ونحكم عليها بالهزيمة قبل دخول المعركة ومهما بذلت من جهد كما نحكم عليها بالتخلف مهما قدمت من عمل، ولهذا يتحدث تأريخنا كالتاريخ الغربي تماماً عن الدولة العثمانية بصفتها ’’رجل أوروبا المريض’’ ولا نتحدث عن ’’رجل أوروبا النهم’’ الذي نشر الإبادة في الأمريكتين وأستراليا ونيوزيلندا وإفريقيا واستعبد آسيا ونشر فيها تعاطي الأفيون، مع أنه لو ترك الرجل المريض وشأنه لربما شفي أو تعافى على يد ’’رجل مصر الفتي’’.[70]
* مرض القوي الموحد ليس كمرض الضعيف المقطع
يتساءل بتعجب بعض من يطلعون على إنجازات الدولة العثمانية في آخر أيامها كما فصلت جانباً منها في دراسات سابقة، عن حقيقة قدرة الدولة على أن تقوم بهذه الإنجازات وأن تقاوم عوامل الفناء ونوائب الدهر بهذا العناد وهي في مرحلة الانهيار؟ وتجيب عن سبب ذلك إحدى فقرات المؤرخ دونالد كواترت في كتابه الدولة العثمانية أثناء حديثه عن تراجع هذه الدولة العظمى بما يبين الفرق بين تراجع العظماء وأحوال الضعفاء سواء في ضعفهم أو حتى في عافيتهم، فيقول: ’’ما من شك أن الدولة العثمانية كانت سنة 1500 تعد من أقوى دول العالم... لكن هذه الدولة العظمى التي أقضت مضجع القوى الأوروبية لقرون، بدأت تضمحل بعد أن قلب الدهر لها ظهر المجن، ومع بداية القرن الثامن عشر أصبح مصطلح رجل أوروبا المريض عبارة متداولة عند الإشارة إلى الدولة العثمانية، وعلى الرغم من ذلك فقد بقي العثمانيون أثناء القرن التاسع عشر قوة يحسب حسابها في السياسة الخارجية في كل من بريطانيا وفرنسا وإمبراطورية النمسا وكذلك ألمانيا وإيطاليا، ومن جهة أخرى فقد بقيت قوى محلية في الهند وآسيا الوسطى وشمال إفريقية تتطلع إلى الدولة العثمانية لحماية مصالحها’’،[71] وبهذا يتبين لنا أن مرض القوي ليس كمرض الضعيف وربما كان القوي في ضعفه أقوى من الضعيف في قوته، ولهذا حرص الغرب على تمزيق وحدتنا والقضاء على آثارها الإيجابية.
* التمهيد لنكباتنا بإزالة أثر وحدتنا
قضية العرب المركزية في مهب العاصفة: فلسطين بين الماضي العثماني والانتداب البريطاني: قامت سلطات الاحتلال البريطاني في فلسطين بإلغاء جميع الإجراءات العثمانية التي ساندت الفلاح العربي وضيقت على الزائر والمهاجر الصهيوني، وفي ذلك يقول الدكتور محمد عيسى صالحية في كتابه مدينة القدس إن هربرت صموئيل أول مندوب سام’’أصدر قراراً في آذار/ مارس 1921 بتصفية البنك الزراعي العثماني، بنك الفلاحين العرب، الذي يقدم القروض الميسرة، بحجة اضطراب أعماله، والهدف من هذا القرار حرمان الفلاح العربي من خدمات البنك وتسهيلاته، والتضييق عليه، وإجبار المضطرين من الفلاحين العرب على اللجوء إلى البنوك والمصارف والمرابين اليهود، والاقتراض منهم بفوائد فاحشة وضمانات رهنية صارمة’’،[72] ويضيف إن حكومة الانتداب عمدت ’’إلى إصدار شهادات عرفت بالورقة البيضاء (التذكرة)، نكاية بالورقة (التذكرة الحمراء)، التي كانت تصدرها الإدارة العثمانية للزوار والسياح والحجاج من اليهود مدتها ثلاثة أشهر، والتي كان عليهم بانتهاء المدة مغادرة فلسطين، وعدم التخلف أو الإقامة في البلاد، أما الورقة البيضاء البريطانية فهي إذن للهجرة والاستقرار’’،[73] ويزيد الدكتور بشارة خضر من تعداد هذه الإجراءات البريطانية فيذكر ’’مرسوم محلول الأرض (1920) الذي يمنع الفلاحين من زيادة أملاكهم بحسب التقاليد العثمانية، ومرسوم الأرض الموات (1921) الذي ألغى التشريع العثماني الذي كان يتيح للفلاح ضم الأراضي البائرة’’،[74] وكان هدف كل تلك الإجراءات عرقلة جهود الفلاحين العرب وتسهيل انتقال الأراضي للمهاجرين الصهاينة، كما فتحت أبواب الهجرة الصهيونية الواسعة لمن كانت السلطات العثمانية قد نفتهم أثناء الحرب ولغيرهم أيضا.
ولم تقتصر عملية إزالة آثار الوحدة على إقامة الكيان الصهيوني، فمنذ وطئت أقدام المحتلين الأجانب بلادنا قاموا بوضع الحدود بينها وقضوا على وحدتها السياسية الماضية، كما استولوا على مواردها التي كانت مسخرة لاكتفائها الذاتي، وربطوا اقتصادها باقتصاديات المراكز الاستعمارية بعدما كانت التجارة داخل الشرق العثماني أهم كثيراً من تجارته الخارجية حتى عندما ازدادت أهمية التجارة العالمية ابتداء من منتصف القرن الثامن عشر،[75] ووضعوا الحواجز بين ما كان حتى وقت قريب منطقة تجارية واحدة،[76] وسهلوا المواصلات مع بلاد الغرب البعيدة لإحكام القبضة الاستعمارية وتسهيل تدفق الثروات من بلادنا في الوقت الذي تراجع حتى في زمن الاستقلال الاتصال بين بلدان المنطقة القريبة من بعضها البعض لصالح هذه المواصلات الخارجية،[77] وسقوا بذور الخلافات والانشقاقات وأشعلوا فتن الانفصال حتى غدا ما كان مجتمعاً موحداً قبائل متفرقة متناحرة متحاسدة قام الكيان الصهيوني وسطها ليحرس انقسامها وتخلفها وتبعيتها إذ أعلن منذ البداية أنه جبهة متقدمة للحضارة الغربية ضد البربرية الشرقية وأنه رأس جسر غربي يعبر الغزاة عليه وقاعدة تحرس مصالحهم وحاملة طائرات تؤوي جيوشهم، وقد استمرت في عهد الاستقلال جميع العيوب التي صنعها الاستعمار ولكنها أصبحت الآن برعاية السيادة الوطنية وحراسة جيوشها المظفرة وتحت راياتها المنصورة (!)
* تبعات قضاء الغرب على وحدة المنطقة المتمثلة في الخلافة العثمانية وإحلال المشروع الغربي محلها
ألف القانوني الأمريكي دافيد فرومكين كتابا بعنوان ’’سلام ينهي كل سلام: ولادة الشرق الأوسط 1914- 1922’’ يؤرخ فيه لجذور أزمات المنطقة في القرن العشرين ويشير إلى بروز هذه الأزمات من عاملين: ’’من تدمير بريطانيا للنظام القديم في المنطقة عام 1918، ومن قراراتها عام 1922 بشأن كيفية استبدال ذلك النظام، بل تنبثق أيضا من غياب القناعة في السنين اللاحقة ببرنامجها الذي فرض التسوية عام 1922’’[78]، وعن العامل الأول يقول إن رئيس الوزراء البريطاني لويد جورج كان مقتنعاً تماماً سنة 1921 بقول رئيس الوزراء اليوناني: ’’إن النتيجة الأهم للحرب الكبرى بالنسبة للإنسانية هي اختفاء الإمبراطورية التركية، وليس حل امبراطورية النمسا- المجر، ولا تقليص الإمبراطورية الألمانية’’،[79] وبناء على زوال الدولة العثمانية كان ذلك العصر ’’عصراً اصطنعت فيه بلدان الشرق الأوسط وحدوده في أوروبا.. وقد اعتقدت الدول الأوروبية آنذاك أن باستطاعتها أن تغير آسيا الإسلامية في صميم أساسيات وجودها السياسي... فقد استحدثت نظام دول مصطنعة في الشرق الأوسط... ويبدو لي أن عام 1922 كان نقطة اللاعودة من حيث وضع مختلف العشائر في الشرق الأوسط على طرقها المؤدية إلى التصادم... لقد بدأ الشرق الأوسط في ذلك العام السير على طريق كان من شأنه أن يقود إلى حروب لا نهاية لها، من ضمنها الحروب بين إسرائيل وجاراتها، وبين الميليشيات المتناحرة في لبنان’’.[80]
أما نزاعات التجزئة العربية فلها بداية وليس لها نهاية وتكاد لا ترى جارين ليس بينهما نزاع أو ربما حرب، منذ الخلاف السوري اللبناني (1949) ثم الخلاف بين الأردن والبلاد العربية على ضم الضفة الغربية (1950) والنزاع السوداني المصري على حلايب (1958) الذي لحقه الأزمة بين لبنان والجمهورية العربية المتحدة ثم بين الأردن ونفس الجمهورية في نفس العام، وهما نزاعان جلبا التدخل الأمريكي البريطاني، ثم النزاع بين العراق والكويت (1961) والذي كان مدخلاً للتدخل الأجنبي البريطاني أيضاً، ثم النزاع بين دمشق والقاهرة داخل الجمهورية العربية المتحدة نفسها في نفس العام (1961)، ثم اندلاع حرب اليمن الضروس بعد الانقلاب الجمهوري في العام التالي (1962) بين مصر والسعودية، وهو نزاع حدث فيه استقطاب داخل المعسكر الغربي نفسه بين اعتراف أمريكي بالجمهورية ودعم بريطاني للملكية،[81] وبعدها نشب الخلاف الحدودي بين الجزائر والمغرب (1963) الذي ما أن هدأ حتى اندلعت مشكلة الصحراء الغربية بين الجزائر والمغرب وموريتانيا في السنة التالية (1964)، ثم نشوب معارك أيلول بين الأردن والمقاومة الفلسطينية (1970) والخلاف السوري المصري بعد حرب أكتوبر (1973) ثم الحرب المصرية الليبية (1977)، ولم تنته خلافات العرب والمسلمين بالحرب العراقية الإيرانية الطاحنة (1980- 1988) وأزمة الكويت الفاضحة (1990) التي استدعت التدخل الأجنبي الكاسح هذه المرة والذي لم ينته أيضاً باحتلال العراق (2003) بمساهمة عربية فاعلة منذ البداية، وتطور التدخل الأجنبي الذي كان يستدعى من خلف الستار أو تحت الطاولة ليصبح الأمر علنياً وبتمويل عربي يهدم أقطاراً عربية أخرى لمجرد خلافات قد لا تعدو الصفة الشخصية بين الزعماء فيذهب ضحيتها مئات الألوف من أفراد الشعوب، ثم لا تجد أبرع من الصهاينة في إحصاء أثر هذه الخلافات وعدد ضحاياها،[82] ولا أكثر منهم فرحاً بنشوبها لإثبات أن الوجود الصهيوني ليس الأشد خطراً على المنطقة، على عكس ما يدعي العرب، ولإيضاح أن هؤلاء العرب بحر تخلف وهمجية ودموية تتوسطه جزيرة التطور والحضارة الصهيونية.
* التجزئة ضد النهضة: هل يمكن لدولنا الصغيرة أن تنمو بعيداً عن التجمع؟
إن كثرة الإمكانات التي توفرها الوحدة هي الأرضية الصالحة لأية عملية نهوض، ويلاحظ بأن وفرة إمكانات العالم العربي وحده موزعة بين عدة جهات، فالإمكانات المالية والاقتصادية في جهة، والإمكانات المائية والزراعية في جهة ثانية، والإمكانات البشرية في جهة ثالثة، والإمكانات العلمية والثقافية تهاجر إلى جهات خارجية بسبب التضييق عليها نتيجة سياسات التبعية، وعلى سبيل المثال كيف ستستطيع دولة صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها المليون أن توفر الإمكانات البشرية العلمية اللازمة لعملية التصنيع، أو السوق اللازمة لتصريف المنتجات وإيداع الفوائض المالية، أو الإرادة السياسية لتحدي أقطاب الصناعة في الغرب، أو موارد الاكتفاء الذاتي التي تغنيها عن الحاجة إليهم؟ وقد أثبتت تجارب حديثة أنه حتى الدول الكبيرة في منظومة التجزئة العربية والإسلامية لا تستطيع الخروج على الإرادة السياسية الغربية التي قد تصل حد تنصيب الحكام بالقوة (حادث 4 فبراير 1942 في مصر ثم انقلاب 1953 في إيران البهلوية ثم غزو العراق 2003)، ولا تستطيع أيضاً الخروج على قرارات الدول الكبرى التي تمنعها من العمل على الاكتفاء الغذائي الذاتي للاستغناء عن المعونات والصدقات التي تربطها بعجلة السياسات الكبرى رغم الإمكانات الزراعية العربية الكبيرة التي توظف لصالح الاقتصاديات الغربية ومصانعها، وتمنعها أيضاً من الوصول إلى اكتفاء من السلاح لتدافع عن وجودها، ولعل استمرار حاجة إيران البهلوية إلى الإمداد العسكري الغربي[83] رغم الغطرسة الامبراطورية وحاجة تركيا الجمهورية إلى المظلة الأطلسية مثالان واضحان على العجز رغم كبر الحجم، وهو عجز لا يستدل عليه بمجرد الانضمام إلى المشاريع العسكرية الغربية، فدول كبرى كدول أوروبا تنضم للولايات المتحدة في هذه المشاريع ولكنها تملك حرية أكبر في إظهار مواقف تتعارض مع السياسة الأمريكية، أما دول كإيران وتركيا فلم يكن أمامها سوى الإذعان للمصالح الأمريكية والسير في ركابها حتى لو كان ذلك ضد شعوب إسلامية أخرى وهو ما لا يمكن أن ترتكبه شعوب الغرب ضد بعضها البعض، بل لعل دولة التجزئة أسرع انقياداً لعداوة الأخ وقتاله من قتال العدو الحقيقي، ولعل المثل الإيراني الإسلامي الذي تعاون مع السياسة الشيطانية الأمريكية ضد جاريه المسلمين في الشرق الأفغاني والغرب العراقي يؤكد حتمية هذا الانحراف باستمرار السياسة الشاهنشاهية - برؤية جديدة- والتي استندت إلى دعم الوجود الأمريكي في المنطقة للحصول على دور فيها وهو ما لا يمكن للدول الصغرى أن تخرج عن إطاره مهما كبر حجمها وتغيرت مبادئها وادعت مثاليتها، وذلك استجلاباً لرضا الدول الكبرى واعترافها، كما تعجز بقلة إمكاناتها عن الخروج عن المعادلات السياسية الدولية التي تفرض التجزئة التي هي أساس الضعف في العالم العربي والإسلامي.
وعندما كان يجتمع لأي قُطر من الإمكانات ما يمكنه من السير قليلاً في طريق الخروج من نفق التخلف والتبعية كان الغرب يقف بالمرصاد لأية محاولة من هذا النوع في بلادنا ويحطمها بقوة السلاح، ولم يكن لأصحابها حينئذ من الإمكانات أو العمق ما يواجهون به هذا العدوان كما فعلت الجماهير السوفييتية مثلاً عندما واجهت التدخل الغربي ضد الثورة البلشفية اعتماداً على عمقها الجغرافي أو عندما انتصرت الثورة الصينية (1949) اعتماداً على نفس العامل، ويكفي دولة التجزئة فشلاً أنها امتلكت مصدر القوة الرئيس في اقتصاديات عالمنا المعاصر وهو النفط ومع ذلك عجزت عن الإفادة منه مع أنه كالدم الذي يسري في شريان حياة الاقتصاد العالمي، وقد عبر الرئيس الأمريكي أيزنهاور سنة 1957 عن ذلك بالقول ’’إن سيطرة الغرب على النفط العربي لا تقل أهمية عن منظمة حلف شمال الأطلنطي، بل إن المنظمة تفقد أهميتها لو فقدنا السيطرة على النفط، العربي’’،[84] وما زالت أهمية النفط العربي في تزايد حتى يومنا هذا وإلى عشرات مقبلة من السنين، إذ يفوق الاحتياطي العربي نصف الاحتياطي العالمي، وتصل نسبة التصدير العربي في السوق العالمي ما يقارب 40% حسب أرقام سنة 2006،[85] ومع ذلك لم تستطع الدولة القطرية تحويل هذه القدرة الكامنة إلى نهضة علمية أو قوة عملية لنفسها أو حتى مصدر ضغط سياسي لصالح القضايا القومية والوطنية في اللحظات الحرجة التي سجلت الفشل العربي في اللعب بالأوراق المتوفرة لصالح أي حق من حقوق العرب وذلك كما حدث عندما قرر الزعماء العرب في مؤتمر بلودان (1946) مقاطعة أمريكا وبريطانيا نصرة لفلسطين ثم انبروا للاعتذار لسفرائهما وتبرير القرارات بأنها مجرد مسايرة للرأي العام العربي الغاضب، وفشل العرب كذلك في استخدام سلاح النفط في سنة 1948 ووصف الرئيس الأمريكي ترومان تهديداتهم بالكلام الفارغ، ثم كان أول قرارات مؤتمر الخرطوم بعد نكسة 1967 هو استئناف ضخ النفط لاستخدامه في إزالة آثار العدوان، وفي حرب 1973 قرر العرب استخدام سلاح النفط حتى يجبر الغرب الكيان الصهيوني على الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة،[86] وليس الرحيل كلياً عن بلادنا، ومع ذلك تراجع القادة بعد أشهر مقابل مجرد وعود كتبت بالماء ولم ينفذ منها شيء، كبقية الوعود الأمريكية التي ما زلنا نلهث خلف سرابها إلى اليوم، وكانت الولايات المتحدة ودول بحر الشمال هي من استفاد أساساً من ارتفاع أسعار النفط في هذه المعركة،[87] ثم انسحب النفط من تمويل معركة أمته ليتحول إلى تمويل معارك الغرب وسياسات العدوان الغربي على أمتنا وشراء المواقف لتمريرها، ويمكننا مقارنة ذلك بقدرة السلطان العثماني رغم الضعف والتراجع والهزيمة في آخر أيام الخلافة على التلاعب بتنافس الدول الكبرى واستماتتها للحصول على امتيازات النفط، فكان يعطي دولاً منها أو يمنعها أو يطردها أو يستدرج منافسيها أو يبحث عن غيرها وهدفه الأول والأخير هو تحقيق مصالح دولته وتمكن من ذلك بكل حزم وقوة غير مستسلم حتى لأصدقائه ودائم اليقظة حتى لحلفائه.[88]
أما في عهد التجزئة فلم نتمكن نحن بل تمكن الآخرون من دعم أنفسهم وإقامة نهضاتهم الذاتية بل والسيطرة على العالم بتحكمهم بهذا النفط العربي[89] الذي لم يفد أصحابه وتحول إلى نقمة على مالكيه نتيجة تكالب حشود الطامعين والمتطفلين عليهم في ظرف ضعفهم وانقسامهم وتشرذمهم مع إمكان حدوث العكس لو كانت كلمتهم موحدة في وجه العالم الخارجي، ورغم كل الحديث الأجوف عن الحرية والديمقراطية فقد كان كل الانهماك الغربي في أزمة الخليج سنة 1990 بسبب الخوف من وقوع احتياطيات الخليج النفطية الضخمة تحت سيطرة سياسية واحدة كما صرح الرئيس الأمريكي آنذاك لشعبه[90]، ولهذا صرحت خطة البنتاغون التي سبق ذكرها وأعدها وولفوتز سنة 1992 إن هدف الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وجنوب غرب آسيا هو إبقاؤها خارج نفوذ أية قوة إقليمية وردع أي هجوم عليها والاحتفاظ بالحق في استخدام أجوائها وممراتها المائية مع التركيز على الحؤول دون هيمنة قوة أو تحالف قوى إقليمية عليها لا سيما الجزيرة العربية،[91] ولعل نظرة خاطفة لإنجازات النفط في العالم المعاصر في التصنيع والتجارة والفوائض المالية وعموم الاقتصاد والسياسة والحرب، تكفي لحساب ما فات ملاكه من عوامل القوة والنهضة والسيادة وهم ما يزالون من أضعف الدول وأكثرها تبعية وتراجعاً، أي أن الدولة القطرية منحت القوة والنهضة لسواها ولم تستطع تحقيق ذلك لنفسها، ويبدو أن الأطراف الغربية تدرك أن استمرار هيمنتها على هذا المورد رهن لاستمرار ضعف مالكيه ولهذا تحرص على إبقائهم في هذا الوضع المتخلف.
ولهذا يكذب من يدعي أنه مع النهضة وفي الوقت نفسه يتمسك بواقع دولة التجزئة الوطنية، أو أنه ليس أكثر من جاهل لا يعرف المتطلبات الرئيسة لهذه النهضة وواقع عظمة الدول إذ لا تنمو دولة صغيرة إلا في الحالات الاستثنائية وفي ظروفها الخاصة التي تكون الاستثناء الذي يثبت القاعدة، وإنه لمن العجيب رؤية مثقف محترم يدعي التنور والعلم ثم يقف مدافعاً عن الدولة الوطنية رغم سجل فشلها الطويل، ويتمسك بها هرباً من بعبع الخلافة الإسلامية الوحدوية، ولهذا لا أفهم وطنية من يدافع عن هذه الدولة القطرية، إذ كيف يحب وطنه من يصر على عزله عن أشقائه وعدم تكامله معهم في زمن تتنافس الأمم فيه على التكتل ولا ينجح منها إلا الكبار الموحدون، كما لا يكون للصغير شأن إلا بالاستناد إلى أشقائه كما سيأتي.
لن ينجح أي مشروع نهضوي يتخذ من دولة التجزئة قاعدة له، فإضافة لقصور إمكاناتها البشرية والمادية القليلة عن تحقيق الطموحات النهضوية الكبرى، فإن هذا القصور يدفع حكامها إلى التعلق بالأقوياء (الذين هم الأعداء في زمننا والذين لا مصلحة لهم في نهوضنا) لضمان استمرار الكراسي والظهور على النظراء المنافسين والمتحاسدين، بالإضافة إلى ضمان استمرار حياة الكيانات السياسية الضعيفة التي يحكمونها ولو بواسطة تنمية تابعة حتى لا يصيبها عقاب الحصار الاقتصادي الذي أنهك المتمردين، وهذا يوضح بجلاء أن الخيانة من طبيعة تكوين كيانات التجزئة، والملخص أن الضعف يحكم هذه الكيانات ويفرض منطقه الخياني عليها فلا تستطيع الخروج من إساره خلافاً لمنطق عظمة الوحدة التي ترفض التبعية حتى زمن الهزيمة، ومقارنة حال دولة كبرى كالدولة العثمانية الضعيفة في آخر أيامها بحالات الولايات التي عملت للاستقلال عنها بمساعدة الأجانب ثم بحالات دول التجزئة يثبت كل ما سبق ذكره.
لقد ثبت عجز الدولة القطرية أمام كل التحديات التي واجهتها، فلم تستطع إطعام نفسها حتى لو كانت بلاداً زراعية تقليدية، أو الدفاع عن حدودها فضلاً عن ضمان وجودها رغم تكديس الأسلحة، أو كفاية حاجات مواطنيها رغم كثرة الصناعات التي هي في حقيقتها هامشية لا تمس الاحتياجات الأساسية، وباختصار عجزت دولة الاستقلال عن الحياة إلا بالتعلق بأهداب الدول الكبرى لتضمن لها وجودها، هذا فضلاً عن فشلها في إقامة المشاريع الحيوية لأبناء المنطقة أو حتى إعادة بناء ما أنجزته الدولة العثمانية ودمرته الأيادي الاستعمارية كسكة الحجاز وسكة بغداد، وهو ما يوضح التناقض بين التجزئة والتطور، فقد عملت هذه التجزئة في افتتاح عهدها الذي جسدت الثورة العربية على الدولة العثمانية (1916) بدايته الرسمية، على تدمير مشروع حضاري حيوي هو سكة الحجاز، وظلت عاجزة عن إعادة تسييره وذلك وفقاً لما أملاه عليها منطقها المفعم بالتنافس والتحاسد وتوزع مراكز اتخاذ القرار بين كيانات الانفصال.
وعملت دوامة الحزازات بين القيادات العربية على إفشال كل قضاياها التي تتطلب وحدة الكلمة مثل قضية فلسطين قبل النكبة حين استعرت الخلافات بين سوريا والأردن، وبين العراق والقيادة الفلسطينية،[92] ثم في زمن النكسة حين كانت ’’الحملات الإعلامية بين دمشق وبغداد وصلت إلى عنان السماء، الحكومة المغربية سحبت سفيريها في دمشق وبيروت، ثم قطعت علاقاتها الدبلوماسية بالجمهورية العربية السورية، وعاد التوتر بين القاهرة وصنعاء والرياض بسبب أزمة اليمن، وبالنسبة إلى الخلاف بين المنظمة والأردن فقد سوي على الورق ولم نستطع الوصول إلى مرحلة التنفيذ، و.. و.. إلخ’’ كما يقول الأستاذ أحمد الشقيري في مذكراته،[93] هذا فضلاً عن فشل أي مشروع وحدوي يتم طرحه للتنفيذ مثل مشروع سوريا الكبرى أو مشروع الهلال الخصيب أو الوحدة بين مصر وسوريا بسبب المنافسات العربية، فالأسرتان العلوية في مصر والسعودية في الرياض تتصديان لمشروع الملك الهاشمي عبد الله لتوحيد سوريا الكبرى، كما تتصديان لمشروع الهلال الخصيب الذي طرحه نوري السعيد في العراق، وبغداد وعمّان تتنافسان على غنيمة هذه الوحدة[94] التي طُرح انضمام الكويت الغنية إليها ولكن بريطانيا تتصدى لذلك بقوة،[95] ولما تقوم وحدة بين سوريا ومصر يقوم اتحاد مناوئ لها بين الأردن والعراق، وتتوتر العلاقات في المغرب العربي إذا اتحدت ليبيا وتونس،[96] ومن الطريف أن تتباكى المملكة أحياناً على النظام الجمهوري في بلد ثان حتى تعيق مشروعاً وحدوياً تطرحه مملكة أخرى،[97] ومعظم المشاريع تأتمر بأمر الأجنبي وتطلب إذنه لتتحقق أو لا تتحقق، فيجتمع العرب إذا طالب الأجنبي أو رضي (الجامعة العربية 1945 واتحاد الجنوب العربي 1959 الذي استهدفت بريطانيا منه فصل عدن عن صنعاء،[98] واتحاد الإمارات العربية 1971 الذي استهدفت منه عزل الثروة النفطية في هذه الإمارات عن العراق والسعودية،[99]) ويتفرق العرب حين لا يأذن لهم الأجنبي بالاجتماع،[100] ومن المعيب أن تجد حاكماً عربياً يطمئن الوكيل البريطاني أن تعاون هذا الحاكم مع الجامعة العربية سيكون محدوداً ولن يطال المسئوليات البريطانية المتحكمة في بلده،[101] ومن المخزي أن تجد الموظفين الإنجليز يتفاوضون مع بعضهم البعض نيابة عن الأطراف العربية المتنازعة أو يحكمون بغطرسة وصلف في الخلافات بين الأطراف العربية الخانعة (مؤتمر العقير سنة 1922)[102] على عكس صلفها مع الخليفة العثماني في السابق حتى عندما كان يروم مصالح بلادها بتأسيس مشاريع حيوية مثل سكة الحجاز وسكة بغداد اللتين واجهتا معارضة عربية اتسمت بالإيذاء الذاتي، هذا فضلاً عن تعامل الأطراف العربية مع بعضها البعض بطريقة تبالغ في التحاسد والتنابذ والحرص الأجوف على الكرامة المهدرة التي لا تجد من يدافع عنها عند خنوع الزعامات الكبرى أمام أصغر موظف بريطاني، ولا تسل عن عمليات تحريض الأجنبي القوي ضد الأشقاء وهي ظاهرة ما زلنا نعيشها إلى اليوم وقد اتخذت أبعاداً علنية طرحت كل براقع الستر والحياء بعدما أهدرت كثيراً من موارد الأمة واستنزفت طاقاتها في الخلافات الجانبية التي كثيراً ما عطلت عمليات نهوض واعدة، ولما برز التحدي الصهيوني كان سبب الفشل العربي هو استفراد الصهاينة بكل جيش عربي على حدة في جبهة مستقلة حتى تمكنوا من هزيمة الجيوش جميعاً سنة 1948،[103] وما زال وجود الصهاينة في بلادنا هو سبب ضعفنا وفرقتنا إذ يتعهد الغرب القوي مجتمعاً بضمان استمرار تفوقهم النوعي على مجموع طاقات دولنا، وهو إقرار واضح لا لبس فيه بالعمل المستمر على إبقائنا متخلفين ولعل هذا هو السر في ضرب كل محاولات الخروج من نفق التخلف.
* النموذج المصري بين فاعلية الوحدة وعجز الاستقلال
إن سجل الوحدة زاخر بالنجاح الفعلي والإنجاز العملي في زمن الخلافة، الضعف والتراجع طارئ عليه، أما سجل التجزئة والاستقلال فليس فيه سوى أحلام وأماني خيالية لم يتحقق منها غير الهزيمة والفشل والتراجع، والنجاح الفعلي هو الطارئ والمؤقت وظروفه خاصة، وعند المقارنة التاريخية بين ريادة مصر ودورها الفاعل عندما كانت ’’تابعة’’ لدولة الخلافة حين أنقذت المسلمين من المجاعة في عام الرمادة ثم أصبحت مركزاً للخلافة (ومن المفارقات أن ليبرالية التغريب ترفض حتى هذه المركزية لمصر باسم الهوية المستقلة) ثم هزمت حملات الفرنجة الصليبية وصدت الغزو المغولي لتعود مركزاً للخلافة ثانية ثم أصبحت الولاية الأولى في دولة الخلافة العثمانية مقدمة على الأناضول وأوروبا العثمانية، وبين فشلها وتراجعها زمن ’’الاستقلال’’ الذي صنعته بريطانيا حين سقط حكام مصر ضحية مشاريعهم لاستقلالها فدخل المسلمون في صراع داخلي أذكته أوروبا بين مصر والدولة العثمانية فتحطم الإثنان، ثم وقعت مصر تحت براثن الإفلاس ثم الهيمنة الأوروبية ثم الاحتلال البريطاني ولم تحقق نجاحاً مؤقتاً إلا اعتماداً على اختلاف الدول العظمى التي لم تلبث أن تكالبت عليها (1967) لتلحقها بمصالحها ثانية وتتخذ منها أداة للسيطرة على المنطقة العربية وتمرير السياسات الأمريكية وقيادة التطبيع مع الصهاينة وتدمير دولة عربية (1990- 2003)، ومع ذلك لم تمكنها كل هذه الخدمات من تحقيق مصالحها الوطنية الضيقة فكبل اقتصادها بالقروض والمساعدات والإصلاح الاقتصادي على حساب الاكتفاء الذاتي والمصالح المصرية وذلك لخدمة السياسة الأمريكية، ولعل المثل الأبرز في هذا المجال بيع النفط والغاز المصريين للكيان الصهيوني بخسارة لمصر بلغت ملايين الدولارات يومياً في حالة الغاز، وهو عبء كبير على الاقتصاد المصري المنهك أصلاً ومع ذلك فقد ضحت الدولة ’’المستقلة’’ بمصالحها الوطنية المباشرة لأجل مصالح الأقوياء، وقبلت كذلك بالتعاون العسكري الأمريكي الصهيوني الذي وصفه مبارك بالكارثة على الدول العربية المعتدلة وبالعقبة في طريق السلام (6-12-1983) ثم اضطر للاستسلام، والتزمت مصر بمعاهدة السلام مع الصهاينة ’’على الرغم من الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاقية’’ كما قال مبارك (11-3-1984)، ومنحت تسهيلات للقوات الأجنبية في مياهها ضد سيادتها وضد البلاد العربية الأخرى، بالإضافة إلى عجزها عن فرض رؤيتها لترتيبات أمنية عربية في الخليج بعد حرب الكويت واستسلامها للوجود الأمريكي هناك،[104] هذا إذا لم نذكر تحييد دورها وتهميشه وتأمين جانبها أثناء شن الصهاينة حروبهم ضد أشقائها العرب (1982 و2003 و2006)، هذا إذا لم تشارك في العدوان فعليا (1991 و2008)، وإذا استدعينا نموذجاً بسيطاً لا يتطلب طموحات كبرى ومع ذلك يدل على مدى عجز دولة التجزئة مهما كبر حجمها عن الخروج على إملاءات الدول الكبرى، فسنجد ذلك على الحدود بين الأراضي الفلسطينية ومصر، حيث استمرار التوتر فيها رغم تعاقب الأنظمة ذات الهويات المختلفة يؤكد أن عداوة الإخوة والجيران هو منطق دولة التجزئة المقيدة بسياسات الكبار التي تمنعها حتى من تحقيق مصالح قُطرية صغيرة كتبادل تجاري محدود، بين الأشقاء والأقارب في مدينة واحدة مقسمة بشكل هزلي بأمر الكبار، وذلك حين تقتضي المصالح الغربية ذلك المنع، ويصبح الأخ أداة لخنق أخيه الواقف خلف الحدود، إكراماً لتسلط الأجنبي وغطرسته واحتلاله، ولهذا فإن أية مراهنة على تحقيق أي نجاح نهضوي مهما صغر بواسطة الدولة القُطرية لن يكون مصيرها سوى إفساد المراهنين وجرهم إلى مستنقع المساومات فهزيمة كل مشاريعهم، إذ مهما تغيرت هويات الحكام سيجدون أنفسهم مقيدين بقلة إمكانات كيانات التجزئة التي التزموا بها ومن ثم عدم قدرتهم على تنفيذ أحلامهم وتحدي الأعداء الكبار، وسواء كانت الأحلام قومية واسعة أو إسلامية أوسع أو وطنية ضيقة لتوحيد شطري دولة أو حتى الحفاظ على وحدتها أو تحقيق مصالحها الوطنية لن يكون حاكم التجزئة في كل ذلك إلا أداة تطبق ما تقبله سياسات الكبار بغض النظر عن مشروعه وآماله.
ومما له دلالة أن دولة التجزئة الوطنية المصرية في عز سلطانها وقمة عنفوانها لم تستطع الحؤول دون فقدانها جميع مكملاتها ومقتضيات مصلحتها (السودان 1956، سوريا 1961، غزة وسيناء 1967) أمام التآمر الأجنبي وهو ما لا يضاهي في زمن الوحدة التي جسدتها الخلافة الإسلامية إلا أشد عصورها تراجعاً وهزيمة وضعفاً عندما كانت تفقد ولاياتها واحدة تلو الأخرى أمام الاحتلال الأجنبي، ومع ذلك يسجل لدولة الخلافة أنها لم تعترف بكل إجراءات الاستعمار في العالم العربي حتى وقّعت على ذلك وتنازلت عنه تركيا الكمالية (1923)، وكل ما سبق يحسم الخلاف والجدال عن ’’ضرورة’’الدولة القُطرية و’’أهميتها’’، فوقوف المرء في صف متراص مع الإخوة لا يلغي الذات أو يمحوها بل يعزز موقفها ويقويها، والوقوف ’’مستقلاً’’ وحيداً هو الذي يمهد لافتراس المرء وزواله بجعله عرضة لهجوم أي وحش عابر في الغابة التي نعيش فيها.
* لماذا نما بعض الصغار؟
وإن تاريخ التنمية في العالم الثالث بعد مرحلة الاستقلال يؤكد أن عدم التنمية هي القاعدة في الوقت الذي كانت ندرة التنمية هي الشذوذ الذي يثبت هذه القاعدة، ففي الوقت الذي لم ينم 130 بلدا على الأقل، تمثل الاستثناء بكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة وهونغ كونغ وهي مراكز اضطرت الولايات المتحدة واليابان إلى تعزيز اقتصاداتها بعد الحرب العظمى الثانية لاحتواء الشيوعية التي كانت تهدد بسقوط متتال للدول كأحجار الدومينو في تلك المنطقة بعد انتصار الصين الشعبية (1949)، وهو أمر انتهى بسقوط المعسكر الاشتراكي،[105] أما في الشرق العربي الإسلامي فقد كانت مصالح الغرب تعمل الضد مساعدة بلادنا على التنمية أو حتى تركها تنمو وحدها، وقد سبقت الإشارة إلى نوايا السياسة الأمريكية تجاه بلادنا، والغرب يعترف كل يوم بالتزامه بتفوق الكيان الصهيوني النوعي على مجموع العرب فكيف يمكنه الموافقة على تنمية أي قطر تنمية تضارع هذا الكيان قوة وقد رأينا ماذا حدث للتجربتين البعثية في العراق والناصرية في مصر واللتين حُطمتا بقوة السلاح، وأي قُطر يحاول تنمية نفسه منعزلاً عن قضايا المنطقة لن يستطيع ذلك حتى لو ركع للغرب كما فعل كثير من زعماء التغريب (نوري السعيد في العراق والوفد في مصر وبورقيبة في تونس) فلم تنفعهم إيجابيتهم مع الاستعمار قط، بل لقد وصل بعضهم كالوفد (1951) إلى اليأس من سادتهم ومقاومتهم ولكن بعد فوات الأوان، هذا فضلاً عن الزعامات التقليدية المستسلمة ومع ذلك لم تصبح بلادهم كسنغافورة الصغيرة المدعومة، ومن هنا كان القول إن نهوضنا لن يتحقق إلا بتجميع طاقاتنا للتصدي للغيلان العالمية الكبرى.
* الفرق بين انقسامات الأمس الإسلامي وانقسامات اليوم الاستعمارية
إن تشبيه الانقسامات السياسية في تاريخ الإسلام بالتجزئة الاستعمارية فيه كثير من التجني وعدم الموضوعية الذي تكشفه حقيقة أن المسل
* معضلة النزعات الاستقلالية عن الكيان الوحدوي الجامع: الاستقلال مقدمة الاحتلال
كانت فكرة الاستقلال عن الكيان العثماني الجامع هي البوابة التي دخل منها الاحتلال الأجنبي الغربي في أمثلة عديدة، وقبل العصر العثماني بقليل ’’لم يجد الإسبان من الدويلات المسلمة في شمال أفريقيا مواجهة تذكر لتوسعهم الكاسح...
تعاوُن الحكام المسلمين مع الغزاة الإسبان أفقدهم مصداقيتهم لدى العامة’’،[1] فلما جاء العثمانيون قضوا على التجزئة والخيانة، ومما له دلالة مهمة أن ذلك تم بمعاونة طليعية من الموريسكيين الأندلسيين في المغرب العربي[2] والذين كانوا يدركون أبعاد معركة المصير ضد الصليبية الإيبيرية، ويلاحظ كثير من مؤرخي حوادث القرن التاسع عشر الأثر السلبي الذي خلفته النزعة الاستقلالية لبعض الولايات العثمانية على مستقبلها الذي أصبح رهينة التسلط والاحتلال الأجنبي، ومن هؤلاء المؤرخين يوجين روجان الذي قال: ’’كانت دمشق وحلب جزءاً لا يتجزأ من الإمبراطورية العثمانية، في حين أصبحت تونس ومصر دولاً مستقلة تابعة للإمبراطورية العثمانية، وصارت بلاد شمال أفريقيا أكثر عرضة للاحتلال الأوروبي بسبب نفس التطورات التي عززت استقلالها والتي تمثلت في ظهور أسر حاكمة مستقلة ترأست حكومات زادت مساحات استقلالها مع الوقت’’،[3] ويقول عن الجزائر: ’’استغل دايات الجزائر استقلالهم، وبنوا علاقات تجارية وسياسية مع أوروبا بعيداً عن سلطة اسطنبول، لكنهم حين فقدوا ثقل الإمبراطورية العثمانية لم يعد لهم وزن أمام الأوروبيين الذين شاركوهم التجارة، ولذا لم يجد الدايات آذاناً صاغية عندما طالبوا الحكومة الفرنسية مراراً وتكراراً بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليها... (و) مرت عقود طويلة دون أن يسدد الفرنسيون ديونهم’’ مما أدى إلى توتر العلاقات الذي انتهى بالاحتلال الفرنسي،[4] ويقول أيضاً عند الحديث عن محاولة الخديو إسماعيل ’’تأمين مكان مصر بين الدول المتحضرة’’ التي ألجأته إلى الاستدانة: ’’والمفارقة في هذا الموقف هي أن مصر أخذت على عاتقها القيام بمشروعات التنمية من أجل ضمان الاستقلال عن الهيمنة العثمانية والأوروبية، لكن الحكومة المصرية كانت تجعل نفسها أكثر عرضة للانتهاكات الأوروبية لسيادتها مع كل امتياز جديد تمنحه للأجانب’’،[5] ويلاحظ كل من المؤرخين شارل عيساوي وروجر أوين أن استقلال مصر عن الدولة العثمانية وعدم تمتعها بثقل العثمانيين الدولي أديا إلى تكالب الدائنين عليها ومن ثم وقوعها في براثن الاحتلال البريطاني بعد إفلاسها سنة 1876،[6] ثم كان فصلها رسمياً عن التبعية العثمانية هو المقدمة القانونية لإعلان الحماية البريطانية عليها بعد اندلاع الحرب الكبرى (1914)، ومن الطريف أن بريطانيا خلعت الخديو عباس حلمي الثاني المحسوب على العثمانيين لتنصب محله عمه حسين كامل سلطاناً على مصر ليكون محسوباً عليها وأرفع مقاماً من مقام الخديو السابق وليناوئ السلطان العثماني بمقام السلطنة في نفس الوقت[7] ولكن كان منصبه في الحقيقة أقل صلاحيات من منصب الخديو ومجرد ألعوبة في يد الاحتلال لفظها شعب مصر بأكثر من محاولة اغتيال، وقد لاحظنا دائماً أن حكام الاستقلال والتجزئة يبالغون في الألقاب والأبهة من حولهم لتعوض ضعفهم وتبعيتهم ويبالغ الاستعمار في مسايرة تضخيم ذواتهم ليركنوا إليه في حكم امبراطورياتهم المجهرية.
ويلاحظ المؤرخون أن النفوذ الأجنبي الذي اتخذ صيغة الامتيازات الأجنبية والذي انتهى بالاحتلال الأجنبي في أمثلة عديدة، كان أكثر قوة في البلاد التي انتهجت سياسة ’’مستقلة’’ منه في الكيان العثماني الجامع، فقد لاحظ الرافعي ذلك عند المقارنة بين ’’حدود الامتيازات الأجنبية في تركيا’’ و’’اتساع حدود الامتيازات في مصر’’، ’’ولقد كان من أسباب هذا الطغيان مجاملة الخديو إسماعيل لقناصل الدول لكي ينال رضا حكوماتهم ويكسب تأييدهم إياه في خلافه مع تركيا’’،[8] وهو ما انتهى بمصر إلى الاحتلال العسكري البريطاني، كما لاحظ لوتسكي أن مراكش التي كانت مستقلة عن الدولة العثمانية شهدت فيها الامتيازات الأجنبية أنظمة لم تعرفها الامتيازات الأجنبية العثمانية، ورغم احتفاظها باستقلالها الشكلي طيلة القرن التاسع عشر فإنها ’’تحولت في الواقع في غضون القرن ذاته إلى شبه مستعمرة للدول الأوروبية، وأعدت هذه الدول العدة للاستيلاء عليها مستغلة ضعفها وتأخرها’’.[9]
كما كان الدفاع عن استقلال تونس عن الدولة العثمانية هو البوابة التي دخل منها الاستعمار الفرنسي كما سيأتي، وكان ’’تحرير’’ العراق من العثمانيين هو الاحتلال البريطاني نفسه، ثم توجت الميول الاستقلالية بالثورة العربية الكبرى (1916) والتي كانت البوابة التي خرجت منها الدولة العثمانية من بلادنا العربية لتدخلها دول الاحتلال الأجنبي التي تقاسمت أراضينا في نفس الوقت الذي كانت تعدنا فيه بالحرية والاستقلال، وبهذا احتلت بلادنا في البداية سواء كانت دائنة أو مدينة نتيجة استقلالها عن الكيان الموحد فخالفت بذلك الحكمة القديمة والبسيطة والتي تؤكد أن العصي تأبى إذا اجتمعن تكسراً وإذا تفرقت تكسرت آحاداً، ثم أصبح التحرر من الدولة العثمانية هو نفسه الوقوع في براثن الاحتلال الأجنبي الذي استدعينا جيوشه لتنقذنا فانقضت علينا.
* معضلة المشاريع النهضوية في القرن التاسع عشر هي الدوافع الذاتية
إن نقطة الضعف الرئيسة في المشاريع النهضوية التي أقامها الولاة العثمانيون في القرن التاسع عشر هي اختلاط الدوافع الذاتية بالعوامل الموضوعية، وقد اشتركت في ذلك مع مجمل الثورات التي قادها الزعماء الطامحون والتي لم يكن يحركها أكثر من هذا الطموح الشخصي،[10] فعندما شرع محمد علي باشا في نهضته، سخّر في البداية قوته لصالح عموم الدولة العثمانية، ولكن مع تزايد انتصاراته وتراكم إنجازاته، بدأت المشاعر الذاتية تطغى على مشروعه وأصبح يرى أنه يستحق مكانة أكبر مما أعطاه السلطان،[11] ولو كانت الساحة العالمية آنذاك خالية من الدول الكبرى المعادية لأمكن له أن يحسم خلافه مع السلطان محمود الثاني بالقوة فتصبح قوته قوة لتجديد شباب الدولة الإسلامية، ولكن حضور القوى العظمى كان يفرض على الطرفين المصري والعثماني شيئاً من الحذر في التعامل لئلا يتلاعب الأوروبيون بهما، فيشجعون محمد علي على العصيان لشق الدولة العثمانية إلى نصفين: عربي وتركي[12] فتستنجد هي بأي طرف خارجي - وهو هنا روسيا ألد الأعداء- لإنقاذها بحكم الغريزة، ولما يتجاوز الوالي الحد المرسوم ويهدد بإعادة القوة الإسلامية ينقلب الجميع ضده ويؤازرون السلطان العثماني عليه لتظل الأطراف الإسلامية جميعها ضعيفة، ثم تقوم بريطانيا التي قادت لعبة تحجيم محمد علي سابقاً بحجة الانتصار للسلطان العثماني، بتشجيع خلفاء محمد علي على الاستقلال عن العثمانيين ثانية بعدما منعت جدهم من ذلك أولاً عندما كان استقلاله مرتبطاً بإنشاء كيان موحد كبير ولكنها شجعت الأحفاد على الاستقلال بكيان صغير، لتنفرد بمصر وتحتلها هذه المرة، وقد سقط الخديو إسماعيل في الفخ وتنازل لأوروبا لتؤيده في خلافه مع السلطنة كما مر، مما جعل المؤرخ الكبير عبد الرحمن الرافعي يعجب من هذه النزعة التغريبية عند الخديو لأن ’’الخطر الذي يتهدد كيان مصر لم يكن آتياُ من تركيا الضعيفة، بل كان مصدره الاستعمار الأوروبي السياسي والمالي، وقد دلت الحوادث على هذه الحقيقة، ولكن نزعة إسماعيل الأوروبية كانت تحجب عنه كثيراً من الحقائق’’ وهذا ما أدى إلى الاحتلال البريطاني (1882)،[13] والحديث نفسه ينطبق على داود باشا في العراق الذي سار على خطى محمد علي في نفس الفترة، إذ اختلطت مشاريعه النهضوية بالدوافع الذاتية التي دفعته لتسخير نهضته في سبيل علو شأنه ومكانته ولم يتردد في انتهاز فرصة هزيمة الدولة العثمانية أمام روسيا في حرب 1827- 1829 ليعلن الخروج عليها مما أدى لهزيمته وهزيمة مشروعه في النهاية (1831)،[14] وكان العامل الموضوعي الذي دفع السلطنة العثمانية للوقوف ضد داود باشا هو’’أن السلطان كان ينظر إلى النفوذ الأجنبي في الدولة العثمانية وفي الولايات التابعة لها والشبه مستقلة منها بنوع خاص على أنه أداة لهدم الدولة وتفككها إلى ولايات مستقلة أو شبه مستقلة يسهل على الدول الاستعمارية ابتلاعها’’، ولأن مشروع داود باشا توقف تحقيقه على إنجازات الإنجليز، فقد كان من شأن ذلك أن يصبح العراق مطمعاً للاستعمار البريطاني ولم يكن يمكن لولاية أن تصمد في وجه الإمبراطورية البريطانية ’’ومن ثم وجب أن تكون العراق تحت عين الباب العالي وفي متناول يده لتدبر الأمور وفق مصالح الدولة العثمانية كلها لا وفق مصالح ولاية بعينها’’ كما يقول الدكتور عبد العزيز نوار،[15] والخلاصة أن المشاريع التي تستهدف إنهاض الأمة يجب ألا تؤثر العوامل الشخصية فيها على مصالح الأمة عامة، فلو سخّر كل من السلطان العثماني وولاة مصر والعراق وتونس جهودهم للنهوض بالدولة عموما وتهاونوا في المصالح الشخصية لأمكن لبلادنا تحقيق ما هو أفضل مما حدث.
* حجب الحقائق هو دور النزعات التغريبية الذي أدى إلى فشل المشاريع النهضوية
الحديث عن فشل المشاريع النهضوية وعدم تحققها كما أرادها القائمون عليها بسبب غلبة دوافع الطموح الذاتي عندهم، لا يعني عدم وجود ثغرات أخرى في هذه المشاريع، فالنزعة التغريبية التي اعتنقها ولاة مصر بدءاً من محمد علي باشا جعلتهم يطلبون رضا الغرب[16] عن مشاريعهم ظناً منهم أنه لا يمانع في تطور بلادنا، وكانت هذه النظرة استمراراً لنظرة الزعماء الطامحين من غير أصحاب المشاريع والذين وجد الغرب في طموحاتهم منفذاً للتدخل في شئون المجتمع الإسلامي، وكان هذا بدء الوهن، إذ أن دخول الغربيين في المشاريع النهضوية جعلهم يسيرونها وفقاً لمصالحهم، ’’فهم يؤيدون المشروع العربي لمحمد علي، فإذا أوشك أن ينجح، وقفوا ضده، مع الإسلام العثماني، ثم هم يناصرون العروبة بالمشرق، ضد إسلام آل عثمان، وفي ذات الوقت يقتسمون الوطن العربي، ويخرجون من الحرب العالمية الأولى بتصفية الخلافة الإسلامية ومشروع الدولة العربية جميعاً، وفي مواجهة الفكر الإسلامي زرعوا العلمانية والتغريب، ولمحاربة المد القومي الناصري سعوا لإقامة الأحلاف تحت أعلام الإسلام’’ كما يقول الدكتور محمد عمارة،[17] وقد ورث خلفاء محمد علي هذه النزعة التغريبية التي فصلتهم عن الرابطة العثمانية وفتحت أبواب مصر للمغامرين والأفاقين والباحثين عن الثراء من الأوروبيين - وليس العلماء وحدهم كما اقتضت النهضة- والذين قال عنهم المؤرخ هرشلاغ: ’’في الإسكندرية وحدها كان يوجد أكثر من 70 ألف هيئة تجارية أجنبية في 1837، تمثل مصالح يونانية وفرنسية وبريطانية ونمسوية وإيطالية... إلخ. إن موجات الأجانب التي غمرت مصر أصبحت عديدة، خاصة أثناء الفترات اللاحقة، بين 1857 و 1861، عندما كان يدخل البلاد 30 ألف أجنبي في المتوسط كل سنة’’،[18] ثم ورطت هذه المصالح الأجنبية مصر في الديون التي عبرت عن مصالح غربية للإقراض أكثر من مصالح مصرية للإقتراض،[19] وغرق في تلك الديون الخديو إسماعيل الذي أراد - نتيجة لنزعته التغريبية- تحويل مصر إلى قطعة من أوروبا، فكانت خطيئة الاستدانة من الأجانب - أكثر من خطيئة التبديد الداخلي- هي التي قادت إلى الإفلاس فالهيمنة الأجنبية على الوزارة ثم الاحتلال العسكري البريطاني (1882)، وذلك بعدما دفعت النزعة التغريبية الخديو نفسه إلى طلب الاستقلال عن الدولة العثمانية مستنداً إلى الدعم الأوروبي الذي لم يقدم إلا بثمن باهظ من التنازلات التي لم يجد بها الخديو ورئيس وزرائه نوبار باشا أية غضاضة بسبب ’’نزعتهما الأوروبية’’ التي حجبت الحقائق عن الخديو كما مر حين صورت له الخطر آتياً من جهة الدولة العثمانية الضعيفة وليس من قبل الاستعمار الغربي، وهي تنازلات جعلت الإصلاح ’’معكوساً مشوهاً.. ومهد لتغلغل النفوذ الأجنبي في سلطة القضاء والتشريع وفي كيان البلاد المالي والاقتصادي’’[20] وهو ما جعل مصر وحيدة في مواجهة الغرب الأوروبي الذي انتهز الفرصة وقام بالهجوم الاقتصادي ثم السياسي ثم العسكري.
وعلى الضفة التونسية فإن الإصلاحات التي قام بها البايات ’’مهدت الطريق في آخر المطاف إلى الصيارفة الأوروبيين الذين كانوا على أهبة الاستعداد للاستيلاء على تونس واستعبادها’’،[21] وقد ’’تسببت تجربة الإصلاح التي خاضتها تونس وما تبعها من إفلاس في نقل البلاد من الخضوع غير الرسمي للسيطرة الأوروبية إلى الهيمنة الإمبريالية التامة’’،[22] وكانت مشاريع داود باشا في العراق معتمدة على جهود بريطانيا الفنية والاقتصادية ومن ضمن ذلك مشروع الملاحة البخارية الذي ربط العراق بمواصلات الإمبراطورية البريطانية وأصبح محط آمال الاستعمار البريطاني ولكنه كان أضعف من أن يقف وحده في وجه السياسة الاستعمارية الأوروبية التي تعنى كلها بمشكلة المواصلات بين الهند وأوروبا،[23] وهذا هو ملخص لأثر النزعة التغريبية التي كانت فرعاً من دوافع الولاة الاستقلالية عن الدولة العثمانية، والمعجبة إلى حد الانبهار بأوروبا، إرضاء لشهوة السلطة والحكم.
* التجزئة مطلب غربي يقوم على حراسة مقدار التغريب المسموح به
وفي العصر الحديث كانت الدولة الاستعمارية الكبرى التي تنشأ لها مصالح في ولاية عثمانية تقوم بمحاولة سلخها عن الدولة العثمانية بالدفاع عن فكرة استقلالها الأزلي وتتشبث بأدلة واهية كانت هي نفسها في السابق لا تلقي إليها بالاً ولكن عندما تستجد المصلحة تغير الحقائق وتبدل الوقائع وتشجع الولاة من أصحاب النزعات التغريبية كأبناء محمد علي باشا في مصر وبايات تونس على الانسلاخ عن الخلافة وإثبات استقلالهم وتقدم في سبيل ذلك ’’مبالغ ضخمة’’ من الأموال للمساعدة على تفكيك الرابطة مع اسطنبول كما فعلت بريطانيا وإيطاليا وفرنسا حينما أقرضت البايات التونسيين لتحقيق هذه الغاية،[24] كما مهدت فرنسا لاستيلائها على تونس بالإعلان أن تونس دولة مستقلة عن تركيا وأنها تنوي الدفاع عن استقلال هذا البلد،[25] وذلك تماماً كما وقفت أوروبا بجانب الخديو إسماعيل لإثبات استقلاله عن اسطنبول فكانت النتيجة هي الوقوع في براثن الاحتلال العسكري الغربي في كل من مصر وتونس، وكذلك دافعت بريطانيا عن استقلال الكويت عن العثمانيين لتحقق المصلحة البريطانية في تعطيل وصول سكة حديد بغداد إلى ساحل الخليج مع وجود مصلحة أكيدة للكويت في هذه السكة إذ كانت ستحولها إلى ميناء عالمي مزدهر ومحطة نهائية لخط طويل يربطها بعواصم أوروبا واسطنبول وبغداد قبل ظهور النفط بعشرات السنين فلا يصبح اقتصادها بعد ذلك مجرد معتمد على تصدير منتج واحد.
ثم أصبح القضاء على الكيان العثماني الموحد هدفاً متداولاً بين الدول الغربية لا سيما بعد اندلاع الحرب الكبرى الأولى (1914- 1918) كما أفصحت عن ذلك رسائل ومذكرات من بلفور ولورنس (دراسة: لماذا يحطم الغرب نهضاتنا/ 1، ودراسة: آثار التغريب السياسي على المجتمع الإسلامي/ 1)، وسياسات الحلفاء التي مزقت الدولة العثمانية بعد الحرب بطريقة لم تحدث حتى مع ألمانيا نفسها التي قادت الحرب ضد هؤلاء الحلفاء، هذا بالإضافة إلى إصرار المنتصرين في الحرب على الحصول على تنازل تركي عن الأملاك العثمانية وهو ما حصلوا عليه في معاهدة لوزان (1923) التي أكدت على ما جاء في معاهدة الاستسلام في سيفر (1920) في ذلك المجال مما جعل الحلفاء يتهاونون في بقية المطالب ويمنحون الكيان الكمالي تنازلات شكلية، إذ لم تعد الدول الغربية بحاجة إلى استنزاف دولة معادية تسيطر على الشرق بعد انتفاء وجودها ولهذا تم إلغاء الامتيازات الأجنبية التي حفزت شركة الهند الشرقية البريطانية في الماضي على إعلان حرب بالمدافع والبوارج على والي العراق داود باشا عندما جرؤ على إلغائها (1821)،[26] فلما قسمت المنطقة إلى دول صغيرة يسيطر الحلفاء عليها وعلى مجرى الحوادث في منطقتها لم يعد هناك حاجة لمثل هذه الامتيازات فقام الغرب بالتنازل عنها بسهولة نسبية مع احتفاظ مندوبيه بالغطرسة الاستعمارية في عملية التنازل.[27]
ثم كان الغرب هو من قام برسم وتخطيط وفرض التقسيم على أجزاء الدولة العثمانية التي وضع أيديه عليها قبل وبعد هزيمة الحرب الكبرى الأولى، فشطر وادي النيل في اتفاقية الحكم الثنائي (1899) ثم تقاسمت دوله شرق المتوسط في اتفاقية سايكس بيكو (1916) ثم رعت بريطانيا سلسلة من اتفاقيات التجزئة في الخليج والجزيرة العربية كالعقير (1922) وحداء (11-1925) وبحرة (12-1925)، ولم يكتف الإنجليز بشطر وادي النيل حتى أصروا قبل مغادرته (1953) على عدم عودة وحدته بعد خروجهم منه،[28] وكانوا منذ البداية قد بذروا بذور تقسيم آخر هو الانفصال الجنوبي[29] الذي رعته الولايات المتحدة والصهيونية وثوار عرب فيما بعد حتى أثمر دولة ثالثة في الوادي سنة 2011.
وكثيراً ما كان الموظفون الاستعماريون البريطانيون يتفاوضون فيما بينهم ممثلين عن الدول العربية لتقرير الحدود بين أصحاب الملك والصولجان، وتزخر الوثائق البريطانية بالمفاوضات والمراسلات بين الموظفين الإنجليز أنفسهم نيابة عن حكام كل من العراق والكويت بعد الحرب الكبرى الأولى، حين تُرك موضوع الحدود برمته بين أيدي حكومة صاحبة الجلالة، لتقرير ما تراه مناسباً، ومن الطرائف التي تدل على حقيقة الأهداف والمتحكمين في مسار الأحداث أنه بينما كان العراق والكويت يتجادلان بواسطة الموظفين البريطانيين على موقع نخلة مندثرة تفصل البلدين وتقسم الشعبين وتحدد ملكية ميناء أم قصر، وذلك أثناء الحرب الكبرى الثانية، ’’قررت بريطانيا إدارة هذا الميناء عسكرياً أثناء فترة الحرب وعدم عائديته لأي من الطرفين، ومن ثم تفكيكه وهدمه وإزالته بعد انتهاء الحرب’’ (1942)،[30] وبهذا انتهكت قدسية النخلة التي سالت لأجلها أنهار من الدماء فيما بعد وأما البريطاني فلم يرد على انتهاكه أحد (!)، وهكذا نختلف فيما بيننا دائماً حتى ينقض الأجنبي على ما نختلف عليه فنخسر جميعاً ونحن راضون بالهزيمة للعدو الخارجي الذي يخرج وحده غالباً من بيننا.
ولم يكن منح الاستقلال للبلدان المستعمَرة إلا شكلاً جديداً من عملية إحكام السيطرة عليها وتأقلماً مع الظروف التي استجدت في عالم الاستعمار، وفي ذلك يقول المؤرخ روجان إن النفقات الرسمية للحفاظ على الإمبراطورية الاستعمارية البريطانية تصاعدت نتيجة المقاومة العنيفة التي واجهتها في الشرق في كل من مصر والعراق وفلسطين، فحاولت بريطانيا ’’تخفيف شروط الإمبراطورية بمنح مستعمراتها استقلالاً صورياً وتأمين مصالحها الاستراتيجية من خلال المعاهدات.. ومع إفلات العالم العربي من سيطرة بريطانيا، أصبحت الإمبراطورية البريطانية في الشرق الأوسط عائقاً أكثر منها مصدر قوة’’، ولم تكن فرنسا أوفر حظاً من الإنجليز.[31]
ووجد الغربيون أنفسهم منسجمين مع دول الاستقلال والتجزئة التي قامت على أنقاض الكيان العثماني الموحد أكثر من انسجامهم مع هذا الكيان في الماضي، ولهذا بادروا بمساعدة هذه الكيانات حتى بعد استقلالها وكانوا يقدمون لها مبالغ كبيرة كونت نسباً عالية من ميزانيات بعضها مقابل الخدمات التي تقدمها،[32] وإن الانسجام بين الغرب والحكومات التي تبنت التغريب في إيران البهلوية وتركيا الكمالية بالإضافة إلى الحكومات الليبرالية والتغريبية في المملكة المصرية والمملكة العراقية والجمهورية التونسية والجمهورية اللبنانية بعد الاستقلال والحكومات التقليدية في ممالك الجزيرة العربية وبقية الممالك في الشام وشمال إفريقيا يدلنا على النموذج الأمثل الذي يريده الغرب لنا بعيداً عن أي نهوض أو توحد، وقد جاء في وثيقة أمريكية رسمية صيغت في سنة 1992- 1993 بعنوان ’’مخطط البرنامج الدفاعي’’ ما يلي: ’’لا بد من منع كل قوة معادية من التحكم في منطقة تؤهلها مواردها للارتقاء إلى مصاف القوى العظمى، وكذا إفشال محاولة أي دولة مصنعة متقدمة من منازعة زعامتنا الدولية، وقلب الوضع السياسي والاقتصادي القائم’’،[33] ويرجى ملاحظة الحرص على الوضع القائم أي على إدامة التخلف والضعف، وقد اعترف عميد السياسة الخارجية الأمريكية المعاصر هنري كيسنجر في مقال كتبه إنه لمدة أكثر من نصف قرن، وجهت عدة أهداف أمنية السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط منها منع أية قوة في المنطقة من الظهور والهيمنة (صحيفة الواشنطن بوست 31-3-2012).
ومما يؤكد ذلك ما يتسم به التأريخ الغربي لبلادنا من تأييد للجبرية السياسية المناقضة لديمقراطيته إذا اقتصرت إنجازاتها على تقليد الغرب في القوانين الشخصية وشرب الخمر والتفسخ الاجتماعي واستعمال اللغات الأجنبية بدلاً من الوطنية ولبس الزي الأوروبي وبقية المظاهر الفارغة، وعندئذ يُمدح المستبد الذي يقود هذه التغيرات حتى لو كان ذلك بطرق دموية فيوصف بإعجاب بأنه ’’المصلح الذي لا يعرف الرحمة’’ كما قيل عن كمال أتاتورك مثلاً الذي مدحه مستشرقون ومؤرخون غربيون كبار بل لقد جعل منه عميد المحافظين الجدد برنارد لويس علاجاً شاملاً للعرب تصور أن يُستنسخ مثيل له في العراق بعد اجتياحه[34] رغم أن إنجازاته لم تنقل تركيا نقلة نوعية مقارنة بثورات أخرى معاصرة بل أدت إلى تراجعها السياسي من دولة عظمى إلى إحدى دول العالم الثالث[35] واقتصرت جذريتها على مظاهر سطحية فارغة كالأزياء الأوروبية والحروف اللاتينية وتغيير يوم العطلة، وعن هذه الإنجازات تتحدث الموسوعة البريطانية فتقول إن المصلح المتميز مصطفى كمال كان يطمح إلى تغيير الحياة الاجتماعية في تركيا بضربة واحدة، فلما واتته الفرصة ألغى الخلافة الإسلامية وأغلق جميع المؤسسات القائمة على الشريعة بالإضافة إلى الطرق الصوفية، كما ألغى التعليم التقليدي وأسس تعليماً علمانياً مكانه، وحدّث القضاء بقوانين جديدة بدلاً من الشريعة الإسلامية، وتخللت إصلاحاته الحياة اليومية للشعب التركي فاستبدل بالملابس القديمة الملابس الأوروبية، وانتشر الرقص والحفلات المختلطة والمسرح والموسيقى، وساوى بين الجنسين، واستبدل بالحروف العربية الحروف اللاتينية، وعمل على إحلال الرابطة القومية مكان الرابطة الإسلامية، وحكم بواسطة نظام الحزب الواحد وقمع المعارضة بعنف، وباختصار فقد شملت إصلاحاته السياسة والثقافة والقانون فتمكنت وجهة النظر الغربية من اكتساب نفوذ بين الطبقة المتعلمة مما جعل العودة إلى النظام القديم مستحيلة، أما عن التصنيع، وهو مربط الفرس في المشاريع النهضوية، فتقول الموسوعة ’’إنه لم يحقق أي نجاح مهم’’، سواء بواسطة رأس المال الخاص أم بواسطة التدخل الحكومي، وذلك رغم أنه برر إصلاحاته بكون العلم هو الموجه الأمثل للحياة.[36]
وعن نتيجة هذه التجربة الإصلاحية والمحاولة النهضوية يلاحظ فيليب روبنس أن ’’تركيا المعاصرة التي أسست على أيديولوجية الدولة- الأمة؛ أي النزعة القومية العلمانية؛ والتطلع نحو غرب الصناعة والعلم والحداثة سرعان ما أجبرتها وقائع التاريخ الصلبة على اكتشاف أن حلم التماثل مع الغرب عسير المنال؛ إذ لا يكفي لتحقيقه التنكر لهوية الشعب الدينية والثقافية وفرض نظام قانوني غربي محل الشريعة الإسلامية وإلغاء التعليم الديني والأخذ بالرموز المسيحية بدلاً من الإسلامية وبالأبجدية اللاتينية عوضاً عن العربية وإحلال الزي الأوروبي مقابل اللباس المحلي... إلخ من مظاهر خيّل لنخبة أنها تختزل جوهر الغرب ولبه’’،[37] ويلاحَظ أن هذه السطحية تشبه إلى حد بعيد سطحية كثير من إجراءات التنظيمات العثمانية التي أدخلت النماذج الأوروبية في الموسيقى والمسرح والأزياء والمعمار، وزادت الإجراءات الكمالية عليها بمزيد من فرض سطحية التقليد بالعنف.
هذا هو النموذج الذي حاز على رضا الغرب وثنائه وتقديس أتباع التغريب وتأليههم، استبداد سياسي يقود إلى التبعية الحضارية والفشل الصناعي، فكيف إذا أضاف المستبد لما سبق صداقة حميمة مع الكيان الصهيوني ممثل الحضارة الغربية في الشرق، وهو أمر يضفي على من يقوم به مدائح التسامح العصري، بل الدعم المادي السخي،[38] ولكن مع كل التنازلات التي قدمتها الجمهورية الكمالية والتبعية التي دانت بها للغرب لم تحصل على عضوية النادي الأوروبي في الوقت الذي قُبلت فيه في عضوية التحالف الأطلسي منذ البداية كما قبلت عضوية بلاد عربية وإسلامية في أحلاف عسكرية غربية كحلف بغداد مثلاً دون الوصول إلى مستوى المعيشة الغربية، وهي مفارقة تدل على المكانة القصوى التي يسمح لأي تابع من بلادنا أن يتبوأها مهما بالغ في التشبه بالغرب الذي لا يكف عن الحرص على حصرية امتيازاته ولهذا يتقبل من الأتباع أن يقوموا بالخدمات السياسية والاقتصادية والعسكرية ولكنه لا يقبل أن يشاركهم في التمتع بمزاياه.
أما إذا رام هذا المصلح أو ذاك المشاركة في مزايا الحضارة الغربية والحصول على ما هو أكثر من تلك الشكليات التي طبقتها الثورة الكمالية، للوصول إلى ما هو أكثر من التقليد السطحي لما عند الغرب أيضاً كالوحدة والتصنيع الثقيل والتسلح والمقاومة فإنه يصبح حينئذ فقط ديكتاتوراً متوحشاً ويُنسى المديح الذي كان يُكال لعدم رحمته من قبل، ويتم تحطيم إنجازاته فلا يجد في إمكانات الدولة القُطرية ما يواجه به العدوان، وخلاصة الأمر أن هنالك جرعة محددة من التغريب مسموح لنا بها وهذا سر إغداق الإطراء حديثاً على نموذج دبي[39] رغم أنه لا يقدم وصفة عامة قادرة على الحياة المكتفية المستمرة حتى لنخبتها فضلاً عن حشود الجماهير الفقيرة في منطقة الشرق العربي الإسلامي، وهو مديح يذكرنا بإطراء النموذج التونسي ودعمه زمن بورقيبة[40] وبن علي حين أُطلق على تونس لقب الدولة- النموذج[41] بسبب نجاحات وقتية وجزئية استكثِرت على بلادنا ولكنها لا تمثل انتقالاً حاسماً في مسيرات النهوض.
* الفرق بين التغريب العثماني المستقل والتغريب التابع عند كيانات التجزئة
عندما ظهر الضعف بوضوح في المجتمع الإسلامي زمن الدولة العثمانية، استخدم الغرب لواء الإصلاح وفق نموذجه حجة لتبرير تدخلاته وتحقيق الربح على حساب هذا المجتمع الشرقي، وقد تمكن بهذه الأداة من القيام بعمليات هدم في بناء هذا المجتمع الذي تراجعت قوته باتباع هذه الوصفة الخارجية (يمكن مراجعة سلسلة دراسات آثار التغريب على المجتمع الإسلامي)، وحين كانت المبادئ لا تحقق الهدف المنشود كان الغرب يعامل الآخرين بغير ما يرضاه لنفسه ويطلب منهم ما لا يطبقه داخل بلاده بكل صفاقة وعدم حياء، فوقف في وجه كل إصلاح ابتغى به العثمانيون تقدم بلادهم حتى لو كان مما يطبقه الغربيون أنفسهم في بلادهم هم في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية والقضائية، ويكفي في هذا المقام الإشارة إلى إصرار الأوروبيين على العمل بالامتيازات الأجنبية رغم علمهم بآثارها الضارة على الدولة العثمانية وإصرارهم كذلك على ابتزازها في لحظات الهزيمة بمعاهدات التجارة الحرة رغم اتباعهم سياسات الحماية الجمركية، وتدخلهم في الشئون العثمانية الداخلية بحماية الأقليات وهو ما لا يقبلوه في دواخلهم، ومعارضتهم كذلك لمشروع سكة حديد الحجاز ومشروع سكة حديد بغداد بصفتهما مشروعين حيويين، ولم يكن من الغريب أن تستهدف بريطانيا خط حديد الحجاز بالتدمير في الحرب الكبرى بعد أن بنته أموال المسلمين وجهودهم دون الحاجة إلى قروض الغرب، هذا بالإضافة إلى معارضة مشروع الإصلاح الضريبي والبريد العثماني والإصلاح القضائي ثم دعم بريطانيا وفرنسا للمعارضة الدستورية ضد الحكم الحميدي رغم أن المستعمرين كانوا يعترضون على الحكم الدستوري في محمياتهم ومستعمراتهم ثم انقلبوا على الحكم الدستوري العثماني نفسه وكان جشع أوروبا وطمعها بممتلكات العثمانيين أقوى من التزامها الديمقراطي تجاههم كما يقول المؤرخان شو،[42] ولهذا وجد أنصار التغريب في المجتمع الإسلامي أنفسهم بين خيارين: إما الخضوع لحاضر الغرب الذي يتضمن القبول بما لا يقبله الغربيون لأنفسهم ومن ثم عدم تطبيق النموذج الغربي كاملاً، وهؤلاء كان مصيرهم الدخول في قفص الاحتلال الأجنبي المباشر مثل بايات تونس (1881) وخديويي مصر (1882)، أما الخيار الثاني فهو الإصرار على تحقيق ما حققه الغرب لنفسه وفق نموذجه وهذا ما لم يكن مقبولاً لدى الغربيين أنفسهم الذين تأمرهم مبادئهم بالربح والمنفعة ولو على حساب المبادئ التي ينادون بها، ويعملون بلا كلل على منع ظهور أقطاب كبرى تنافس هيمنتهم، ولأن ساسة التغريب العثمانيين كانوا ينتمون لدولة كبرى رغم ضعفها ويحتم عليها وضعها أن تسعى للتكافؤ مع أقرانها العظام فإن منطق الاستقلالية فرض نفسه عليهم فكانوا - مثل المحافظين من ساسة الدولة أيضاً- يرون مكان دولتهم بين الكبار[43]، و’’يعتقدون بجلاء بأن مكان الإمبراطورية العثمانية هو بين دول أوروبا العظمى وأن تقوية هذه الدولة هو السبيل الذي لا غنى عنه لتحقيق هذا الهدف’’،[44] ’’ولم يكونوا مجرد أدوات للنفوذ الغربي بل طبقوا جدولهم الخاص وسعوا لدعم برنامجهم السياسي الذاتي’’،[45] وكانوا يتبعون نهج التغريب آملين به دعم دولتهم العثمانية لتتمكن من مواجهة التحديات الأوروبية وهو أمر لم يخطر ببال أنصار التغريب في دول الاستقلال الوهمي والتجزئة المجهرية التي قامت فيما بعد وكان أقصى ما تسعى إليه هو الازدهار في كنف قوة غربية عظمى مهما بلغت درجة التبعية والاستغلال، وهذا المنطق بالطبع لم يناسب دولة كبرى وإن كانت ضعيفة كالدولة العثمانية ولهذا فإن النتائج التي أسفر عنها التغريب أدت إلى استياء أتباعه وعدم موافقتهم على فقدان الاستقلال العثماني في مواجهة الأطماع الغربية، وكان من أوائل منتقدي هذه النتائج التغريبية الوزير العثماني ورائد التغريب مصطفى رشيد باشا الذي استنكر إلحاق فرمان الإصلاح الهمايوني سنة 1856 بمعاهدة باريس التي أنهت حرب القرم وجعله التزاماً دولياً على السلطنة لأن ذلك خطر على شرف السلطان واستقلال الدولة، ومن المنتقدين أيضا الأديب الشهير نامق كمال (ت 1888) الذي اتهم الإداريين العثمانيين بإفساح المجال للتوغل الاقتصادي الغربي وعدم إدراك أهمية التقاليد الإسلامية الإيجابية،[46] وقد وصل الأمر بأصحاب هذا الخيار بالانتقال من الارتباط الفكري والسياسي الوثيق بالغرب الأوروبي إلى الانفصال السياسي الحاسم عنه وإعلان الحرب على أطماعه كما حدث لأتباع جمعية الاتحاد والترقي زمن الحرب الكبرى الأولى (1914- 1918) بعدما نشئوا في الحضن الغربي، وهذا ما أحب لفت النظر إليه دائماً من فرق بين التغريب المستقل الذي يعمل لما يتصوره صالح الذات مما يؤدي لاصطدامه بالتربص الغربي بهذه المصالح، والتغريب التابع الذي يعمل على خدمة مصالح الغرب حتى ولو تناقضت مع الفكر الغربي ومصالح الذات مما يجعله مجرد أداة بيد سادته فلا يقدم تطوراً لأمته، فكانت هذه هي دائما معضلة التغريب في دولة التجزئة مع غرب لا يرى إدخال الآخرين في جنته المزعومة ومع ذلك لا يكف عن تقديمها بصيغة موعودة.
* معضلة التغريب التابع هي نخبوية الحضارة الغربية
ومنشأ هذه المعضلة هي في كون الإنسان يشعر بالتآلف مع من يتفق معه في الفكر، ومن الطبيعي أن يشعر المتغربون بالميل إلى جهة مرجعيتهم الفكرية، ولكن المشكلة أن الحضارة الغربية لا تؤمن بدخول الآخرين جنتها الموعودة لأنها حضارة حصرية وتؤصل هذه النخبوية بفكرة المنفعة المغروسة في النفس البشرية والتي تسعى إلى احتكار اللذة والفائدة لصاحبها المدعوم بالفكر الدارويني الذي يرى أن لا بقاء إلا للأقوى وليس هناك مكان للضعيف رغم كل الكلام الإنساني الأجوف عن الإخاء والمساواة والقانون وغير ذلك، وبهذا يجد أتباع الغرب أنفسهم في مشكلة أمام جمهورهم وليس أمام أنفسهم لأن ألفتهم مع الغرب تجعلهم تبعاً لمصالحه الحصرية التي تستثنيهم من نعمها وتقودهم لأن يصبحوا عملاء وليسوا أصدقاء ولا نصيب لهم من التقدم الغربي إلا بما يبقيهم أتباعاً ضعفاء محتاجين إليه ولا أمل لهم بتكرار نموذج النهضة الغربية الذي حتى لو كان ممكناً فإن الغربيين لن يسمحوا به حتى لا يخلقوا عمالقة تنافسهم ولهذا انتهت كل المحاولات للنهوض المستقل على خطى الغرب بالتدمير والتحطيم بالقوة الغربية نفسها لأن الغرب لا يؤمن إلا بالاستتباع وليس بالتكافؤ في التعامل.
ولو وضعنا الأمر في سياقه التاريخي لقلنا إنه من الطبيعي أن يشعر الإنسان بالألفة مع من يماثله فكرياً، وقد كان التقدم الأوروبي حافزاً لنخبة متعلمة في بلادنا أن تنبهر بالحضارة الغربية، كما كانت حالة التراجع والضعف التي عاشتها دولة الخلافة في مراحلها الأخيرة مبرراً إضافياً لأصحاب التوجهات التغريبية للشعور بالغربة من مجتمعهم والمراهنة على التطور عن طريق التبعية للغرب المتقدم، حتى لو كانت هذه التبعية مفضية إلى تأييد الاستعمار الذي تصوروا أنه سيأتي لنا بالخروج من التخلف، ولكن المعضلة التي واجهت التغريب أن الحضارة الغربية حضارة منفعة واستئثار لا تؤمن بالمشاركة، أي أن مكان ’’الآخر’’ فيها هو مكان التابع الذي يخدم المصالح الغربية ولكنه لا يصعد إلى درجة التكافؤ مع أصحاب هذه الحضارة، وكان على أنصار التغريب الاختيار بين خيارين: إما التبعية وخدمة المصالح الغربية على حساب أمتهم دون الحصول على مركز متقدم كتقدم الغرب، وهذا هو السبب الذي دعا القيادات القومية، التي نادت بالاستقلال العربي والوحدة العربية زمن الدولة العثمانية بتحريض من الحلفاء، للتخلي عن هذا الحلم لما تخلت عنه المصالح البريطانية[47] بعدما استفادت منه في القضاء على الخلافة، فأصبح دعاة الاستقلال والوحدة هم قادة الانفصال والتجزئة[48] الذين كانوا يتلقون ’’النصائح’’ من سفراء بريطانيا[49] أو ضباط المخابرات البريطانية الذين يوجهونهم ويملون عليهم ما تتطلبه مصالحهم الغربية،[50] ولم يتردد رؤساء الدول العربية ورؤساء الحكومات من إفشاء قراراتهم ’’السرية’’ونقلها حرفياً إلى سفراء بريطانيا المعتمدين لديهم،[51] ولم يتحرج أصحاب الفخامة والسمو والصولجان من العمل كالموظفين عند الموظفين بتقديم التقارير السرية إلى الموظفين الإنجليز،[52] وهذا ما يريده الغربيون ويسعون له تحت لافتات الإصلاح الذي ينادون به، أما الخيار الثاني أمام المتغربين فكان الصدام مع الغربيين الذين لا يسمحون بتكرار تجربتهم لكي لا تظهر أقطاب قوية أخرى تنافسهم، وهذا ما حدث مع بعض أنصار التغريب مثل جمعية الاتحاد والترقي التي دخلت الحرب الكبرى 1914 ضد الحلفاء الذين كانوا أصدقاءها بالأمس بعدما اكتشفت حقيقة الأهداف الغربية والتي تحدث عنها السلطان عبد الحميد مبكراً وأشار إلى غفلة رجال التغريب عن الأطماع الأوروبية[53] وفضح شعارات الإصلاح الغربية التي لا يراد منها سوى تدمير الدولة العثمانية.[54]
وقد واصل الغرب معاملة دولة التجزئة بخلاف ما يقبله لنفسه، كما عامل العثمانيين من قبل، وذلك رغم اختلاف الظروف وخضوع حكام العرب له، ولم يصغ لتوسلات ساسة التغريب الذين وضعوا الآمال العربية تحت رحمة السياسات الاستعمارية وطالما طالبوا الحكومات الغربية المسيطرة بدعم تطلع العرب لأية صيغة وحدوية حتى لو اقتصرت على كيانات أصغر من وحدة المشرق العربي كسوريا الكبرى مثلاً أو الهلال الخصيب، لأن الحوادث التي جرت في البلاد العربية أثبتت ضعف الدويلات كما قال نوري السعيد للإنجليز سنة 1942 مضيفاً أنه ’’لا بد من نبذ الفكرة القديمة الرامية إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ودولة لبنانية سورية مستقلة والنظر في حل جديد’’ مبيناً حاجة العراق إلى منفذ بحري وحاجة فلسطين إلى سوق كبير لصناعتها ولهذا فإن’’الحل المنصف الوحيد’’ هو إعادة توحيد بلاد الشام ونشوء عصبة عربية بين الشام والعراق يباح لبقية العرب الدخول فيها لو شاءوا، وذلك ’’لضمان دوام السلم والاطمئنان والتقدم في هذه المناطق العربية’’،[55] وكأن غاية غايات الدول الكبرى من الاستعمار والانتداب والحماية هي سعادة العرب وهناؤهم يا دولة الباشا (!)، وكانت النتيجة هي نبذ كل هذه الاقتراحات حتى لو بنيت على أساس الحرص على حماية وتحصين مصالح الحلفاء ضد استغلال ودعاية المحور في زمن الحرب الكبرى الحرج، وكذلك ضمان الأمن والسعادة للوجود الصهيوني الذي سيزول القلق منه عند أهل فلسطين وسيتقبلونه ضمن دولة الوحدة السورية وستتوقف المقاومة ضده، وكان الرد على كل هذه الضمانات هو الإمعان في التجزئة والتقسيم والتهويد مما أثبت بُعد النوايا الغربية عن آمال النهوض العربي مهما تنازل، وعن آمال التغريب في الغربيين مهما تجمل لهم، ولهذا ظل البريطانيون يصمون آذانهم عن نصائح نوري السعيد حتى عندما قدم تنازلاً جديداً ونصح العرب بالإيجابية والاعتدال والعقلانية في المطالب (1951) وذلك بالرجوع إلى خطوط تقسيم فلسطين معتمداً على أننا ’’نستطيع بواسطة أصدقائنا في لندن أن نرغم إسرائيل على قبول هذا الحل’’ (!)، وهو أمر يذكرنا بوضع 99% من أوراق الحل في يد أمريكا بعد ذلك بعشرات السنين، والحال يغني عن بيان ما أسفرت عنه هذه العقلانية والثقة في الغرب.
وحتى عندما ’’لم يبق بين الرجال الذين تعتمد بريطانيا عليهم في المنطقة، بعد إعفاء غلوب (1956)، سوى نوري السعيد في بغداد’’،[56] لم يتم الإصغاء إلى مشاريعه وآرائه، وحتى عندما دخل العراق في الاتحاد العربي مع الأردن استجابة لمصلحة بريطانيا في مناوأة الجمهورية العربية المتحدة (1958) رفضت الحكومة البريطانية بقوة مشروعه لمنح الكويت استقلالها وضمها إلى الاتحاد دون أن تجعله يفقد الثقة فيها أو تضعف حماسته في مقاومة مصر وسوريا، أي أن وظيفته هو خدمة المصالح البريطانية دون التدخل فيها أو الحصول على مكاسب منها، وكان سبب الرفض هو شعور بريطانيا أن العراق والأردن يريدان وضع الأيدي على ثروة الكويت في الوقت الذي تحرص فيه بريطانيا على بقاء هذه الثروة ذخراً لها كما اتضح بعد أشهر عند قيام ثورة14 تموز في العراق فصرح رئيس الوزراء البريطاني معبراً عن القلق من امتدادها إلى الخليج حيث ’’الكويت بإنتاجها الضخم من النفط مفتاح لحياة بريطانيا وأوروبا’’،[57] وظل الاهتمام البريطاني منصباً على استغلال العرب في مشاريعهم الخاصة المفصلة على المقاس الإنجليزي وحده كحلف بغداد (1955) دون محاولة تقديم أي تنازل ولو كان شكلياً للجانب العربي المخلص لهم، كما كان الإنجليز قد تحفظوا على مشروع الوحدة العربية لرئيس الوزراء العراقي الآخر فاضل الجمالي (1954) ورفضوا السير قدماً في تنفيذه رغم تأكيده أنه مستعد لحماية المصالح البريطانية في أي اتحاد فيدرالي يتم التوصل إليه، وأنه لا يمكن تحقيق الخطوة الأولى إلا بالاتفاق مع البريطانيين،[58] وقد ساهم كل ما سبق في النهاية الدموية للحكم الملكي في العراق ولعرابه نوري السعيد شخصياً.
ومن الأمثلة الدامغة التي قررت مستقبل بلادنا خلافاً لأوضاع الغربيين الذين سيطروا علينا أنهم قسموا هذه البلاد ووضعوا الحدود الفاصلة بينها في الوقت الذي كانت فيه أممهم تتجه للتكتل، وانسجموا مع قيادات مستبدة وحكومات فاسدة لا يقبلون بها في الغرب، وأيدوا إقامة دولة تعتمد الهوية الدينية على أنقاض شعب فلسطين رغم أن الغرب نفسه يرفض اعتماد التصنيفات الدينية في الكيانات السياسية، وحدث ذلك بإهمال حق تقرير المصير الذي رفعوا لواءه منذ الحرب الكبرى الأولى وميثاق الأمم المتحدة التي نشأت بعد الحرب الثانية،[59] كما أنشأ الفرنسيون كياناً طائفياً في لبنان يخالف كل أعراف الغرب العلمانية ومن أعجب مظاهره أن آخر إحصاء تم فيه كان منذ أكثر من ثمانين عاماً وذلك بسبب الخشية من اهتزاز الصيغة الطائفية التي رسمها الغرب ويريدها لهذا البلد، كما ابتلى الغربيون مصر بزراعة المحصول الواحد لتكون ممولاً لصناعات القطن في بلادهم وتهمل اكتفاءها الذاتي الذي عمر فيها قروناً ماضية، كما فرض الغرب على إيران حكماً مستبداً لعشرات السنين على أنقاض حكم منتخب ديمقراطياً (1953)، ومازال الغرب يثير نعرات العصبية والانفصال والتقسيم في بلادنا بعد أن قضى على معظم الجيوب الإثنية داخله بالعنف.
ولعل الفرق بين سويسرا الغرب وسويسرا الشرق، أي لبنان، يلخص معضلة التغريب بين واقع الغرب المبهر وما يريده الغربيون لنا من تخلف: فمنذ مؤتمر فيينا سنة 1815 أقرت أوروبا حياد سويسرا وظل الفرقاء الأوروبيون جميعاً يحترمون هذا القرار حتى أثناء الحربين العظميين إذ لم يقدم أحد حتى النازيون على خرقه، أما سويسرا الشرق التي صنعها الغرب أيضا فقد سمح لذيله الصهيوني باتخاذها مسرحاً لمغامراته الدموية ولو دون سبب كما حدث في غزو 1982، كما أن النموذج السياسي الطائفي الذي صنعه الغرب في لبنان والذي ولد سيولاً من الدماء لا يمكن أن نعثر عليه في مكان في الغرب حتى سويسرا المتنوعة دينياً، الفرق بين السويسرتين هو الفرق بين ما يصنعه الغرب بإتقان لنفسه وما يصدره لنا من قمامته الفكرية فضلاً عن قمامته النووية وهو درس عجز الكثيرون عن التقاطه والاعتبار به، وما زال أنصار التبعية يصرون على عدم الاعتبار بدروس الماضي وينادون بالخضوع للغرب ليأتي لنا بالتقدم رغم كل النتائج السلبية التي أسفر عنها اتباع نهجه والكوارث التي حلت بنا من التعامل معه، وهذا الخضوع هو سر تفضيلهم الحكم الاستعماري على الحكم العثماني أو حتى على أي حكم وطني وإن حاول الخروج من نفق التخلف بنفس الآليات التي اتبعها الغرب في تاريخه الطويل.
* تواضع إنجازات التغريب وأسبابه والدروس المستفادة من التحدي النهضوي ضد الهيمنة الغربية
وفي الوقت الذي اهتمت فيه بدايات نهضات القرن العشرين في الاتحاد السوفييتي والصين بمناوأة المشاريع الغربية التي تشدها إلى الوراء، انشغل ساسة العالم العربي بالتأقلم مع المصالح الغربية، فالقيادات التقليدية كانت لا ترى إلا ما تراه حكومة ’’الدولة البهية القيصرية الإنكليس’’، إذ ’’هل يقول (المسئول البريطاني) كوكرين إلا الخير؟’’!، ولهذا كان الغرب يفضل هذا النوع التقليدي المتسم بالجهل من القيادات، ورغم ادعاء الغربيين العمل على تطوير الممتلكات والمحميات الاستعمارية فإنهم كانوا يفضلون التعامل مع الزعامات التقليدية المطواعة على التعامل مع المتعلمين،[60] وقد أوضحت حوادث الثورة العربية (1916) سهولة انقياد الجمهور التقليدي من زعماء القبائل ورجالها للرغبات الأجنبية التي مثلها الجاسوس البريطاني لورنس الذي حرضهم وقادهم لتدمير معلم حضاري بارز هو سكة حديد الحجاز التي قامت قيادات التجزئة فيما بعد بحراسة تعطيل تشغيلها كاملة إلى اليوم، وهو حدث يبين بوضوح ارتباط التجزئة بالغرب والتخلف كما يبين بوضوح موقف الغرب من تنمية بلادنا رغم ادعاءاته ودعاياته عن جلب الحضارة والتمدن.
أما القيادات الليبرالية المثقفة فقد آمنت أن مصالح بلادها مرهونة بالاتفاق مع السيد الاستعماري الديمقراطي رغم وضوح القمع والطمع اللذين كانا من المفترض أن ينتهيا نهاية سعيدة إذا اندمج العرب في مخططات الغرب (!)،[61] وبهذا كان العمل للاستقلال الحقيقي بواسطة التغريب كمحاولة الخروج من الرمال المتحركة لا تزيد الغريق إلا غرقاً كما سبق توضيح تجربة نوري السعيد الذي وضح أول رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية الأستاذ أحمد الشقيري بعدما حل بالباشا المصير المحتوم أن إيجابيته وصداقته الممتدة مع بريطانيا لمدة أربعين عاماً لم تحقق شيئاً مذكوراً،[62] وأما القيادات الثورية فقد لعبت على وتر الخلافات بين الأقطاب الدولية فارتبط كثير منها بمركز ضد آخر حتى أننا رأينا تواطؤاً بين الشيوعيين والمستعمرين الغربيين عامة وبريطانيا خاصة ضد نفوذ دول كبرى أخرى كألمانيا مرة والولايات المتحدة مرة أخرى،[63] هذا إضافة لقيادات ثورية أخرى اعتقدت صدق الأمريكيين في مناوأة الاستعمار[64] ولهذا تورطت زمناً بالميل إليهم والتنسيق معهم رغم تناقض الأهداف والذي أدى في النهاية إلى الصدام المسلح وتدمير المحاولات النهضوية، وخلاصة الحديث أن الانصياع للمصالح الغربية طبع دولة التجزئة منذ سقوط الخلافة العثمانية مما أدى إلى تراجع إنجازاتها كما ينبئ عن ذلك واقع جميع الدول التي انسجم حكامها مع المصالح الغربية وخدموها بإخلاص، ولا عجب في ذلك فقد كان الغربيون هم الذين أوجدوا هذه الكيانات ونصبوا عليها هذه الزعامات، وما زال كثير من أقطار التجزئة يبني شرعية وجوده على لحظة تحالفه مع بريطانيا التي فصلته عن كيان الخلافة الإسلامية ويشعر بالامتنان لها على ذلك ووجوب استمرار دفع الثمن الباهظ سداداً لديْن الميلاد.
هذا في الوقت الذي نهضت فيه بلاد ناوأت الغرب ثم انتقلت إلى التفاوض معه من موقع القوة وليس التبعية التي طبعت سلوكنا منذ ولادة دولة الاستقلال والتجزئة التي وجدت أن مصالحها تابعة لمصالح مؤسسيها من السادة الاستعماريين بصورة موضوعية لا دخل للميول الذاتية في تقريرها، ولهذا لم يتمكن حتى المؤيدون لسياسات زعامات التجزئة الخاضعة من الفخر إلا بإنجازات متواضعة كتحقيق استقلال منقوص أو دخول منظمة دولية في المجال السياسي[65]وهي إنجازات لا تحسب ضمن الجهود النهضوية الكبرى، أو كالتعليم وزيادة أعداد السكان والرعاية الصحية وتراجع معدلات الوفيات وزيادة الرقعة المزروعة ونشوء صناعات حديثة وتطور وسائل المواصلات والاتصالات في المجال الاقتصادي،[66] وهي كلها إنجازات إما: 1- سخرت لإفادة الغرب بثرواتنا كالمحاصيل الزراعية التي توسعت رقعتها ورغم ذلك عجزت عن إطعام زراعها في الوقت الذي تزود فيه مصانع الغرب بالمواد الخام، وكالنفط الذي توصله وسائل المواصلات الحديثة فيحرك مصانع الغرب ولا يستفيد أصحابه إلا من ثمنه لتمويل ترف يعود على الغرب ذاته بالفائدة سواء عند الشراء أو الادخار، أو 2- لم تستفد دولنا منها كأعداد السكان التي أصبحت عبئاً بدلاً من مزية وصار معظمها غارقاً في الفقر والمرض، أو 3- هي في النهاية فوائد قاصرة كالتعليم الذي لا يجد فرصه للتطبيق إلا بالأعمال المكتبية والخدمية أو بالهجرة إلى الغرب، وهي أيضاً غير مرشحة للنمو إلى درجة تنافسية كالصناعة التي ما زالت تحبو وقصرت عن المنافسة في أي مجال حديث حتى فيما تحتكره بلادنا من ثروات معدنية أو يتوفر فيها على الأقل من إمكانات.
وفي الوقت الذي قصرت فيه فوائد الاندماج بالنظام الدولي الغربي عن بناء نموذج نهضوي كالغرب ذاته أو حتى عن إنشاء كيانات مستقلة ومكتفية وقابلة للحياة المستمرة دون التطفل على غيرها، وذلك رغم الخطوات الواسعة التي حققها غيرنا في الشرق والغرب، فقد فاقت أضرار هذا الاندماج محاسنه وذلك بتكريس تقسيمنا وشرذمتنا وضعفنا عن طريق حماية الصيغة السياسية التي تقوم عليها دولنا بتوافق دولي يحرس التجزئة المضادة للنهوض كما سيأتي.
* التقليد مضاد لنهوض الضعفاء ومقدمة لانهيار الأقوياء
وكان من مظاهر تبعية التغريب وخضوعه للجداول الغربية تقليده الحرفي للنموذج الغربي وعدم بذل أي جهد في تطويع الأفكار الغربية للحاجات العربية المحلية رغم محاولة فرض هذه الأفكار على الشعب العربي، وفي ذلك يقول الدكتور مجيد خدوري إن الدول الغربية لما استعمرت بلادنا كانت تقدم مصالحها على بناء المؤسسات الديمقراطية على غرار المؤسسات القائمة في أوروبا، وإنها استغلت الأوضاع المناقضة للديمقراطية لتقوية مواقعها في هذه البلاد، ولم تتردد في دعم الاستبداد أو إلغاء الحياة النيابية عندما تقتضي مصالحها، وإنها لم تكن تهتم بمدى ملاءمة هذه المؤسسات للواقع المحلي في البلاد العربية، مما أفقد العملية الديمقراطية الحماس الشعبي لأن الشعوب أحست بأن هذه المؤسسات لم تقم لأجل المصلحة القومية، كما أحست بالمذلة نتيجة الخضوع السياسي للهيمنة الأجنبية، وأصبحت الديمقراطية تقليداً زائفاً لمن رام الديمقراطية الحقيقية.
أما مدرسة التغريب الحاكمة التي خضعت للتوجيه الغربي بعد توليها السلطة بعد الحرب الكبرى الأولى فلم تر تناقضاً بين هذا الخضوع والمؤسسات الديمقراطية، وكان أمل المتغربين أن تزول السيطرة الأوروبية لتحل محلها مؤسسات جديدة توفق بين المصالح الأجنبية والوطنية، مما جعل هذه المؤسسات منذ البداية غير مستمدة من الواقع الاجتماعي وغير معبرة عن الرغبات الشعبية الحقيقية، ولم تنظر مدرسة التغريب إلى مدى ملاءمة الأفكار المستوردة للواقع العربي التقليدي، ولم تبذل أي جهد لتمحيص هذه الأفكار وهضمها ودمجها بالمفاهيم الإسلامية أو تعديلها وفق الأوضاع القائمة، ولما فشلت في تحقيق التطور المنشود أو تضميد جرح الكرامة، أدى ذلك إلى انهيار المؤسسات التي أنشأتها هذه المدرسة بعد فشلها في اكتساب ولاء الشعوب واحترامها.[67]
ويتحدث في هذا الموضوع المفكر الراحل الدكتور عبد الوهاب المسيري قائلاً إن الإنسان الذي لا هوية له لا يمكنه أن يبدع، لأن الإبداع مرهون بأن ينظر للعالم بمنظاره هو وليس بمناظير الآخرين، ولو فقد هويته ونظر بمنظار غيره فإنه سيكرر ما يقوله الآخرون ويصبح تابعاً لهم همه التقليد والإبداع داخل إطار مغاير كما يحدث للعلماء العرب المهاجرين للخارج، كما كان القضاء على التراث الروحي والثقافي للهند ضرورياً للقضاء على ثرائها ورقيها وأخلاقها ومن ثم هزيمتها وجعلها تابعة لبريطانيا، وإن تفعيل الهوية جزء رئيس في عملية النهوض الحضاري،[68] والانفتاح لا يعني الخضوع والتبعية بل تفاعلاً يأخذ ويعطي، وليس من الممكن أن نبدع عندما نتبنى مفاهيم الآخرين، وإذا أردنا تحقيق ما حققوه فإن ذلك لن يتم بالتقليد الذي ينقل الشيء بحذافيره كما يفعل دعاة التغريب، بل بالمحاكاة وهي الوصول إلى جوهر الشيء وتوليد ما يتناسب مع زمان المحاكي ومكانه وليس مجرد استنساخ أعمى يؤدي إلى عدم الإفادة من النموذج المحاكى كما يحدث لبعض دعاة التنوير العرب الذين لا يطبقون آليات النقد والتحليل الغربية على الحضارة الغربية واكتفوا بتطبيقها على التراث الإسلامي بطريقة ثأرية، ولقد أدت محاولة اللحاق بالغرب إلى انهيار الاتحاد السوفييتي الذي أسقط نموذجه الخاص بما فيه من مثل إنسانية وحاول تقليد النموذج الاستهلاكي الغربي،[69] وقد سقط العرب في التبعية الإدراكية فصاروا يدركون الغرب كما يريد هو ولا يطرحون الأسئلة التي تحتمها أوضاعنا ومصالحنا ومبادئنا، ومن ذلك مثلاً أننا نعتقد أن الثورة الفرنسية (1789) هي ثورة الحرية والإخاء والمساواة دون طرح الأسئلة التي تتعارض مع هذه الرؤية حتى لو كان الغرب هو الذي يطرحها فضلاً عما علينا نحن أن نطرحه فيما يتعلق بالحملة الفرنسية على مصر (1798) أو احتلال الجزائر (1830)، بل لقد أصبحنا ندرك أنفسنا كما يريد لنا الآخرون ونحكم عليها بالهزيمة قبل دخول المعركة ومهما بذلت من جهد كما نحكم عليها بالتخلف مهما قدمت من عمل، ولهذا يتحدث تأريخنا كالتاريخ الغربي تماماً عن الدولة العثمانية بصفتها ’’رجل أوروبا المريض’’ ولا نتحدث عن ’’رجل أوروبا النهم’’ الذي نشر الإبادة في الأمريكتين وأستراليا ونيوزيلندا وإفريقيا واستعبد آسيا ونشر فيها تعاطي الأفيون، مع أنه لو ترك الرجل المريض وشأنه لربما شفي أو تعافى على يد ’’رجل مصر الفتي’’.[70]
* مرض القوي الموحد ليس كمرض الضعيف المقطع
يتساءل بتعجب بعض من يطلعون على إنجازات الدولة العثمانية في آخر أيامها كما فصلت جانباً منها في دراسات سابقة، عن حقيقة قدرة الدولة على أن تقوم بهذه الإنجازات وأن تقاوم عوامل الفناء ونوائب الدهر بهذا العناد وهي في مرحلة الانهيار؟ وتجيب عن سبب ذلك إحدى فقرات المؤرخ دونالد كواترت في كتابه الدولة العثمانية أثناء حديثه عن تراجع هذه الدولة العظمى بما يبين الفرق بين تراجع العظماء وأحوال الضعفاء سواء في ضعفهم أو حتى في عافيتهم، فيقول: ’’ما من شك أن الدولة العثمانية كانت سنة 1500 تعد من أقوى دول العالم... لكن هذه الدولة العظمى التي أقضت مضجع القوى الأوروبية لقرون، بدأت تضمحل بعد أن قلب الدهر لها ظهر المجن، ومع بداية القرن الثامن عشر أصبح مصطلح رجل أوروبا المريض عبارة متداولة عند الإشارة إلى الدولة العثمانية، وعلى الرغم من ذلك فقد بقي العثمانيون أثناء القرن التاسع عشر قوة يحسب حسابها في السياسة الخارجية في كل من بريطانيا وفرنسا وإمبراطورية النمسا وكذلك ألمانيا وإيطاليا، ومن جهة أخرى فقد بقيت قوى محلية في الهند وآسيا الوسطى وشمال إفريقية تتطلع إلى الدولة العثمانية لحماية مصالحها’’،[71] وبهذا يتبين لنا أن مرض القوي ليس كمرض الضعيف وربما كان القوي في ضعفه أقوى من الضعيف في قوته، ولهذا حرص الغرب على تمزيق وحدتنا والقضاء على آثارها الإيجابية.
* التمهيد لنكباتنا بإزالة أثر وحدتنا
قضية العرب المركزية في مهب العاصفة: فلسطين بين الماضي العثماني والانتداب البريطاني: قامت سلطات الاحتلال البريطاني في فلسطين بإلغاء جميع الإجراءات العثمانية التي ساندت الفلاح العربي وضيقت على الزائر والمهاجر الصهيوني، وفي ذلك يقول الدكتور محمد عيسى صالحية في كتابه مدينة القدس إن هربرت صموئيل أول مندوب سام’’أصدر قراراً في آذار/ مارس 1921 بتصفية البنك الزراعي العثماني، بنك الفلاحين العرب، الذي يقدم القروض الميسرة، بحجة اضطراب أعماله، والهدف من هذا القرار حرمان الفلاح العربي من خدمات البنك وتسهيلاته، والتضييق عليه، وإجبار المضطرين من الفلاحين العرب على اللجوء إلى البنوك والمصارف والمرابين اليهود، والاقتراض منهم بفوائد فاحشة وضمانات رهنية صارمة’’،[72] ويضيف إن حكومة الانتداب عمدت ’’إلى إصدار شهادات عرفت بالورقة البيضاء (التذكرة)، نكاية بالورقة (التذكرة الحمراء)، التي كانت تصدرها الإدارة العثمانية للزوار والسياح والحجاج من اليهود مدتها ثلاثة أشهر، والتي كان عليهم بانتهاء المدة مغادرة فلسطين، وعدم التخلف أو الإقامة في البلاد، أما الورقة البيضاء البريطانية فهي إذن للهجرة والاستقرار’’،[73] ويزيد الدكتور بشارة خضر من تعداد هذه الإجراءات البريطانية فيذكر ’’مرسوم محلول الأرض (1920) الذي يمنع الفلاحين من زيادة أملاكهم بحسب التقاليد العثمانية، ومرسوم الأرض الموات (1921) الذي ألغى التشريع العثماني الذي كان يتيح للفلاح ضم الأراضي البائرة’’،[74] وكان هدف كل تلك الإجراءات عرقلة جهود الفلاحين العرب وتسهيل انتقال الأراضي للمهاجرين الصهاينة، كما فتحت أبواب الهجرة الصهيونية الواسعة لمن كانت السلطات العثمانية قد نفتهم أثناء الحرب ولغيرهم أيضا.
ولم تقتصر عملية إزالة آثار الوحدة على إقامة الكيان الصهيوني، فمنذ وطئت أقدام المحتلين الأجانب بلادنا قاموا بوضع الحدود بينها وقضوا على وحدتها السياسية الماضية، كما استولوا على مواردها التي كانت مسخرة لاكتفائها الذاتي، وربطوا اقتصادها باقتصاديات المراكز الاستعمارية بعدما كانت التجارة داخل الشرق العثماني أهم كثيراً من تجارته الخارجية حتى عندما ازدادت أهمية التجارة العالمية ابتداء من منتصف القرن الثامن عشر،[75] ووضعوا الحواجز بين ما كان حتى وقت قريب منطقة تجارية واحدة،[76] وسهلوا المواصلات مع بلاد الغرب البعيدة لإحكام القبضة الاستعمارية وتسهيل تدفق الثروات من بلادنا في الوقت الذي تراجع حتى في زمن الاستقلال الاتصال بين بلدان المنطقة القريبة من بعضها البعض لصالح هذه المواصلات الخارجية،[77] وسقوا بذور الخلافات والانشقاقات وأشعلوا فتن الانفصال حتى غدا ما كان مجتمعاً موحداً قبائل متفرقة متناحرة متحاسدة قام الكيان الصهيوني وسطها ليحرس انقسامها وتخلفها وتبعيتها إذ أعلن منذ البداية أنه جبهة متقدمة للحضارة الغربية ضد البربرية الشرقية وأنه رأس جسر غربي يعبر الغزاة عليه وقاعدة تحرس مصالحهم وحاملة طائرات تؤوي جيوشهم، وقد استمرت في عهد الاستقلال جميع العيوب التي صنعها الاستعمار ولكنها أصبحت الآن برعاية السيادة الوطنية وحراسة جيوشها المظفرة وتحت راياتها المنصورة (!)
* تبعات قضاء الغرب على وحدة المنطقة المتمثلة في الخلافة العثمانية وإحلال المشروع الغربي محلها
ألف القانوني الأمريكي دافيد فرومكين كتابا بعنوان ’’سلام ينهي كل سلام: ولادة الشرق الأوسط 1914- 1922’’ يؤرخ فيه لجذور أزمات المنطقة في القرن العشرين ويشير إلى بروز هذه الأزمات من عاملين: ’’من تدمير بريطانيا للنظام القديم في المنطقة عام 1918، ومن قراراتها عام 1922 بشأن كيفية استبدال ذلك النظام، بل تنبثق أيضا من غياب القناعة في السنين اللاحقة ببرنامجها الذي فرض التسوية عام 1922’’[78]، وعن العامل الأول يقول إن رئيس الوزراء البريطاني لويد جورج كان مقتنعاً تماماً سنة 1921 بقول رئيس الوزراء اليوناني: ’’إن النتيجة الأهم للحرب الكبرى بالنسبة للإنسانية هي اختفاء الإمبراطورية التركية، وليس حل امبراطورية النمسا- المجر، ولا تقليص الإمبراطورية الألمانية’’،[79] وبناء على زوال الدولة العثمانية كان ذلك العصر ’’عصراً اصطنعت فيه بلدان الشرق الأوسط وحدوده في أوروبا.. وقد اعتقدت الدول الأوروبية آنذاك أن باستطاعتها أن تغير آسيا الإسلامية في صميم أساسيات وجودها السياسي... فقد استحدثت نظام دول مصطنعة في الشرق الأوسط... ويبدو لي أن عام 1922 كان نقطة اللاعودة من حيث وضع مختلف العشائر في الشرق الأوسط على طرقها المؤدية إلى التصادم... لقد بدأ الشرق الأوسط في ذلك العام السير على طريق كان من شأنه أن يقود إلى حروب لا نهاية لها، من ضمنها الحروب بين إسرائيل وجاراتها، وبين الميليشيات المتناحرة في لبنان’’.[80]
أما نزاعات التجزئة العربية فلها بداية وليس لها نهاية وتكاد لا ترى جارين ليس بينهما نزاع أو ربما حرب، منذ الخلاف السوري اللبناني (1949) ثم الخلاف بين الأردن والبلاد العربية على ضم الضفة الغربية (1950) والنزاع السوداني المصري على حلايب (1958) الذي لحقه الأزمة بين لبنان والجمهورية العربية المتحدة ثم بين الأردن ونفس الجمهورية في نفس العام، وهما نزاعان جلبا التدخل الأمريكي البريطاني، ثم النزاع بين العراق والكويت (1961) والذي كان مدخلاً للتدخل الأجنبي البريطاني أيضاً، ثم النزاع بين دمشق والقاهرة داخل الجمهورية العربية المتحدة نفسها في نفس العام (1961)، ثم اندلاع حرب اليمن الضروس بعد الانقلاب الجمهوري في العام التالي (1962) بين مصر والسعودية، وهو نزاع حدث فيه استقطاب داخل المعسكر الغربي نفسه بين اعتراف أمريكي بالجمهورية ودعم بريطاني للملكية،[81] وبعدها نشب الخلاف الحدودي بين الجزائر والمغرب (1963) الذي ما أن هدأ حتى اندلعت مشكلة الصحراء الغربية بين الجزائر والمغرب وموريتانيا في السنة التالية (1964)، ثم نشوب معارك أيلول بين الأردن والمقاومة الفلسطينية (1970) والخلاف السوري المصري بعد حرب أكتوبر (1973) ثم الحرب المصرية الليبية (1977)، ولم تنته خلافات العرب والمسلمين بالحرب العراقية الإيرانية الطاحنة (1980- 1988) وأزمة الكويت الفاضحة (1990) التي استدعت التدخل الأجنبي الكاسح هذه المرة والذي لم ينته أيضاً باحتلال العراق (2003) بمساهمة عربية فاعلة منذ البداية، وتطور التدخل الأجنبي الذي كان يستدعى من خلف الستار أو تحت الطاولة ليصبح الأمر علنياً وبتمويل عربي يهدم أقطاراً عربية أخرى لمجرد خلافات قد لا تعدو الصفة الشخصية بين الزعماء فيذهب ضحيتها مئات الألوف من أفراد الشعوب، ثم لا تجد أبرع من الصهاينة في إحصاء أثر هذه الخلافات وعدد ضحاياها،[82] ولا أكثر منهم فرحاً بنشوبها لإثبات أن الوجود الصهيوني ليس الأشد خطراً على المنطقة، على عكس ما يدعي العرب، ولإيضاح أن هؤلاء العرب بحر تخلف وهمجية ودموية تتوسطه جزيرة التطور والحضارة الصهيونية.
* التجزئة ضد النهضة: هل يمكن لدولنا الصغيرة أن تنمو بعيداً عن التجمع؟
إن كثرة الإمكانات التي توفرها الوحدة هي الأرضية الصالحة لأية عملية نهوض، ويلاحظ بأن وفرة إمكانات العالم العربي وحده موزعة بين عدة جهات، فالإمكانات المالية والاقتصادية في جهة، والإمكانات المائية والزراعية في جهة ثانية، والإمكانات البشرية في جهة ثالثة، والإمكانات العلمية والثقافية تهاجر إلى جهات خارجية بسبب التضييق عليها نتيجة سياسات التبعية، وعلى سبيل المثال كيف ستستطيع دولة صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها المليون أن توفر الإمكانات البشرية العلمية اللازمة لعملية التصنيع، أو السوق اللازمة لتصريف المنتجات وإيداع الفوائض المالية، أو الإرادة السياسية لتحدي أقطاب الصناعة في الغرب، أو موارد الاكتفاء الذاتي التي تغنيها عن الحاجة إليهم؟ وقد أثبتت تجارب حديثة أنه حتى الدول الكبيرة في منظومة التجزئة العربية والإسلامية لا تستطيع الخروج على الإرادة السياسية الغربية التي قد تصل حد تنصيب الحكام بالقوة (حادث 4 فبراير 1942 في مصر ثم انقلاب 1953 في إيران البهلوية ثم غزو العراق 2003)، ولا تستطيع أيضاً الخروج على قرارات الدول الكبرى التي تمنعها من العمل على الاكتفاء الغذائي الذاتي للاستغناء عن المعونات والصدقات التي تربطها بعجلة السياسات الكبرى رغم الإمكانات الزراعية العربية الكبيرة التي توظف لصالح الاقتصاديات الغربية ومصانعها، وتمنعها أيضاً من الوصول إلى اكتفاء من السلاح لتدافع عن وجودها، ولعل استمرار حاجة إيران البهلوية إلى الإمداد العسكري الغربي[83] رغم الغطرسة الامبراطورية وحاجة تركيا الجمهورية إلى المظلة الأطلسية مثالان واضحان على العجز رغم كبر الحجم، وهو عجز لا يستدل عليه بمجرد الانضمام إلى المشاريع العسكرية الغربية، فدول كبرى كدول أوروبا تنضم للولايات المتحدة في هذه المشاريع ولكنها تملك حرية أكبر في إظهار مواقف تتعارض مع السياسة الأمريكية، أما دول كإيران وتركيا فلم يكن أمامها سوى الإذعان للمصالح الأمريكية والسير في ركابها حتى لو كان ذلك ضد شعوب إسلامية أخرى وهو ما لا يمكن أن ترتكبه شعوب الغرب ضد بعضها البعض، بل لعل دولة التجزئة أسرع انقياداً لعداوة الأخ وقتاله من قتال العدو الحقيقي، ولعل المثل الإيراني الإسلامي الذي تعاون مع السياسة الشيطانية الأمريكية ضد جاريه المسلمين في الشرق الأفغاني والغرب العراقي يؤكد حتمية هذا الانحراف باستمرار السياسة الشاهنشاهية - برؤية جديدة- والتي استندت إلى دعم الوجود الأمريكي في المنطقة للحصول على دور فيها وهو ما لا يمكن للدول الصغرى أن تخرج عن إطاره مهما كبر حجمها وتغيرت مبادئها وادعت مثاليتها، وذلك استجلاباً لرضا الدول الكبرى واعترافها، كما تعجز بقلة إمكاناتها عن الخروج عن المعادلات السياسية الدولية التي تفرض التجزئة التي هي أساس الضعف في العالم العربي والإسلامي.
وعندما كان يجتمع لأي قُطر من الإمكانات ما يمكنه من السير قليلاً في طريق الخروج من نفق التخلف والتبعية كان الغرب يقف بالمرصاد لأية محاولة من هذا النوع في بلادنا ويحطمها بقوة السلاح، ولم يكن لأصحابها حينئذ من الإمكانات أو العمق ما يواجهون به هذا العدوان كما فعلت الجماهير السوفييتية مثلاً عندما واجهت التدخل الغربي ضد الثورة البلشفية اعتماداً على عمقها الجغرافي أو عندما انتصرت الثورة الصينية (1949) اعتماداً على نفس العامل، ويكفي دولة التجزئة فشلاً أنها امتلكت مصدر القوة الرئيس في اقتصاديات عالمنا المعاصر وهو النفط ومع ذلك عجزت عن الإفادة منه مع أنه كالدم الذي يسري في شريان حياة الاقتصاد العالمي، وقد عبر الرئيس الأمريكي أيزنهاور سنة 1957 عن ذلك بالقول ’’إن سيطرة الغرب على النفط العربي لا تقل أهمية عن منظمة حلف شمال الأطلنطي، بل إن المنظمة تفقد أهميتها لو فقدنا السيطرة على النفط، العربي’’،[84] وما زالت أهمية النفط العربي في تزايد حتى يومنا هذا وإلى عشرات مقبلة من السنين، إذ يفوق الاحتياطي العربي نصف الاحتياطي العالمي، وتصل نسبة التصدير العربي في السوق العالمي ما يقارب 40% حسب أرقام سنة 2006،[85] ومع ذلك لم تستطع الدولة القطرية تحويل هذه القدرة الكامنة إلى نهضة علمية أو قوة عملية لنفسها أو حتى مصدر ضغط سياسي لصالح القضايا القومية والوطنية في اللحظات الحرجة التي سجلت الفشل العربي في اللعب بالأوراق المتوفرة لصالح أي حق من حقوق العرب وذلك كما حدث عندما قرر الزعماء العرب في مؤتمر بلودان (1946) مقاطعة أمريكا وبريطانيا نصرة لفلسطين ثم انبروا للاعتذار لسفرائهما وتبرير القرارات بأنها مجرد مسايرة للرأي العام العربي الغاضب، وفشل العرب كذلك في استخدام سلاح النفط في سنة 1948 ووصف الرئيس الأمريكي ترومان تهديداتهم بالكلام الفارغ، ثم كان أول قرارات مؤتمر الخرطوم بعد نكسة 1967 هو استئناف ضخ النفط لاستخدامه في إزالة آثار العدوان، وفي حرب 1973 قرر العرب استخدام سلاح النفط حتى يجبر الغرب الكيان الصهيوني على الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة،[86] وليس الرحيل كلياً عن بلادنا، ومع ذلك تراجع القادة بعد أشهر مقابل مجرد وعود كتبت بالماء ولم ينفذ منها شيء، كبقية الوعود الأمريكية التي ما زلنا نلهث خلف سرابها إلى اليوم، وكانت الولايات المتحدة ودول بحر الشمال هي من استفاد أساساً من ارتفاع أسعار النفط في هذه المعركة،[87] ثم انسحب النفط من تمويل معركة أمته ليتحول إلى تمويل معارك الغرب وسياسات العدوان الغربي على أمتنا وشراء المواقف لتمريرها، ويمكننا مقارنة ذلك بقدرة السلطان العثماني رغم الضعف والتراجع والهزيمة في آخر أيام الخلافة على التلاعب بتنافس الدول الكبرى واستماتتها للحصول على امتيازات النفط، فكان يعطي دولاً منها أو يمنعها أو يطردها أو يستدرج منافسيها أو يبحث عن غيرها وهدفه الأول والأخير هو تحقيق مصالح دولته وتمكن من ذلك بكل حزم وقوة غير مستسلم حتى لأصدقائه ودائم اليقظة حتى لحلفائه.[88]
أما في عهد التجزئة فلم نتمكن نحن بل تمكن الآخرون من دعم أنفسهم وإقامة نهضاتهم الذاتية بل والسيطرة على العالم بتحكمهم بهذا النفط العربي[89] الذي لم يفد أصحابه وتحول إلى نقمة على مالكيه نتيجة تكالب حشود الطامعين والمتطفلين عليهم في ظرف ضعفهم وانقسامهم وتشرذمهم مع إمكان حدوث العكس لو كانت كلمتهم موحدة في وجه العالم الخارجي، ورغم كل الحديث الأجوف عن الحرية والديمقراطية فقد كان كل الانهماك الغربي في أزمة الخليج سنة 1990 بسبب الخوف من وقوع احتياطيات الخليج النفطية الضخمة تحت سيطرة سياسية واحدة كما صرح الرئيس الأمريكي آنذاك لشعبه[90]، ولهذا صرحت خطة البنتاغون التي سبق ذكرها وأعدها وولفوتز سنة 1992 إن هدف الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وجنوب غرب آسيا هو إبقاؤها خارج نفوذ أية قوة إقليمية وردع أي هجوم عليها والاحتفاظ بالحق في استخدام أجوائها وممراتها المائية مع التركيز على الحؤول دون هيمنة قوة أو تحالف قوى إقليمية عليها لا سيما الجزيرة العربية،[91] ولعل نظرة خاطفة لإنجازات النفط في العالم المعاصر في التصنيع والتجارة والفوائض المالية وعموم الاقتصاد والسياسة والحرب، تكفي لحساب ما فات ملاكه من عوامل القوة والنهضة والسيادة وهم ما يزالون من أضعف الدول وأكثرها تبعية وتراجعاً، أي أن الدولة القطرية منحت القوة والنهضة لسواها ولم تستطع تحقيق ذلك لنفسها، ويبدو أن الأطراف الغربية تدرك أن استمرار هيمنتها على هذا المورد رهن لاستمرار ضعف مالكيه ولهذا تحرص على إبقائهم في هذا الوضع المتخلف.
ولهذا يكذب من يدعي أنه مع النهضة وفي الوقت نفسه يتمسك بواقع دولة التجزئة الوطنية، أو أنه ليس أكثر من جاهل لا يعرف المتطلبات الرئيسة لهذه النهضة وواقع عظمة الدول إذ لا تنمو دولة صغيرة إلا في الحالات الاستثنائية وفي ظروفها الخاصة التي تكون الاستثناء الذي يثبت القاعدة، وإنه لمن العجيب رؤية مثقف محترم يدعي التنور والعلم ثم يقف مدافعاً عن الدولة الوطنية رغم سجل فشلها الطويل، ويتمسك بها هرباً من بعبع الخلافة الإسلامية الوحدوية، ولهذا لا أفهم وطنية من يدافع عن هذه الدولة القطرية، إذ كيف يحب وطنه من يصر على عزله عن أشقائه وعدم تكامله معهم في زمن تتنافس الأمم فيه على التكتل ولا ينجح منها إلا الكبار الموحدون، كما لا يكون للصغير شأن إلا بالاستناد إلى أشقائه كما سيأتي.
لن ينجح أي مشروع نهضوي يتخذ من دولة التجزئة قاعدة له، فإضافة لقصور إمكاناتها البشرية والمادية القليلة عن تحقيق الطموحات النهضوية الكبرى، فإن هذا القصور يدفع حكامها إلى التعلق بالأقوياء (الذين هم الأعداء في زمننا والذين لا مصلحة لهم في نهوضنا) لضمان استمرار الكراسي والظهور على النظراء المنافسين والمتحاسدين، بالإضافة إلى ضمان استمرار حياة الكيانات السياسية الضعيفة التي يحكمونها ولو بواسطة تنمية تابعة حتى لا يصيبها عقاب الحصار الاقتصادي الذي أنهك المتمردين، وهذا يوضح بجلاء أن الخيانة من طبيعة تكوين كيانات التجزئة، والملخص أن الضعف يحكم هذه الكيانات ويفرض منطقه الخياني عليها فلا تستطيع الخروج من إساره خلافاً لمنطق عظمة الوحدة التي ترفض التبعية حتى زمن الهزيمة، ومقارنة حال دولة كبرى كالدولة العثمانية الضعيفة في آخر أيامها بحالات الولايات التي عملت للاستقلال عنها بمساعدة الأجانب ثم بحالات دول التجزئة يثبت كل ما سبق ذكره.
لقد ثبت عجز الدولة القطرية أمام كل التحديات التي واجهتها، فلم تستطع إطعام نفسها حتى لو كانت بلاداً زراعية تقليدية، أو الدفاع عن حدودها فضلاً عن ضمان وجودها رغم تكديس الأسلحة، أو كفاية حاجات مواطنيها رغم كثرة الصناعات التي هي في حقيقتها هامشية لا تمس الاحتياجات الأساسية، وباختصار عجزت دولة الاستقلال عن الحياة إلا بالتعلق بأهداب الدول الكبرى لتضمن لها وجودها، هذا فضلاً عن فشلها في إقامة المشاريع الحيوية لأبناء المنطقة أو حتى إعادة بناء ما أنجزته الدولة العثمانية ودمرته الأيادي الاستعمارية كسكة الحجاز وسكة بغداد، وهو ما يوضح التناقض بين التجزئة والتطور، فقد عملت هذه التجزئة في افتتاح عهدها الذي جسدت الثورة العربية على الدولة العثمانية (1916) بدايته الرسمية، على تدمير مشروع حضاري حيوي هو سكة الحجاز، وظلت عاجزة عن إعادة تسييره وذلك وفقاً لما أملاه عليها منطقها المفعم بالتنافس والتحاسد وتوزع مراكز اتخاذ القرار بين كيانات الانفصال.
وعملت دوامة الحزازات بين القيادات العربية على إفشال كل قضاياها التي تتطلب وحدة الكلمة مثل قضية فلسطين قبل النكبة حين استعرت الخلافات بين سوريا والأردن، وبين العراق والقيادة الفلسطينية،[92] ثم في زمن النكسة حين كانت ’’الحملات الإعلامية بين دمشق وبغداد وصلت إلى عنان السماء، الحكومة المغربية سحبت سفيريها في دمشق وبيروت، ثم قطعت علاقاتها الدبلوماسية بالجمهورية العربية السورية، وعاد التوتر بين القاهرة وصنعاء والرياض بسبب أزمة اليمن، وبالنسبة إلى الخلاف بين المنظمة والأردن فقد سوي على الورق ولم نستطع الوصول إلى مرحلة التنفيذ، و.. و.. إلخ’’ كما يقول الأستاذ أحمد الشقيري في مذكراته،[93] هذا فضلاً عن فشل أي مشروع وحدوي يتم طرحه للتنفيذ مثل مشروع سوريا الكبرى أو مشروع الهلال الخصيب أو الوحدة بين مصر وسوريا بسبب المنافسات العربية، فالأسرتان العلوية في مصر والسعودية في الرياض تتصديان لمشروع الملك الهاشمي عبد الله لتوحيد سوريا الكبرى، كما تتصديان لمشروع الهلال الخصيب الذي طرحه نوري السعيد في العراق، وبغداد وعمّان تتنافسان على غنيمة هذه الوحدة[94] التي طُرح انضمام الكويت الغنية إليها ولكن بريطانيا تتصدى لذلك بقوة،[95] ولما تقوم وحدة بين سوريا ومصر يقوم اتحاد مناوئ لها بين الأردن والعراق، وتتوتر العلاقات في المغرب العربي إذا اتحدت ليبيا وتونس،[96] ومن الطريف أن تتباكى المملكة أحياناً على النظام الجمهوري في بلد ثان حتى تعيق مشروعاً وحدوياً تطرحه مملكة أخرى،[97] ومعظم المشاريع تأتمر بأمر الأجنبي وتطلب إذنه لتتحقق أو لا تتحقق، فيجتمع العرب إذا طالب الأجنبي أو رضي (الجامعة العربية 1945 واتحاد الجنوب العربي 1959 الذي استهدفت بريطانيا منه فصل عدن عن صنعاء،[98] واتحاد الإمارات العربية 1971 الذي استهدفت منه عزل الثروة النفطية في هذه الإمارات عن العراق والسعودية،[99]) ويتفرق العرب حين لا يأذن لهم الأجنبي بالاجتماع،[100] ومن المعيب أن تجد حاكماً عربياً يطمئن الوكيل البريطاني أن تعاون هذا الحاكم مع الجامعة العربية سيكون محدوداً ولن يطال المسئوليات البريطانية المتحكمة في بلده،[101] ومن المخزي أن تجد الموظفين الإنجليز يتفاوضون مع بعضهم البعض نيابة عن الأطراف العربية المتنازعة أو يحكمون بغطرسة وصلف في الخلافات بين الأطراف العربية الخانعة (مؤتمر العقير سنة 1922)[102] على عكس صلفها مع الخليفة العثماني في السابق حتى عندما كان يروم مصالح بلادها بتأسيس مشاريع حيوية مثل سكة الحجاز وسكة بغداد اللتين واجهتا معارضة عربية اتسمت بالإيذاء الذاتي، هذا فضلاً عن تعامل الأطراف العربية مع بعضها البعض بطريقة تبالغ في التحاسد والتنابذ والحرص الأجوف على الكرامة المهدرة التي لا تجد من يدافع عنها عند خنوع الزعامات الكبرى أمام أصغر موظف بريطاني، ولا تسل عن عمليات تحريض الأجنبي القوي ضد الأشقاء وهي ظاهرة ما زلنا نعيشها إلى اليوم وقد اتخذت أبعاداً علنية طرحت كل براقع الستر والحياء بعدما أهدرت كثيراً من موارد الأمة واستنزفت طاقاتها في الخلافات الجانبية التي كثيراً ما عطلت عمليات نهوض واعدة، ولما برز التحدي الصهيوني كان سبب الفشل العربي هو استفراد الصهاينة بكل جيش عربي على حدة في جبهة مستقلة حتى تمكنوا من هزيمة الجيوش جميعاً سنة 1948،[103] وما زال وجود الصهاينة في بلادنا هو سبب ضعفنا وفرقتنا إذ يتعهد الغرب القوي مجتمعاً بضمان استمرار تفوقهم النوعي على مجموع طاقات دولنا، وهو إقرار واضح لا لبس فيه بالعمل المستمر على إبقائنا متخلفين ولعل هذا هو السر في ضرب كل محاولات الخروج من نفق التخلف.
* النموذج المصري بين فاعلية الوحدة وعجز الاستقلال
إن سجل الوحدة زاخر بالنجاح الفعلي والإنجاز العملي في زمن الخلافة، الضعف والتراجع طارئ عليه، أما سجل التجزئة والاستقلال فليس فيه سوى أحلام وأماني خيالية لم يتحقق منها غير الهزيمة والفشل والتراجع، والنجاح الفعلي هو الطارئ والمؤقت وظروفه خاصة، وعند المقارنة التاريخية بين ريادة مصر ودورها الفاعل عندما كانت ’’تابعة’’ لدولة الخلافة حين أنقذت المسلمين من المجاعة في عام الرمادة ثم أصبحت مركزاً للخلافة (ومن المفارقات أن ليبرالية التغريب ترفض حتى هذه المركزية لمصر باسم الهوية المستقلة) ثم هزمت حملات الفرنجة الصليبية وصدت الغزو المغولي لتعود مركزاً للخلافة ثانية ثم أصبحت الولاية الأولى في دولة الخلافة العثمانية مقدمة على الأناضول وأوروبا العثمانية، وبين فشلها وتراجعها زمن ’’الاستقلال’’ الذي صنعته بريطانيا حين سقط حكام مصر ضحية مشاريعهم لاستقلالها فدخل المسلمون في صراع داخلي أذكته أوروبا بين مصر والدولة العثمانية فتحطم الإثنان، ثم وقعت مصر تحت براثن الإفلاس ثم الهيمنة الأوروبية ثم الاحتلال البريطاني ولم تحقق نجاحاً مؤقتاً إلا اعتماداً على اختلاف الدول العظمى التي لم تلبث أن تكالبت عليها (1967) لتلحقها بمصالحها ثانية وتتخذ منها أداة للسيطرة على المنطقة العربية وتمرير السياسات الأمريكية وقيادة التطبيع مع الصهاينة وتدمير دولة عربية (1990- 2003)، ومع ذلك لم تمكنها كل هذه الخدمات من تحقيق مصالحها الوطنية الضيقة فكبل اقتصادها بالقروض والمساعدات والإصلاح الاقتصادي على حساب الاكتفاء الذاتي والمصالح المصرية وذلك لخدمة السياسة الأمريكية، ولعل المثل الأبرز في هذا المجال بيع النفط والغاز المصريين للكيان الصهيوني بخسارة لمصر بلغت ملايين الدولارات يومياً في حالة الغاز، وهو عبء كبير على الاقتصاد المصري المنهك أصلاً ومع ذلك فقد ضحت الدولة ’’المستقلة’’ بمصالحها الوطنية المباشرة لأجل مصالح الأقوياء، وقبلت كذلك بالتعاون العسكري الأمريكي الصهيوني الذي وصفه مبارك بالكارثة على الدول العربية المعتدلة وبالعقبة في طريق السلام (6-12-1983) ثم اضطر للاستسلام، والتزمت مصر بمعاهدة السلام مع الصهاينة ’’على الرغم من الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاقية’’ كما قال مبارك (11-3-1984)، ومنحت تسهيلات للقوات الأجنبية في مياهها ضد سيادتها وضد البلاد العربية الأخرى، بالإضافة إلى عجزها عن فرض رؤيتها لترتيبات أمنية عربية في الخليج بعد حرب الكويت واستسلامها للوجود الأمريكي هناك،[104] هذا إذا لم نذكر تحييد دورها وتهميشه وتأمين جانبها أثناء شن الصهاينة حروبهم ضد أشقائها العرب (1982 و2003 و2006)، هذا إذا لم تشارك في العدوان فعليا (1991 و2008)، وإذا استدعينا نموذجاً بسيطاً لا يتطلب طموحات كبرى ومع ذلك يدل على مدى عجز دولة التجزئة مهما كبر حجمها عن الخروج على إملاءات الدول الكبرى، فسنجد ذلك على الحدود بين الأراضي الفلسطينية ومصر، حيث استمرار التوتر فيها رغم تعاقب الأنظمة ذات الهويات المختلفة يؤكد أن عداوة الإخوة والجيران هو منطق دولة التجزئة المقيدة بسياسات الكبار التي تمنعها حتى من تحقيق مصالح قُطرية صغيرة كتبادل تجاري محدود، بين الأشقاء والأقارب في مدينة واحدة مقسمة بشكل هزلي بأمر الكبار، وذلك حين تقتضي المصالح الغربية ذلك المنع، ويصبح الأخ أداة لخنق أخيه الواقف خلف الحدود، إكراماً لتسلط الأجنبي وغطرسته واحتلاله، ولهذا فإن أية مراهنة على تحقيق أي نجاح نهضوي مهما صغر بواسطة الدولة القُطرية لن يكون مصيرها سوى إفساد المراهنين وجرهم إلى مستنقع المساومات فهزيمة كل مشاريعهم، إذ مهما تغيرت هويات الحكام سيجدون أنفسهم مقيدين بقلة إمكانات كيانات التجزئة التي التزموا بها ومن ثم عدم قدرتهم على تنفيذ أحلامهم وتحدي الأعداء الكبار، وسواء كانت الأحلام قومية واسعة أو إسلامية أوسع أو وطنية ضيقة لتوحيد شطري دولة أو حتى الحفاظ على وحدتها أو تحقيق مصالحها الوطنية لن يكون حاكم التجزئة في كل ذلك إلا أداة تطبق ما تقبله سياسات الكبار بغض النظر عن مشروعه وآماله.
ومما له دلالة أن دولة التجزئة الوطنية المصرية في عز سلطانها وقمة عنفوانها لم تستطع الحؤول دون فقدانها جميع مكملاتها ومقتضيات مصلحتها (السودان 1956، سوريا 1961، غزة وسيناء 1967) أمام التآمر الأجنبي وهو ما لا يضاهي في زمن الوحدة التي جسدتها الخلافة الإسلامية إلا أشد عصورها تراجعاً وهزيمة وضعفاً عندما كانت تفقد ولاياتها واحدة تلو الأخرى أمام الاحتلال الأجنبي، ومع ذلك يسجل لدولة الخلافة أنها لم تعترف بكل إجراءات الاستعمار في العالم العربي حتى وقّعت على ذلك وتنازلت عنه تركيا الكمالية (1923)، وكل ما سبق يحسم الخلاف والجدال عن ’’ضرورة’’الدولة القُطرية و’’أهميتها’’، فوقوف المرء في صف متراص مع الإخوة لا يلغي الذات أو يمحوها بل يعزز موقفها ويقويها، والوقوف ’’مستقلاً’’ وحيداً هو الذي يمهد لافتراس المرء وزواله بجعله عرضة لهجوم أي وحش عابر في الغابة التي نعيش فيها.
* لماذا نما بعض الصغار؟
وإن تاريخ التنمية في العالم الثالث بعد مرحلة الاستقلال يؤكد أن عدم التنمية هي القاعدة في الوقت الذي كانت ندرة التنمية هي الشذوذ الذي يثبت هذه القاعدة، ففي الوقت الذي لم ينم 130 بلدا على الأقل، تمثل الاستثناء بكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة وهونغ كونغ وهي مراكز اضطرت الولايات المتحدة واليابان إلى تعزيز اقتصاداتها بعد الحرب العظمى الثانية لاحتواء الشيوعية التي كانت تهدد بسقوط متتال للدول كأحجار الدومينو في تلك المنطقة بعد انتصار الصين الشعبية (1949)، وهو أمر انتهى بسقوط المعسكر الاشتراكي،[105] أما في الشرق العربي الإسلامي فقد كانت مصالح الغرب تعمل الضد مساعدة بلادنا على التنمية أو حتى تركها تنمو وحدها، وقد سبقت الإشارة إلى نوايا السياسة الأمريكية تجاه بلادنا، والغرب يعترف كل يوم بالتزامه بتفوق الكيان الصهيوني النوعي على مجموع العرب فكيف يمكنه الموافقة على تنمية أي قطر تنمية تضارع هذا الكيان قوة وقد رأينا ماذا حدث للتجربتين البعثية في العراق والناصرية في مصر واللتين حُطمتا بقوة السلاح، وأي قُطر يحاول تنمية نفسه منعزلاً عن قضايا المنطقة لن يستطيع ذلك حتى لو ركع للغرب كما فعل كثير من زعماء التغريب (نوري السعيد في العراق والوفد في مصر وبورقيبة في تونس) فلم تنفعهم إيجابيتهم مع الاستعمار قط، بل لقد وصل بعضهم كالوفد (1951) إلى اليأس من سادتهم ومقاومتهم ولكن بعد فوات الأوان، هذا فضلاً عن الزعامات التقليدية المستسلمة ومع ذلك لم تصبح بلادهم كسنغافورة الصغيرة المدعومة، ومن هنا كان القول إن نهوضنا لن يتحقق إلا بتجميع طاقاتنا للتصدي للغيلان العالمية الكبرى.
* الفرق بين انقسامات الأمس الإسلامي وانقسامات اليوم الاستعمارية
إن تشبيه الانقسامات السياسية في تاريخ الإسلام بالتجزئة الاستعمارية فيه كثير من التجني وعدم الموضوعية الذي تكشفه حقيقة أن المسل