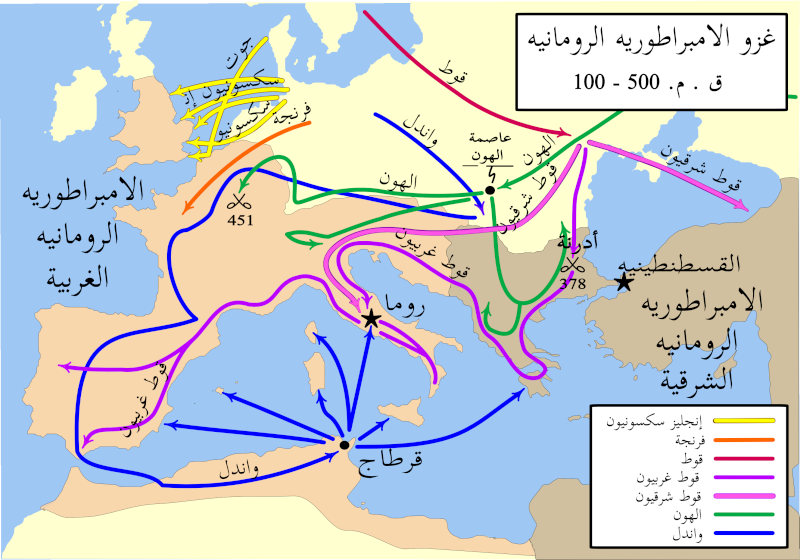مدى مسئولية تاريخنا الحديث عن تخلفنا المعاصر
محمد شعبان صوان
نشأت أجيالنا المتعاقبة على سماع جملة تكررت حتى أصبحت في حكم المسلّمة: العثمانيون هم سبب تخلفنا الحالي، فقد حكمونا أربعة قرون اتسمت بالجهل والركود والظلم، ورغم ما في هذا التعميم الواسع من مفارقة يرفضها البحث العلمي وهي استمرار دولة كبرى لمدة طويلة زادت عن ستة قرون دون أن يكون لديها مقومات ذلك الاستمرار،[1] فلا بأس بفحص هذه ’’المسلّمة’’ وتفكيكها باختصار انطلاقاً من منطقها ثم محاولة الرد عليها لتفنيدها وإثبات عكسها ولكن أيضاً باختصار لأن الرد المفصل قد يستغرق دراسات طويلة جداً ليس هذا هو محلها.
تحتوي ’’مسلّمة’’ السبب العثماني في تخلفنا العربي على ظلمين: ظلم مكاني وظلم زماني.
1- الظلم المكاني هو في حصر ’’الركود والجهل والتخلف’’ في الدائرة العثمانية وحدها في الوقت الذي لم يكن فيه الحال أفضل في بقية العالم الإسلامي خارج النطاق العثماني بل في بقية العالم الثالث، وهذا يقودنا إلى اللغز الذي لم يجد جواباً جامعاً حتى اليوم وهو سبب تقدم الغرب الأوروبي على بقية العالم،[2] مع أن تفاوت المستويات الحضارية هو سنة التاريخ في جميع مراحله منذ بدء التدوين، فلم تمر فترة توحد فيها العالم كله على مستوى حضاري واحد ودائماً كان هناك المتقدم والمتخلف والمتوسط ولهذا فإن زمننا الذي تقدم فيه غرب أوروبا ليس استثناء من مسيرة التاريخ، وتخلف بقية العالم عن مسيرة الغرب اليوم هو أمر لا يتعلق بتخلف الدولة العثمانية وحدها عن الركب الغربي بل يتعلق بتقدم هذا الركب على العالم كله بما فيه العالم العثماني الذي ظل - على عكس صورة الضعف والهزيمة الشائعة- من المراكز النادرة لمجاراة الغرب تقنياً ومقاومته حتى وقت متأخر من العصر الحديث.
2- أما الظلم الزماني فهو يتضمن عدة نقاط:
أ- فتاريخ الإسلام يثبت أن تراجع الحضارة الإسلامية بدأ قبل زمن العثمانيين بكثير على اختلاف بين الباحثين في تحديد بداية هذا التراجع ولكن لا أحد منهم يشير إلى أن الحضارة الإسلامية كانت مشعة حتى أطفأ العثمانيون أضواءها بلمسة يد، بل إن التاريخ يقول إن مجيء الدولة العثمانية أدى إلى ’’إضفاء الحيوية على العالم الإسلامي’’[3] كما تضاءلت أوروبا مقارنة بدولة العثمانيين التي كانت خصماً ’’قد يقزّم بحجمه وتنظيمه وثروته وقوته أي شيء قد يحتشد أمامه. ولربما ظن زعماء بلدان إسبانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، والإمبراطورية الرومانية المقدسة بأنهم جبابرة، ولكن أمام العثمانيين لا يكاد يمكن عدّهم أقزاماً، كما لم تكد تتمكن الأساطيل الإيطالية وفرسان إسبانيا وفرنسا وجنود المشاة من المجر وبولونيا، والنمسا، وبروسيا من تجنب الهزيمة الكاملة. ولكن حتى في القرن الثامن عشر، كدّر ظِل ما وصفوه ب’’الترك الغاشمين’’، أكثر أيامهم إشراقاً على الإطلاق’’.[4]
ب- والنقطة الثانية تقول إن الزمن العثماني شهد محاولات بعث ونهضة نبعت من داخله ولم تستسلم لواقع الضعف والتراجع، وقد سبقت هذه المحاولات المحاولات اليابانية الناجحة بل تفوقت عليها في البداية وكان من الممكن جداً أن تؤدي إلى إحياء المنطقة ونهوضها سواء في ظل الدولة العثمانية أو في ظل دولة منبثقة عنها، ’’ولعله... لو لم تتآمر الدول الغربية على الخلافة العثمانية ثم على محمد علي، لقامت الدولة الإسلامية المركزية بتمويل عملية تصنيع كبرى لا تتخلى بالضرورة عن القيم الدينية الإنسانية’’[5] كما يؤكد المفكر الراحل عبد الوهاب المسيري في رأي تثبته الاتجاهات التصنيعية العثمانية حتى في ظل التراجع الشديد في القرن التاسع عشر (دراسة: الأثر الاقتصادي للتغريب الرأسمالي على المجتمع الإسلامي، بند: المقاومة الصناعية)، ويجمع عليه كثير من المؤرخين وبخاصة فيما يتعلق بنهضة مصر التي يؤكد حتى المتشكك بمآلاتها الصناعية أنه لو توفرت لمصر قيادة ذو عزم واستنارة ولم تقم ضدها القوى الغربية بقيادة بريطانيا بعد محمد علي باشا لكان باستطاعتها إنعاش إمبراطورية عربية تسيطر على وادي النيل والبحر الأحمر والمشرق مع احتمال أن تحل محل الدولة العثمانية بصفتها قوة إسلامية قيادية عالمية،[6] وكانت هذه هي نقطة الاختلاف الحاسمة عن اليابان والتي أدت لفشل هذه المحاولات العثمانية في النهاية وهي أن العثمانيين تعرضوا لقُطّاع الطرق الحضارية من الغرب ووُجد من يتصدى لتجاربهم الفتية ويجهض كل محاولاتهم بما فيها تجربة محمد علي باشا في مصر[7] خلافاً لليابان البعيدة عن الجغرافيا الأوروبية وذلك مما لم يفت بعض الباحثين،[8] وكان السلطان عبد الحميد الثاني قد تنبه مبكراً (1902) إلى أثر هذا الاختلاف في الحال بين الواقعين العثماني والياباني،[9] ولذلك فإن تحميل الجانب العثماني جريرة التخلف فيه تبرئة فاضحة لدور الغرب المعرقل الذي لاحظه كثير من دارسي هذه الحقبة، كما أن فيه إغفالاً واضحاً لإنجازات الدورة الاجتماعية الداخلية في الدولة العثمانية في محاولات الإحياء وهو ما سأشير إليه لاحقاً.
ت- أما النقطة الزمنية الثالثة والأخيرة فهي أن العثمانيين غادرونا منذ قرن تقريباً وفي أثناء هذه المدة بدأت دولة كالاتحاد السوفييتي في البناء من نفس المستوى الذي كانت فيه الدولة العثمانية زمن الثورة البلشفية على القيصرية، وبينما انشغل السوفييت بالعمل والبناء رغم عوائق الغرب وتدخله الفظ في مسيرة الثورة، ظلت بلادنا رازحة تحت نير الاستعمار القديم ثم الجديد مشغولة بالخضوع لأوامر الغرب وحراسة مصالحه لأن تنميتها كانت مرهونة بتوافق مصالحها مع هذه المصالح الغربية في رأي كوكبة كبيرة من زعامات الاستقلال والتجزئة سواء التقليدية التي كانت لا ترى الخير إلا فيما تراه الحكومة ’’البهية القيصرية’’ الاستعمارية، أم القيادات التغريبية التي قادها اقتناعها بالديمقراطية الليبرالية الغربية إلى عدم تصور نجاة بلادنا إلا بها رغم القمع الأوروبي والأطماع الغربية، بل حتى في رأي القيادات الثورية أيضاً والتي نسقت مع دولة كبرى ضد أخرى، هذا مع إلقاء تبعة تردي بلادنا على العثمانيين الذين ذهبوا مع مزاياهم وعيوبهم بعدما قاموا بمحاولة يائسة للتصدي للغرب في الحرب الكبرى الأولى (1914- 1918) والتي كلفتهم سيلاً من الدماء الغزيرة أثناء الدفاع عن بلادنا ومحاولة استرجاع ما احتل منها[10] ولم يتنازلوا حتى الرمق الأخير عما احتله الغرب حتى عما بعُد من هذه البلاد عن مركزهم[11] وظلت الخرائط العثمانية تدرج جميع الأراضي العثمانية المحتلة ضمن أراضي الدولة ولا تعترف بالأوضاع التي أوجدها الاحتلال البريطاني أو الفرنسي أو الإيطالي في مصر والجزائر وتونس والصومال والسودان وأريتريا وعدن وإمارات الخليج إلى أن جاءت أنظمة التغريب فباعت البلاد والعباد بعدما أصرت دول الاستعمار على الحصول على تنازل تركي عن الأملاك العثمانية في معاهدة لوزان (1923)، وبينما وصل السوفييت، وإن بثمن بشري باهظ، إلى قمة العالم في مرحلة قياسية، ظلت بلادنا في قاعه تندب وتولول بسبب حظها العثماني غافلة عن ظرفها الحالي، مما جعلها تدفع أيضاً ثمناً بشرياً باهظاً ولكن ليس في سبيل التقدم بل ضريبة للتبعية والعمالة والاحتلال والاستبداد والتخلف.
تعميمات مخلة عن مجمل العصر الحديث: التتريك والظلم والضعف والركود والجهل والعزلة
1- استعمار وتتريك بأثر رجعي وإعادة تشكيل الماضي وفق رغبات الحاضر: غالباً ما يكون الانطباع العام عن الدولة العثمانية تعميماً مخلاً لما تركته آخر أيامها من انطباعات في ذهنية الأجيال الحديثة، فليس من النادر أن نسمع أنها عملت على تتريك العرب، مع أن هذه كانت سياسة جمعية الاتحاد والترقي بعد سنة 1908، ولو كانت قد انتهجت هذه السياسة منذ أربعمائة سنة لما ظل هناك من يتكلم العربية في بلادنا وبخاصة عند المقارنة بنتائج سياسة الفرنسة التي طبقتها فرنسا في المغرب العربي مدة أقل من ذلك، بل إن هناك من يرى أن عدم انتهاج سياسة التتريك هو ما أدى إلى المآسي التي تعرض لها العثمانيون في القرن التاسع عشر من القوميات المسيحية في أوروبا وروسيا،[12] إذ لو كان العثمانيون قد قاموا بتتريك هذه المناطق وإجبار أهاليها على الرحيل لو رفضوا ذلك لما ظل هناك من يناوئ الدولة وتستعمله الدول الكبرى ضدها في مراحل ضعفها المتأخرة، وفي ذلك يقول المؤرخ مجيد خدوري: ’’ولم يفرض الإسلام نفسه على أتباع الديانات الأخرى، بل كانت الأقليات الدينية، برغم بعض القيود الخاصة بالشرع، تتمتع بحرية واسعة في ممارسة حقوق دينية ومدنية عزت على الأقليات في المجتمع الأوروبي المعاصر، وثابر السلاطنة العثمانيون على تطبيق هذه السياسة في أقاليم أوروبا الشرقية التي احتلوها، فبقيت تسكنها أكثرية مسيحية، ذلك لأن الإمبراطورية العثمانية ورثت الطابع المسكوني الذي يميز المجتمع الإسلامي، فأجازت لغير المسلمين التمتع بحرية دينية واسعة’’، هذا عن العناصر الأجنبية، أما الأتراك والعرب، وهما العنصران السائدان في امبراطورية دينية في جوهرها، فقد وجدا ’’ارتياحاً روحياً في ظل سلاطين أثبتوا أنهم خير ورثة للخلفاء العرب’’.[13]
وقد حظي العرب بمنزلة خاصة داخل الدولة، وعن مكانتهم في الدولة العثمانية، يتحدث المؤرخ زين نور الدين زين في كتاب ’’نشوء القومية العربية’’ عن التعميمات المخلة التي طبعت أفكار الأجيال عن العلاقات العربية التركية في ظل الدولة العثمانية فيقول إنه ’’ليس صوابا القول إن العرب المسلمين ظلوا طوال أربع مئة سنة أمة مستضعفة تحت نير الأتراك، أو إن البلدان العربية نُهبت خيراتها وخيم عليها الفقر من جراء الاحتلال التركي. كذلك ليس صواباً القول إن العرب المسلمين لم يكن يسمح لهم أن يتقلدوا سلاحاً أو أن ينضووا تحت العلم العثماني للخدمة العسكرية، ذلك لأن جيوشاً عربية وضباطاً عرباً من ذوي المراكز العسكرية العالية كانوا يعملون في الجيش العثماني... وقد شغل عدد كبير من العرب وظائف عالية حساسة في الإمبراطورية العثمانية... والواقع إن الأتراك كانوا عندما يتكلمون عن العرب يقولون عنهم (قوم نجيب)، كذلك كان العثمانيون في بادئ أمرهم ينظرون إلى الولايات التي يتكلم أهلها العربية نظرة إكرام لم ينظروا بها إلى سائر الولايات التي دخلت امبراطورية السلطان وذلك لسبب واضح وهو أن سكان الولايات العربية يتكلمون اللغة العربية لغة القرآن الكريم، وأكثرهم كانوا مسلمين’’[14] نقلا عن كتاب المجتمع الإسلامي والغرب للمستشرقين جب وبوون اللذين فندا التعميمات والعبارات الجارفة التي كتبت عن القرون الأولى من الحكم العثماني والتي كان مروجوها يجهلون وفرة الوثائق التاريخية التي يجب أن يطلع عليها الباحث كما كانوا على كثير من التحيز والتعصب كما يقول زين نقلا عن هذين المستشرقين اللذين اعتنقا تلك التعميمات المخلة عن العثمانيين في بداية دراستهما ثم تبدلت آراؤهما بعد عرض الوثائق والمعطيات العلمية ’’تبديلا تاما’’،[15] ومن الظلم أن نعمم فترة التتريك القصيرة التي حكمت فيها جمعية الاتحاد والترقي (1908- 1918) على أربعمائة سنة خلت من ذلك حتى أن رئيس وزراء العراق السابق نوري السعيد الذي اشترك في الثورة العربية على حكم الاتحاديين شهد أن العرب بصفتهم مسلمين كانوا يعدون ’’شركاء للأتراك، كانوا يشتركون معهم في الحقوق والواجبات بدون تمييز عنصري، وكانت الوظائف العليا في الدولة سواء العسكرية أم المدنية مفتوحة للعرب، وقد كان للعرب ممثلون في مجلسي البرلمان العثماني، أصبح كثير منهم رؤساء وزارة، ومنهم من كان شيخ الإسلام ومن أصبح قائداً عسكرياً أو والياً، فكنت ترى الموظفين العرب في جميع دوائر الدولة’’.[16]
وكما مات العرب في حروب الدولة بطريقة رفضها بعض المعارضين لأنها تزج بالعرب في حروب بعيدة عن بلادهم، فقد مات الأتراك أنفسهم أيضاً دفاعاً عن العرب، ومن أمثلة ذلك استشهاد 10 آلاف تركي في معركة خاسرة عندما هجمت فرنسا على الجزائر سنة 1830 كما يقول المؤرخ السوفييتي لوتسكي.[17]
ونجد في آثار الأستاذ أحمد الشقيري أول رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي مثل دولاً عربية في الهيئات والمحافل الدولية تحسراً كبيراً على العهد العثماني ومن ذلك قوله: ’’كان العرب هم العنصر النجيب كما كان يسميهم الأتراك، وفي مدينتي عكا كان الأطفال الأتراك.. يعرفون أنفسهم بأنهم عثمانيون، ولم أسمع أحدا يقول إنه تركي’’.[18]
أما عن اللغة العربية فيؤكد المؤرخ زين ابتداء أن الأتراك لم يحاولوا تتريك الأعراق البشرية التي دخلت ضمن دولتهم،[19] ويورد المؤرخ نفسه دلائل عديدة طبعت الدولة العثمانية بطابعها الإسلامي’’وأظهرت ما كان للغة العربية من شأن عظيم في تلك الامبراطورية’’، فأسماء السلاطين كانت عربية، وأختامهم كان عليها كتابات عربية، ورايات الدولة تتعدد ألوانها وأحجامها ’’لكن هناك أمراً واحداً مشتركاً بينها وهو أن على حواشي الرايات آيات قرآنية عربية مطرزة... فليس في هذه الرايات أثر أو طابع تركي، بل عربي إسلامي’’، ومن هذه الدلائل أيضا أسماء السفن والبواخر العثمانية التي نقشت على لوحات مازال ثلاثون منها في اسطنبول إلى اليوم تحمل أسماء عربية مثل سليمية ومحمودية ومجيدية،[20] وكل ما سبق يتعلق برموز الدولة التي تدل على هويتها ولم يتطرق الحديث إلى إتقان السلاطين اللغة العربية إلى درجة نظم الشعر بها، أما لغة التعليم في الدولة فقد كانت حتى التنظيمات التغريبية (1839) هي اللغة العربية كما يقول الدكتور فاضل بيات في كتابه دراسات في تاريخ العرب في العهد العثماني ويقول أيضاً إنه على الرغم من استخدام العثمانيين اللغة التركية في الأمور الرسمية فإنهم لم يدرسوها في أية مؤسسة من مؤسساتهم بل جعلوا اللغة العربية لغة التعليم في المدارس وظلت لغة التدريس في المدارس الإسلامية في جميع الممتلكات العثمانية طوال العهد العثماني ولم تدخل اللغة الفارسية والتركية فيها إلا بعد سنة 1908.[21]
وكانت القاهرة هي المدينة الثانية في الدولة، فكانت تلي العاصمة اسطنبول مباشرة في الأهمية تليها مدينة حلب، العربية أيضا،[22] ويصف الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم مصر العثمانية بأنها كانت’’محور العلاقات الاقتصادية بين المشرق والمغرب... وهي مركز لعمليات التصدير والاستيراد مع كل من البلدان الأوروبية والإفريقية والآسيوية’’،[23] ويصف المؤرخ روجين روجان وضع حلب داخل العالم العثماني بالقول إن أهلها لم يكونوا يعرفون ’’أن الفتح العثماني سيأتي لمدينتهم بعصر ذهبي يمتد حتى القرن الثامن عشر، تصبح فيه المدينة واحدة من أهم مراكز التجارة البرية بين آسيا ودول البحر المتوسط... وأصبحت من أكثر مدن العالم العربي عالمية’’،[24] فهل احتفى المستعمرون البريطانيون بالقاهرة وجعلوها تلي لندن في امبراطوريتهم، أم هل اهتم الفرنسيون بحلب وجعلوها تلي باريس في الامبراطورية الاستعمارية الفرنسية؟
وسيطول الحديث لو تكلمنا عن مكانة العرب في زمن السلطان عبد الحميد في آخر أيام الخلافة عندما جعلهم مركز مشروع الجامعة الإسلامية وأكثر من رجالهم في المراكز العليا حتى أصبح القصر السلطاني يوصف بأنه تحت سيطرتهم. وقد رفض السلطان عبد الحميد بيع فلسطين لهرتزل تقديراً لتضحيات جنوده السوريين والفلسطينيين في معارك الدفاع عن دولتهم جميعا، وهو ما يوحي بأن التضحيات كانت مقدرة وليس كما حدث عند المستعمرين الذين جندوا أبناءنا في حروبهم العبثية ثم قتلوهم لما طالبوا بحريتهم (مجازر 8 أيار/ مايو/ ماي في الجزائر 1945 مثلاً)، كما انعدم هذا التقدير حتى عند زعامات التجزئة الوطنية، ويقول المؤرخ فيليب مانسل إن ’’عبد الحميد الثاني عمد إلى توفير المال وتركيز الاهتمام على الأقاليم العربية بحيث فضلها على العديد من المناطق التركية’’،[25] وأكد ذلك المشاريع الحيوية التي قام بها وبدأ بعضها بالبلاد العربية قبل الأناضول كسكة الحجاز إضافة لسكة بغداد وتطوير بيروت وحيفا ومعان وتبوك ودرعا وبناء بئر السبع لمواجهة الاحتلال البريطاني في مصر وبناء العمارة والناصرية في العراق قبل ذلك وكلها مشاريع حيوية لو استمرت لأحدثت تطوراً كبيراً للحالة الوحدوية التي كانت تجمعنا ولكن دول الاستقلال والتجزئة العربية أوقفتها أو هدمتها أو عطلتها بالتعاون مع الاستعمار.
كل ما سبق من الحقائق لا يتفق مع مفهوم الاستعمار الذي حاولت بعض الكتابات إلصاقه بالحكم العثماني في البلاد العربية، وأساس هذا المفهوم هو الفصل الحاسم والتناقض الواضح بين حال المستعمِر (المركز) والمستعمَر (الأطراف) في ظل الحكم الاستعماري، لأن إمكانات المستعمَر تكون مسخرة لمصالح المستعمِر فيحصل من ذلك تقدمه وتطوره على حساب المحكوم الذي يصيبه التأخر والتخلف من هذا الاستنزاف.
ولم نجد أن الحكم العثماني فضّل مركزاً تركياً (الأناضول مثلاً) على بقية أنحاء الدولة، بل وجدنا أحياناً تفضيل ’’الأطراف’’ العربية على ’’المركز’’ التركي، كما سبقت الإشارة، والأصح أن وحدة المصير هي التي حكمت تاريخ هذه الدولة، فما أصاب التركي من نِعم أو مصائب أصاب بقية القوميات أيضاً، وفي نهاية الحكم العثماني في الأقطار العربية لم يكن حال الأناضول أفضل من حالها، كما أن الفكرة القومية التي ترفض حكماً من خارج دائرتها لم تكن معروفة حتى أواخر العهد العثماني الذي سيطر فيه الولاء الديني على الولاءات القومية وغيرها،[26] ولهذا يصبح توصيف الحكم العثماني بالاستعمار هو من باب المفارقة التاريخية التي تجمع نقيضين لم يجتمعا في زمن واحد كعبارة التلفزيون الإغريقي أو الهاتف الفرعوني، والدليل الأقوى على ذلك أن معظم أصحاب الشأن، وهم العرب الذين عاصروا دخول بلادهم ضمن الدولة العثمانية ’’نظروا بعين الرضا لوضعهم في ظل الإمبراطورية العالمية التي سادت في ذلك العصر على اعتبار أنهم مسلمون في إمبراطورية إسلامية عظمى’’كما يقول المؤرخ يوجين روجان،[27] ويؤكد المؤرخ السوفييتي نيقولاي إيفانوف ذلك بالقول إن العرب عندما التحقوا بالسلطنة العثمانية ’’لم يشعروا أنهم في وضع الشعوب المحرومة من الحقوق أو المضطهَدة، وحتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر ظلوا يعارضون اعتبار الفتح العثماني استعباداً أجنبياً، وقد أشار أحد أكبر أيديولوجيي القومية العربية الحديثة، المؤرخ السوري المرموق ساطع الحصري في مؤلفاته إلى أن العرب اعتبروا حكم السلاطين العثمانيين استمراراً مباشراً للخلافة الإسلامية وأنهم لم يشعروا بأنهم شعب مستعمَر تابع لسلطة أجنبية’’،[28] وذلك خلافاً لنظرة العرب إلى حكم الاحتلال الأوروبي الذي حل بهم بعد ذلك، وفي توصيف حكم العثمانيين بالاحتلال مزايدة لم يشعر المعنيون بها بالحاجة إليها في زمنهم وهي إسقاط آراء مستقبلية على وضع ماض لم يكن لها مكان فيه، وليّ لعنق التاريخ ليناسب أهواء لحظة معينة تود أن تشكله ليناسب رؤاها وحدها بغض النظر عما حدث فعلاً، فيصبح التأريخ حينئذ ليس مجرد تدوين الحوادث الماضية بأمانة بل إعادة تشكيلها بما يناسب رغبات الحاضر، وهو إجراء يشبه إلى حد ما ما يفعله من يريدون اليوم تقديم الاعتذار للاستعمار الغربي بسبب عدم تفهم أجدادنا لمقاصده الخيرة ومقاومتهم إياه، رغم أن هؤلاء المعتذرين لم يجرءوا، حتى الآن على الأقل، على الزعم أن بلادنا رحبت بالمستعمرين!!
وقد واجهت فكرة الاستعمار العثماني معضلة كبرى كان لا بد من حلها وهي طول فترة الحكم العثماني للبلاد العربية، وكان سكوت العرب طوال أربعمائة سنة مدعاة لإحراج أصحاب هذه الفكرة[29] فكانوا بين خيار رفض هذا الواقع ومن ثم تخيل البديل في ’’قرون من المقاومة العربية’’ لا توجد إلا في خيالهم الذي حوّر الطموحات الشخصية لبعض الزعماء المحليين - وكثير منهم من غير العرب[30] - لتصبح هبّات ثورية قومية، ولم يجيبوا على تساؤل كيف أمكن لدولة ضعيفة معزولة راكدة، كما وصفوها، التغلب على مقاومة الجماهير الكاسحة في وقت لم تستطع أقوى الامبراطوريات الحديثة الاستمرار في حكم قطر من الأقطار الثائرة لهذه الدولة الشاسعة، وهو الجزائر، أكثر من 132 سنة، وهي أطول مدة استعمارية لقطر عربي؟ أما الخيار الثاني أمام أنصار فكرة الاستعمار العثماني فهو القبول باستكانة الجماهير العربية لعبودية هذا الاستعمار ووصم أمتهم بالخضوع الذليل هذه المدة الطويلة.
ولأن هذين الخيارين غير تاريخيين اتجه أصحاب بعض الرؤى القومية، بل والماركسية أيضاً، التي تتسم بالواقعية التاريخية، أي بفهم التاريخ كما حدث لا كما ترغب الأيديولوجيات، إلى عدم إسقاط العناوين الجاهزة على حوادث مغايرة لأصولها، والاعتدال في النظر إلى هذه المرحلة التاريخية وعدم الحماس لوضعها داخل القوالب الجاهزة للفكر المستورد، مع بذل الجهد في محاولة تعديله وفقاً لمتغيرات تاريخنا، ذلك لأن إغفال السياق التاريخي لنشوء الدولة العثمانية ومحاولة فهم الحوادث فيها انطلاقاً من معايير قومية أوروبية ’’أحدثا اضطراباً في تحليل كثير من المؤرخين العرب’’ كما يقول المفكر العربي الأستاذ فكتور سحّاب،[31] وقد حدث ذلك في مرحلة تميزت بسيادة النقل العام عن الشرق والغرب دون محاولة تعديل الأفكار لتلائم تغيرات الواقع.
ولعل أبرز الأصوات القومية في هذا المجال هو الأستاذ أحمد الشقيري الذي رفض وصف الحكم العثماني بالاحتلال أو الاستعمار وأبرز مزاياه للعرب مقارنة بما حل بعده من انتداب وتجزئة وأكد أن الأمة العربية ابتهجت بانتقال الخلافة الإسلامية إلى العثمانيين الذين كانوا يمثلون القوة والمنعة والنصر للإسلام، وأن العرب تعاطفوا مع هذه الدولة ورضوا بوضع الخلافة بين يديها وتناسوا الشرط الديني بأن يكون الخليفة عربياً قرشياً لأن الانتصارات العثمانية تحت راية الجهاد لم تترك مجالاً للنقاش حول مؤهلات الخليفة وشروطه، وأن الدولة العثمانية كانت دولة مشتركة وليست هيمنة أحادية ولهذا أحس العرب أنها دولتهم وخلافتهم وتمتعوا فيها بمزايا المشاركة في الحكم والتمثيل وحرية التنقل، بل إنه ذهب إلى وصفها بأنها آخر تجليات الوحدة العربية وأن عاصمتها اسطنبول كانت عاصمة لوحدة العرب، وأن سير الحوادث كان من الممكن أن يتجه إلى الأفضل لولا حكم جمعية الاتحاد والترقي الذي فصل بين الشعبين.[32]
وعلى الضفة الماركسية ينحو القائد الشيوعي الفلسطيني إميل توما إلى تحليل غير مقيد بالإملاءات المستوردة ويقول عنه الأستاذ سحّاب إن ’’توما الماركسي التقليدي، يدهشك بموقف من الدولة العثمانية، لم يدركه معظم الكتاب القوميين، وهو أن الدولة العثمانية ليست حكماً أجنبياً بالمعايير الذاتية لسياق الدولة الإسلامية التاريخي... غير أن توما، وهو يؤكد هذا الأمر بشجاعة وحصافة فكرية، توقف عند هذا، ولم يوغل في الاستنتاج المترتب على هذا القول، وهو أن كثيراً من القيادات القومية العربية، بل إن كثيراً من الأفكار القومية العربية يحتاج إلى إعادة نظر وتقويم في ضوء هذه الحقيقة التاريخية، وهي أن السلطنة العثمانية لم تكن استعماراً بالمعنى الذي نعرفه اليوم للاستعمار الأوروبي، ولا كانت حوافز الحركة القومية آنذاك حوافز تستحق الإكبار الذي تستحقه منا اليوم حركة التحرير الاستقلالية الذاتية غير الموحى بها لمصالح أجنبية معينة’’،[33] وتصل المفارقة قمتها عندما يصف ورثة توما الفلسطينيون الدولة العثمانية بالاحتلال العثماني في نفس الوقت الذي يصادقون فيه على ’’حق’’ الكيان الصهيوني في معظم أرض فلسطين ولا يصفونه بالاحتلال، ولو مجرد وصف لفظي خال من التبعات العملية!!
2- الضعف والجهل والدمار والركود في أقوى دولة في العالم: وكما كان الانطباع الخاص بالتتريك مخلاً فكذلك كانت الانطباعات الخاصة بالضعف والجهل والهزيمة والتراجع تعميمات نسيت أن الدولة العثمانية كانت ’’من أعظم الإمبراطوريات في التاريخ وأكبرها وأطولها عمراً’’، وما من شك أنها كانت سنة 1500 ’’أقوى دول العالم ربما باستثناء الصين’’، وقد أثرت في مستقبل وأوضاع دول عديدة في الشرق والغرب مثل دولة المماليك والدولة الصفوية، وإمبراطورية الهابسبيرغ وروسيا القيصرية إلى زوال الحكم الملكي فيهما في بداية القرن العشرين، وقامت أيضاً بدور في السياسة الدولية بعد تحولها إلى ’’قوة مرهوبة الجانب إلى درجة أن فيليب الثاني ملك إسبانيا دعا إلى حرب صليبية لإيقاف المد العثماني’’كما يقول المؤرخ البريطاني الأمريكي دونالد كواترت،[34] فقد سيطرت على ثلاثة بحار كبرى (الأبيض والأسود والأحمر) وما بينها وما يحيط بها من أراض، وأن ’’العرب وجدوا أنفسهم جزءاً من أعظم وأقوى امبراطورية إسلامية عُرفت منذ ظهور الإسلام’’ وأنه ’’يصح القول بأن الحكم العثماني حمى الأقطار العربية والإسلام من التعدي الخارجي قرابة أربعمائة سنة’’ وفقاً للمؤرخ العربي زين نور الدين زين[35] والدكتور فهمي جدعان[36] والدكتور أحمد شلبي،[37] وأن هذه الدولة ’’أعظم إمبراطورية إسلامية في العالم في ذلك الوقت’’ في تقدير المؤرخ البريطاني يوجين روجان،[38] ووصفها المؤرخ الفرنسي أندري كلو بأنها كانت ’’إمبراطورية الإمبراطوريات’’في زمن السلطان سليمان القانوني،[39] وأنها كانت عند وفاته ليست الأقوى بعدتها وعددها عسكرياً وحسب، بل وبامتداد أراضيها، وبثروة عاهلها، وأيضاً بعدد سكانها الذي جعلها الأولى بين أمم أوروبا (35 مليوناً مقابل 5 ملايين لإنجلترا و7 ملايين لإسبانيا و12 مليوناً لإيطاليا و18 مليوناً لفرنسا) وجعل عاصمتها الأولى كذلك بين عواصم أوروبا ويزيد عدد سكانها بضعف على أكبر المدن الأوروبية، وتؤلف قلباً لشبكة ’’لا خلل فيها من إدارة وجيش لم يوجد أحسن منهما في ذلك العصر’’.[40]
ويصف المستشرق البريطاني الأمريكي الصهيوني برنارد لويس (*) حالها بالقول إنه قد ’’رافق توسع الامبراطورية وقوتها العسكرية اقتصاد متين، وإدارة دقيقة، وثقافة غنية رفيعة، وأصبحت استنبول العاصمة الآخذة في التطور منذ عهد أسلاف سليمان ’’المدينة الأم’’ الواسعة المزدهرة، وبمثابة مغناطيس لأصحاب الطموح والمواهب، وازدحم فيها الشعراء، والعلماء، والفنانون والمهندسون، والإداريون، ورجال الدين من جميع أنحاء الامبراطورية وما ورائها، وأسهم كل هؤلاء في إعطاء الحضارة العثمانية الجديدة طابعها المتميز الخاص، وبلغت هذه الحضارة في عهد سليمان وتحت رعايته الخاصة إلى حد كبير أرقى مدارجها وتحققت أعظم إنجازاتها... وظلت الإمبراطورية العثمانية بعد وفاة سليمان بأكثر من قرن قوة جبارة. وكانت قادرة في سنة 1683 أن تقوم بالحملة الثانية العظيمة على فيينا’’،[41] ويؤكد المؤرخ البريطاني بيتر مانسفيلد ذلك بالقول إن اسطنبول كانت ’’من أروع المدن في العالم وملتقى الحضارات الغربية والشرقية’’، وهو ما يقوله أندري كلو أيضاً إذ أنها ’’أعظم مدينة في الشرق والغرب’’،[42] ويتابع مانسفيلد إن الدولة العثمانية ظلت بعد أوج مجدها زمن السلطان سليمان بأكثر من مائة وخمسين عاماً تالية ’’قوة عظيمة قادرة على أن تغرس الفزع والرهبة في نفوس البابوات المتعاقبين، وفي أرجاء الولايات المسيحية لأوروبا الغربية خشية أن تقوم باجتياح تلك الولايات ثانية... وحتى عام 1683م، لم يكن أحد في أوروبا ليصدق أن المسلمين لن يعودوا ثانية، وقد مر وقت طويل حتى اقتنع فيه الأوروبيون أن الخطر العثماني قد ولى إلى غير رجعة’’،[43] ويقول المؤرخ البريطاني بيري أندرسون إن ’’حمية وضخامة وبراعة قوات السلطان جعلتهم قوة لا تغلب في أوروبا لمدة مائتي عام’’ منذ فتح القسطنطينية.[44]
وعن الاقتصاد العثماني في الفترة ما بين منتصف القرن السادس عشر ومنتصف القرن الثامن عشر تقول المؤرخة ثريا فاروقي إن ’’الأقاليم العثمانية كانت تتمتع بالاكتفاء الذاتي في السلع الضرورية اليومية والمواد الحربية’’، وإن الدولة كانت ’’لا تزال قادرة على الأداء بدون استيراد تلك البضائع الاستهلاكية التي يحتاج إليها غالبية السكان مثل الحبوب والمواد الغذائية الأخرى، وكان يتم تصنيع الحديد والنحاس والأقمشة وكل الأشياء اللازمة للاستعمال اليومي بكميات كافية داخل الأقاليم التابعة للسلطان، أما فيما يتعلق بالمواد الحربية فقد كان العثمانيون مكتفين ذاتياً إلى حد كبير’’، وقد وصف المؤرخ فرنان بروديل البلاد التي حكمها السلاطين العثمانيون بأنها ’’اقتصاد عالمي’’ قائم بذاته بفضل السلام العثماني جزئياً وهو ما يعني أنها لم تكن وحدة سياسية فقط بل منطقة يسهل التبادل التجاري بين أقاليمها.[45]
ويقول المؤرخ أندرسون إن الولايات الآسيوية في الدولة العثمانية شهدت’’انتعاشاً وتقدماً ملحوظين أثناء ذروة الجبروت التركي في القرن السادس عشر، وفي حين بقيت الروملي (شرق أوروبا العثماني) المسرح الرئيس للحرب لجيوش السلطان، فإن الأناضول وسوريا ومصر تمتعت بفوائد السلام والوحدة اللذين حققهما الفتح العثماني في الشرق الأوسط، إن عدم الاستقرار، الناجم عن انحلال دول المماليك في المشرق، قد حلت محله إدارة مركزية قوية، قضت على قطاع الطرق ونشطت التجارة الداخلية، ووضع حد للركود الاقتصادي في سوريا ومصر، والناجم عن الغزو والطاعون في أواخر العصر الوسيط، ذلك بانتعاش الزراعة وزيادة السكان.. كان النمو السكاني ملحوظاً.. وازدهرت التجارة..’’.[46]
كما وصف المؤرخ الأمريكي زاكري كارابل الدولة العثمانية بأنها ’’دامت قرابة خمسمئة سنة، فكانت أطول الدول عمراً باستثناء عدد قليل من الأسر الحاكمة التي عرفها العالم’’،[47] ووصف المؤرخ البريطاني جاسون غودوين العثمانيين بأنهم ’’سادة الآفاق’’ وأن دولتهم كانت ’’أعجوبة في الحيوية، قوية جداً ومنظمة جداً، معجزة من معجزات العبقرية الإنسانية التي جعلت معاصريها يشعرون أنها مؤيدة بقوى غير بشرية، سواء شيطانية أو إلهية حسب وجهة نظر كل مراقب منهم’’،[48] وقد وصفها أحد معاصريها هو مؤرخ العثمانيين لدى الملكة إليزابيث الأولى الإنجليزي ريتشارد نولز في كتابه تاريخ الترك (1603) الذي صدر فيما بعد بإضافات السير بول رايكوت (1687): ’’في الوقت الحاضر، إذا اعتبرت قيام هذه الإمبراطورية العثمانية وتقدمها، فإنك لن تجد في هذا العالم أمراً يثير الإعجاب والدهشة أكثر مما تثيره هذه الإمبراطورية، وإذا اعتبرت عظمتها وشهرتها المتألقة فإنك لن تجد شيئا يضاهي هذه العظمة وهذا التألق، وإذا نظرت في قوتها ومضائها فإنك لن تجد ما يفوقها رهبة وخطراً... هذه الإمبراطورية التي تهزأ بالدنيا (المعادية) وترعد فتمطرها دماً وخراباً، وهي شديدة الاقتناع بأنها ستسود العالم بأسره، وبأنها هي التي ستضع حدوداً لملكها، ولن تكون هذه الحدود إلا أقاصي المعمورة من مشرق الشمس إلى مغربها’’،[49] وفي الزمن المعاصر وصفها المستشرق الفرنسي جان سوفاجيه بأنها ظلت طوال القرنين السادس عشر والسابع عشر ’’دولة من أعظم دول الغرب وأقواها، إن لم نقل أعظمها وأقواها على الإطلاق.. فقد كانت مساحتها تبلغ بضعة ملايين من الكيلومترات المربعة، وكانت مصادر ميزانيتها أعظم وأثبت من مصادر أية دولة أوروبية أخرى بما في ذلك إسبانيا ومعادن الذهب فيها، وكانت إدارتها الحكومية منظمة تنظيما محكماً تهدف إلى توفير الخير العام، وكانت تثق بولاء شعبها وإخلاصه لها... أما جيشها النظامي فقد كان أحسن الجيوش تدريبا وكانت مدفعيتها أحسن مدفعية تملكها أية دولة وكان أسطولها يسيطر على البحر الأبيض المتوسط كله، فكان السلاطين يفرضون على الدول الأوروبية أن تحسب لدولة قوية كدولتهم حسابها..’’ كما جاء في كتابه مقدمة تاريخ الشرق الإسلامي (1943)[50] ويؤيد مؤرخون آخرون هذا الكلام،[51] وكثيراً ما وصف الجيش العثماني في أوروبا بأنه الجيش الذي لا يُقهر.[52]
وفي الوقت الذي كان فيه بناء أسطول يقتضي وقتاً طويلاً وجهوداً مالية كبرى عند الغرب الأوروبي، كانت بضعة شهور كافية للعثمانيين ’’لوضع عدة مئات من السفن في الأحواض ودفعها إلى البحر’’.[53]
3- العزلة والستار الحديدي الخيالي: يرد المؤرخ دونالد كواترت على تهمة’’الستار الحديدي’’ التي استعارها بعض المؤرخين لوصف عزلة الدولة العثمانية في علاقاتها الخارجية، ويؤكد أن ’’هذا القول يجانب الحقيقة’’، وأنه كان هناك تبادلاً ’’دبلوماسياً وثقافياً واقتصادياً بين الدولة العثمانية وجيرانها الأوروبيين’’، مستدلاً على ذلك بالاتفاقيات والمعاهدات التي تم عقدها والتي وصل عددها بين 1703- 1774 إلى ثمان وستين، وخلص إلى القول إن ’’الستار الحديدي المزعوم لم يكن له وجود’’.[54]
ويفصل الأستاذ الدكتور عبد العزيز الشناوي القول في ذلك فيقول إن العثمانيين فتحوا أراضيهم للعلاقات الاقتصادية مع جوارهم فكان لكل من مصر والشام علاقات تجارية مع أوروبا وكان للعراق علاقات مع إيران والهند وأوروبا، ولفت نظره أن ’’الدولة العثمانية، وهي الدولة السنية والمدافعة عن المذهب السني في العالم الإسلامي، قد يسرت السبل امام شيعة فارس والهند وأفغانستان وغيرهم لزيارة العتبات المقدسة، وكانت في تصرفاتها مثالاً يحتذى في الترفع عن سياسة التعصب الديني والمذهبي’’، نافياً أن يكون الحصول على إيرادات الزيارة هو دافعها لذلك لأنها لم تكن تؤلف دخلاً كبيراً للحكومة ’’وكان في مقدور السلطات العثمانية في العراق الاستعاضة عن مثل هذه المبالغ (أقل من خمسة آلاف جنيه استرليني لسنة 1889 وأقل من عشرة آلاف جنيه في السنة التالية) بتدبير موارد مالية أخرى لخزانة الحكومة’’.[55]
4- الظلم الذي يستقطب المؤيدين ويجتذب المهاجرين: أما عن فرية الظلم فتعج كتب المؤرخين بما يدحضها، ففي حديثه عن خصائص الحكم العثماني في العصر الأول (من الفتح في القرن 16 إلى القرن 19) في البلاد العربية يقول الدكتور محمد أنيس إن ’’ نظام الحكم العثماني في الشرق الأوسط بصفة عامة كان عملياً للغاية ولم يكن ظالماً أو عنيفاً... وكانت القاعدة أن كل إيالة تعيش على دخلها الخاص وتدفع إلى خزانة الدولة قدراً معقولاً جداً من الجزية ولذلك لم يكن التشريع الضرائبي العثماني مرهقاً لرعايا الدولة. فالسلاطين العثمانيون أدركوا أن الضرائب البسيطة وأساليب الإدارة البسيطة في صالح كل من الحكام والمحكومين’’، وعند حديثه عن المساوئ التي ارتكبها الحكم العثماني كالنزاع بين الأحزاب وتعدي الهيئات المحلية على الحكومة المركزية قال مستدركاً: ’’ولكن رغم هذا فإن الإدارة العثمانية المالية كانت أمينة إلى حد معقول، كما أن الفلاحين لم يعانوا ما عانوه من حكم دول قبل وبعد العثمانيين ’’، وعند حديثه عن بقية المساوئ كالمحسوبية والرشوة وبيع الوظائف قال إن مجتمعات الشرق الأدنى كانت على شفا الانهيار قبل دخول العثمانيين مباشرة ’’إلا أن دخول العثمانيين أخر هذا الانهيار، فقد سار العثمانيون على نظام ضرائبي مخفف فأنقذوا الفلاحين والتجار وبسطوا حالة من الأمن والاستقرار تمتع بها الشرق الأدنى حتى النصف الثاني من القرن الثامن عشر’’،[56] ويقول برنارد لويس إنه في البلاد العربية ’’جلب الحكم العثماني السلام والأمن بعد الكابوس العنيف للحكم المملوكي الأخير’’.[57]
ويذهب المؤرخ السوفييتي نيقولاي إيفانوف إلى ما هو أبعد من ذلك بالقول إن سمعة العثمانيين كانت ’’في الأوج عند مطالع القرن السادس عشر، ففي الشرق كما في الغرب على حد سواء ازداد الإعجاب بالعثمانيين ولا سيما في الأوساط الشعبية المضطَهَدة والمستغَلة’’، وينقل عن المؤرخ الروسي كريمسكي من بداية القرن العشرين قوله إنه في البلقان والمجر وأوروبا الغربية وروسيا ’’برزت مجموعات كبيرة من الناس، كانت بأفكارها ومشاعرها، وبدرجات متفاوتة، لا تخاف غزوات العثمانيين وفتوحاتهم بل تدعو إليها صراحة’’، وأما في العالم العربي ’’فقد وقف الفلاحون إلى جانب العثمانيين’’، ومع أن هذا التعاطف الشعبي استند إلى المبالغة في تصور الكمال لدى المجتمع العثماني فإنه ’’في الواقع، لم تكن النظم العثمانية الاجتماعية الطوباوية (أي المثالية) مجرد سفسطة كلامية، بل كانت أساساً للعمل’’، وعلى أساس الشعارات العثمانية التي تمكنت ’’وبقدرة سحرية من استقطاب مشاعر الفلاحين وجماهير سكان المدن... بنيت على قاعدتها النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للباب العالي بخاصة قراءة فلاحية فريدة من نوعها للمبادئ الأساسية للإسلام وأفكاره عن المساواة، والأخوة بين الجميع، والعدالة الاجتماعية، والوفاق، والعمل كمصدر وحيد لتلبية الحاجات المادية للإنسان، وإدانة مظاهر الترف والإثراء، وضرورة التواضع في العيش والابتعاد عن الإسراف، وتحاشي استغلال الإنسان للإنسان’’، ويؤرخ ذلك إلى مطلع القرن السابع عشر.[58]
ويؤيد كلام برنارد لويس ما قاله إيفانوف ويتحدث عن الهجرة بصفتها اقتراعاً بالأقدام وكانت وجهتها الدولة العثمانية في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، أي من الغرب إلى الشرق وليس العكس الذي يحدث في أيامنا، ولم يكن اللاجئون المسلمون واليهود هم وحدهم المستفيدين، بل استفاد المسيحيون من أصحاب الانشقاقات الدينية والسياسية، ولم يكن كل أولئك أيضاً هم المستفيدين الوحيدين من الحكم العثماني ’’إذ أن الفلاحين في المناطق التي غزيت قد تمتعوا، بدورهم، بتحسن كبير في أوضاعهم، فقد جلبت الحكومة الامبراطورية العثمانية الوحدة والأمن مكان الصراع والفوضى، كما ترتبت على الغزو نتائج اجتماعية واقتصادية هامة’’، ويقول إن الإمبراطورية العثمانية كانت ذات سحر قوي إضافة إلى كونها عدواً خطراً’’فقد كان المستاءون والطموحون ينجذبون إليها بالفرص التي تتاح إليهم في ظل التسامح العثماني، وكان الفلاحون المسحوقون (في أوروبا) يتطلعون بأمل إلى أعداء أسيادهم’’ وحتى القرن التاسع عشر ’’كان الأوروبيون الذين يزورون البلقان يعلقون على أوضاع فلاحي البلقان الحسنة وعلى رضاهم عن هذه الأوضاع، وكانوا يجدونها أفضل من الأوضاع السائدة في بعض أنحاء أوروبا المسيحية، وكان الفرق أوضح بكثير في القرنين الخامس عشر والسادس عشر’’... ويقارن بين الحكم العثماني والحكم الأوروبي بقوله: ’’وعندما انتهى الحكم العثماني في أوروبا، كانت الأمم المسيحية التي حكمها العثمانيون عدة قرون لا تزال هناك، بلغاتها وثقافاتها ودياناتها وحتى إلى حد ما بمؤسساتها، كل هذه الأمور بقيت سليمة وجاهزة لاستئناف وجودها الوطني المستقل، أما إسبانيا وصقلية فليس فيهما مسلمون أو ناطقون باللغة العربية’’،[59] ويستنتج كواترت من تتبع الازدهار الاقتصادي في البلقان عشية انفصال بلاده عن الدولة العثمانية وتردي أحوال هذه البلاد بعد انفصالها، أننا لا نستطيع أن نعزي ظهور الحركات الانفصالية في البلقان إلى تردي أحواله الاقتصادية في ظل العثمانيين.[60]
ويتحدث المستشرق الفرنسي الماركسي مكسيم رودنسون عن موضوع الهجرة إلى الأراضي العثمانية طلباً للتسامح فقال: ’’لجأ أتباع مذهب كالفن في هنفاريا وترنسيلفانيا وبروتستانت سيليزيا وقدماء المؤمنين من قفقاس روسيا، إلى تركيا وتطلعوا إلى الباب العالي في هروبهم من الاضطهاد الكاثوليكي أو الأرثوذكسي، وذلك مثلما فعل اليهود الإسبانيون قبل ذلك بقرنين’’.[61]
ويؤكد أندري كلو ما سبق بالقول إن ’’دهاء العثمانيين كان يتمثل في حكمهم الناس بالعدل والاعتدال’’، وإن أقنان أوروبا لم يكونوا يخفون أحياناً ترحيبهم برايات النبي (عليه الصلاة والسلام)، لأن ’’حال الفلاح في الإمبراطورية العثمانية أحسن من حال سكان الأرياف في أوروبا، ويشهد على ذلك أولئك الغلاظ الشداد في بلاد النصارى الذين يهربون إلى دار الإسلام بعد إحراق الدور والضيعات، انتقاماً من ظلم سيدهم، وتشهد على ذلك حفاوة الأهالي عند اقتراب جند السلطان’’، وفي المجر كان القرويون في بؤس شديد دفع كثيراً منهم لانتظار الأتراك وعدهم محررين، وإن الاحتلال التركي يسر على السكان في البلقان وبلغاريا ما كانوا يلاقونه من جبروت الإقطاعيين البلغار والصرب وظلم الهيئات الدينية،[62] وفي تقديمه لكتاب كلو عن السلطان سليمان القانوني يقول الأستاذ البشير بن سلامة إن السلطنة العثمانية اشتهرت بالنزوع إلى العدل وكان شعار السلاطين هو: ’’لا دولة بدون جيش، ولا جيش بدون مال، ولا مال بدون رعايا راضين، ولا رعايا بدون عدل، إذ بدون عدل لا وجود للدولة’’ فكان العدل قضية عملية محورية ترتبط بسيادة الدولة[63] وليست مجرد شعار نظري.
ويؤكد بيري أندرسون أن الدولة العثمانية لم تحاول فرض الإسلام على المسيحيين في البلقان، وأن الفلاحين البلقانيين ’’وجدوا أنفسهم فجأة وقد تحرروا من الخضوع المهين والاستغلال الأرستقراطي في ظل حكامهم المسيحيين، وانتقلوا إلى وضع اجتماعي كان في معظم النواحي أكثر راحة وحرية منه في أي مكان في أوروبا الشرقية آنذاك’’، وأن الحكم العثماني قضى على طبقة النبلاء المحلية وأزال لعنة الحروب الأرستقراطية المتواصلة في الريف.[64]
ومن الصفات الفريدة التي تحلى بها الحكم العثماني ما رواه السفير النمساوي في بلاط السلطان سليمان جيسلان دي بوسبك (1555- 1562) الذي بهر برعاية العثمانيين للمواهب واهتمامهم باجتذابها وتنميتها حتى أصبح كل إنسان يعتمد على مجهوده ويفخر بأنه وصل إلى المعالي بقدراته الذاتية رغم تواضع أصله مما حرم عديم الشرف والجاهل والكسول والعاطل من تبوء المناصب الرفيعة، ’’وهذا هو السر وراء نجاح العثمانيين في كل عمل أقدموا عليه، فتحولوا إلى جنس ساد العالم كله، واتسعت رقعة أراضيهم إلى هذا الحد’’،[65] في الوقت الذي كانت فيه أوروبا، كما يصفها، تعتمد الأحساب والأنساب في تقويم البشر، وكانت تهتم برعاية مواهب الحيوانات أكثر من مواهب الرجال.[66]
5- الاستبداد السياسي كان مقيداً: نبعت تهمة الظلم الذي لف القرون العثمانية من صفة الاستبداد السياسي التي طالما ألحقت بالحكم العثماني وقد تطرقت إليها في دراسة سابقة (أثر التغريب السياسي على المجتمع الإسلامي/1) وملخص ما جاء فيها أن سلطة السلطان حددت بسلطات أخرى حكمت رقعة الدولة، وأضيف هنا ما قاله مجموعة من المؤرخين عن تحديد سلطة السلطان العثماني بالشرع الإسلامي الذي يحكم جميع المسلمين ويؤلف قاعدة البناء السياسي والاجتماعي للدولة ويخضع له الجميع وهو من ضمنهم، ولهذا يستنتج برنارد لويس أن السلطان ’’لم يكن مستبداً حقيقياً’’،[67] ويؤكد كارابل الناحية نفسها وهي أنه رغم سلطات السلطان الواسعة ’’كان هو نفسه مقيداً وخاضعاً للشرع الإسلامي كأي واحد من المسلمين، وكغيره ممن سبقه من الحكام، راعى السلطان العلماء والقضاة واحترمهم’’.[68]
6- الإقطاع مجرد اشتراك لفظي: استخدمت كثير من المؤلفات التاريخية صفة الإقطاع سيئة الصيت والمستعارة من الواقع الأوروبي لوصم الحياة الاقتصادية في الدولة العثمانية وللاستدلال على الظلم الذي كان يلف أرجاءها استناداً إلى الاشتراك اللفظي مع الإقطاع الأوروبي، وليس هنا مجال تفصيل حقيقة الإقطاعات العثمانية ولمن كانت تمنح، فما يهمنا هو اختلاف النظام العثماني جذرياً عن الإقطاع في أوروبا، وفي ذلك يقول إيفانوف إن العثمانيين قاموا بتصفية الإقطاع وغيره من أشكال الملكية الإقطاعية التي كانت سائدة منذ أيام الموحدين والأيوبيين ونقلوا الأراضي إلى ملكية الدولة التي أعطتها للفلاحين الذين ألغيت كل التزاماتهم الإجبارية المفروضة عليهم تجاه أصحاب النفوذ،[69] وكان صاحب الإقطاع، وفقاً لأندري كلو ’’ليس له أي حق في السيطرة على الفلاح ومقاضاته، فله مجرد حق الشرطي المرتبط بالقاضي الذي بدون قراره لا يمكن له اتخاذ أي إجراء قهري’’،[70] ويلاحظ بيري أندرسون أن الفرسان العثمانيين ’’لم يمارسوا أية سيادة إقطاعية على الفلاحين الذين كانوا يعملون في تيماراتهم (أي إقطاعاتهم)’’، وفي الوقت الذي كان فيه الفلاحون يتوارثون إجارة القطع التي يحرثونها، لم يكن هذا الامتياز ممنوحاً للفرسان الملاك الذين لم يكن من سلطتهم أيضاً تغيير الضرائب وفق مشيئتهم وكان أمر تحديدها منوطاً بالباب العالي،[71] كما غابت القنانة قانونياً من الولايات العثمانية،[72] ولكل هذا لم تظهر طبقة إقطاعية وراثية في الدولة العثمانية إلا بعد إجراءات التغريب في القرن التاسع عشر.
*****
ومن نافل القول أن كل هذه الحقائق لا تتفق مع سيادة الظلم والضعف والركود والجهل وبقية الصفات السلبية التي طبعت الأذهان عن مجمل تاريخ الدولة العثمانية والتي لم يكن لها أن تصمد في وجه أوروبا القوية قروناً لو كانت هذه هي صفاتها، وربما كانت هذه الصفات أقرب إلى أوضاعها في آخر أيامها، وليس من أهدافي أن أنفي أي عيب عن فترة الحكم العثماني، فقد تعرض المثل عند تطبيقه للانحدار والفساد والبعد بدرجات متفاوتة عن المثل العليا مثل أي تاريخ بشري لا سيما إذا استمر طويلاً، وقد كتب الكثير عن هذه العيوب وليس هناك داع لتكرارها، وهدفي الواضح هو أن أنفي أن القرون العثمانية طبعت جميعها بالصفات السلبية التي ناقشتها والتي يحمّل تخلفنا المعاصر على أكتاف طول استمرارها.
ومع ذلك فقد تميزت المراحل العثمانية الأخيرة بمقاومة ملحمية لظروف الضعف والإنهاك التي تمكنت منها، ’’وكان السلطان العثماني يحاول جاهداً الاحتفاظ بما عنده’’ رغم أنه ’’لم يكن في وضع يسمح له بفرض الحدود على أي كان’’،[73] وظلت الدولة العثمانية ’’تكافح لإصلاح ذاتها والحفاظ على وجودها دولة حديثة، اضطرت في البداية إلى أن تستنزف مواردها المحدودة لتحمي شعبها من القتل على يد أعدائها، ثم إلى أن تحاول أن تقدم الرعاية للاجئين الذين تدفقوا إلى الامبراطورية عندما انتصر هؤلاء الأعداء’’،[74] وكان لها حضور أيضاً في ساحة الإنجازات.
إنجازات آخر أيام الخلافة
لقد كتب الكثير عن مظاهر الضعف والتراجع في آخر سني الدولة العثمانية، ولكن الخلافة حققت إنجازات كبرى في آخر أيامها رغم كل ذلك، وقد تمتعت بلادنا العربية في ظلها بآخر مظاهر وحدتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي لم تستطع الدول التي نشأت بعدها وفقا لاتفاقيات التجزئة كسايكس بيكو (1916) والحكم الثنائي (1899) والعقير (1922) حتى مجرد العودة إلى هذه المظاهر فضلا عن تحقيق ما هو أفضل منها:
فعلى الصعيد السياسي قاومت الخلافة في زمن السلطان عبد الحميد مشاريع التفتيت الغربية، بفكرة الجامعة الإسلامية التي استهدفت التصدي للعدوان الغربي على المسلمين ولهذا أصبحت غولاً مرعباً لأوروبا بتعبير بعض المؤرخين، وقد نتج عن تبني هذه الفكرة أن ظلت الهوية الجامعة هي التي تلم شعث عناصر الدولة المختلفة ولم تظهر الانقسامات القومية إلا بعد خلع السلطان ومجيء القوميين الاتحاديين إلى الحكم 1908- 1909، وقد دعم السلطان هذه الفكرة بمشاريع حيوية كسكة حديد الحجاز التي بنيت بأموال المسلمين دون اللجوء إلى الديون الأجنبية وعدّتها بريطانيا مناهضة لمصالحها فعملت على تعطيلها ثم تدميرها فيما بعد ومازلنا عاجزين عن إعادة تشغيلها كما كانت، كما دعم السلطان فكرته الإسلامية بتقريب العرب - أهل لغة القرآن- من مركز اتخاذ القرار حتى قيل في زمنه إنه إذا كان الأتراك يهيمنون على الوزارة فالعرب يهيمنون على القصر السلطاني نفسه، وبث الدعاة والمبعوثين والمطبوعات في ديار المسلمين لتشجيعهم على الالتفاف حول الخلافة، وقاوم مشاريع الاستيطان الغربية إضافة للاستيطان الصهيوني الذي وعد بتسوية ديون الدولة وهو عرض شديد الإغراء لدولة غارقة في الديون، ورفضت الدولة إلى جانبه مشاريع استيطان فرنسية وبريطانية وأمريكية بل حتى من ألمانيا حليفة العثمانيين التي لم تتمكن من تنفيذ استيطانها لأن الدولة العثمانية فضلت أن تظل أراضيها الفارغة مخزونا احتياطياً للمسلمين المضطهدين في أوروبا وروسيا كالشركس والشيشان والبشناق ومسلمي اليونان وألبانيا وبلغاريا، وظلت الخلافة لا تعترف بالتغيرات السياسية التي صنعها الاحتلال الأوروبي حتى آخر أيامها، ورغم رمزية هذا الإنجاز في مواجهة الآلة العسكرية الاستعمارية فإن الدول الغربية أصرت على انتزاع تخلي تركيا الكمالية عن السيادة العثمانية على ما عدا الأناضول في اتفاقية لوزان (1923) وذلك ليصفو لها جو احتلال هذه البلاد العربية قانونياً، وهو ما حققه لها كمال أتاتورك بكل سهولة واشترى به استقلالاً موهوماً لتركيا ليربطها حقيقة بذيل أوروبا وهو وضع رفضته الدولة العثمانية في أشد ساعات تراجعها وقامت في النهاية بدخول الحرب الكبرى الأولى للوقوف ثانية على مستوى بقية الدول الكبرى.
وعلى صعيد السياسة الخارجية ظلت الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر’’قوة يحسب حسابها في السياسة الخارجية في كل من بريطانيا وفرنسا وإمبراطورية النمسا وكذلك ألمانيا وإيطاليا، ومن جهة أخرى فقد بقيت قوى محلية في الهند وآسيا الوسطى وشمال إفريقية تتطلع إلى الدولة العثمانية لحماية مصالحها’’.[75]
وعلى الصعيد الاقتصادي حافظت الدولة العثمانية حتى آخر أيامها على أهمية التجارة بين ولاياتها وكانت التجارة الداخلية مقدمة على التجارة الخارجية وهو ما تفتقده بلادنا في زمن التجزئة إذ يسيطر الغرب على معظم تجارتها ولا تشكل التجارة بين البلاد العربية إلا 8% من مجموع تجارتها، كما حافظت الدولة على درجة عالية من الاكتفاء الذاتي الغذائي على عكس دول التجزئة التي تستورد معظم غذائها حتى لو كانت بلاداً زراعية تقليدية وتخضع لسلاح الغذاء الذي يشهره الغرب في وجه العرب إذا حاولوا استعمال سلاح النفط لنصرة قضاياهم، ولم تعتمد الدولة العثمانية على تصدير منتج واحد بل نوعت منتجاتها الزراعية وقاومت المحاولات الغربية لتحويلها إلى الزراعة الأحادية تلبية لحاجات أوروبا على عكس حالة التجزئة العربية التي صنعها الاستعمار وفق مصالحه الحصرية، وقاومت الدولة كذلك تمدد الصناعات الغربية فحافظت على كثير من الصناعات الحرفية التي ظلت توفر معظم الحاجات لسكانها، ودخلت عصر التصنيع الآلي رغم الصعوبات الاقتصادية وشهد عهد السلطان عبد الحميد وما بعده إنشاء كثير من المصانع حتى في مجال التسلح الذي كان العثمانيون يصدرونه إلى الخارج إضافة للاستخدام الداخلي، ولم تستسلم الدولة لمطالب الدائنين بعد إفلاسها سنة 1875 وفرض السلطان عبد الحميد عليهم تسوية ألغت نصف الديون وتجنبت الدولة بذلك مصير ولاياتها التي أصرت على الاستقلال عنها مثل مصر وتونس مما أدى إلى تفرد المستعمرين الدائنين بها فوقعت في براثن الاحتلال الأجنبي البريطاني والفرنسي، وتمكن برنامجه الاقتصادي من زيادة الإيرادات بنسبة 43% في غضون ربع قرن مما أثار انتباه المؤرخين، كما جذب الاقتصاد العثماني في هذه الفترة استثمارات أجنبية في البنية التحتية ولكنه لم يستسلم لمتطلبات المصالح الأجنبية وتمكن من فرض المصالح العثمانية على عملية إنشاء المشاريع الاستثمارية، وكانت الدولة قادرة على الاختيار بين عروض الاقتصاديات الغربية عندما تمكن السلطان عبد الحميد من تحويل المنافسات الاستعمارية على بلاده إلى منافسات اقتصادية لتطويرها، وكانت الدولة الكبرى التي تعادي الدولة العثمانية يتضاءل نفوذها التجاري أو الاستثماري أو المالي تبعاً لذلك كما حدث مع بريطانيا، والعكس يحدث مع الدول التي تعرض صداقتها دون أطماع طاغية كما حدث مع ألمانيا، وهو ما نفتقده في عصر الاستقلال الوهمي والتجزئة المجهرية إذ يزيد نفوذ الغرب لدينا كلما أمعن في معاداة قضايانا ومصالحنا لأنه يجد تربة خصبة في التجزئة لحفز التنافس بين الأقزام على إرضائه مهما أجرم في حقوقهم.
وعلى الصعيد العسكري ظل الجيش العثماني محتفظا بقدر كبير من التماسك والعناد حتى آخر أيامه فصمد في وجه روسيا (1877- 1878) وانتصر على اليونان (1897) ثم دخل الحرب الكبرى الأولى (1914) ليستعيد ما احتله الحلفاء من قبل وليخلص الدولة من قيود الامتيازات الأجنبية وتمكن من تحقيق انتصارات مهمة على جبهات مضائق اسطنبول (غاليبولي) والقوقاز والبلقان وفلسطين (غزة) والعراق (الكوت) والجزيرة العربية (سكة الحجاز) ولكن الانتصار في معارك لا يعني الانتصار في الحرب وبخاصة أمام غيلان الغرب المتحالفة التي صممت على تدمير دولة تمثل آخر مظاهر وحدة المسلمين كما أكد على ذلك بلفور ولورنس في أثناء الحرب.
وشهد زمن السلطان عبد الحميد كذلك مشاريع عمرانية كسكة حديد بغداد التي كان من المخطط أن تصل عواصم أوروبا باسطنبول فبغداد فالكويت والتي بذلت بريطانيا كل ما في وسعها لتعطيلها، وأدت هذه السكة مع سكة الحجاز إلى إعمار كثير من المناطق التي مرتا بها في الأناضول والهلال الخصيب والجزيرة العربية، كما أنشئت سكك الحديد الأخرى في بلاد الشام التي تفوقت على الأناضول في نسبتها، ومدت شبكة التلغراف في أنحاء الدولة، وشهدت مدن عربية مثل بيروت عمراناً استثنائياً، وعمرت المواقع الفلسطينية المهجورة لمناهضة الاستيطان الصهيوني، وبنيت مدينة بئر السبع (1900) لتوطين العشائر البدوية التي شهدت عملية استقرار ملحوظة في أنحاء الدولة التي شجعت هذه العشائر على ذلك بمد العمران (بناء الناصرية والعمارة في جنوب العراق مثلا)، كما استهدف بناء مدينة بئر السبع مناهضة تمدد الاحتلال البريطاني من مصر حيث دعم السلطان عبد الحميد الحركة الوطنية بزعامة مصطفى كامل باشا ضد الاحتلال البريطاني دعماً مطلقاً، كما شهدت الدولة نهضة تعليمية نشرت آلاف المدارس في كل مكان فيها ونهضة ثقافية عدها المؤرخون من أغزر ما شهده تاريخ الدولة في هذا المجال.
ولو قدر لبلادنا الاحتفاظ بوحدتها والسير في تقدمها بنفس المعدل منذ ذلك الوقت لكنا في مكان آخر اليوم وهو ما يعطي أجيالنا درساً موثقاً عن أهمية الوحدة وإنجازاتها، لأن منطق الوحدة والكيان الجامع حتى مع الضعف الطارئ أفضل من منطق التجزئة والفرقة الملازم للاستسلام، فالكيان الكبير يفرض على أصحابه منطق الدولة العظمى الذي يقتضي العمل المستمر على البقاء في المقدمة ويتمكن من ذلك بالإمكانات الكبيرة المتوفرة لديه من الاتساع الجغرافي كما نرى في الدول الكبرى اليوم، أما الكيانات الصغيرة العاجزة عن إطعام أنفسها والدفاع عن حدودها وتلبية حاجات مواطنيها لقلة إمكاناتها فإنها لا ترى الحل إلا في التبعية للدول الكبرى المعادية لقضايانا والتي حققت اكتفاءها على حساب ثرواتنا المبعثرة بين أيديها. (كل الفقرات غير الموثقة في هذا البند تلخيص لدراسة سابقة هي سياسات آخر أيام الخلافة: قضايانا بين الوحدة والتجزئة).
الاستنتاج
في زمن يعيد فيه المستعمِرون الاعتبار لتاريخهم الاستعماري زاعمين أنه تاريخ إيجابي حتى لمن كان ضحيته، من الأوْلى أن يكف فيه الضحايا عن تشريح ذواتهم ولوم تاريخهم الحديث الذي لم يدخر وسعاً للدفاع عن وجودهم وبقائهم ضد قوى عظمى قضى الله أن تكون في مرحلة الفتوة التي تجاوزناها منذ زمن فكان لها بذلك ميزة علينا في حلبة المنافسة ولم يكن بإمكاننا وقتها إعادة عقارب الساعة إلى الوراء بلمح البصر أو إنجاز القفزة المطلوبة في لحظات في وقت اقتضى إنجازها قروناً عند أصحابها[76] بعيداً عن القوى الخارجية المعرقلة[77] التي حفل بها تاريخنا الحديث،[78] ومن الأجدى اليوم الانشغال بهموم اللحظة الحاضرة بدلاً من استمرار البكاء على ما فات والانشغال بتشويه مرحلة تاريخية اتسمت بإنجازات كبرى عجزت عنها المراحل التالية وبصمود عز نظيره آنذاك بين الأمم، كما لا يمكن لنا الانطلاق بثقة لبناء المستقبل مادامت لدينا قناعات سلبية عن ماضينا الذي يستحق منا تقديراً أكبر يدعم قدراتنا التي يشلها اليوم انعدام الثقة بالذات المؤدي للانبهار بما عند الأعداء ومن ثم الوقوع في فخ الاستلاب، في الوقت الذي تؤكد فيه الدراسات التاريخية الأجنبية المحايدة أكثر من العربية، مع الأسف، وجوب فخرنا بهذا التاريخ الذي طالما استقيناه كله من مصادر معادية.[79]
محمد شعبان صوان
نشأت أجيالنا المتعاقبة على سماع جملة تكررت حتى أصبحت في حكم المسلّمة: العثمانيون هم سبب تخلفنا الحالي، فقد حكمونا أربعة قرون اتسمت بالجهل والركود والظلم، ورغم ما في هذا التعميم الواسع من مفارقة يرفضها البحث العلمي وهي استمرار دولة كبرى لمدة طويلة زادت عن ستة قرون دون أن يكون لديها مقومات ذلك الاستمرار،[1] فلا بأس بفحص هذه ’’المسلّمة’’ وتفكيكها باختصار انطلاقاً من منطقها ثم محاولة الرد عليها لتفنيدها وإثبات عكسها ولكن أيضاً باختصار لأن الرد المفصل قد يستغرق دراسات طويلة جداً ليس هذا هو محلها.
تحتوي ’’مسلّمة’’ السبب العثماني في تخلفنا العربي على ظلمين: ظلم مكاني وظلم زماني.
1- الظلم المكاني هو في حصر ’’الركود والجهل والتخلف’’ في الدائرة العثمانية وحدها في الوقت الذي لم يكن فيه الحال أفضل في بقية العالم الإسلامي خارج النطاق العثماني بل في بقية العالم الثالث، وهذا يقودنا إلى اللغز الذي لم يجد جواباً جامعاً حتى اليوم وهو سبب تقدم الغرب الأوروبي على بقية العالم،[2] مع أن تفاوت المستويات الحضارية هو سنة التاريخ في جميع مراحله منذ بدء التدوين، فلم تمر فترة توحد فيها العالم كله على مستوى حضاري واحد ودائماً كان هناك المتقدم والمتخلف والمتوسط ولهذا فإن زمننا الذي تقدم فيه غرب أوروبا ليس استثناء من مسيرة التاريخ، وتخلف بقية العالم عن مسيرة الغرب اليوم هو أمر لا يتعلق بتخلف الدولة العثمانية وحدها عن الركب الغربي بل يتعلق بتقدم هذا الركب على العالم كله بما فيه العالم العثماني الذي ظل - على عكس صورة الضعف والهزيمة الشائعة- من المراكز النادرة لمجاراة الغرب تقنياً ومقاومته حتى وقت متأخر من العصر الحديث.
2- أما الظلم الزماني فهو يتضمن عدة نقاط:
أ- فتاريخ الإسلام يثبت أن تراجع الحضارة الإسلامية بدأ قبل زمن العثمانيين بكثير على اختلاف بين الباحثين في تحديد بداية هذا التراجع ولكن لا أحد منهم يشير إلى أن الحضارة الإسلامية كانت مشعة حتى أطفأ العثمانيون أضواءها بلمسة يد، بل إن التاريخ يقول إن مجيء الدولة العثمانية أدى إلى ’’إضفاء الحيوية على العالم الإسلامي’’[3] كما تضاءلت أوروبا مقارنة بدولة العثمانيين التي كانت خصماً ’’قد يقزّم بحجمه وتنظيمه وثروته وقوته أي شيء قد يحتشد أمامه. ولربما ظن زعماء بلدان إسبانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، والإمبراطورية الرومانية المقدسة بأنهم جبابرة، ولكن أمام العثمانيين لا يكاد يمكن عدّهم أقزاماً، كما لم تكد تتمكن الأساطيل الإيطالية وفرسان إسبانيا وفرنسا وجنود المشاة من المجر وبولونيا، والنمسا، وبروسيا من تجنب الهزيمة الكاملة. ولكن حتى في القرن الثامن عشر، كدّر ظِل ما وصفوه ب’’الترك الغاشمين’’، أكثر أيامهم إشراقاً على الإطلاق’’.[4]
ب- والنقطة الثانية تقول إن الزمن العثماني شهد محاولات بعث ونهضة نبعت من داخله ولم تستسلم لواقع الضعف والتراجع، وقد سبقت هذه المحاولات المحاولات اليابانية الناجحة بل تفوقت عليها في البداية وكان من الممكن جداً أن تؤدي إلى إحياء المنطقة ونهوضها سواء في ظل الدولة العثمانية أو في ظل دولة منبثقة عنها، ’’ولعله... لو لم تتآمر الدول الغربية على الخلافة العثمانية ثم على محمد علي، لقامت الدولة الإسلامية المركزية بتمويل عملية تصنيع كبرى لا تتخلى بالضرورة عن القيم الدينية الإنسانية’’[5] كما يؤكد المفكر الراحل عبد الوهاب المسيري في رأي تثبته الاتجاهات التصنيعية العثمانية حتى في ظل التراجع الشديد في القرن التاسع عشر (دراسة: الأثر الاقتصادي للتغريب الرأسمالي على المجتمع الإسلامي، بند: المقاومة الصناعية)، ويجمع عليه كثير من المؤرخين وبخاصة فيما يتعلق بنهضة مصر التي يؤكد حتى المتشكك بمآلاتها الصناعية أنه لو توفرت لمصر قيادة ذو عزم واستنارة ولم تقم ضدها القوى الغربية بقيادة بريطانيا بعد محمد علي باشا لكان باستطاعتها إنعاش إمبراطورية عربية تسيطر على وادي النيل والبحر الأحمر والمشرق مع احتمال أن تحل محل الدولة العثمانية بصفتها قوة إسلامية قيادية عالمية،[6] وكانت هذه هي نقطة الاختلاف الحاسمة عن اليابان والتي أدت لفشل هذه المحاولات العثمانية في النهاية وهي أن العثمانيين تعرضوا لقُطّاع الطرق الحضارية من الغرب ووُجد من يتصدى لتجاربهم الفتية ويجهض كل محاولاتهم بما فيها تجربة محمد علي باشا في مصر[7] خلافاً لليابان البعيدة عن الجغرافيا الأوروبية وذلك مما لم يفت بعض الباحثين،[8] وكان السلطان عبد الحميد الثاني قد تنبه مبكراً (1902) إلى أثر هذا الاختلاف في الحال بين الواقعين العثماني والياباني،[9] ولذلك فإن تحميل الجانب العثماني جريرة التخلف فيه تبرئة فاضحة لدور الغرب المعرقل الذي لاحظه كثير من دارسي هذه الحقبة، كما أن فيه إغفالاً واضحاً لإنجازات الدورة الاجتماعية الداخلية في الدولة العثمانية في محاولات الإحياء وهو ما سأشير إليه لاحقاً.
ت- أما النقطة الزمنية الثالثة والأخيرة فهي أن العثمانيين غادرونا منذ قرن تقريباً وفي أثناء هذه المدة بدأت دولة كالاتحاد السوفييتي في البناء من نفس المستوى الذي كانت فيه الدولة العثمانية زمن الثورة البلشفية على القيصرية، وبينما انشغل السوفييت بالعمل والبناء رغم عوائق الغرب وتدخله الفظ في مسيرة الثورة، ظلت بلادنا رازحة تحت نير الاستعمار القديم ثم الجديد مشغولة بالخضوع لأوامر الغرب وحراسة مصالحه لأن تنميتها كانت مرهونة بتوافق مصالحها مع هذه المصالح الغربية في رأي كوكبة كبيرة من زعامات الاستقلال والتجزئة سواء التقليدية التي كانت لا ترى الخير إلا فيما تراه الحكومة ’’البهية القيصرية’’ الاستعمارية، أم القيادات التغريبية التي قادها اقتناعها بالديمقراطية الليبرالية الغربية إلى عدم تصور نجاة بلادنا إلا بها رغم القمع الأوروبي والأطماع الغربية، بل حتى في رأي القيادات الثورية أيضاً والتي نسقت مع دولة كبرى ضد أخرى، هذا مع إلقاء تبعة تردي بلادنا على العثمانيين الذين ذهبوا مع مزاياهم وعيوبهم بعدما قاموا بمحاولة يائسة للتصدي للغرب في الحرب الكبرى الأولى (1914- 1918) والتي كلفتهم سيلاً من الدماء الغزيرة أثناء الدفاع عن بلادنا ومحاولة استرجاع ما احتل منها[10] ولم يتنازلوا حتى الرمق الأخير عما احتله الغرب حتى عما بعُد من هذه البلاد عن مركزهم[11] وظلت الخرائط العثمانية تدرج جميع الأراضي العثمانية المحتلة ضمن أراضي الدولة ولا تعترف بالأوضاع التي أوجدها الاحتلال البريطاني أو الفرنسي أو الإيطالي في مصر والجزائر وتونس والصومال والسودان وأريتريا وعدن وإمارات الخليج إلى أن جاءت أنظمة التغريب فباعت البلاد والعباد بعدما أصرت دول الاستعمار على الحصول على تنازل تركي عن الأملاك العثمانية في معاهدة لوزان (1923)، وبينما وصل السوفييت، وإن بثمن بشري باهظ، إلى قمة العالم في مرحلة قياسية، ظلت بلادنا في قاعه تندب وتولول بسبب حظها العثماني غافلة عن ظرفها الحالي، مما جعلها تدفع أيضاً ثمناً بشرياً باهظاً ولكن ليس في سبيل التقدم بل ضريبة للتبعية والعمالة والاحتلال والاستبداد والتخلف.
تعميمات مخلة عن مجمل العصر الحديث: التتريك والظلم والضعف والركود والجهل والعزلة
1- استعمار وتتريك بأثر رجعي وإعادة تشكيل الماضي وفق رغبات الحاضر: غالباً ما يكون الانطباع العام عن الدولة العثمانية تعميماً مخلاً لما تركته آخر أيامها من انطباعات في ذهنية الأجيال الحديثة، فليس من النادر أن نسمع أنها عملت على تتريك العرب، مع أن هذه كانت سياسة جمعية الاتحاد والترقي بعد سنة 1908، ولو كانت قد انتهجت هذه السياسة منذ أربعمائة سنة لما ظل هناك من يتكلم العربية في بلادنا وبخاصة عند المقارنة بنتائج سياسة الفرنسة التي طبقتها فرنسا في المغرب العربي مدة أقل من ذلك، بل إن هناك من يرى أن عدم انتهاج سياسة التتريك هو ما أدى إلى المآسي التي تعرض لها العثمانيون في القرن التاسع عشر من القوميات المسيحية في أوروبا وروسيا،[12] إذ لو كان العثمانيون قد قاموا بتتريك هذه المناطق وإجبار أهاليها على الرحيل لو رفضوا ذلك لما ظل هناك من يناوئ الدولة وتستعمله الدول الكبرى ضدها في مراحل ضعفها المتأخرة، وفي ذلك يقول المؤرخ مجيد خدوري: ’’ولم يفرض الإسلام نفسه على أتباع الديانات الأخرى، بل كانت الأقليات الدينية، برغم بعض القيود الخاصة بالشرع، تتمتع بحرية واسعة في ممارسة حقوق دينية ومدنية عزت على الأقليات في المجتمع الأوروبي المعاصر، وثابر السلاطنة العثمانيون على تطبيق هذه السياسة في أقاليم أوروبا الشرقية التي احتلوها، فبقيت تسكنها أكثرية مسيحية، ذلك لأن الإمبراطورية العثمانية ورثت الطابع المسكوني الذي يميز المجتمع الإسلامي، فأجازت لغير المسلمين التمتع بحرية دينية واسعة’’، هذا عن العناصر الأجنبية، أما الأتراك والعرب، وهما العنصران السائدان في امبراطورية دينية في جوهرها، فقد وجدا ’’ارتياحاً روحياً في ظل سلاطين أثبتوا أنهم خير ورثة للخلفاء العرب’’.[13]
وقد حظي العرب بمنزلة خاصة داخل الدولة، وعن مكانتهم في الدولة العثمانية، يتحدث المؤرخ زين نور الدين زين في كتاب ’’نشوء القومية العربية’’ عن التعميمات المخلة التي طبعت أفكار الأجيال عن العلاقات العربية التركية في ظل الدولة العثمانية فيقول إنه ’’ليس صوابا القول إن العرب المسلمين ظلوا طوال أربع مئة سنة أمة مستضعفة تحت نير الأتراك، أو إن البلدان العربية نُهبت خيراتها وخيم عليها الفقر من جراء الاحتلال التركي. كذلك ليس صواباً القول إن العرب المسلمين لم يكن يسمح لهم أن يتقلدوا سلاحاً أو أن ينضووا تحت العلم العثماني للخدمة العسكرية، ذلك لأن جيوشاً عربية وضباطاً عرباً من ذوي المراكز العسكرية العالية كانوا يعملون في الجيش العثماني... وقد شغل عدد كبير من العرب وظائف عالية حساسة في الإمبراطورية العثمانية... والواقع إن الأتراك كانوا عندما يتكلمون عن العرب يقولون عنهم (قوم نجيب)، كذلك كان العثمانيون في بادئ أمرهم ينظرون إلى الولايات التي يتكلم أهلها العربية نظرة إكرام لم ينظروا بها إلى سائر الولايات التي دخلت امبراطورية السلطان وذلك لسبب واضح وهو أن سكان الولايات العربية يتكلمون اللغة العربية لغة القرآن الكريم، وأكثرهم كانوا مسلمين’’[14] نقلا عن كتاب المجتمع الإسلامي والغرب للمستشرقين جب وبوون اللذين فندا التعميمات والعبارات الجارفة التي كتبت عن القرون الأولى من الحكم العثماني والتي كان مروجوها يجهلون وفرة الوثائق التاريخية التي يجب أن يطلع عليها الباحث كما كانوا على كثير من التحيز والتعصب كما يقول زين نقلا عن هذين المستشرقين اللذين اعتنقا تلك التعميمات المخلة عن العثمانيين في بداية دراستهما ثم تبدلت آراؤهما بعد عرض الوثائق والمعطيات العلمية ’’تبديلا تاما’’،[15] ومن الظلم أن نعمم فترة التتريك القصيرة التي حكمت فيها جمعية الاتحاد والترقي (1908- 1918) على أربعمائة سنة خلت من ذلك حتى أن رئيس وزراء العراق السابق نوري السعيد الذي اشترك في الثورة العربية على حكم الاتحاديين شهد أن العرب بصفتهم مسلمين كانوا يعدون ’’شركاء للأتراك، كانوا يشتركون معهم في الحقوق والواجبات بدون تمييز عنصري، وكانت الوظائف العليا في الدولة سواء العسكرية أم المدنية مفتوحة للعرب، وقد كان للعرب ممثلون في مجلسي البرلمان العثماني، أصبح كثير منهم رؤساء وزارة، ومنهم من كان شيخ الإسلام ومن أصبح قائداً عسكرياً أو والياً، فكنت ترى الموظفين العرب في جميع دوائر الدولة’’.[16]
وكما مات العرب في حروب الدولة بطريقة رفضها بعض المعارضين لأنها تزج بالعرب في حروب بعيدة عن بلادهم، فقد مات الأتراك أنفسهم أيضاً دفاعاً عن العرب، ومن أمثلة ذلك استشهاد 10 آلاف تركي في معركة خاسرة عندما هجمت فرنسا على الجزائر سنة 1830 كما يقول المؤرخ السوفييتي لوتسكي.[17]
ونجد في آثار الأستاذ أحمد الشقيري أول رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي مثل دولاً عربية في الهيئات والمحافل الدولية تحسراً كبيراً على العهد العثماني ومن ذلك قوله: ’’كان العرب هم العنصر النجيب كما كان يسميهم الأتراك، وفي مدينتي عكا كان الأطفال الأتراك.. يعرفون أنفسهم بأنهم عثمانيون، ولم أسمع أحدا يقول إنه تركي’’.[18]
أما عن اللغة العربية فيؤكد المؤرخ زين ابتداء أن الأتراك لم يحاولوا تتريك الأعراق البشرية التي دخلت ضمن دولتهم،[19] ويورد المؤرخ نفسه دلائل عديدة طبعت الدولة العثمانية بطابعها الإسلامي’’وأظهرت ما كان للغة العربية من شأن عظيم في تلك الامبراطورية’’، فأسماء السلاطين كانت عربية، وأختامهم كان عليها كتابات عربية، ورايات الدولة تتعدد ألوانها وأحجامها ’’لكن هناك أمراً واحداً مشتركاً بينها وهو أن على حواشي الرايات آيات قرآنية عربية مطرزة... فليس في هذه الرايات أثر أو طابع تركي، بل عربي إسلامي’’، ومن هذه الدلائل أيضا أسماء السفن والبواخر العثمانية التي نقشت على لوحات مازال ثلاثون منها في اسطنبول إلى اليوم تحمل أسماء عربية مثل سليمية ومحمودية ومجيدية،[20] وكل ما سبق يتعلق برموز الدولة التي تدل على هويتها ولم يتطرق الحديث إلى إتقان السلاطين اللغة العربية إلى درجة نظم الشعر بها، أما لغة التعليم في الدولة فقد كانت حتى التنظيمات التغريبية (1839) هي اللغة العربية كما يقول الدكتور فاضل بيات في كتابه دراسات في تاريخ العرب في العهد العثماني ويقول أيضاً إنه على الرغم من استخدام العثمانيين اللغة التركية في الأمور الرسمية فإنهم لم يدرسوها في أية مؤسسة من مؤسساتهم بل جعلوا اللغة العربية لغة التعليم في المدارس وظلت لغة التدريس في المدارس الإسلامية في جميع الممتلكات العثمانية طوال العهد العثماني ولم تدخل اللغة الفارسية والتركية فيها إلا بعد سنة 1908.[21]
وكانت القاهرة هي المدينة الثانية في الدولة، فكانت تلي العاصمة اسطنبول مباشرة في الأهمية تليها مدينة حلب، العربية أيضا،[22] ويصف الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم مصر العثمانية بأنها كانت’’محور العلاقات الاقتصادية بين المشرق والمغرب... وهي مركز لعمليات التصدير والاستيراد مع كل من البلدان الأوروبية والإفريقية والآسيوية’’،[23] ويصف المؤرخ روجين روجان وضع حلب داخل العالم العثماني بالقول إن أهلها لم يكونوا يعرفون ’’أن الفتح العثماني سيأتي لمدينتهم بعصر ذهبي يمتد حتى القرن الثامن عشر، تصبح فيه المدينة واحدة من أهم مراكز التجارة البرية بين آسيا ودول البحر المتوسط... وأصبحت من أكثر مدن العالم العربي عالمية’’،[24] فهل احتفى المستعمرون البريطانيون بالقاهرة وجعلوها تلي لندن في امبراطوريتهم، أم هل اهتم الفرنسيون بحلب وجعلوها تلي باريس في الامبراطورية الاستعمارية الفرنسية؟
وسيطول الحديث لو تكلمنا عن مكانة العرب في زمن السلطان عبد الحميد في آخر أيام الخلافة عندما جعلهم مركز مشروع الجامعة الإسلامية وأكثر من رجالهم في المراكز العليا حتى أصبح القصر السلطاني يوصف بأنه تحت سيطرتهم. وقد رفض السلطان عبد الحميد بيع فلسطين لهرتزل تقديراً لتضحيات جنوده السوريين والفلسطينيين في معارك الدفاع عن دولتهم جميعا، وهو ما يوحي بأن التضحيات كانت مقدرة وليس كما حدث عند المستعمرين الذين جندوا أبناءنا في حروبهم العبثية ثم قتلوهم لما طالبوا بحريتهم (مجازر 8 أيار/ مايو/ ماي في الجزائر 1945 مثلاً)، كما انعدم هذا التقدير حتى عند زعامات التجزئة الوطنية، ويقول المؤرخ فيليب مانسل إن ’’عبد الحميد الثاني عمد إلى توفير المال وتركيز الاهتمام على الأقاليم العربية بحيث فضلها على العديد من المناطق التركية’’،[25] وأكد ذلك المشاريع الحيوية التي قام بها وبدأ بعضها بالبلاد العربية قبل الأناضول كسكة الحجاز إضافة لسكة بغداد وتطوير بيروت وحيفا ومعان وتبوك ودرعا وبناء بئر السبع لمواجهة الاحتلال البريطاني في مصر وبناء العمارة والناصرية في العراق قبل ذلك وكلها مشاريع حيوية لو استمرت لأحدثت تطوراً كبيراً للحالة الوحدوية التي كانت تجمعنا ولكن دول الاستقلال والتجزئة العربية أوقفتها أو هدمتها أو عطلتها بالتعاون مع الاستعمار.
كل ما سبق من الحقائق لا يتفق مع مفهوم الاستعمار الذي حاولت بعض الكتابات إلصاقه بالحكم العثماني في البلاد العربية، وأساس هذا المفهوم هو الفصل الحاسم والتناقض الواضح بين حال المستعمِر (المركز) والمستعمَر (الأطراف) في ظل الحكم الاستعماري، لأن إمكانات المستعمَر تكون مسخرة لمصالح المستعمِر فيحصل من ذلك تقدمه وتطوره على حساب المحكوم الذي يصيبه التأخر والتخلف من هذا الاستنزاف.
ولم نجد أن الحكم العثماني فضّل مركزاً تركياً (الأناضول مثلاً) على بقية أنحاء الدولة، بل وجدنا أحياناً تفضيل ’’الأطراف’’ العربية على ’’المركز’’ التركي، كما سبقت الإشارة، والأصح أن وحدة المصير هي التي حكمت تاريخ هذه الدولة، فما أصاب التركي من نِعم أو مصائب أصاب بقية القوميات أيضاً، وفي نهاية الحكم العثماني في الأقطار العربية لم يكن حال الأناضول أفضل من حالها، كما أن الفكرة القومية التي ترفض حكماً من خارج دائرتها لم تكن معروفة حتى أواخر العهد العثماني الذي سيطر فيه الولاء الديني على الولاءات القومية وغيرها،[26] ولهذا يصبح توصيف الحكم العثماني بالاستعمار هو من باب المفارقة التاريخية التي تجمع نقيضين لم يجتمعا في زمن واحد كعبارة التلفزيون الإغريقي أو الهاتف الفرعوني، والدليل الأقوى على ذلك أن معظم أصحاب الشأن، وهم العرب الذين عاصروا دخول بلادهم ضمن الدولة العثمانية ’’نظروا بعين الرضا لوضعهم في ظل الإمبراطورية العالمية التي سادت في ذلك العصر على اعتبار أنهم مسلمون في إمبراطورية إسلامية عظمى’’كما يقول المؤرخ يوجين روجان،[27] ويؤكد المؤرخ السوفييتي نيقولاي إيفانوف ذلك بالقول إن العرب عندما التحقوا بالسلطنة العثمانية ’’لم يشعروا أنهم في وضع الشعوب المحرومة من الحقوق أو المضطهَدة، وحتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر ظلوا يعارضون اعتبار الفتح العثماني استعباداً أجنبياً، وقد أشار أحد أكبر أيديولوجيي القومية العربية الحديثة، المؤرخ السوري المرموق ساطع الحصري في مؤلفاته إلى أن العرب اعتبروا حكم السلاطين العثمانيين استمراراً مباشراً للخلافة الإسلامية وأنهم لم يشعروا بأنهم شعب مستعمَر تابع لسلطة أجنبية’’،[28] وذلك خلافاً لنظرة العرب إلى حكم الاحتلال الأوروبي الذي حل بهم بعد ذلك، وفي توصيف حكم العثمانيين بالاحتلال مزايدة لم يشعر المعنيون بها بالحاجة إليها في زمنهم وهي إسقاط آراء مستقبلية على وضع ماض لم يكن لها مكان فيه، وليّ لعنق التاريخ ليناسب أهواء لحظة معينة تود أن تشكله ليناسب رؤاها وحدها بغض النظر عما حدث فعلاً، فيصبح التأريخ حينئذ ليس مجرد تدوين الحوادث الماضية بأمانة بل إعادة تشكيلها بما يناسب رغبات الحاضر، وهو إجراء يشبه إلى حد ما ما يفعله من يريدون اليوم تقديم الاعتذار للاستعمار الغربي بسبب عدم تفهم أجدادنا لمقاصده الخيرة ومقاومتهم إياه، رغم أن هؤلاء المعتذرين لم يجرءوا، حتى الآن على الأقل، على الزعم أن بلادنا رحبت بالمستعمرين!!
وقد واجهت فكرة الاستعمار العثماني معضلة كبرى كان لا بد من حلها وهي طول فترة الحكم العثماني للبلاد العربية، وكان سكوت العرب طوال أربعمائة سنة مدعاة لإحراج أصحاب هذه الفكرة[29] فكانوا بين خيار رفض هذا الواقع ومن ثم تخيل البديل في ’’قرون من المقاومة العربية’’ لا توجد إلا في خيالهم الذي حوّر الطموحات الشخصية لبعض الزعماء المحليين - وكثير منهم من غير العرب[30] - لتصبح هبّات ثورية قومية، ولم يجيبوا على تساؤل كيف أمكن لدولة ضعيفة معزولة راكدة، كما وصفوها، التغلب على مقاومة الجماهير الكاسحة في وقت لم تستطع أقوى الامبراطوريات الحديثة الاستمرار في حكم قطر من الأقطار الثائرة لهذه الدولة الشاسعة، وهو الجزائر، أكثر من 132 سنة، وهي أطول مدة استعمارية لقطر عربي؟ أما الخيار الثاني أمام أنصار فكرة الاستعمار العثماني فهو القبول باستكانة الجماهير العربية لعبودية هذا الاستعمار ووصم أمتهم بالخضوع الذليل هذه المدة الطويلة.
ولأن هذين الخيارين غير تاريخيين اتجه أصحاب بعض الرؤى القومية، بل والماركسية أيضاً، التي تتسم بالواقعية التاريخية، أي بفهم التاريخ كما حدث لا كما ترغب الأيديولوجيات، إلى عدم إسقاط العناوين الجاهزة على حوادث مغايرة لأصولها، والاعتدال في النظر إلى هذه المرحلة التاريخية وعدم الحماس لوضعها داخل القوالب الجاهزة للفكر المستورد، مع بذل الجهد في محاولة تعديله وفقاً لمتغيرات تاريخنا، ذلك لأن إغفال السياق التاريخي لنشوء الدولة العثمانية ومحاولة فهم الحوادث فيها انطلاقاً من معايير قومية أوروبية ’’أحدثا اضطراباً في تحليل كثير من المؤرخين العرب’’ كما يقول المفكر العربي الأستاذ فكتور سحّاب،[31] وقد حدث ذلك في مرحلة تميزت بسيادة النقل العام عن الشرق والغرب دون محاولة تعديل الأفكار لتلائم تغيرات الواقع.
ولعل أبرز الأصوات القومية في هذا المجال هو الأستاذ أحمد الشقيري الذي رفض وصف الحكم العثماني بالاحتلال أو الاستعمار وأبرز مزاياه للعرب مقارنة بما حل بعده من انتداب وتجزئة وأكد أن الأمة العربية ابتهجت بانتقال الخلافة الإسلامية إلى العثمانيين الذين كانوا يمثلون القوة والمنعة والنصر للإسلام، وأن العرب تعاطفوا مع هذه الدولة ورضوا بوضع الخلافة بين يديها وتناسوا الشرط الديني بأن يكون الخليفة عربياً قرشياً لأن الانتصارات العثمانية تحت راية الجهاد لم تترك مجالاً للنقاش حول مؤهلات الخليفة وشروطه، وأن الدولة العثمانية كانت دولة مشتركة وليست هيمنة أحادية ولهذا أحس العرب أنها دولتهم وخلافتهم وتمتعوا فيها بمزايا المشاركة في الحكم والتمثيل وحرية التنقل، بل إنه ذهب إلى وصفها بأنها آخر تجليات الوحدة العربية وأن عاصمتها اسطنبول كانت عاصمة لوحدة العرب، وأن سير الحوادث كان من الممكن أن يتجه إلى الأفضل لولا حكم جمعية الاتحاد والترقي الذي فصل بين الشعبين.[32]
وعلى الضفة الماركسية ينحو القائد الشيوعي الفلسطيني إميل توما إلى تحليل غير مقيد بالإملاءات المستوردة ويقول عنه الأستاذ سحّاب إن ’’توما الماركسي التقليدي، يدهشك بموقف من الدولة العثمانية، لم يدركه معظم الكتاب القوميين، وهو أن الدولة العثمانية ليست حكماً أجنبياً بالمعايير الذاتية لسياق الدولة الإسلامية التاريخي... غير أن توما، وهو يؤكد هذا الأمر بشجاعة وحصافة فكرية، توقف عند هذا، ولم يوغل في الاستنتاج المترتب على هذا القول، وهو أن كثيراً من القيادات القومية العربية، بل إن كثيراً من الأفكار القومية العربية يحتاج إلى إعادة نظر وتقويم في ضوء هذه الحقيقة التاريخية، وهي أن السلطنة العثمانية لم تكن استعماراً بالمعنى الذي نعرفه اليوم للاستعمار الأوروبي، ولا كانت حوافز الحركة القومية آنذاك حوافز تستحق الإكبار الذي تستحقه منا اليوم حركة التحرير الاستقلالية الذاتية غير الموحى بها لمصالح أجنبية معينة’’،[33] وتصل المفارقة قمتها عندما يصف ورثة توما الفلسطينيون الدولة العثمانية بالاحتلال العثماني في نفس الوقت الذي يصادقون فيه على ’’حق’’ الكيان الصهيوني في معظم أرض فلسطين ولا يصفونه بالاحتلال، ولو مجرد وصف لفظي خال من التبعات العملية!!
2- الضعف والجهل والدمار والركود في أقوى دولة في العالم: وكما كان الانطباع الخاص بالتتريك مخلاً فكذلك كانت الانطباعات الخاصة بالضعف والجهل والهزيمة والتراجع تعميمات نسيت أن الدولة العثمانية كانت ’’من أعظم الإمبراطوريات في التاريخ وأكبرها وأطولها عمراً’’، وما من شك أنها كانت سنة 1500 ’’أقوى دول العالم ربما باستثناء الصين’’، وقد أثرت في مستقبل وأوضاع دول عديدة في الشرق والغرب مثل دولة المماليك والدولة الصفوية، وإمبراطورية الهابسبيرغ وروسيا القيصرية إلى زوال الحكم الملكي فيهما في بداية القرن العشرين، وقامت أيضاً بدور في السياسة الدولية بعد تحولها إلى ’’قوة مرهوبة الجانب إلى درجة أن فيليب الثاني ملك إسبانيا دعا إلى حرب صليبية لإيقاف المد العثماني’’كما يقول المؤرخ البريطاني الأمريكي دونالد كواترت،[34] فقد سيطرت على ثلاثة بحار كبرى (الأبيض والأسود والأحمر) وما بينها وما يحيط بها من أراض، وأن ’’العرب وجدوا أنفسهم جزءاً من أعظم وأقوى امبراطورية إسلامية عُرفت منذ ظهور الإسلام’’ وأنه ’’يصح القول بأن الحكم العثماني حمى الأقطار العربية والإسلام من التعدي الخارجي قرابة أربعمائة سنة’’ وفقاً للمؤرخ العربي زين نور الدين زين[35] والدكتور فهمي جدعان[36] والدكتور أحمد شلبي،[37] وأن هذه الدولة ’’أعظم إمبراطورية إسلامية في العالم في ذلك الوقت’’ في تقدير المؤرخ البريطاني يوجين روجان،[38] ووصفها المؤرخ الفرنسي أندري كلو بأنها كانت ’’إمبراطورية الإمبراطوريات’’في زمن السلطان سليمان القانوني،[39] وأنها كانت عند وفاته ليست الأقوى بعدتها وعددها عسكرياً وحسب، بل وبامتداد أراضيها، وبثروة عاهلها، وأيضاً بعدد سكانها الذي جعلها الأولى بين أمم أوروبا (35 مليوناً مقابل 5 ملايين لإنجلترا و7 ملايين لإسبانيا و12 مليوناً لإيطاليا و18 مليوناً لفرنسا) وجعل عاصمتها الأولى كذلك بين عواصم أوروبا ويزيد عدد سكانها بضعف على أكبر المدن الأوروبية، وتؤلف قلباً لشبكة ’’لا خلل فيها من إدارة وجيش لم يوجد أحسن منهما في ذلك العصر’’.[40]
ويصف المستشرق البريطاني الأمريكي الصهيوني برنارد لويس (*) حالها بالقول إنه قد ’’رافق توسع الامبراطورية وقوتها العسكرية اقتصاد متين، وإدارة دقيقة، وثقافة غنية رفيعة، وأصبحت استنبول العاصمة الآخذة في التطور منذ عهد أسلاف سليمان ’’المدينة الأم’’ الواسعة المزدهرة، وبمثابة مغناطيس لأصحاب الطموح والمواهب، وازدحم فيها الشعراء، والعلماء، والفنانون والمهندسون، والإداريون، ورجال الدين من جميع أنحاء الامبراطورية وما ورائها، وأسهم كل هؤلاء في إعطاء الحضارة العثمانية الجديدة طابعها المتميز الخاص، وبلغت هذه الحضارة في عهد سليمان وتحت رعايته الخاصة إلى حد كبير أرقى مدارجها وتحققت أعظم إنجازاتها... وظلت الإمبراطورية العثمانية بعد وفاة سليمان بأكثر من قرن قوة جبارة. وكانت قادرة في سنة 1683 أن تقوم بالحملة الثانية العظيمة على فيينا’’،[41] ويؤكد المؤرخ البريطاني بيتر مانسفيلد ذلك بالقول إن اسطنبول كانت ’’من أروع المدن في العالم وملتقى الحضارات الغربية والشرقية’’، وهو ما يقوله أندري كلو أيضاً إذ أنها ’’أعظم مدينة في الشرق والغرب’’،[42] ويتابع مانسفيلد إن الدولة العثمانية ظلت بعد أوج مجدها زمن السلطان سليمان بأكثر من مائة وخمسين عاماً تالية ’’قوة عظيمة قادرة على أن تغرس الفزع والرهبة في نفوس البابوات المتعاقبين، وفي أرجاء الولايات المسيحية لأوروبا الغربية خشية أن تقوم باجتياح تلك الولايات ثانية... وحتى عام 1683م، لم يكن أحد في أوروبا ليصدق أن المسلمين لن يعودوا ثانية، وقد مر وقت طويل حتى اقتنع فيه الأوروبيون أن الخطر العثماني قد ولى إلى غير رجعة’’،[43] ويقول المؤرخ البريطاني بيري أندرسون إن ’’حمية وضخامة وبراعة قوات السلطان جعلتهم قوة لا تغلب في أوروبا لمدة مائتي عام’’ منذ فتح القسطنطينية.[44]
وعن الاقتصاد العثماني في الفترة ما بين منتصف القرن السادس عشر ومنتصف القرن الثامن عشر تقول المؤرخة ثريا فاروقي إن ’’الأقاليم العثمانية كانت تتمتع بالاكتفاء الذاتي في السلع الضرورية اليومية والمواد الحربية’’، وإن الدولة كانت ’’لا تزال قادرة على الأداء بدون استيراد تلك البضائع الاستهلاكية التي يحتاج إليها غالبية السكان مثل الحبوب والمواد الغذائية الأخرى، وكان يتم تصنيع الحديد والنحاس والأقمشة وكل الأشياء اللازمة للاستعمال اليومي بكميات كافية داخل الأقاليم التابعة للسلطان، أما فيما يتعلق بالمواد الحربية فقد كان العثمانيون مكتفين ذاتياً إلى حد كبير’’، وقد وصف المؤرخ فرنان بروديل البلاد التي حكمها السلاطين العثمانيون بأنها ’’اقتصاد عالمي’’ قائم بذاته بفضل السلام العثماني جزئياً وهو ما يعني أنها لم تكن وحدة سياسية فقط بل منطقة يسهل التبادل التجاري بين أقاليمها.[45]
ويقول المؤرخ أندرسون إن الولايات الآسيوية في الدولة العثمانية شهدت’’انتعاشاً وتقدماً ملحوظين أثناء ذروة الجبروت التركي في القرن السادس عشر، وفي حين بقيت الروملي (شرق أوروبا العثماني) المسرح الرئيس للحرب لجيوش السلطان، فإن الأناضول وسوريا ومصر تمتعت بفوائد السلام والوحدة اللذين حققهما الفتح العثماني في الشرق الأوسط، إن عدم الاستقرار، الناجم عن انحلال دول المماليك في المشرق، قد حلت محله إدارة مركزية قوية، قضت على قطاع الطرق ونشطت التجارة الداخلية، ووضع حد للركود الاقتصادي في سوريا ومصر، والناجم عن الغزو والطاعون في أواخر العصر الوسيط، ذلك بانتعاش الزراعة وزيادة السكان.. كان النمو السكاني ملحوظاً.. وازدهرت التجارة..’’.[46]
كما وصف المؤرخ الأمريكي زاكري كارابل الدولة العثمانية بأنها ’’دامت قرابة خمسمئة سنة، فكانت أطول الدول عمراً باستثناء عدد قليل من الأسر الحاكمة التي عرفها العالم’’،[47] ووصف المؤرخ البريطاني جاسون غودوين العثمانيين بأنهم ’’سادة الآفاق’’ وأن دولتهم كانت ’’أعجوبة في الحيوية، قوية جداً ومنظمة جداً، معجزة من معجزات العبقرية الإنسانية التي جعلت معاصريها يشعرون أنها مؤيدة بقوى غير بشرية، سواء شيطانية أو إلهية حسب وجهة نظر كل مراقب منهم’’،[48] وقد وصفها أحد معاصريها هو مؤرخ العثمانيين لدى الملكة إليزابيث الأولى الإنجليزي ريتشارد نولز في كتابه تاريخ الترك (1603) الذي صدر فيما بعد بإضافات السير بول رايكوت (1687): ’’في الوقت الحاضر، إذا اعتبرت قيام هذه الإمبراطورية العثمانية وتقدمها، فإنك لن تجد في هذا العالم أمراً يثير الإعجاب والدهشة أكثر مما تثيره هذه الإمبراطورية، وإذا اعتبرت عظمتها وشهرتها المتألقة فإنك لن تجد شيئا يضاهي هذه العظمة وهذا التألق، وإذا نظرت في قوتها ومضائها فإنك لن تجد ما يفوقها رهبة وخطراً... هذه الإمبراطورية التي تهزأ بالدنيا (المعادية) وترعد فتمطرها دماً وخراباً، وهي شديدة الاقتناع بأنها ستسود العالم بأسره، وبأنها هي التي ستضع حدوداً لملكها، ولن تكون هذه الحدود إلا أقاصي المعمورة من مشرق الشمس إلى مغربها’’،[49] وفي الزمن المعاصر وصفها المستشرق الفرنسي جان سوفاجيه بأنها ظلت طوال القرنين السادس عشر والسابع عشر ’’دولة من أعظم دول الغرب وأقواها، إن لم نقل أعظمها وأقواها على الإطلاق.. فقد كانت مساحتها تبلغ بضعة ملايين من الكيلومترات المربعة، وكانت مصادر ميزانيتها أعظم وأثبت من مصادر أية دولة أوروبية أخرى بما في ذلك إسبانيا ومعادن الذهب فيها، وكانت إدارتها الحكومية منظمة تنظيما محكماً تهدف إلى توفير الخير العام، وكانت تثق بولاء شعبها وإخلاصه لها... أما جيشها النظامي فقد كان أحسن الجيوش تدريبا وكانت مدفعيتها أحسن مدفعية تملكها أية دولة وكان أسطولها يسيطر على البحر الأبيض المتوسط كله، فكان السلاطين يفرضون على الدول الأوروبية أن تحسب لدولة قوية كدولتهم حسابها..’’ كما جاء في كتابه مقدمة تاريخ الشرق الإسلامي (1943)[50] ويؤيد مؤرخون آخرون هذا الكلام،[51] وكثيراً ما وصف الجيش العثماني في أوروبا بأنه الجيش الذي لا يُقهر.[52]
وفي الوقت الذي كان فيه بناء أسطول يقتضي وقتاً طويلاً وجهوداً مالية كبرى عند الغرب الأوروبي، كانت بضعة شهور كافية للعثمانيين ’’لوضع عدة مئات من السفن في الأحواض ودفعها إلى البحر’’.[53]
3- العزلة والستار الحديدي الخيالي: يرد المؤرخ دونالد كواترت على تهمة’’الستار الحديدي’’ التي استعارها بعض المؤرخين لوصف عزلة الدولة العثمانية في علاقاتها الخارجية، ويؤكد أن ’’هذا القول يجانب الحقيقة’’، وأنه كان هناك تبادلاً ’’دبلوماسياً وثقافياً واقتصادياً بين الدولة العثمانية وجيرانها الأوروبيين’’، مستدلاً على ذلك بالاتفاقيات والمعاهدات التي تم عقدها والتي وصل عددها بين 1703- 1774 إلى ثمان وستين، وخلص إلى القول إن ’’الستار الحديدي المزعوم لم يكن له وجود’’.[54]
ويفصل الأستاذ الدكتور عبد العزيز الشناوي القول في ذلك فيقول إن العثمانيين فتحوا أراضيهم للعلاقات الاقتصادية مع جوارهم فكان لكل من مصر والشام علاقات تجارية مع أوروبا وكان للعراق علاقات مع إيران والهند وأوروبا، ولفت نظره أن ’’الدولة العثمانية، وهي الدولة السنية والمدافعة عن المذهب السني في العالم الإسلامي، قد يسرت السبل امام شيعة فارس والهند وأفغانستان وغيرهم لزيارة العتبات المقدسة، وكانت في تصرفاتها مثالاً يحتذى في الترفع عن سياسة التعصب الديني والمذهبي’’، نافياً أن يكون الحصول على إيرادات الزيارة هو دافعها لذلك لأنها لم تكن تؤلف دخلاً كبيراً للحكومة ’’وكان في مقدور السلطات العثمانية في العراق الاستعاضة عن مثل هذه المبالغ (أقل من خمسة آلاف جنيه استرليني لسنة 1889 وأقل من عشرة آلاف جنيه في السنة التالية) بتدبير موارد مالية أخرى لخزانة الحكومة’’.[55]
4- الظلم الذي يستقطب المؤيدين ويجتذب المهاجرين: أما عن فرية الظلم فتعج كتب المؤرخين بما يدحضها، ففي حديثه عن خصائص الحكم العثماني في العصر الأول (من الفتح في القرن 16 إلى القرن 19) في البلاد العربية يقول الدكتور محمد أنيس إن ’’ نظام الحكم العثماني في الشرق الأوسط بصفة عامة كان عملياً للغاية ولم يكن ظالماً أو عنيفاً... وكانت القاعدة أن كل إيالة تعيش على دخلها الخاص وتدفع إلى خزانة الدولة قدراً معقولاً جداً من الجزية ولذلك لم يكن التشريع الضرائبي العثماني مرهقاً لرعايا الدولة. فالسلاطين العثمانيون أدركوا أن الضرائب البسيطة وأساليب الإدارة البسيطة في صالح كل من الحكام والمحكومين’’، وعند حديثه عن المساوئ التي ارتكبها الحكم العثماني كالنزاع بين الأحزاب وتعدي الهيئات المحلية على الحكومة المركزية قال مستدركاً: ’’ولكن رغم هذا فإن الإدارة العثمانية المالية كانت أمينة إلى حد معقول، كما أن الفلاحين لم يعانوا ما عانوه من حكم دول قبل وبعد العثمانيين ’’، وعند حديثه عن بقية المساوئ كالمحسوبية والرشوة وبيع الوظائف قال إن مجتمعات الشرق الأدنى كانت على شفا الانهيار قبل دخول العثمانيين مباشرة ’’إلا أن دخول العثمانيين أخر هذا الانهيار، فقد سار العثمانيون على نظام ضرائبي مخفف فأنقذوا الفلاحين والتجار وبسطوا حالة من الأمن والاستقرار تمتع بها الشرق الأدنى حتى النصف الثاني من القرن الثامن عشر’’،[56] ويقول برنارد لويس إنه في البلاد العربية ’’جلب الحكم العثماني السلام والأمن بعد الكابوس العنيف للحكم المملوكي الأخير’’.[57]
ويذهب المؤرخ السوفييتي نيقولاي إيفانوف إلى ما هو أبعد من ذلك بالقول إن سمعة العثمانيين كانت ’’في الأوج عند مطالع القرن السادس عشر، ففي الشرق كما في الغرب على حد سواء ازداد الإعجاب بالعثمانيين ولا سيما في الأوساط الشعبية المضطَهَدة والمستغَلة’’، وينقل عن المؤرخ الروسي كريمسكي من بداية القرن العشرين قوله إنه في البلقان والمجر وأوروبا الغربية وروسيا ’’برزت مجموعات كبيرة من الناس، كانت بأفكارها ومشاعرها، وبدرجات متفاوتة، لا تخاف غزوات العثمانيين وفتوحاتهم بل تدعو إليها صراحة’’، وأما في العالم العربي ’’فقد وقف الفلاحون إلى جانب العثمانيين’’، ومع أن هذا التعاطف الشعبي استند إلى المبالغة في تصور الكمال لدى المجتمع العثماني فإنه ’’في الواقع، لم تكن النظم العثمانية الاجتماعية الطوباوية (أي المثالية) مجرد سفسطة كلامية، بل كانت أساساً للعمل’’، وعلى أساس الشعارات العثمانية التي تمكنت ’’وبقدرة سحرية من استقطاب مشاعر الفلاحين وجماهير سكان المدن... بنيت على قاعدتها النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للباب العالي بخاصة قراءة فلاحية فريدة من نوعها للمبادئ الأساسية للإسلام وأفكاره عن المساواة، والأخوة بين الجميع، والعدالة الاجتماعية، والوفاق، والعمل كمصدر وحيد لتلبية الحاجات المادية للإنسان، وإدانة مظاهر الترف والإثراء، وضرورة التواضع في العيش والابتعاد عن الإسراف، وتحاشي استغلال الإنسان للإنسان’’، ويؤرخ ذلك إلى مطلع القرن السابع عشر.[58]
ويؤيد كلام برنارد لويس ما قاله إيفانوف ويتحدث عن الهجرة بصفتها اقتراعاً بالأقدام وكانت وجهتها الدولة العثمانية في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، أي من الغرب إلى الشرق وليس العكس الذي يحدث في أيامنا، ولم يكن اللاجئون المسلمون واليهود هم وحدهم المستفيدين، بل استفاد المسيحيون من أصحاب الانشقاقات الدينية والسياسية، ولم يكن كل أولئك أيضاً هم المستفيدين الوحيدين من الحكم العثماني ’’إذ أن الفلاحين في المناطق التي غزيت قد تمتعوا، بدورهم، بتحسن كبير في أوضاعهم، فقد جلبت الحكومة الامبراطورية العثمانية الوحدة والأمن مكان الصراع والفوضى، كما ترتبت على الغزو نتائج اجتماعية واقتصادية هامة’’، ويقول إن الإمبراطورية العثمانية كانت ذات سحر قوي إضافة إلى كونها عدواً خطراً’’فقد كان المستاءون والطموحون ينجذبون إليها بالفرص التي تتاح إليهم في ظل التسامح العثماني، وكان الفلاحون المسحوقون (في أوروبا) يتطلعون بأمل إلى أعداء أسيادهم’’ وحتى القرن التاسع عشر ’’كان الأوروبيون الذين يزورون البلقان يعلقون على أوضاع فلاحي البلقان الحسنة وعلى رضاهم عن هذه الأوضاع، وكانوا يجدونها أفضل من الأوضاع السائدة في بعض أنحاء أوروبا المسيحية، وكان الفرق أوضح بكثير في القرنين الخامس عشر والسادس عشر’’... ويقارن بين الحكم العثماني والحكم الأوروبي بقوله: ’’وعندما انتهى الحكم العثماني في أوروبا، كانت الأمم المسيحية التي حكمها العثمانيون عدة قرون لا تزال هناك، بلغاتها وثقافاتها ودياناتها وحتى إلى حد ما بمؤسساتها، كل هذه الأمور بقيت سليمة وجاهزة لاستئناف وجودها الوطني المستقل، أما إسبانيا وصقلية فليس فيهما مسلمون أو ناطقون باللغة العربية’’،[59] ويستنتج كواترت من تتبع الازدهار الاقتصادي في البلقان عشية انفصال بلاده عن الدولة العثمانية وتردي أحوال هذه البلاد بعد انفصالها، أننا لا نستطيع أن نعزي ظهور الحركات الانفصالية في البلقان إلى تردي أحواله الاقتصادية في ظل العثمانيين.[60]
ويتحدث المستشرق الفرنسي الماركسي مكسيم رودنسون عن موضوع الهجرة إلى الأراضي العثمانية طلباً للتسامح فقال: ’’لجأ أتباع مذهب كالفن في هنفاريا وترنسيلفانيا وبروتستانت سيليزيا وقدماء المؤمنين من قفقاس روسيا، إلى تركيا وتطلعوا إلى الباب العالي في هروبهم من الاضطهاد الكاثوليكي أو الأرثوذكسي، وذلك مثلما فعل اليهود الإسبانيون قبل ذلك بقرنين’’.[61]
ويؤكد أندري كلو ما سبق بالقول إن ’’دهاء العثمانيين كان يتمثل في حكمهم الناس بالعدل والاعتدال’’، وإن أقنان أوروبا لم يكونوا يخفون أحياناً ترحيبهم برايات النبي (عليه الصلاة والسلام)، لأن ’’حال الفلاح في الإمبراطورية العثمانية أحسن من حال سكان الأرياف في أوروبا، ويشهد على ذلك أولئك الغلاظ الشداد في بلاد النصارى الذين يهربون إلى دار الإسلام بعد إحراق الدور والضيعات، انتقاماً من ظلم سيدهم، وتشهد على ذلك حفاوة الأهالي عند اقتراب جند السلطان’’، وفي المجر كان القرويون في بؤس شديد دفع كثيراً منهم لانتظار الأتراك وعدهم محررين، وإن الاحتلال التركي يسر على السكان في البلقان وبلغاريا ما كانوا يلاقونه من جبروت الإقطاعيين البلغار والصرب وظلم الهيئات الدينية،[62] وفي تقديمه لكتاب كلو عن السلطان سليمان القانوني يقول الأستاذ البشير بن سلامة إن السلطنة العثمانية اشتهرت بالنزوع إلى العدل وكان شعار السلاطين هو: ’’لا دولة بدون جيش، ولا جيش بدون مال، ولا مال بدون رعايا راضين، ولا رعايا بدون عدل، إذ بدون عدل لا وجود للدولة’’ فكان العدل قضية عملية محورية ترتبط بسيادة الدولة[63] وليست مجرد شعار نظري.
ويؤكد بيري أندرسون أن الدولة العثمانية لم تحاول فرض الإسلام على المسيحيين في البلقان، وأن الفلاحين البلقانيين ’’وجدوا أنفسهم فجأة وقد تحرروا من الخضوع المهين والاستغلال الأرستقراطي في ظل حكامهم المسيحيين، وانتقلوا إلى وضع اجتماعي كان في معظم النواحي أكثر راحة وحرية منه في أي مكان في أوروبا الشرقية آنذاك’’، وأن الحكم العثماني قضى على طبقة النبلاء المحلية وأزال لعنة الحروب الأرستقراطية المتواصلة في الريف.[64]
ومن الصفات الفريدة التي تحلى بها الحكم العثماني ما رواه السفير النمساوي في بلاط السلطان سليمان جيسلان دي بوسبك (1555- 1562) الذي بهر برعاية العثمانيين للمواهب واهتمامهم باجتذابها وتنميتها حتى أصبح كل إنسان يعتمد على مجهوده ويفخر بأنه وصل إلى المعالي بقدراته الذاتية رغم تواضع أصله مما حرم عديم الشرف والجاهل والكسول والعاطل من تبوء المناصب الرفيعة، ’’وهذا هو السر وراء نجاح العثمانيين في كل عمل أقدموا عليه، فتحولوا إلى جنس ساد العالم كله، واتسعت رقعة أراضيهم إلى هذا الحد’’،[65] في الوقت الذي كانت فيه أوروبا، كما يصفها، تعتمد الأحساب والأنساب في تقويم البشر، وكانت تهتم برعاية مواهب الحيوانات أكثر من مواهب الرجال.[66]
5- الاستبداد السياسي كان مقيداً: نبعت تهمة الظلم الذي لف القرون العثمانية من صفة الاستبداد السياسي التي طالما ألحقت بالحكم العثماني وقد تطرقت إليها في دراسة سابقة (أثر التغريب السياسي على المجتمع الإسلامي/1) وملخص ما جاء فيها أن سلطة السلطان حددت بسلطات أخرى حكمت رقعة الدولة، وأضيف هنا ما قاله مجموعة من المؤرخين عن تحديد سلطة السلطان العثماني بالشرع الإسلامي الذي يحكم جميع المسلمين ويؤلف قاعدة البناء السياسي والاجتماعي للدولة ويخضع له الجميع وهو من ضمنهم، ولهذا يستنتج برنارد لويس أن السلطان ’’لم يكن مستبداً حقيقياً’’،[67] ويؤكد كارابل الناحية نفسها وهي أنه رغم سلطات السلطان الواسعة ’’كان هو نفسه مقيداً وخاضعاً للشرع الإسلامي كأي واحد من المسلمين، وكغيره ممن سبقه من الحكام، راعى السلطان العلماء والقضاة واحترمهم’’.[68]
6- الإقطاع مجرد اشتراك لفظي: استخدمت كثير من المؤلفات التاريخية صفة الإقطاع سيئة الصيت والمستعارة من الواقع الأوروبي لوصم الحياة الاقتصادية في الدولة العثمانية وللاستدلال على الظلم الذي كان يلف أرجاءها استناداً إلى الاشتراك اللفظي مع الإقطاع الأوروبي، وليس هنا مجال تفصيل حقيقة الإقطاعات العثمانية ولمن كانت تمنح، فما يهمنا هو اختلاف النظام العثماني جذرياً عن الإقطاع في أوروبا، وفي ذلك يقول إيفانوف إن العثمانيين قاموا بتصفية الإقطاع وغيره من أشكال الملكية الإقطاعية التي كانت سائدة منذ أيام الموحدين والأيوبيين ونقلوا الأراضي إلى ملكية الدولة التي أعطتها للفلاحين الذين ألغيت كل التزاماتهم الإجبارية المفروضة عليهم تجاه أصحاب النفوذ،[69] وكان صاحب الإقطاع، وفقاً لأندري كلو ’’ليس له أي حق في السيطرة على الفلاح ومقاضاته، فله مجرد حق الشرطي المرتبط بالقاضي الذي بدون قراره لا يمكن له اتخاذ أي إجراء قهري’’،[70] ويلاحظ بيري أندرسون أن الفرسان العثمانيين ’’لم يمارسوا أية سيادة إقطاعية على الفلاحين الذين كانوا يعملون في تيماراتهم (أي إقطاعاتهم)’’، وفي الوقت الذي كان فيه الفلاحون يتوارثون إجارة القطع التي يحرثونها، لم يكن هذا الامتياز ممنوحاً للفرسان الملاك الذين لم يكن من سلطتهم أيضاً تغيير الضرائب وفق مشيئتهم وكان أمر تحديدها منوطاً بالباب العالي،[71] كما غابت القنانة قانونياً من الولايات العثمانية،[72] ولكل هذا لم تظهر طبقة إقطاعية وراثية في الدولة العثمانية إلا بعد إجراءات التغريب في القرن التاسع عشر.
*****
ومن نافل القول أن كل هذه الحقائق لا تتفق مع سيادة الظلم والضعف والركود والجهل وبقية الصفات السلبية التي طبعت الأذهان عن مجمل تاريخ الدولة العثمانية والتي لم يكن لها أن تصمد في وجه أوروبا القوية قروناً لو كانت هذه هي صفاتها، وربما كانت هذه الصفات أقرب إلى أوضاعها في آخر أيامها، وليس من أهدافي أن أنفي أي عيب عن فترة الحكم العثماني، فقد تعرض المثل عند تطبيقه للانحدار والفساد والبعد بدرجات متفاوتة عن المثل العليا مثل أي تاريخ بشري لا سيما إذا استمر طويلاً، وقد كتب الكثير عن هذه العيوب وليس هناك داع لتكرارها، وهدفي الواضح هو أن أنفي أن القرون العثمانية طبعت جميعها بالصفات السلبية التي ناقشتها والتي يحمّل تخلفنا المعاصر على أكتاف طول استمرارها.
ومع ذلك فقد تميزت المراحل العثمانية الأخيرة بمقاومة ملحمية لظروف الضعف والإنهاك التي تمكنت منها، ’’وكان السلطان العثماني يحاول جاهداً الاحتفاظ بما عنده’’ رغم أنه ’’لم يكن في وضع يسمح له بفرض الحدود على أي كان’’،[73] وظلت الدولة العثمانية ’’تكافح لإصلاح ذاتها والحفاظ على وجودها دولة حديثة، اضطرت في البداية إلى أن تستنزف مواردها المحدودة لتحمي شعبها من القتل على يد أعدائها، ثم إلى أن تحاول أن تقدم الرعاية للاجئين الذين تدفقوا إلى الامبراطورية عندما انتصر هؤلاء الأعداء’’،[74] وكان لها حضور أيضاً في ساحة الإنجازات.
إنجازات آخر أيام الخلافة
لقد كتب الكثير عن مظاهر الضعف والتراجع في آخر سني الدولة العثمانية، ولكن الخلافة حققت إنجازات كبرى في آخر أيامها رغم كل ذلك، وقد تمتعت بلادنا العربية في ظلها بآخر مظاهر وحدتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي لم تستطع الدول التي نشأت بعدها وفقا لاتفاقيات التجزئة كسايكس بيكو (1916) والحكم الثنائي (1899) والعقير (1922) حتى مجرد العودة إلى هذه المظاهر فضلا عن تحقيق ما هو أفضل منها:
فعلى الصعيد السياسي قاومت الخلافة في زمن السلطان عبد الحميد مشاريع التفتيت الغربية، بفكرة الجامعة الإسلامية التي استهدفت التصدي للعدوان الغربي على المسلمين ولهذا أصبحت غولاً مرعباً لأوروبا بتعبير بعض المؤرخين، وقد نتج عن تبني هذه الفكرة أن ظلت الهوية الجامعة هي التي تلم شعث عناصر الدولة المختلفة ولم تظهر الانقسامات القومية إلا بعد خلع السلطان ومجيء القوميين الاتحاديين إلى الحكم 1908- 1909، وقد دعم السلطان هذه الفكرة بمشاريع حيوية كسكة حديد الحجاز التي بنيت بأموال المسلمين دون اللجوء إلى الديون الأجنبية وعدّتها بريطانيا مناهضة لمصالحها فعملت على تعطيلها ثم تدميرها فيما بعد ومازلنا عاجزين عن إعادة تشغيلها كما كانت، كما دعم السلطان فكرته الإسلامية بتقريب العرب - أهل لغة القرآن- من مركز اتخاذ القرار حتى قيل في زمنه إنه إذا كان الأتراك يهيمنون على الوزارة فالعرب يهيمنون على القصر السلطاني نفسه، وبث الدعاة والمبعوثين والمطبوعات في ديار المسلمين لتشجيعهم على الالتفاف حول الخلافة، وقاوم مشاريع الاستيطان الغربية إضافة للاستيطان الصهيوني الذي وعد بتسوية ديون الدولة وهو عرض شديد الإغراء لدولة غارقة في الديون، ورفضت الدولة إلى جانبه مشاريع استيطان فرنسية وبريطانية وأمريكية بل حتى من ألمانيا حليفة العثمانيين التي لم تتمكن من تنفيذ استيطانها لأن الدولة العثمانية فضلت أن تظل أراضيها الفارغة مخزونا احتياطياً للمسلمين المضطهدين في أوروبا وروسيا كالشركس والشيشان والبشناق ومسلمي اليونان وألبانيا وبلغاريا، وظلت الخلافة لا تعترف بالتغيرات السياسية التي صنعها الاحتلال الأوروبي حتى آخر أيامها، ورغم رمزية هذا الإنجاز في مواجهة الآلة العسكرية الاستعمارية فإن الدول الغربية أصرت على انتزاع تخلي تركيا الكمالية عن السيادة العثمانية على ما عدا الأناضول في اتفاقية لوزان (1923) وذلك ليصفو لها جو احتلال هذه البلاد العربية قانونياً، وهو ما حققه لها كمال أتاتورك بكل سهولة واشترى به استقلالاً موهوماً لتركيا ليربطها حقيقة بذيل أوروبا وهو وضع رفضته الدولة العثمانية في أشد ساعات تراجعها وقامت في النهاية بدخول الحرب الكبرى الأولى للوقوف ثانية على مستوى بقية الدول الكبرى.
وعلى صعيد السياسة الخارجية ظلت الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر’’قوة يحسب حسابها في السياسة الخارجية في كل من بريطانيا وفرنسا وإمبراطورية النمسا وكذلك ألمانيا وإيطاليا، ومن جهة أخرى فقد بقيت قوى محلية في الهند وآسيا الوسطى وشمال إفريقية تتطلع إلى الدولة العثمانية لحماية مصالحها’’.[75]
وعلى الصعيد الاقتصادي حافظت الدولة العثمانية حتى آخر أيامها على أهمية التجارة بين ولاياتها وكانت التجارة الداخلية مقدمة على التجارة الخارجية وهو ما تفتقده بلادنا في زمن التجزئة إذ يسيطر الغرب على معظم تجارتها ولا تشكل التجارة بين البلاد العربية إلا 8% من مجموع تجارتها، كما حافظت الدولة على درجة عالية من الاكتفاء الذاتي الغذائي على عكس دول التجزئة التي تستورد معظم غذائها حتى لو كانت بلاداً زراعية تقليدية وتخضع لسلاح الغذاء الذي يشهره الغرب في وجه العرب إذا حاولوا استعمال سلاح النفط لنصرة قضاياهم، ولم تعتمد الدولة العثمانية على تصدير منتج واحد بل نوعت منتجاتها الزراعية وقاومت المحاولات الغربية لتحويلها إلى الزراعة الأحادية تلبية لحاجات أوروبا على عكس حالة التجزئة العربية التي صنعها الاستعمار وفق مصالحه الحصرية، وقاومت الدولة كذلك تمدد الصناعات الغربية فحافظت على كثير من الصناعات الحرفية التي ظلت توفر معظم الحاجات لسكانها، ودخلت عصر التصنيع الآلي رغم الصعوبات الاقتصادية وشهد عهد السلطان عبد الحميد وما بعده إنشاء كثير من المصانع حتى في مجال التسلح الذي كان العثمانيون يصدرونه إلى الخارج إضافة للاستخدام الداخلي، ولم تستسلم الدولة لمطالب الدائنين بعد إفلاسها سنة 1875 وفرض السلطان عبد الحميد عليهم تسوية ألغت نصف الديون وتجنبت الدولة بذلك مصير ولاياتها التي أصرت على الاستقلال عنها مثل مصر وتونس مما أدى إلى تفرد المستعمرين الدائنين بها فوقعت في براثن الاحتلال الأجنبي البريطاني والفرنسي، وتمكن برنامجه الاقتصادي من زيادة الإيرادات بنسبة 43% في غضون ربع قرن مما أثار انتباه المؤرخين، كما جذب الاقتصاد العثماني في هذه الفترة استثمارات أجنبية في البنية التحتية ولكنه لم يستسلم لمتطلبات المصالح الأجنبية وتمكن من فرض المصالح العثمانية على عملية إنشاء المشاريع الاستثمارية، وكانت الدولة قادرة على الاختيار بين عروض الاقتصاديات الغربية عندما تمكن السلطان عبد الحميد من تحويل المنافسات الاستعمارية على بلاده إلى منافسات اقتصادية لتطويرها، وكانت الدولة الكبرى التي تعادي الدولة العثمانية يتضاءل نفوذها التجاري أو الاستثماري أو المالي تبعاً لذلك كما حدث مع بريطانيا، والعكس يحدث مع الدول التي تعرض صداقتها دون أطماع طاغية كما حدث مع ألمانيا، وهو ما نفتقده في عصر الاستقلال الوهمي والتجزئة المجهرية إذ يزيد نفوذ الغرب لدينا كلما أمعن في معاداة قضايانا ومصالحنا لأنه يجد تربة خصبة في التجزئة لحفز التنافس بين الأقزام على إرضائه مهما أجرم في حقوقهم.
وعلى الصعيد العسكري ظل الجيش العثماني محتفظا بقدر كبير من التماسك والعناد حتى آخر أيامه فصمد في وجه روسيا (1877- 1878) وانتصر على اليونان (1897) ثم دخل الحرب الكبرى الأولى (1914) ليستعيد ما احتله الحلفاء من قبل وليخلص الدولة من قيود الامتيازات الأجنبية وتمكن من تحقيق انتصارات مهمة على جبهات مضائق اسطنبول (غاليبولي) والقوقاز والبلقان وفلسطين (غزة) والعراق (الكوت) والجزيرة العربية (سكة الحجاز) ولكن الانتصار في معارك لا يعني الانتصار في الحرب وبخاصة أمام غيلان الغرب المتحالفة التي صممت على تدمير دولة تمثل آخر مظاهر وحدة المسلمين كما أكد على ذلك بلفور ولورنس في أثناء الحرب.
وشهد زمن السلطان عبد الحميد كذلك مشاريع عمرانية كسكة حديد بغداد التي كان من المخطط أن تصل عواصم أوروبا باسطنبول فبغداد فالكويت والتي بذلت بريطانيا كل ما في وسعها لتعطيلها، وأدت هذه السكة مع سكة الحجاز إلى إعمار كثير من المناطق التي مرتا بها في الأناضول والهلال الخصيب والجزيرة العربية، كما أنشئت سكك الحديد الأخرى في بلاد الشام التي تفوقت على الأناضول في نسبتها، ومدت شبكة التلغراف في أنحاء الدولة، وشهدت مدن عربية مثل بيروت عمراناً استثنائياً، وعمرت المواقع الفلسطينية المهجورة لمناهضة الاستيطان الصهيوني، وبنيت مدينة بئر السبع (1900) لتوطين العشائر البدوية التي شهدت عملية استقرار ملحوظة في أنحاء الدولة التي شجعت هذه العشائر على ذلك بمد العمران (بناء الناصرية والعمارة في جنوب العراق مثلا)، كما استهدف بناء مدينة بئر السبع مناهضة تمدد الاحتلال البريطاني من مصر حيث دعم السلطان عبد الحميد الحركة الوطنية بزعامة مصطفى كامل باشا ضد الاحتلال البريطاني دعماً مطلقاً، كما شهدت الدولة نهضة تعليمية نشرت آلاف المدارس في كل مكان فيها ونهضة ثقافية عدها المؤرخون من أغزر ما شهده تاريخ الدولة في هذا المجال.
ولو قدر لبلادنا الاحتفاظ بوحدتها والسير في تقدمها بنفس المعدل منذ ذلك الوقت لكنا في مكان آخر اليوم وهو ما يعطي أجيالنا درساً موثقاً عن أهمية الوحدة وإنجازاتها، لأن منطق الوحدة والكيان الجامع حتى مع الضعف الطارئ أفضل من منطق التجزئة والفرقة الملازم للاستسلام، فالكيان الكبير يفرض على أصحابه منطق الدولة العظمى الذي يقتضي العمل المستمر على البقاء في المقدمة ويتمكن من ذلك بالإمكانات الكبيرة المتوفرة لديه من الاتساع الجغرافي كما نرى في الدول الكبرى اليوم، أما الكيانات الصغيرة العاجزة عن إطعام أنفسها والدفاع عن حدودها وتلبية حاجات مواطنيها لقلة إمكاناتها فإنها لا ترى الحل إلا في التبعية للدول الكبرى المعادية لقضايانا والتي حققت اكتفاءها على حساب ثرواتنا المبعثرة بين أيديها. (كل الفقرات غير الموثقة في هذا البند تلخيص لدراسة سابقة هي سياسات آخر أيام الخلافة: قضايانا بين الوحدة والتجزئة).
الاستنتاج
في زمن يعيد فيه المستعمِرون الاعتبار لتاريخهم الاستعماري زاعمين أنه تاريخ إيجابي حتى لمن كان ضحيته، من الأوْلى أن يكف فيه الضحايا عن تشريح ذواتهم ولوم تاريخهم الحديث الذي لم يدخر وسعاً للدفاع عن وجودهم وبقائهم ضد قوى عظمى قضى الله أن تكون في مرحلة الفتوة التي تجاوزناها منذ زمن فكان لها بذلك ميزة علينا في حلبة المنافسة ولم يكن بإمكاننا وقتها إعادة عقارب الساعة إلى الوراء بلمح البصر أو إنجاز القفزة المطلوبة في لحظات في وقت اقتضى إنجازها قروناً عند أصحابها[76] بعيداً عن القوى الخارجية المعرقلة[77] التي حفل بها تاريخنا الحديث،[78] ومن الأجدى اليوم الانشغال بهموم اللحظة الحاضرة بدلاً من استمرار البكاء على ما فات والانشغال بتشويه مرحلة تاريخية اتسمت بإنجازات كبرى عجزت عنها المراحل التالية وبصمود عز نظيره آنذاك بين الأمم، كما لا يمكن لنا الانطلاق بثقة لبناء المستقبل مادامت لدينا قناعات سلبية عن ماضينا الذي يستحق منا تقديراً أكبر يدعم قدراتنا التي يشلها اليوم انعدام الثقة بالذات المؤدي للانبهار بما عند الأعداء ومن ثم الوقوع في فخ الاستلاب، في الوقت الذي تؤكد فيه الدراسات التاريخية الأجنبية المحايدة أكثر من العربية، مع الأسف، وجوب فخرنا بهذا التاريخ الذي طالما استقيناه كله من مصادر معادية.[79]