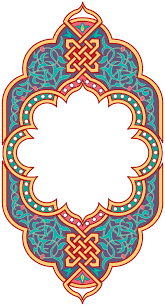من أشد مظاهر الخلل تجاه عقيدة القضاء والقدر، القول بأن العباد ليس لهم اختيار في سلوك طريق الخير أو الشر، فيحتجّ أصحاب هذا التصور لمخالفاتهم بالقدر.
وسبب هذا الخلل، الخلط بين إرادة الله الكونية وإرادته الشرعية، فالله تعالى أراد المعصية قدَرًا لحكمةٍ مقتضِية، لكنه لم يردها شرعًا ولا يحبها ولا يرضاها ونهى عن ارتكابها.
قال في مختصر معارج القبول: «لو لم يقدر الله السيئات لجبر عباده كلهم على الإيمان، ولما كان هناك فريقان أحدهما يستحق الجنة والآخر يستحق النار، ولانتفت حكمة الله عز وجل من ابتلاء العباد في هذه الحياة، وهو سبحانه لم يرد هذه السيئات شرعاً بل نفر عنها وإنما شاء وقوعها في الكون مشيئة قدرية يتحقق بها عدل الله تعالى ويكون من ورائها الخير».
احتجاج المذنبين على معصيتهم بأن الله قدّرها عليهم يوقعهم في تناقضات واضحة، لأنه لو كان يصلح الاحتجاج بالقدر على المعصية لكان ذلك في حق الناس جميعًا ولا يلامون عليها، فلماذا إذن لا يتعامل بهذه القناعة مع من يظلمه ويسلب حقوقه؟ أليس ذلك مقدرًا؟ فلم يُجنّ جنونه لو أخطأ أحدٌ بحقه؟ لماذا لا يقول: لا بأس فالله قدر عليّ ذلك؟!
ولو كان الاحتجاج بالقدر على المعصية مقبولًا للزم أن يكون إبليس وفرعون وهامان وقارون معذورين في طغيانهم، طالما أن الله قدر ذلك، فلذلك هي دعوة باطلة يترتب عليها تعطيل الشريعة والمساواة بين الصالح والفاسد.
الله سبحانه وتعالى أقدر عباده ومكنهم من أداء ما يُؤمرون به وترك ما يُنهون عنه، فيقول {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}، فكيف ينهاهم عن المعصية وهم عاجزون عن التخلي عنها؟
ومن العجب أن المحتج بالقدر لمعصيته لا يفعل ذلك في الأمور الحياتية، فهو لا يقول لو أن الله كتب لي الذرية لوهبنيها دون أن يسعى للزواج، ولا يجلس المزارع في بيته ويقول لو أراد الله أن تنبت الأرض لأنبتها دون أن يبذر ويروي ويحرث، إنما يقول ذلك عندما يؤمر بالصلاة مثلا فيأبى معللًا ذلك بأن الله لو كتب عليه الصلاة لصلى.
الله تعالى قدَّر المقادير بأسبابها، وجعل للعبد اختيارًا وإرادة، ولم يجبره على الطاعة ولا المعصية، وبيَّن له طريق الخير والشر، فمن سلك طريق الجنة كان من أهلها، ومن سلك طريق النار كان من أهلها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلاَّ كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَإِلاَّ قَدْ كُتِبَ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا، وَنَدَعُ الْعَمَلَ فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَّا مَنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ قَالَ: أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسِّرُونَ لَعَمَلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَبُيَسِّرُونَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَأَ (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى) الآية).
يحتج هؤلاء على تصورهم الفاسد بحديث: (احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسى فَقَالَ لَهُ مُوسى: يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا، خَيَّبْتَنَا، وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ لَهُ آدَمُ: يَا مُوسى اصْطَفَاكَ اللهُ بِكَلاَمِهِ، وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ، أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدَّرَ اللهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً فَحَجَّ آدَمُ مُوسى).
والاستدلال بهذا الحديث على جواز الاحتجاج بالقدر للمخالفة فيه مغالطة كبيرة، فإن آدم عليه السلام لم يحتج بالقدر على المعصية، وإنما احتج به على المصيبة، قال في شرح الطحاوية: «وَإِنَّمَا وَقَعَ اللَّوْمُ عَلَى الْمُصِيبَةِ الَّتِي أَخْرَجَتْ أَوْلَادَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، فَاحْتَجَّ آدَمُ بِالْقَدَرِ عَلَى الْمُصِيبَةِ، لَا عَلَى الْخَطِيئَةِ، فَإِنَّ الْقَدَرَ يُحْتَجُّ بِهِ عِنْدَ الْمَصَائِبِ، لَا عِنْدَ الْمَعَائِبِ».
ويقول ابن القيم: «وقد يتوجه آخر وهو أن الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع، فينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته كما فعل آدم فيكون في ذكر القدر».
فليس لمذنب أن يجعل من القدر تبريرًا للمخالفة، وليس له أن يتخاذل في طاعة الله بحجة أن الله لو أراد لجعله من المطيعين، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.