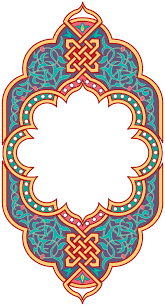يقع دعاة وعلماء الإسلام دائما على خطوط التماس مع جهتين، مع السلطات الحاكمة المتنفذة من ناحية، ومع أفكار الناس وأهوائهم وموروثاتهم الفكرية والاجتماعية من ناحية أخرى، وكلتاهما تمثلان جبهة ضاغطة على مسيرة العلماء والدعاة في الانسجام والتماهي معها.
ومن أجل ذلك كان التحذير القرآني متمثلا في خطاب رباني للنبي صلى الله عليه وسلم {ولولا أنْ ثبَّتناكَ لقد كِدْتَ ترْكن إليهم شيئًا قليلًا} [سورة الإسراء: 74]، فهو سبحانه يُظهر فضله على نبيه بأنه لولا عنايته وحفظه إياه، لمال إلى المشركين، لذا يقول الإمام ابن القيم: “الخلق كلهم قسمان: موفق بالتثبيت، ومخذول بترك التثبيت”، وفي هذا بيان لفتنة مسايرة الواقع والاستجابة لضغوطه.
قد يستجيب الداعية لضغوطات الواقع، فيلجأ إلى موافقة الناس عبر طرْحه الأقوال الشاذة المهجورة لينسجم مع أهواء مجتمعه، فيكون كل همه أن يشرعن للناس الخلل، فإذا ما ظفر من بطون كتب الفقه بقول شاذٍ لا يُعمل به ولا وزن له، أتى به ليوافق هوى الناس، أو يقوم بتأويل النص على نحو لم يأت به أحد من العلماء الثقات، وهو يحسب أنه يحسن صنعا، ثم يحاول تهدئة ضميره بالحديث عن اختيار أيسر الأقوال للناس وعدم تحجير الواسع، أو التوسعة على الناس في الأقوال، ولا يفرق في ذلك بين كون الرأي مرجوحًا وبين كونه شاذا لا يُعتدُّ له، وكأن الدعوة إلى الله صارت مهمتها إرضاء الأذواق والأهواء؛ وفي ذلك يقول الشاطبي رحمه الله: “المقصد الشرعي من وضع الشريعة، إخراج المكلف عن داعية هواه، حتى يكون عبدا لله اختيارا، كما هو عبد لله اضطرارا”.
يضغط الواقع على الداعية ليُساير بإقرار المحدثات التي ساقها الموروث الفكري والثقافي للمجتمع، والذي يضر بوعي الجماهير، وتلك آفة الأمم التي تعامل معها المرسلون {إنَّا وجدْنا آباءنا على أُمَّةٍ وإنَّا على آثارهم مُقْتَدون} [سورة الزخرف: 23]، فإن ضعف عن مواجهة الواقع شاركهم في إقرارها، ووفقا للمنطق التبريري يؤصل لهذا الشطط، فتارة تحت مظلة (التدرج في الدعوة)، وتارة تحت دعوى (مخاطبة الناس على قدر عقولهم)، وتارة أخرى تحت شعار (تأليف القلوب)، حتى تغدو المخالفة أو البدعة أمرًا واقعًا، ويُحتج لها بأن فلانا الداعية يقول بها، وأن فلانا الداعية يفعلها.
وفي الوقت الذي يُتهم فيه الإسلام بإنتاج الإرهاب ويُحاسب النصّ الإسلامي المعصوم، تلقي هذه الفتنة بظلالها، ويحاول الداعية إثبات وسطية الإسلام وإبراز القيم الإنسانية التي جاء بها، فليته يكتفي بالتأكيد على تلك الوسطية المثبتة، لكنه يميل ويجنح إلى تقديم الدين في قالب يرضي توجهات المخالف ولو أتى ذلك على حساب الشريعة وتمييع ثوابت الدين؛ فيسعى حينًا لخلط المنهج الإسلامي بغيره ليثبت أن الاشتراكية من الإسلام، أو أن الليبرالية لها جذور في الإسلام، أو قد يركب موجة الفكر المعتزلي لإقصاء بعض النصوص التي يُزعم أنها لا توافق العقل للهرب من وصف المسلمين بالرجعية والتخلف.
واليوم، يشكل الموقف من المقاومة الفلسطينية التي تقف حركة حماس في القلب منها، واحدة من أبرز الصور الحالية التي يُمتحن فيها الدعاة أمام ضغط الواقع؛ فبعض العلماء والدعاة قد استجابوا لتوجهات أنظمتهم الحاكمة في شيطنة حماس، باعتبارها امتدادا لفكر الإخوان المسلمين المستهدف في العديد من الدول العربية. يعمل هؤلاء الدعاة على شيطنة حماس واتهامها بالتسبب في الدمار الحاصل في قطاع غزة، واتهامها بالجهل والبعد عن صحيح المعتقد، وأنها وبال على الأمة، ومشعلة الفتن والاضطرابات فيها، وأنها ليست سوى ذنَب إيراني.
هؤلاء الدعاة والعلماء لم يراعوا الظرف التاريخي ولا أولويات المرحلة، ولم يتعاملوا مع المقاومة على أنها حركة تحررية تهدف إلى تحرير الأراضي الفلسطينية العربية الإسلامية بمقدساتها، وأسقطوا من حساباتهم أن الوقت ليس لتصفية حسابات مع فصائل المقاومة على قاعدة التصنيف والأيديولوجيا؛ وهم – كما أسلفنا- يندفعون غالبا في هذه النظرة وخلال هذا المسار بضغط السلطة، وحتما ليس ذلك بمبرر يعفيهم من المساءلة، فزلة العالم تختلف عن زلة الإنسان العادي، وكان الأولى بهم إن لم يستطيعوا الدعم أن يكفوا ألسنتهم وأقلامهم عن فصائل مقاومة تنوب عن الأمة في الدفاع عن أرض محتلة، ضد العدو المحتل.
إن من شأن استجابة الدعاة لضغط الواقع ومسايرة اعوجاجه، الإسهام في تذويب هوية المسلمين وشخصيتهم الإسلامية، ومع مضي الوقت يرضى الدعاة بالمخالفات، كما أن استجابتهم لضغوط التوجهات الرسمية تعرضهم لممارسة خديعة كبرى بحق الشعوب، عندما يتعلق الأمر بالقضايا الكلية الكبرى والأحداث العظيمة التي تمر بها الأمة، وإضافة إلى ذلك يفقد هذا الداعية مصداقيته لدى المجتمع، كما هو حال كثير من الدعاة الذين سقطوا في تلك الحفرة رغم بذلهم الجهد للتماهي مع الواقع، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.