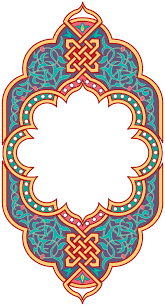كما رُويَ في الحديث (الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها)، لذلك لا يستنكف الإنسان أن يلتمس الحكمة من أصغر مخلوقات الله، ومن ذلك ما خلده القرآن الكريم من حديث نملة سمعها نبي الله سليمان عليه السلام والذي علمه الله منطق الطير.
ونحن كمؤمنين، نصدق بما أنزله الله تبارك وتعالى، ونؤمن بكل ما أخبرنا به القرآن الكريم، فلقد حكى قول نملة خشيت أن يطأ قومَها جيشُ النبي سليمان فيهلكهم، فجعلت تحذر قومها وتنذرهم بالخطر العظيم: {حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَاأَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ } [النمل: 18].
ولنا هنا وقفة مع جملة قصيرة قالتها النملة: (وهم لا يشعرون)، فهي تعطي درسا تاريخيا إلى يوم القيامة، بتقديم حسن الظن بالآخرين، وهو أمر عظيم، تخلينا عن الامتثال لقيمته في معظم مناحي حياتنا، فأصبح سوء الظن بالناس هو الأساس، تارة نسميه حذرا، وتارة نسميه فطنة، وتارة نسميه دراية كافية بواقع الناس.
وكون القرآن يحكي عن النملة تلك المقولة في موقف عظيم كهذا تترتب عليه حياة قومها، فلا ريب أنه منطق بالغ الأهمية أراد القرآن تبيانه للناس.
سوء الظن بالناس مفسدة للعلاقات بينهم، يفترض في الآخرين أنهم شياطين إلى أن يثبت العكس، فيفوت فرصة صفاء النوايا والتعامل العفوي بروح المحبة والتسامح، ولذا جاء التحذير القرآني من سوء الظن: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} [الحجرات: 12].
إننا بحاجة إلى التخلُّص من أسْر الحُكم على النِّيات واتهامِها، بحاجةٍ إلى إجراء الأحكام على الظاهر؛ كما أجمع على ذلك أهل العلم، بحاجةٍ إلى مدافعة الخواطر الرديئة في النفس والتي تَزيد من اشتعالها تجاه المسلمين، بحاجةٍ إلى الْتماس الأعذار وتأويل السيِّئات على الوجه الحسن إن كانت تحتمل، بحاجةٍ إلى الكفِّ عن التفتيش في قلوب الناس والبوْح عن سرائرهم بالظن والتخرُّص.
وجاء البيان النبوي كذلك بالتحذير من سوء الظن، قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إيَّاكم والظنَّ؛ فإن الظنَّ أكذبُ الحديث))، وقال الفاروق عمرُ بنُ الخطاب – رضي الله عنه -: “لا تظنَّ بكلمة خرجت من أخيك المؤمن شرًّا وأنت تجد لها في الخير محملاً “.
وامتد هذا المنهج النقي إلى التابعين ومن تبعهم بإحسان، فهذا ابن سيرين رحمه الله يقول: “إذا بلغك عن أخيك شيءٌ، فالتمس له عذرًا، فإن لم تجدْ، فقل: لعلَّ له عذرًا لا أعرفُه “.
وانظر إلى الإمام الشافعي رحمه الله حين مرض وأتاه بعض إخوانه يعوده، فقال للشافعي: “قوَّى الله ضعفَك”، قال الشافعي والذي هو بلغة العرب خبير عليم: “لو قوَّى ضعفي لقتلني”، قال: والله ما أردتُ إلا الخيرَ! فقال الإمام: “أعلمُ أنك لو سببتني ما أردتَ إلا الخيرَ “.
فهذه الرُّوح لا بدَّ أن تسودَ الناس، فهي سبيل لالتئام الشمل ولمّ الشعث، وخطوة سديدة عظيمة على طريق حل الخلافات، علما بأن سوء الظن لا يتعارض مع الحذر، فالأول دليل سوء طويّة، والآخر دليل فطنة وكياسة.
إننا بحاجة لمعالجة أمراضنا الاجتماعية التي استشرت وحوّلت العلاقات بين أبناء المجتمع الواحد والأمة الواحدة إلى جحيم حقيقي، والسبيل إلى ذلك هو التزام الإطار الأخلاقي للإسلام، لاتسامه بالربانية، فهو رباني المصدر لن يضل الطريق إلى إصلاح حياة البشر، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.