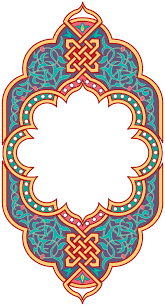معظم الأفكار التي تنادي بإقصاء المنهج الإسلامي، يربطون بينه وبين التخلف والجهل والرجعية التي تعاني منها بلادنا، ويدّعون بأنه ليس كفيلا بوضعنا على مسار السباق الحضاري، على الرغم من أن التاريخ يضم في صفحاته حضارة إسلامية ساطعة، فتحت الطريق أمام العالم بأسره للتقدم والازدهار.
لقد جاء الإسلام بمنهج شامل متكامل لإسعاد البشرية، وإخراجها من الضيق إلى السعة ومن الجور إلى العدل، جاء بمنظومة عقدية تشفي النفوس الحائرة في قضية الكون، وتجيب على أسئلته الهائمة بشأن الخلق، وجاء بمنظومة من القيم والأخلاق التي تتسم بالثبات لأنها ربانية المصدر، وبالواقعية فتتناغم مع طاقات البشر وقدراتهم، وبالمرونة أيضا، فهي تراعي الحالات الخاصة، فيبيح الإسلام مثلا الكذب على الزوجة لتأليف قلبها.
وجاء الإسلام كذلك إلى الإنسان بمهمة الاستخلاف وعمارة الأرض، باعتبار الإنسان موضوع الرسالة، فهو يدعو للأخذ بأسباب الحضارة والقوة وإعمار الحياة، ويعتبر ذلك من صميم العبودية التي خلق الله الناس من أجل تحقيقها، وإنك لتقرأ في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وصية عظيمة بهذا الصدد: (إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها).
إنه يجعل من عمارة الأرض شيئا تتصل به الدنيا بالآخرة، فهما طريق واحد أوله في الدنيا وآخره في الجنة.
هو ذلك الإسلام الذي قال لمعتنقيه {فامشوا في مناكبها} هو الذي قال {وأعدوا}، هو الذي قدم لنا في الكتاب قصة ذي القرنين بأبعادها الحضارية، والهدهد السليماني بأبعادها الإدارية والقيادية، تعليما للناس كيف بالإسلام يعيشون وبه يرتقون.
ولما استمسك المسلمون الأوائل بالكتاب والسنة وعضوا عليهما بالنواجذ، أفرز ذلك حضارة إسلامية بلغت المشارق والمغارب، وقدمت أنموذجا فريدا في سياق التاريخ.
وإنَّ ما أصاب الأمة من تخلف وتدهور لا يستطيع أحد إنكاره، قد أصابها بعد نأي أبنائها عن المنهج، والسير وراء كل ناعق يستورد أفكارا سادت في أرض غير الأرض، ومناخ غير المناخ، واجه بها الغرب ظرفا زمنيا قاهرًا، وواجهوا أوضاعا سيئة بحلول أخرى سيئة.
العلاقة بين الإسلام والتحضر، علاقة طردية، متى تمسك به أتباعه تقدموا وازدهروا، حتى إذا ما جعلوه وراءهم ظهريا تخلفوا وتنكبوا، فهو ليس مسئولا عن التخلف، وإنما يُسأل عن ذلك من حصروه في المساجد والزوايا والتكايا، أو قالوا بأن الدين لا يصلح لهذا الزمان، أو قاموا بتفريغه واختزاله إلى علاقة بين العبد وربه.
لقد أنصف بعض الكتاب والفلاسفة الغربيين عندما خرجوا عن قيود التعصب الأعمى، وأظهروا الحقيقة الساطعة بين الإسلام والتحضر والتقدم، ومن هؤلاء الفيلسوف الفرنسي «جوستاف لوبون» في كتابه «حضارة العرب» إذ يقول عن العرب: «الجامعات الأوروبية ومنها جامعة باريس عاشت مدة ستمائة عام على ترجمات كتبهم وجرت على أساليبهم في البحث، وكانت الحضارة الإسلامية من أعجب ما عرف التاريخ «.
ومنهم المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه في كتابها «شمس العرب تسطع على الغرب» حيث تقول: «إن أوروبا مدينة للعرب وللحضارة العربية، وإن الدين الذي في عنق أوروبا وسائر القارات للعرب كبير جدا. وكان يتعين على أوروبا أن تعترف بهذا الفضل منذ زمن بعيد، لكن التعصب واختلاف العقيدة أعميا عيوننا وتركا عليها غشاوة».
وفي كتابه «معالم تاريخ الإنسانية»، يقول الكاتب البريطاني هـ. ج. ويلز عن المسلمين العرب:
«وتقدموا في الطب أشواطا بعيدة على الإغريق، ودرسوا علم وظائف الأعضاء،… وكان لجراحيهم دراية باستعمال التخدير، وكانوا يجرون طائفة من أصعب الجراحات المعروفة. وفي ذات الوقت التي كانت الكنيسة تحرم فيه ممارسة الطب انتظارا منها لتمام الشفاء بموجب المناسك الدينية التي يتولاها القساوسة، كان لدى العرب علم طبي حق».
إنها غيض من فيض شهادات غربية بالحضارة التي قامت على الإسلام، نخاطب بها دائما المنبهرين ببريق الغرب الذين يتهمون الإسلام بالمسؤولية عن تخلفنا عن ركب الحضارة، مع أنه في الأزمان التي تمسك فيها المسلمون بهذا المنهج أقاموا حضارة أدهشت الأمم، وإننا لم نتخلف عن الركب الحضاري إلا بعدما نأينا عن التمسك بهذا المنهج الذي يوفر كل سبل التقدم والازدهار، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.