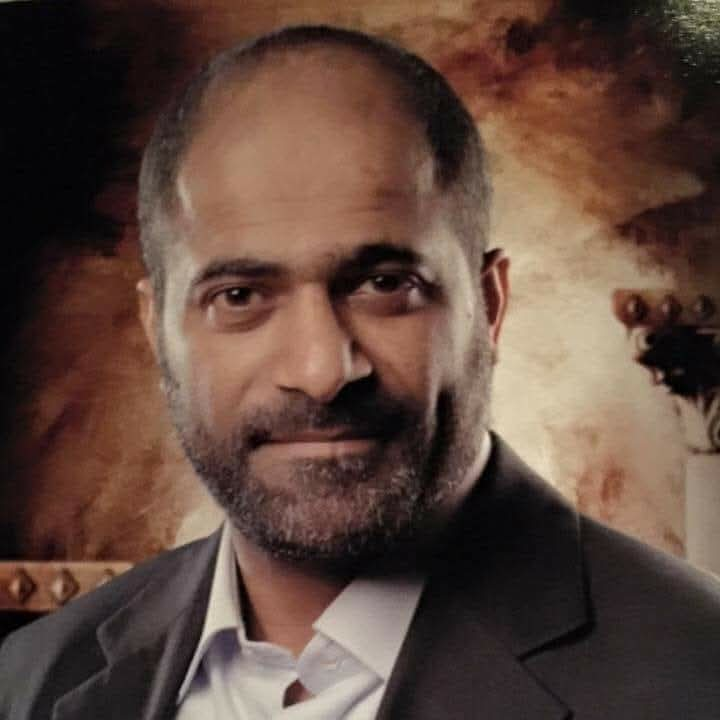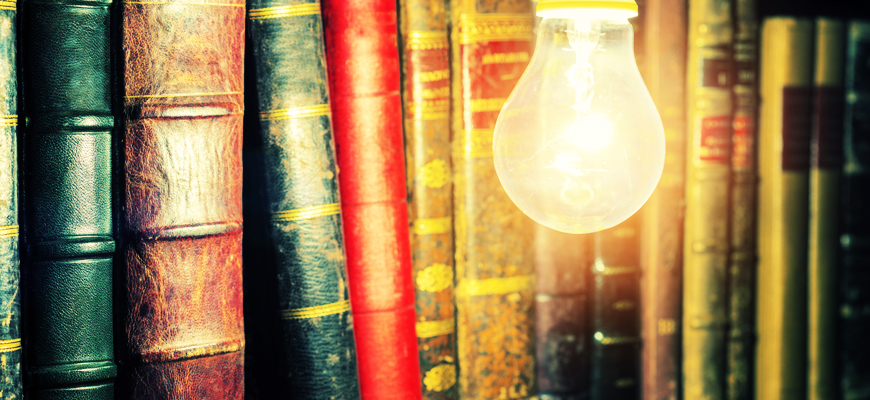في استعادة العلاقة بالماضي، يقف الباحث متأملاً سلسلة معقدة من العلائق الجدلية التي وسمت الفكر الإنساني عبر العصور: بين الفلاسفة وبابوات السلطة الروحية في روما، بين حداثة الشعر العباسي وموقف اللغويين منه، بين الكلاسيكيين والرومانسيين في القرن التاسع عشر، وبين الاتجاهات اليسارية والتيارات الإسلامية الصاعدة. إنَّها دوَّامة فكرية تخطف الأنفاس!
لقد انتصرت الحداثة في مطلع عصر التنوير، معلنةً القطيعة مع التراث، وجعلت الدين خارج التاريخ. غير أن هذه القطيعة، كما يبدو، كانت ذات أثر بالغ الخطورة، إذ غابت الروح، وتحول الإنسان إلى أرقام وآلات، مما أخلَّ بتوازن الطبيعة. وإزاء هذا الاختلال، بدأ العقلاء يدقون أجراس الخطر.
الحداثة كامتداد للماضي: مراجعة نقدية
في كتابها سلطان البدايات، الذي يجمع بين الأبعاد الدينية والاجتماعية والسياسية والتربوية، تطرح الكاتبة الأميركية ميريام دالون رؤيتها بوضوح: "إن الفكرة التي تزعم أن الحداثة قامت على استقلالية ذاتية عقلانية وهم وخداع! بل إن الحداثة في كل مظاهرها ليست سوى نتيجة تحولات ماضوية" (ص55). هذه الأطروحة تثير تساؤلات عميقة، كتلك الدوائر التي يخلفها حجر سقط في مستنقع هادئ.
الكاتبة، إذ تبحث في مفهوم السلطة، تقدم معادلة مثيرة:
السلطة الروحية + السلطة القانونية = سلطان السلطة
بمعنى أن السلطة، وفق منظورها، ليست مجرد أمر، لكنها أكثر من نصيحة. تستطرد قائلة: "كل المفاهيم الراسخة الخاصة بنظرية الدولة الحديثة هي مفاهيم لاهوتية تمت علمنتها" (ص55). وتستعرض في هذا السياق آراء فلاسفة وأدباء كجان جاك روسو، الذين شاركوها القلق إزاء غياب السلطة الروحية.
العودة إلى الروح في النقد الغربي
في حقل مختلف، وهو النقد الأدبي، نجد أن النقاد الغربيين بدأوا يعيدون الاعتبار للروح في الأدب. ففي كتابه النقد التطبيقي الجمالي واللغوي، يؤكد د. أحمد عثمان رحماني أن النقد الغربي بات يُعنى بالروح عناية فائقة، بعدما أيقن أن المادة قد سلبت الإنسان حقيقته، وجعلته عبداً للظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ومن هنا، يرى أن استعادة العلاقة بالميراث الروحي باتت ضرورة (ص49). ويستشهد بمقولة نورمان فورستر:
"إذا كانت حياة الإنسان فعلاً مقرفة وبهيمية تماماً كما يمثلها جانب كبير من الأدب في عصرنا، فإن انتظار الشر المنظم والمميكن والمنطلق الآن في العالم لن يتأكد إلا بكارثة قد احتلت مكانها فعلاً. لن تنقذنا القوات الحربية وحدها، بل يجب أن نعيد اكتساب كل ميراثنا المفقود من الحرية والنظام، وعلى ذلك يعتمد الإيمان بكرامة الإنسان. وهذا لن يتحقق إلا من خلال التجديد الديني للإيمان بالإنسان ككائن روحي" (ص49).
الشعر بين الروح والحداثة
في مجال الشعر، نجد أن التقدم المعرفي الحديث أفضى إلى تشذيب الخيال وتضييق حدوده. في كتابه الصورة الشعرية، يقول سيسل لويتس في الفصل الرابع بعنوان "الصور الفنية المهشَّمة": "إن التقدم في المعرفة والذوق يميل إلى تضييق حدود الخيال وتشذيب أجنحة الشعر" (ص131). ويضيف: "ظاهرة الانفصام بين القيم الروحية والمادية أصابت خيال الشعراء عامة" (ص131).
وهنا يلتقي مع رؤية د. جابر عصفور في كتابه الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، حيث يوضح أن الشاعر الجاهلي كان يرى الشعر قدرة على دقة الوصف والتشبيه، لا مجرد نظم كلمات موزونة مقفاة (ص104). هذا التأكيد على البعد الروحي في الشعر يعيدنا إلى دعوة ميريام دالون لإعادة سلطة الروح، بوصفها تمكينًا لعالم المثل، كما نجد في فلسفة الإشراق عند السهروردي (ص81) أو في الأفلاطونية الحديثة.
خاتمة: تساؤلات مفتوحة
إن كتاب سلطان البدايات عمل فكري بالغ الأهمية، إذ يتتبع التجربة السياسية للسلطة الرومانية القديمة، ويناقش نشأة المدينة واستمراريتها. لكن يبقى السؤال الأهم الذي تطرحه الكاتبة في نهاية عملها: "ماذا حلَّ بالسلطة في عالم بات فيه الانسلاخ عن التقليد والماضي أمراً وجب الرجوع إليه؟ وماذا يحدث عندما تصبح السلطة في مواجهة الفردانية، ونزعة المساواة الديمقراطية، وعندما ينقطع المستقبل عن كل رجاء، كما هو الحال اليوم؟" (ص105).
هذا التساؤل يظل مفتوحًا للنقاش، حيث نجد أنفسنا في مواجهة حتمية بين القيم الروحية والمادية، بين التراث والحداثة، وبين الفردانية والسلطة. فهل آن الأوان لمراجعة هذه العلاقة المعقدة واستعادة سلطان البدايات؟
لقد انتصرت الحداثة في مطلع عصر التنوير، معلنةً القطيعة مع التراث، وجعلت الدين خارج التاريخ. غير أن هذه القطيعة، كما يبدو، كانت ذات أثر بالغ الخطورة، إذ غابت الروح، وتحول الإنسان إلى أرقام وآلات، مما أخلَّ بتوازن الطبيعة. وإزاء هذا الاختلال، بدأ العقلاء يدقون أجراس الخطر.
الحداثة كامتداد للماضي: مراجعة نقدية
في كتابها سلطان البدايات، الذي يجمع بين الأبعاد الدينية والاجتماعية والسياسية والتربوية، تطرح الكاتبة الأميركية ميريام دالون رؤيتها بوضوح: "إن الفكرة التي تزعم أن الحداثة قامت على استقلالية ذاتية عقلانية وهم وخداع! بل إن الحداثة في كل مظاهرها ليست سوى نتيجة تحولات ماضوية" (ص55). هذه الأطروحة تثير تساؤلات عميقة، كتلك الدوائر التي يخلفها حجر سقط في مستنقع هادئ.
الكاتبة، إذ تبحث في مفهوم السلطة، تقدم معادلة مثيرة:
السلطة الروحية + السلطة القانونية = سلطان السلطة
بمعنى أن السلطة، وفق منظورها، ليست مجرد أمر، لكنها أكثر من نصيحة. تستطرد قائلة: "كل المفاهيم الراسخة الخاصة بنظرية الدولة الحديثة هي مفاهيم لاهوتية تمت علمنتها" (ص55). وتستعرض في هذا السياق آراء فلاسفة وأدباء كجان جاك روسو، الذين شاركوها القلق إزاء غياب السلطة الروحية.
العودة إلى الروح في النقد الغربي
في حقل مختلف، وهو النقد الأدبي، نجد أن النقاد الغربيين بدأوا يعيدون الاعتبار للروح في الأدب. ففي كتابه النقد التطبيقي الجمالي واللغوي، يؤكد د. أحمد عثمان رحماني أن النقد الغربي بات يُعنى بالروح عناية فائقة، بعدما أيقن أن المادة قد سلبت الإنسان حقيقته، وجعلته عبداً للظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ومن هنا، يرى أن استعادة العلاقة بالميراث الروحي باتت ضرورة (ص49). ويستشهد بمقولة نورمان فورستر:
"إذا كانت حياة الإنسان فعلاً مقرفة وبهيمية تماماً كما يمثلها جانب كبير من الأدب في عصرنا، فإن انتظار الشر المنظم والمميكن والمنطلق الآن في العالم لن يتأكد إلا بكارثة قد احتلت مكانها فعلاً. لن تنقذنا القوات الحربية وحدها، بل يجب أن نعيد اكتساب كل ميراثنا المفقود من الحرية والنظام، وعلى ذلك يعتمد الإيمان بكرامة الإنسان. وهذا لن يتحقق إلا من خلال التجديد الديني للإيمان بالإنسان ككائن روحي" (ص49).
الشعر بين الروح والحداثة
في مجال الشعر، نجد أن التقدم المعرفي الحديث أفضى إلى تشذيب الخيال وتضييق حدوده. في كتابه الصورة الشعرية، يقول سيسل لويتس في الفصل الرابع بعنوان "الصور الفنية المهشَّمة": "إن التقدم في المعرفة والذوق يميل إلى تضييق حدود الخيال وتشذيب أجنحة الشعر" (ص131). ويضيف: "ظاهرة الانفصام بين القيم الروحية والمادية أصابت خيال الشعراء عامة" (ص131).
وهنا يلتقي مع رؤية د. جابر عصفور في كتابه الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، حيث يوضح أن الشاعر الجاهلي كان يرى الشعر قدرة على دقة الوصف والتشبيه، لا مجرد نظم كلمات موزونة مقفاة (ص104). هذا التأكيد على البعد الروحي في الشعر يعيدنا إلى دعوة ميريام دالون لإعادة سلطة الروح، بوصفها تمكينًا لعالم المثل، كما نجد في فلسفة الإشراق عند السهروردي (ص81) أو في الأفلاطونية الحديثة.
خاتمة: تساؤلات مفتوحة
إن كتاب سلطان البدايات عمل فكري بالغ الأهمية، إذ يتتبع التجربة السياسية للسلطة الرومانية القديمة، ويناقش نشأة المدينة واستمراريتها. لكن يبقى السؤال الأهم الذي تطرحه الكاتبة في نهاية عملها: "ماذا حلَّ بالسلطة في عالم بات فيه الانسلاخ عن التقليد والماضي أمراً وجب الرجوع إليه؟ وماذا يحدث عندما تصبح السلطة في مواجهة الفردانية، ونزعة المساواة الديمقراطية، وعندما ينقطع المستقبل عن كل رجاء، كما هو الحال اليوم؟" (ص105).
هذا التساؤل يظل مفتوحًا للنقاش، حيث نجد أنفسنا في مواجهة حتمية بين القيم الروحية والمادية، بين التراث والحداثة، وبين الفردانية والسلطة. فهل آن الأوان لمراجعة هذه العلاقة المعقدة واستعادة سلطان البدايات؟