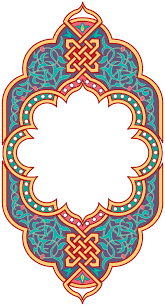قال الله تعالى {وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ } [الحج: 78].
ذكر بعض المفسرين أن الضمير في قوله {هو سماكم} يعود إلى إبراهيم عليه السلام، وذكر البعض الآخر وهو ما رجحه الطبري وابن كثير، أن الضمير يعود إلى الله جل جلاله، هو الذي سمى هذه الأمة بالمسلمين في الكتب السابقة وفي القرآن كذلك.
وعلى كلا التفسيرين، فلا تسمية لهذه الأمة سوى (المسلمين)، ارتضاه الله لهذه الأمة، ليصبح اسمًا ووصفًا لها متلازمين، يُذكِّرها بالحنيفية السمحة، ملة أبينا إبراهيم، والتي تسلَّم نبينا صلى الله عليه وسلم لواءها ومن بعدِه أمتُه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
فعلى ذلك لا يُفرقها مسميات قومية، ولا يُفتِّت أوصالها عِرقٌ أو جنسية، ولا تُشتتها لغة أو لون، ولا تذهب ريحُها بمسميات يُتعصب لها ويُنحاز لرايتها.
لم يمنع الإسلام المسميات التي تعبر عن انتماءات جزئية بشكل مطلق، فقد أبقى على مسميات المهاجرين والأنصار والأوس والخزرج، لكنه قد جعل ذلك في إطار الانتماء العام لراية الإسلام العظمى، فلا يصطدم ولا يتعارض معها، وإلا صارت دعوة مفرقة مشتتة للشمل، منتنة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم.
فعن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رضي الله عنهما. قَالَ: كُنَّا فِي غَزَاةٍ، فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَار! فقَالَ الأَنْصَارِيُّ: يَا لَلأَنصار! وَقَالَ المُهَاجِرِيِّ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ! فَسَمِعَ ذَاكَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقَالَ: «مَا بَالُ دَعْوَى جَاهِلِيَّةٍ؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الأَنصَارِ. فَقَالَ: «دَعُوهَا، فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ» متفق عليه.
فلا يمنع الإسلام التسمي بمسميات تعبر عن رايات جزئية تكون تعيينا لأهلها، طالما كانت سبيلا لخدمة الإسلام دون التعصب لها، ودون عقد الولاءات والبراءات عليها، وإلا صارت هذه المسميات باطلة.
لكن الأصل الذي يجدر بنا جميعا الالتفاف حوله هو نبذ المسميات، فلا نتسمى إلا بما سمانا به الله تعالى {هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ}.
ولكن لما برزت في حقب الإسلام المختلفة فرقٌ مخالفة لأصول الدين وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلها تنسب نفسها إلى الإسلام، رأى المتمسكون بهدْي نبيهم ومنهاجه أن يكون لهم اسمٌ يمتازون به عن أهل الأهواء، فتسموا بأهل السنة، أو أهل السنة والجماعة، والذين يمثلون الإسلام الصحيح، ذلك الاسم الذي يرادف مسمى «المسلمين»، ويعبر عن أهل الصراط المستقيم.
سئل مالك رحمه الله عن السنة، فقال: «هي ما لا اسم له غير السنة، وتلا: { وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ} [الأنعام:153]».
وقال ابن عبد البر: «جاء رجل إلى مالك فقال: يا أبا عبد الله، أسألك عن مسألة أجعلك حجة فيما بيني وبين الله. قال مالك: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، سل. قال: من أهل السنة؟ قال: أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي، ولا قدري، ولا رافضي».
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: «وقد سئل بعض الأئمة عن السنة؟ فقال: ما لا اسم له سوى السنة. يعني: أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها».
ولذا، مصطلح أهل السنة ليس مسمى يعبر عن اتجاه في إطار التعدد المقبول، فليست مذهبًا منفردا ضمن مذاهب أخرى تتبع الحق، ولا علاقة له بالتقسيم الإثني المتعارف عليه في بعض الدول على غرار: سنة، شيعة، أكراد….
إنما هو مصطلح يجسد الإسلام الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يكون العبد من أهل السنة، أو يكون من أهل الأهواء والبدعة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.