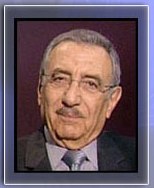منير شفيق
تُعرّف الحداثة باعتبارها «الديمقراطية والتعددية واحترام الرأي والرأي الآخر»، والبعض يضيف «العلمانية» باعتبارها «العقلانية والإنسانية أو الأنسنة»، وآخرون يعرّفونها باعتبارها نقيضاً للأصوليات على اختلافها، القومية واليسارية والوطنية والدينية (الإسلامية على الخصوص). ويضم البعض هنا كل من يتحدّث عن الصراع مع الإمبريالية والصهيونية والاستعمار والممانعة والمقاومة والوحدة العربية، باتهامه نقيضاً للحداثة.
وفي مناخ الثورات العربية ذهب البعض في التعريف النظري أو في التنظير إلى اعتبار كل من له علاقة بالاستبداد، أيّ استبداد خارج العلمانية والحداثة. والاستبداد لا يشمل الاستبداد العالمي، فالدول التي استعمرت غالبية شعوب العالم ونـهبت ثرواتها لا علاقة لها بالاستبداد بما في ذلك إحلال المستوطنين اليهود الصهاينة في فلسطين وطرد شعبها واستملاكها ما داموا سيطبّقون نظاماً ديمقراطياً وتعدّدياً ويحترمون الرأي والرأي الآخر في ما بينهم. فالغرب الاستعماري ونظامه وقِيَمه لبس الحداثة، بالضرورة، وإلاّ تصبح الحداثة فرضية أيديولوجية لا علاقة لها بواقع عياني.
وبهذا تصبح الحداثة لا حدود ولا تخوم لها، وتحمل تعريفاً حسب مقتضى الحال. والأهم تصبح فرضية لا علاقة لها بمكان وزمان محدّدين ولا ببلدان بعينها، وإن كان المتضمّن دائماً هو الغرب باعتباره الحداثة والعلمانية، وهو نموذج الديمقراطية والتعدّدية واحترام الرأي والرأي الآخر وهو العقلانية والأنسنة.
وعندما يرتطم هذا التعريف الفضفاض والمتقلّب بين ما هو فرضية أو نظرية وما هو واقع يهرب أصحابه من الربط بين الغرب والحداثة، فيصبح حديث الحداثة والعلمنة خارج واقع الغرب تاريخاً وحاضراً ليدخل عالم الفرضية أو الافتراض أو النظرية والتنظير، ولكن حين يناقش باعتباره تنظيراً جاء به العقل مستقلاً عن التاريخ والوقائع يصبح هذراً، لأن ما من تنظير يستطيع أن يهرب من حكم التاريخ والوقائع مهما لجأ إلى التأويل.
الحداثة في الأنظمة الغربية منذ الثورتين الأمريكية والفرنسية، وقبلهما منذ ثورة كرومويل في إنكلترا عاشت مع العبودية والرق والتمييز العنصري واستئثار فئة اجتماعية بعينها للسلطة، وصاحبت كل عهود الاستعمار والإمبريالية وهي تغوص الآن إلى حد التماهي بالصهينة بكل ما تحمل الكلمة من معنى.
والسؤال هل يمكن الحديث عن حداثة أو ديمقراطية أو علمنة مثّلها الغرب بعيداً من أنماط من الاستبداد الداخلي مثلاً في استئثار «الواسبس» (البروتستانت البيض الأنكلو سكسون) على الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية، وما مورس من نظام عبودي ثم تمييز عنصري ثم ألوان من التمييز الراهن المعلن والمستتر حتى الآن، ومن ثم تعايشت التعدّدية الديمقراطية وإياه، وكذلك «احترام الرأي والرأي الآخر»، كما يتعايش وجها العملة الواحدة. هذا إذا كان للحداثة موطن ما، ولها علاقة بالتاريخ والواقع ماضياً وحاضراً، وهل يمكن أن يسمّى الوجه الآخر لتلك العملة استبداداً أم ماذا؟ أو قل هل تدخل العنصرية في تعريف الاستبداد أم الاستبداد محصور تعريفاً ووجوداً في التجربة العربية في الأنظمة المستبدة.
أو مثلاً، إشكالية أن يكون رأس الدولة في بريطانيا بروتستانتياً إنجيلياً ورأساً للكنيسة في آن واحد، فلا يستطيع رئيس وزراء بريطانيا، ليس في الماضي بل في الحاضر الراهن، أن يعلن إيمانه بالكاثوليكية إلاّ بعد أن يخرج من الوزارة والسلطة وقيادة حزب العمال، كما حدث مع توني بلير.
ثم كيف يمكن من ناحية أخرى ألاّ تُقرأ علاقة الحداثة المتجليّة في الدول الغربية بما شنّته تلك الدول ومجتمعاتها، وبمباركة الثقافة العامة، من حروب استعمارية سواء أكان في ما بينها أم كان ضدّ شعوب العالم الأخرى.
وما عرفه التاريخ الحديث من سيطرة استعمارية وهيمنة عالمية هل يدخل في حساب الاستبداد؟ والأهم هل له علاقة بالحداثة أو للحداثة علاقة به، أم الحداثة المقصودة موجودة في عالم وهمي أو في عالم غير عالمنا؟
إذا كانت الحداثة خارج التاريخ والواقع، ولا علاقة لها بتاريخ الغرب ماضياً ووضعه راهناً، فكيف تؤخذ معياراً حتى في نقد الاستبداد الذي لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، ولا يحتاج لفرضيات الحداثة الوهمية لنقضه والثورة عليه، فهو نقيض لفطرة الإنسان وبداهته ولأسس العدالة والحق.
نقد الاستبداد يجب أن ينطلق من نقده من حيث أتى وليس استناداً إلى فرضية الحداثة التي تعيش في عالم كان ولم يزل من صناع الاستبداد فيه، ولا سيما في البلدان العربية والعالم ثالثية، فالدولة المستبدّة الراهنة هي الدولة الموروثة من عهد الاستعمار، وقد أسهمت الدول الغربية بحداثيتها الرأسمالية والاشتراكية في التأسيس لها ورعايتها ودعمها، فكيف يمكن نقدها استناداً إلى من أقامها وترعرعت في ظلاله وبناءً على أجنداته.
بل نقد الاستبداد المعاصر الذي عرفته البلاد العربية والعالم ثالثية لا يستقيم ما لم تنقد الحداثة الغربية المشطورة بين حداثة مهيمنة وحداثة تابعة.
فالاستبداد المعاصر استبداد عالمي، والفساد المعاصر فسادٌ عالمي (عولمي)، والتبعية لا تكون إلاّ بوجود الهيمنة العالمية.
لا يستطيع أحد أن يفصل بين ما عرفه نظاما زين العابدين بن علي وحسني مبارك من استبداد وفساد وتبعية من جهة وبين الهيمنة الأمريكية-الغربية عليهما وأجندتها سياسياً واقتصادياً ومالياً وثقافياً.
ولكن باراك أوباما وهيلاري كلينتون استدركا الكارثة التي أنزلتها ثورتا تونس ومصر بنظامين تابعين للولايات المتحدة الأمريكية باعتبار أنّ ما توجّهت الثورات للإطاحة به لا علاقة لأمريكا والغرب والصهيونية به، ولهذا كان لا بدّ من فصل الاستبداد والفساد عن إطارهما العالمي وتجاهل أشكال التبعية والتفريط في القضية الفلسطينية، فيصبح الاستبداد والفساد شأناً خاصاً جداً يتعلّق بحسني مبارك وزين العابدين بن علي وأسرتيهما وبطاميهما. ومن ثم يمكن لأمريكا إلقاء بعض الورود على الثورات التي أطاحت بهما، بل عرض المساعدات عليها لبناء الديمقراطية وتحقيق التنمية.
فيا للمهزلة، ويا لفقدان الذاكرة.
*التجديد والحداثة
تُعرّف الحداثة باعتبارها «الديمقراطية والتعددية واحترام الرأي والرأي الآخر»، والبعض يضيف «العلمانية» باعتبارها «العقلانية والإنسانية أو الأنسنة»، وآخرون يعرّفونها باعتبارها نقيضاً للأصوليات على اختلافها، القومية واليسارية والوطنية والدينية (الإسلامية على الخصوص). ويضم البعض هنا كل من يتحدّث عن الصراع مع الإمبريالية والصهيونية والاستعمار والممانعة والمقاومة والوحدة العربية، باتهامه نقيضاً للحداثة.
وفي مناخ الثورات العربية ذهب البعض في التعريف النظري أو في التنظير إلى اعتبار كل من له علاقة بالاستبداد، أيّ استبداد خارج العلمانية والحداثة. والاستبداد لا يشمل الاستبداد العالمي، فالدول التي استعمرت غالبية شعوب العالم ونـهبت ثرواتها لا علاقة لها بالاستبداد بما في ذلك إحلال المستوطنين اليهود الصهاينة في فلسطين وطرد شعبها واستملاكها ما داموا سيطبّقون نظاماً ديمقراطياً وتعدّدياً ويحترمون الرأي والرأي الآخر في ما بينهم. فالغرب الاستعماري ونظامه وقِيَمه لبس الحداثة، بالضرورة، وإلاّ تصبح الحداثة فرضية أيديولوجية لا علاقة لها بواقع عياني.
وبهذا تصبح الحداثة لا حدود ولا تخوم لها، وتحمل تعريفاً حسب مقتضى الحال. والأهم تصبح فرضية لا علاقة لها بمكان وزمان محدّدين ولا ببلدان بعينها، وإن كان المتضمّن دائماً هو الغرب باعتباره الحداثة والعلمانية، وهو نموذج الديمقراطية والتعدّدية واحترام الرأي والرأي الآخر وهو العقلانية والأنسنة.
وعندما يرتطم هذا التعريف الفضفاض والمتقلّب بين ما هو فرضية أو نظرية وما هو واقع يهرب أصحابه من الربط بين الغرب والحداثة، فيصبح حديث الحداثة والعلمنة خارج واقع الغرب تاريخاً وحاضراً ليدخل عالم الفرضية أو الافتراض أو النظرية والتنظير، ولكن حين يناقش باعتباره تنظيراً جاء به العقل مستقلاً عن التاريخ والوقائع يصبح هذراً، لأن ما من تنظير يستطيع أن يهرب من حكم التاريخ والوقائع مهما لجأ إلى التأويل.
الحداثة في الأنظمة الغربية منذ الثورتين الأمريكية والفرنسية، وقبلهما منذ ثورة كرومويل في إنكلترا عاشت مع العبودية والرق والتمييز العنصري واستئثار فئة اجتماعية بعينها للسلطة، وصاحبت كل عهود الاستعمار والإمبريالية وهي تغوص الآن إلى حد التماهي بالصهينة بكل ما تحمل الكلمة من معنى.
والسؤال هل يمكن الحديث عن حداثة أو ديمقراطية أو علمنة مثّلها الغرب بعيداً من أنماط من الاستبداد الداخلي مثلاً في استئثار «الواسبس» (البروتستانت البيض الأنكلو سكسون) على الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية، وما مورس من نظام عبودي ثم تمييز عنصري ثم ألوان من التمييز الراهن المعلن والمستتر حتى الآن، ومن ثم تعايشت التعدّدية الديمقراطية وإياه، وكذلك «احترام الرأي والرأي الآخر»، كما يتعايش وجها العملة الواحدة. هذا إذا كان للحداثة موطن ما، ولها علاقة بالتاريخ والواقع ماضياً وحاضراً، وهل يمكن أن يسمّى الوجه الآخر لتلك العملة استبداداً أم ماذا؟ أو قل هل تدخل العنصرية في تعريف الاستبداد أم الاستبداد محصور تعريفاً ووجوداً في التجربة العربية في الأنظمة المستبدة.
أو مثلاً، إشكالية أن يكون رأس الدولة في بريطانيا بروتستانتياً إنجيلياً ورأساً للكنيسة في آن واحد، فلا يستطيع رئيس وزراء بريطانيا، ليس في الماضي بل في الحاضر الراهن، أن يعلن إيمانه بالكاثوليكية إلاّ بعد أن يخرج من الوزارة والسلطة وقيادة حزب العمال، كما حدث مع توني بلير.
ثم كيف يمكن من ناحية أخرى ألاّ تُقرأ علاقة الحداثة المتجليّة في الدول الغربية بما شنّته تلك الدول ومجتمعاتها، وبمباركة الثقافة العامة، من حروب استعمارية سواء أكان في ما بينها أم كان ضدّ شعوب العالم الأخرى.
وما عرفه التاريخ الحديث من سيطرة استعمارية وهيمنة عالمية هل يدخل في حساب الاستبداد؟ والأهم هل له علاقة بالحداثة أو للحداثة علاقة به، أم الحداثة المقصودة موجودة في عالم وهمي أو في عالم غير عالمنا؟
إذا كانت الحداثة خارج التاريخ والواقع، ولا علاقة لها بتاريخ الغرب ماضياً ووضعه راهناً، فكيف تؤخذ معياراً حتى في نقد الاستبداد الذي لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، ولا يحتاج لفرضيات الحداثة الوهمية لنقضه والثورة عليه، فهو نقيض لفطرة الإنسان وبداهته ولأسس العدالة والحق.
نقد الاستبداد يجب أن ينطلق من نقده من حيث أتى وليس استناداً إلى فرضية الحداثة التي تعيش في عالم كان ولم يزل من صناع الاستبداد فيه، ولا سيما في البلدان العربية والعالم ثالثية، فالدولة المستبدّة الراهنة هي الدولة الموروثة من عهد الاستعمار، وقد أسهمت الدول الغربية بحداثيتها الرأسمالية والاشتراكية في التأسيس لها ورعايتها ودعمها، فكيف يمكن نقدها استناداً إلى من أقامها وترعرعت في ظلاله وبناءً على أجنداته.
بل نقد الاستبداد المعاصر الذي عرفته البلاد العربية والعالم ثالثية لا يستقيم ما لم تنقد الحداثة الغربية المشطورة بين حداثة مهيمنة وحداثة تابعة.
فالاستبداد المعاصر استبداد عالمي، والفساد المعاصر فسادٌ عالمي (عولمي)، والتبعية لا تكون إلاّ بوجود الهيمنة العالمية.
لا يستطيع أحد أن يفصل بين ما عرفه نظاما زين العابدين بن علي وحسني مبارك من استبداد وفساد وتبعية من جهة وبين الهيمنة الأمريكية-الغربية عليهما وأجندتها سياسياً واقتصادياً ومالياً وثقافياً.
ولكن باراك أوباما وهيلاري كلينتون استدركا الكارثة التي أنزلتها ثورتا تونس ومصر بنظامين تابعين للولايات المتحدة الأمريكية باعتبار أنّ ما توجّهت الثورات للإطاحة به لا علاقة لأمريكا والغرب والصهيونية به، ولهذا كان لا بدّ من فصل الاستبداد والفساد عن إطارهما العالمي وتجاهل أشكال التبعية والتفريط في القضية الفلسطينية، فيصبح الاستبداد والفساد شأناً خاصاً جداً يتعلّق بحسني مبارك وزين العابدين بن علي وأسرتيهما وبطاميهما. ومن ثم يمكن لأمريكا إلقاء بعض الورود على الثورات التي أطاحت بهما، بل عرض المساعدات عليها لبناء الديمقراطية وتحقيق التنمية.
فيا للمهزلة، ويا لفقدان الذاكرة.
*التجديد والحداثة